الشريعة والقانون والأنثروبولوجيا: النسخ والتناسخ
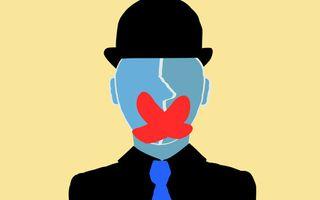
مصطفى لافي الحرازين
من حيث ظاهره يبدو النقاش الذي دار في بلادنا حول إعادة تشكيل الشريعة -وما يزال يدور بصيغ جديدة- وكأنه يرسو على حجج بدهية قادرة على امتصاص أي نقد يوجه إليه أو هضم أي تعديل يطرأ عليه.
وإذا كنا نرى أن الأمر ليس على هذا النحو إلاّ من حيث ظاهره فإن علينا أن نكتشف وراء هذا الظاهر ما يدحضه أو يعيد النظر فيه على الأقل، وهو ما نحاول أن نقوم به في هذه التوطئة لإيضاح ما لا تتوضح هذه الحجج إلاّ به. والواقع أن انتقال الكلام عن عدم المقايسة بين براغماتيات الشرع الإسلامي وبراغماتيات القانون إلى مفاهيم جديدة تصب في التمييز بين الانضباط الذاتي والانضباط المفروض يضع مجمل هذه الحجج على المحك، ويؤمّن لنا سبيلاً نسلكه فيما بعد للمقارنة بين الدعوات الإسلامية إلى التحديث والإرشاد التدخلي الحديث(2).
وإننا في هذا السياق نقوم بقراءتين: أولى تستمد عناوينها من المصاغ حول هذا النقاش وثانية مكثفة تهدف إلى توتير النقد الذي يقوم به طلال أسد وفتح أفق إبستيمولوجي لتتبّع الدعوات الغربية الانشقاقية عن القانون والحكم على مدى قدرتها التفسيرية.
متناولاً آلية تحويل الشرع في الإسلام إلى قانون يشير غاي بيخور في كتابه اللافت من حيث تصنيفه ووضوحه إلى أن عبد الرازق السنهوري قد انطلق لإرساء هذه الآلية من التمييز بين الخاص والعام في التشريع مورداً ما يقوله في هذا الخصوص على النحو الآتي: "يتناول السنهوري في أُطروحته حول الخلافة الإسلامية بعمق السبيل لجعل الشريعة الأصل الجامع للثقافة الشرقية، وذلك بعد تعريضها لعملية اصطناع بالعلم... وقد جاءت المرحلة الأولى من مراجعة السنهوري للشريعة في أُطروحة علمية يبيّن فيها كيف أنه من الأجدى مقاربة الشريعة وفقاً للمنهجية العالمية المعتمدة في القانون المقارن ومقايستها بنظريات حقوقية أخرى. ولهذه المقارنة أن تُفضي إلى اصطفاء المعايير التشريعية التي لا ترتبط بالطقوس الدينية، ولا تنحصر بالمسلمين بل تطال الإنسانية جمعاء. وهكذا تتحوّل الشريعة إلى فرع قانوني في متن الحياة لا تسجنه أطر الفقه المغلقة، ويصبح بذلك جزءاً طبيعياً من الحياة الحديثة"(3).
غير أنه لا يمكننا أن نردّ هذه الآلية -على غرار ما يفعل بيخور نفسه- إلى أسباب تاريخية؛ حيث تصبح المفاهيم وصفاً لتشكل التاريخ، وحيث يصبح من الصعب إدراك هذه المفاهيم بالرجوع إلى روحية اقتحامية للواقع(4) بما يحول دون التقاط العلاقة بين براغماتيات الشرع وبراغماتيات القانون، لا بما هي بدهية ترسم حقل الرؤية؛ بل بما هي موضع سؤال: لماذا أقدم الفكر المحلي الحديث -ومن بعده الفكر الإسلامي التحديثي- على التقريب بين هذين النوعين من البراغماتيات واعتبارهما بمثابة فرعين متضائفين لا ينفصل أحدهما عن الآخر؟
ولذلك علينا في مواجهة هذا النص أن نميّز بين المآرب المعلنة وتلك التي تنتج عن الفعالية وتبقى مشدوده إليها؛ إذ الجملة التفسيرية لا تفسر نفسها بداهة، وإن خرق البداهة لا يعني التخلّي عن المضمون الذي يتلبّس بها؛ بل التبصّر به والكشف عن شحنته المقصدية(5).
وبالفعل فإن اللحظة الانطوائية عن السلطة بما هي لحظة مكثفة قابلة للاشتداد مُنظِمة للفعالية هي التي تُستهدف هنا باسم السعي إلى العصرنة والتكيّف مع متطلبات الحياة وتحرير التشريع من احتباس الفقه في نظم مغلقة، وتمكينه من تحصيل شرعية جديدة تنضاف إلى شرعيته التراثية. ولذلك بالضبط تبرز أهمية الدعوة إلى العودة إلى المفاهيم التأصيلية وبنائها بالمقارنة، وتوسيع دلالاتها بتكثيف فعاليتها، وليس بتوسيع حقل انطباقها حتى تفريغها من مضامينها. وإن عدم قبول الداعين إلى التقريب والإصلاح والتحديث في بلادنا بهذه الدعوة قادهم إلى تقديم صيغ للتقييد والتقعيد ظلت خارج الممارسة الفعلية للإسلام كما يعبّر عنها الدمج بشكل مركّب بين الذكر والتشريع، وهو ما سنبينه مركزين على المسألة الآتية: إن تحويل الشرع إلى قانون يصطدم بمفهوم الطقس لا بما هو خاص في مقابل العام؛ بل بما هو آلية لتشكيل الإنيّة لا تقوم على الفرض(6).
الطقس كتقنية لتشكيل الإنية:
علينا أن نركّز على ما هو مضيء في قراءة بورديو للطقس وضبطه في ضوء فرضيتنا التأسيسية القائمة على عدم المقايسة بين الشرع والقانون وانفتاح أحدهما بالتعاكس على الآخر، متجاوزين ما يقوله بورديو حول مفهوم التطبّع الذي نتخذ منه مثالاً لتبيان الفشل في تحقيق التأمل الانطوائي على الذات، وبالتالي استهلاك نموذج ضبط السلطة الخارجية من دون أن يفتح له أفقاً يحرره من إلزامات الإمبيريقية.
لا يقبل بورديو بالتعريف الذي يعطيه الفكر البنيوي مع فرديناند دي سوسور للغة؛ كونه يغلّب بنية العلامات والعلاقات القائمة فيما بينها على حساب الوظائف العملية لها بما هي وظائف لا يمكن اختزالها، كما يوحي بذلك هذا الفكر إلى مجرد وظائف معرفية أو تواصلية. وهو يرى في هذا التعريف تأسيساً للغة القواعد ووجوب تأسيس إشكالية جديدة تقوم على الانتظام الذاتي للفاعلين: " إن الفاعل الذي ينظم نفسه، أو يحقق لنفسه الاستقامة يتغلّب ببساطة على الجماعة متمكناً من لغتها الخاصة، وهو -ملتزماً بالقواعد محصلاً صيغة مناسبة لها- يكسب الجماعة إلى جانبة مبجلاً القيم التي تبجلها. وفي التشكيلات الاجتماعية حيث يُراقَب بشدة التعبير عن المصالح المادية وحيث تبقى السلطة السياسية غير مترسخة نسبياً لا يمكن للإستراتيجيات السياسية التعبوية أن تكتسب الفعالية إلاّ إذا قدمت القيم التي تتوسلها أو تقترحها بالصيغ نفسها التي تبلور الجماعة من خلالها نفسها. وبالتالي ليس كافياً القول بأن القاعدة تحدد الممارسة عندما يكون ما يمكن اكتسابه بالطاعة أكبر بكثير من عدمها. وما تغفل عنه القاعدة هو تناسي كون الفاعلين لديهم مصلحة في الطاعة أو بمعنى أدق في أن يكونوا في وضعية منتظمة. إن الاختزال المادي الحاد يمكّن من القطع مع النظرية العفوية المبسطة حول الممارسة، غير أنه مسؤول أيضاً عن هذا التغفيل عن الفوائد المتوخاة من الالتزام بالقواعد الذي يشكل مبدأ الاستراتيجيات في المرتبة الثانية من الانتظام الذي يحقق الفاعل من خلاله لنفسه الاستقامة"(7).
منطلقاً من هذه الإشكالية سوف يعيد بورديو الاعتبار لمفهوم الطقس، وذلك بالقطع مع القانون متجنباً هكذا وفي الوقت نفسه النماذج الموضوعية التي يقدمها الفكر البنيوي والأنوية الوجه الآخر للفكر عينه.
غير أنه لن يكون بإمكاننا مقاربة الطقس على هذا النحو وفكّ إقفالات الدعوة المتكررة إلى الدخول في العصر وتجاوز التمييز بين الخاص والعام، وإعادة اللحمة إلى لغة الشرع دون فهم المقصود تفصيلاً بكون الفاعلين لديهم مصلحة في الطاعة التي تبقى عرضة للتأويلات البراغماتية، وخاصة عندما تتلاقى هذه التأويلات مع السعي إلى مناهضة التأمل أو أي علم تفكّري انطلاقاً من الفصل بين النظر والعمل ذي النزعة اليونانية(8). والواقع أن التبصر بهذه العبارة يفتح أمامنا سبيلاً لمقاربة مفهوم الرغبة من منظور جديد بحيث ينكشف لنا مفهوم الإنيّة التي تحكم نفسها بما هو نظام إقفال يحجب كون المقاصد التقدمية هي -تاريخياً- نتاج استخدام لغة القانون الحقوقية للبت بعدم شرعية النفس المتألمة التي لا تركز أو تمتّن الحقل الإرشادي التدخلي الحديث؛ بل إنها تستدعي مفهوم البر الذي يدحضه(9).
وبالفعل فهنا في المصلحة في الطاعة تبرز الرغبة بما هي عملية انضباطية تنتج عن فصل دمج الإنيّة عن الانضباط المحسوب للذهن والجسد بما هو شبيه بالانضباط الكلامي في نظام التراث في الإسلام عبر السعي إلى ضبط الوحي وانفصام الإنسان وتحوّله إلى مكلَّف، وربط هذا الدمج في المقابل بالانضباط الاتباعي، حيث تأخذ تقنية ممارسة الفعالية أبعاداً مركبة، وتتطلب حقلاً مفهومياً يتشكل من مفاهيم متعددة الأبعاد مكثفة الدلالات، هي نتاج مقارنة بين نظم غير متقايسة. وهنا يكمن المعنى العميق للاستقامة، وهو تزويد الإنيّة بأداة تمنع الانضباط من أجل الانضباط، وتفتحه على إمكانية تجربة ذهنية تضع مفهومي الإنية التكلميّة والسلطة الحديثة التدخلية في حال من التواطؤ بين مفاهيم تعدّ متعارضة.
لكن علينا أن ندقق بما نقوله هنا، وذلك من خلال طرح السؤال الآتي، وهو: لماذا لا يسمح نقد الرأسمالية القائم على الدعوة إلى الاختلاف بمثل هذه التجربة الذهنية؟ لأن رفض الانضباط الذي يعود إلى الرغبة كقوة توليدية يُبنى عليها هذا النقد يطفئ أي توتر ضرروي للقيام بهذه التجربة، وأن هذا التوتر لن يتوفر لنا إلاّ بالكف عن تقديم مفهوم موحد لعقيدة الحكم باللجوء إلى عقيدة التواطؤ، وإحلال معنى واحد للعرضي بما هو سند إمبيريقي بدل إبراز المعنى الموسع للسند والإسناد بما هو أداة أو آلية من آليات الجماعة للحيلولة دون احتكار السلطة لفعالية تحقيق الواقعية الذي يسمح لها بالقطع مع السابق عليها أو الطغيان عليه بما هو لا واقع(10).
هكذا مهما حاول النقد استبعاد الرغبة في الطاعة فإنه لن يستطيع تعطيل أثر المفهوم التدخّلي الذي يأتي من تعطيلها وتمويه هذا التعطيل في الوقت نفسه.
ورغم أن هذا التوجه في قراءة الطقس له جذوره كما يوضح طلال أسد في كتابه جينالوجيات الدين في الفكر الرهبني القروسطي؛ حيث يبرز مفهوم الطقس كتعبير عن البرنامج المسيحي القروسطي الجمعي لتطوير الفضائل، وحيث يتجاوز هذا الأمر واقع ارتباط الانضباط بتشكل البنى القيمية ليطال بصورة أساسية النظر إلى السلوك الشكلي بما هو ضروري للمشاركة في التدبير الذي يبدو في النقد حتى في الاتباعي منه كملكة حكم كاشفاً بذلك زيف القراءات التي تربطه بالاستكمال، وتحصر في الوقت نفسه الاستكمال بالكتابة بما هي لا تسمح إلا بالكلام المفصول عن الزمان، ورغم أن هذا المفهوم للطقس سوف يتعرض في ظل حاكمية الحياة الحديثة وفي ظل تحول الانضباط إلى موضوع للتدخلات الإستراتيجية والحسابات الإحصائية للانحسار؛ ليصبح دراما رمزية، هي تعبير عن التحول من الممارسات المخصوصة بالفضائل إلى السلوك الحضوري باعتباره شرطاً مسبقاً لتحول أكبر للحياة المتغايرة إلى نص مقروء؛ إلاّ أننا لا نرى في هذه الفضائل نماذج صافية تدعّم الممانعة ضد الانشقاقات الكلامية التي قادت إلى إخضاع المسيحية لمتطلبات الفصل الإمبيريقي بين التحقق بالفرض والتحقق بالحكم(11).
غير أننا لسنا هنا -على الأقل في هذه المرحلة من معالجة فرضيتنا التأسيسية حول عدم المقايسة بين براغماتيات الشرع وبراغماتيات القانون- بشأن تقديم رؤية متكاملة للرغبة في الطاعة التي تبقى شديدة الصعوبة من جراء انحسار القطع المنهجي القديم وتأصيل الجديد على السوق؛ بل الإشارة بصورة أساسية إلى دورها في إعادة الاعتبار للطقس كمفهوم تأصيلي يتبين منه كيف أن التمييز بين الخاص والعام يؤدي إلى صياغة فرضية وهمية حول ممارسة الفعالية في الإسلام التي تحول دون فرض التشريع باسم العقل؛ أي باسم لغة منطقية متعالية على تراكم لغة الخبر والاحتراف الذي يتجاوز حكماً إمكانية العبور من القديم إلى الجديد إلى إمكانية التدخل لإعادة التوجيه والتنظيم وضبط الانتظام الذاتي للفاعلين.
"الإنسان الإرادوي": السنهوري والفلسفة الاسمية:
هل نحن هنا أمام هوسات أو أخطاء في القراءة؟ كلا؛ لأن تعطيل الرغبة في الطاعة بإحلال الإنيّة التي تحكم نفسها مكانها يتحول فعلياً في نص السنهوري إلى نقطة تقاطع بالغة الأهمية بين نظام التراث في الإسلام والحداثة الديموقراطية، وهو ما يلتقطه بيخور؛ ولكنه لا يستفيد من دلالته: "لقد ناقش السنهوري مفهوم الإجماع في مناسبات عديدة؛ غير أن اهتمامه على الرغم من ذلك لم يكن منصباً -كما سوف نرى- على التجديد الداخلي للشريعة أو على الجانب الديني لهذا التجديد؛ بل بصورة أساسية على الاعتبارات السياسية والقانونية... ولقد ظهرت أُولى مناقشات السنهوري لمفهوم الإجماع في أُطروحته للدكتوراة حول الخلافة الإسلامية مبيناً إياه من حيث هو آلية للتجديد السياسي، وليس من حيث هو تفسير للشريعة: هل هناك ما هو أكثر ديموقراطية من التأكيد على أن إرادة الأمة هي إرادة الله. وهو ما شكل الإجابة النظرية على مسألة الحكومة المنتخبة في الديموقراطيات الغربية. والمنطق النظري الكامن هنا هو وجود تكافؤ بين إرادة الله وإرادة الناس، وبالتالي -وبالمنطق نفسه- فإن كليهما معصوم عن الخطأ وإن إرادة الناس هي عين الديموقراطية"(12).
وبالفعل فإننا حين ندقق جيداً في هذا النص يتضح لنا بالضبط كيف يتم هذا التعطيل الذي يبقى مبهماً لغيابه من جراء العادة أو الغفلة عنه.
ولذلك علينا هنا أن نتجاوز مقاصد كلام السنهوري، وندفع بها إلى حقل اهتماماتنا المنهجية، علينا أن نلتقط الحيثية المعكوسة التي تحملها العلاقة بين إرادة الله وإرادة الناس؛ أي كون "التكافؤ" بين الاثنين لا ينتج عن توجه الإسلام لنشر القوة في الجماعة؛ بل إنه نتاج الانضباط الكلامي المحسوب حيث الله يبدو طرفاً في حوار مع الإنسان، وحيث الحوار يضعهما أمام خيار مستحيل، فإما أن يدخل الله في انتظام العقل أو في نظام تداولي تبادلي يفرض على الطرفين منطق التعاقد، أو تسود حال من اللاقواعد ليرتسم بذلك الحقل السلطوي الحديث وكأنما في خطوطه الأولى(13).
وإننا نستطيع الآن -مستندين إلى ما تقدم- أن نعدّها بمثابة محاولة لإعادة تشكيل الشريعة، تصب في تكثيف مفهوم الإنسان الإرادوي الذي يظهر كبدهي في نص السنهوري؛ ليقفل على أي استشكال ويقطع الأحكام الشرعية عن أي واقع مخصوص بها أي عن أي فعالية ليصبح السؤال في هذه الحالة الوهمية: هل تنطبق هذه الأحكام على الواقع أم لا؟ وإن إدخال مثل هذا المفهوم الذي نستعيره من الفلسفة الاسمية التي تشكلت في سياق الانشقاق عن الفكر الكنسي القروسطي رغم كل ما تتعرض له من تأويل سُيحدث نوعاً من التوتر المنهجي، ويؤدي إلى توضيح معنى الأنوية، وإلى فهم أعمق لبراغماتيات القانون، وأيضاً إلى تحديد منطلقات جديدة لتحديد الواقع هي بمثابة مبادئ يـتأسس عليها المنهج الموضوعي، مبادئ لا تُمس وتظل مقفلة على النقد؛ وذلك لأن المس بها يعطّل البداهة الموضوعية، ويجعلنا نمر إلى نظام منهجي آخر.
علينا إذن إيضاح ما نقوله تدريجياً للوصول في هذا الحجاج إلى بداية خيط ناظم لتفسير فرضيتنا التأسيسية القائمة على عدم المقايسة بين براغماتيات الشرع وبراغماتيات القانون، وتكذيب الفرضية التي تقابلها بها(14).
في محاولته إعادة الحداثة الغربية إلى أصولها التي تأسست عليها للتمكن من تفسير خواتيمها العدمية يشير مايكل غليسبي في كتابه البالغ الأهمية إلى الجدل الذي نشأ في سياق المسيحية في أواخر العصور الوسطى حول علاقة الله بالإنسان، وأدى إلى ظهور الفلسفة الاسمية كانقلاب منهجي على الفكر المدرسي، قام على كون الوجود الفردي هو الوجود الحقيقي، فيما الوجود الكلي هو وجود مخيالي، وهو ما أدى إلى تحول مفهوم الخلق بصورة جذرية باتجاه فصله عن أي غائية، بما هي توسط يستحضر منطق الكينونات الكلية وتكييف اللغة على هذا التحول، الأمر الذي مكّنها من خوض تجربة الخروج من النسق القديم، ووضع حد للجهود التاريخية التي قامت بها الكنيسة للجمع بين الوحي والعقل من خلال السعي إلى الدمج بين المفاهيم المسيحية حول الخالق كلي القدرة والتعاليم الأخلاقية اليونانية. ورغم أن هذا الانقلاب المنهجي سوف يخضع للتعديل في أصوله غير أنه لن يتم إلاّ بثمن باهظ، وهو حصر علاقة الله بالإنسان في مفهوم القضاء والقدر الذي يضع الإنسان ليس في مسار يختاره؛ بل في حقل ضروري لا مفر منه يجري داخله الانتظام ولا يعرف قوانينه(15).
غير أن ما يحصل هنا هو التباس؛ أي فيما تبدو الفلسفة الاسمية وكأنها تدفع بحجج تزعزع العلاقة الثنائية بين الله والإنسان؛ فإنها تُرسي نواة مفهوم الإنسان الإرادوي.
الروحية الاقتحامية للواقع:
ولذلك لا يعّد ما ورد حتى الآن حول المبادئ التي تأسست عليها الفلسفة الاسمية كلاماً في آلية تعطيل النظام القديم للعبور إلى النظام الواقعي الجديد، يُحدث نوعاً من التوتر المنهجي، ويؤدي إلى توضيح معنى الأنوية، وإلى فهم أعمق لبراغماتيات القانون إلاّ من حيث أنه يمسّ بالقراءة المبسطة لها التي تعينها بكونها نظرية أو وليدة مرحلة تاريخية، وليس لأنها نموذج منتظم يتعين على ما هو عليه ويحدُّ نفسه بهذا التعيين. ومن هذا المنطلق فإن دفع هذه المبادئ نحو الانتقال من التطابق بين المفهوم والمصداق إلى الفعالية يفتح لنا سبيلاً نسلكه لحل هذا الالتباس، وهو خطوة لا يمكن لنا إلاّ البدء منها والتوسع بها؛ وذلك لأن بغيابها يدخل الكلام عن هذا الالتباس في دائرة الفراغ، ويهوي إلى ثرثرة مقفلة.
علينا إذن لتفصيل هذه الخطوة أن نعود بداية إلى مايكل غليسبي للتبصّر في خطابه بما يساعدنا على اكتشاف المعابر التي تصل دقائقه باهتماماتنا المنهجية.
وبالفعل يقوم غليسبي في إطار سعيه إلى تفسير المفاهيم على مقتضى ما يريد أن يتوصل إليه بالتدقيق في الفسلفة الاسمية في نقطة بالغة الأهمية، نقطة هي آلية لفك نظام إقفال العلاقة الحتمية بين الله والإنسان. إنها آلية تحققية جديدة تبرز من خلال مفهوم الفرضية: "يعتبر أُكام أن وجود الله وحده هو الوجود الضروري؛ أما المخلوقات الأخرى فهي جميعاً ذات وجود عرضي خاضع لإرادته. وبمعنى تقني فإن الأشياء التي يختار الله إيجادها هي أصلاً ذات طبيعة، غير أن طبائع هذه الأشياء ليست كلية من حيث ذاتها؛ بل إنها تعود إلى كل شيء بمفرده تخصيصاً. وعلاوة على ذلك فإنها محدودة بالعدد ومختارة اختياراً حراً بإرادة إلهية. وهكذا فإن هذه الطبائع لا تُمارس بالمعنى الحقيقي مع الإرادة الإلهية أي إكراه إلاّ استثناءً؛ من حيث إنها تستبعد الممتنع باعتباره متناقضاً منطقياً. فهذه الطبائع لا يستدعيها شيء، ولا هي شرط مسبق لأي شيء آخر. ومن هذه الحيثية فإن حكم أُكام بشأن الفردية الأنطولوجية لا يقوّض فقط الواقعية الإنطولوجية؛ بل أيضاً المنطق القياسي والعلم، فبغياب الكليات الواقعية تصبح الأسماء مجرد إشارات أو إشارات للإشارات... ومن هنا فإن أُكام يرى أن كل وجود فردي هو عرضي يقوم على الإرادة الإلهية الحرة، ومن هنا أيضاً تصبح أية معرفة للمخلوقات سابقة على التحقق مستحيلة. ومن هذا المنطلق نستنتج أنه لا يمكن للبشر أن يدركوا الطبيعة دون التحقق من الظواهر نفسها. وهكذا تحل الفرضية -باعتبارها أساساً للعلم- مكان القياس"(16).
علينا إذن دفع مفهوم الفرضية إلى مزيد من الانكشاف في بنيته الدلالية التي يشير إليها هذا النص مصطدماً بذلك مع تحليلات تبدو راسخة.
ولنسترجع -انطلاقاً من ذلك- ما كنا قد افترضناه حول كون العلاقة بين إرادة الله وإرادة الإنسان كما يبينها السنهوري هي محاولة لإعادة تشكيل الشريعة، تصب في تكثيف مفهوم الإنسان الإرادوي ليقفل على أي استشكال، ويقطع الأحكام الشرعية عن أي واقع مخصوص بها؛ ليصبح السؤال: هل تنطبق هذه الأحكام على الواقع أم لا؟ وإننا هنا نتبين فجأة أن هذا السؤال لا ينتج عن إشكالية العلاقة بين القديم والجديد في حد ذاتها؛ أي من حيث إنها تتطلب جهداً نظرياً مركباً للانتقال والعبور وعدم الركون إلى التقريب المنطقي المبسط بل عن نوع من الأنوية يُقرّر وفقاً لمتطلبات الانتقال من التطابق بين المفهوم والمصداق إلى الفعالية؛ حيث يفقد مفهوم الواقع واقعيته الأرسطية، ويتحول إلى مفهوم بمعنىً مستجد حيث لا تحقق بالقياس وتسهيل الحكم بالتماثل بين الأشياء، وحيث نشهد ولادة الإنيّة الإنسانية التكلمية(17).
ورغم أن هذا التحول هنا يثبت غرضنا الأساس، وهو إمكانية فتح أفق منهجي نسلكه لحل التباس الفلسفة الاسمية؛ فإننا نرى أنه من الضروري توضيح أن هذا الأفق لا يحدث مباشرة قبل التوقف عند المقصود فعلياً في النص من أنه "بغياب الكليات الواقعية تصبح الأسماء مجرد إشارات أو إشارات للإشارات"؛ لما يسمح به ذلك من تكوين نواة له، والانطلاق من هذه النواة لإثبات تشكل الفلسفة الاسمية كمرجعية حديثة جامعة.
لذلك علينا للتقدم في محاولتنا أن نعود إلى أسبقية المسدد على الإنجازي في الحداثة الغربية وذلك من خلال إيراد بعض الملاحظات لكاثرين بكستوك التي تتناول فيها هذه الأسبقية.
هنا في ملاحظات بكستوك تبرز أسبقية المسدّد على الإنجازي من حيث إنها تعبير عن روحية "اقتحامية" للواقع تقوم على تدمير البنية الثلاثية للدلالة وتؤدي إلى وضع الدال في علاقة مباشرة مع السند على حساب المدلول الذي يتوسط الواقع بالثقافة متحولاً بذلك إلى موقع ممانعة(18). وهذه الأسبقية إذ تتخذ من الانفتاح والعفوية سبيلاً لضمان هذه الروحية؛ فإنها تحجب صيغتها المخصوصة من حيث هي صيغة مقفلة وانضباطية بل أكثر من ذلك يؤدي استئصال المدلول من الحقل إلى صياغة مدلول جديد يخفي نفسه ببداهة وجوده؛ ولكنه يعبّر عن طغيان القوة المتركزة ذات الوتائر المرسّخة لتشكل المكان كآمرية، وحيث تبرز أيضاً آلية التعقّب بالعين كنتاج للعبور من الداخل إلى الخارج وكنظرة جسدية ذاتية لا يمكن تصنيفها بالفعالة أو السلبية؛ كونها تعبر هنا عن السعي الديكارتي لمضاعفة فعل الانعكاس على الذات الذي يجعل من إثبات الموضوع صدىً للإنيّة(19).
ومن هنا علينا منهجياً الانطلاق من هذه الملاحظات لإيجاد تفسير لكينونة الأسماء التي مضت وإن نوهنا إليها، ونبادر الآن إلى إيضاح حقيقتها.
ولنشر بداية إلى أننا عندما تناولنا مفهوم الإنسان الإرادوي في الفلسفة الاسمية اتخذنا من محاولة مايكل غليسبي إعادة الحداثة الغربية إلى أصولها التاريخية منطلقاً لقراءتنا المنهجية؛ وذلك لأننا نرى في هذه القراءة نوعاً من التلاوة التكرارية للأصول التي تؤسس القطع المنهجي بين القديم والجديد الذي يأخذ معنى النبذ الفعلي نبذ الحداثة لما سواها. غير أن ما يبدو صعباً على هذا الصعيد هو الجمع بين هذه الأصول من حيث فعاليتها؛ أي من حيث كونها جزءاً من هذه الروحية الاقتحامية للواقع، وهو ما يعبّر عنه غليسبي حين ينطلق من مفهوم الأنا في جملة ديكارت الشهيرة: "أنا أفكر إذاً أنا موجود" ليبين التطويع الذي يقوم به لمفهوم الخالق كلي القدرة عبر تحويل سيولة التجربة إلى انتظام موضوعي تضبطه آلية تحليلية رياضية مستنتجاً بذلك عجز الفلسفة الاسمية عن الدخول في العقلانية الديكارتية من دون الخضوع لمتطلباتها(20).
والواقع أن هذا ما يستفاد من القراءة الأولى؛ غير أنها قراءة لا تكشف إلاّ الجانب الدلالي من هذه الأصول دون إبراز إسهاماتها التي تشدّ نقلاتها إلى مركز ذي ثقل جاذب.
فبعكس ما يتوقع غليسبي من الفلسفة الاسمية أن تحافظ على سيولة التجربة حين تنتقل من التحقق بالقياس إلى التحقق بالفرضية؛ فإنها تتجه إلى إلغاء أي توسط للواقع. وقد كنا افترضنا في قراءتنا لهذا الانتقال أنه فعلياً نتاج العبور من التطابق بين المفهوم والمصداق إلى الفعالية، وبالفعل تشكل هنا أسبقية المسدّد على الإنجازي مدخلاً لصياغة مفاهيم تأصيلية مترابطة لتفصيل هذه الفعالية يشكل مفهوم الاسم نموذجاً لها.
غير أنه لن يكون بمقدورنا تقديم تصور شامل عن هذا المفهوم لصعوبة ذلك؛ كونه يتطلب بحثاً متخصصاً لسنا جاهزين له الآن، على أننا نركز هنا على مبررات قراءته بالعدسة الديكارتية التي تُؤخذ مجدداً من خلال الفن التصويري الحديث بعيداً عن أهدافها منطلقين في ذلك من قراءة لبكستوك توضح فيها هذه المبررات: "كان الشعر التصويري يطمح من حيث مشروعه لتوفير أساسٍ صلب يؤمّن وضوح الموضوع الملموس، ومن هنا تم تمجيد الاسم بما هو الصيغة القصوى للجزء المفهومي من الكلام؛ أي الصيغة الأكثر ملاءمة لتعميد الواقع باللغة. وعلى الرغم من ذلك هناك على الأقل سبيلان لتبيان كيف أن هذا المشروع يحجب الثنائية الديكارتية بين الذهن والإنشاء التي تحدد قبل أي شيء الموضوع كمثال. فأولاً لا يحمل الاسم أي أمارات زمنية أو فعالية ذاتية، وهو لذلك يبدو في آن معاً مستداماً وثابتاً ومعطى. وفي المقام الثاني فإن مثل هذا التجريد لا يقع في تقضي الزمان أو في السرد المعاش بل في الخريطة الديكارتية المجردة اللاتعلقية القائمة على تراصفية مكانية في حقل مغلق"(21).
هنا يبدو أن الأهم في هذه القراءة النقدية يدور منهجياً حول إعطاء مفهوم الاسم صيغته الموضوعية المخصوصة؛ حيث لا تحقق بالفرضية بمعنى الحفاظ على سيولة التجربة الإمبيريقية؛ بل فرض من خارج الحقل يبين -وبغض النظر عن الأسماء التي يحتجب وراءها- آلية خضوع المنطق التشريعي للقانون التدخلي الحديث القائم على فعالية السيادة وفي الوقت نفسه ضحالة استخدام ثنائية الاسم/ الفعل للتعبير عن الانتماء للحداثة(22). ولذلك لم يكن من المستطاع أن يتكون مثل هذا المفهوم ضمن حدود تداول اللغات التقعيدية السابقة على القانون ولا بفعل تجاوزها بتقريبها من تداوليات أخرى أو تعديلها أو اختراقها من الداخل، إذ ما تم فعلياً إنما تشكل نسق جديد استطاع البروز والشيوع بعد أن تمكن من تعطيل مبدئها الكامن في تعلقيتها؛ أي في تغليبها الإنجازي على المسدد بمعنى وجود "واقعين": واقع يعبّر عن نفسه بمطواعية التنمذج والاقتداء التي تعبر عن اللحمة الذاتية للجماعة حيث يقترن الحدثي بلغة القواعد؛ كذكِر أي كفعالية لتوليد قدرة ذاتية على النقد والحكم، وحيث لا ينفصل التشريع عن هذه الفعالية وواقع آخر يُبنى من خلال اللجوء لتعطيل هذا المبدأ إلى تحويل التشريع إلى عملية للترتيبات المكانية بما هي تكثّف السريرة ليس كميتافيزيقيا متعالية؛ بل كإنيّة تسدّد موضوعها وتعطيه علة وجوده واضعةً بذلك الحقل تحت قبضة الآمرية بالفرض(23).
من هنا ليست الشريعة مبادئ عامة يمكن صياغتها بطريقة قانونية إلاّ بقدر ما يتم حجب هذا الانقلاب في مفهوم الواقع الذي يجعل من الصعب الاحتجاج بأرسطو لمواجهة مفاعيله الاشتدادية من دون وجود معيار للإنجازية قائم على نموذج للوحي مدعم بتنزيل لغوي صارم في ثباته.
هكذا يمكننا أن نستفيد من مزاوجة التكافؤ بين إرادة الله وإرادة الناس الذي يبنى عليه السنهوري مع مفهوم الإنسان الإرادوي في الفلسفة الاسمية لتكذيب الدعوة إلى التقريب بين نظم مختلفة حيث يغلب التغفيل على التفسير. وقد كان علينا لتدعيم هذا التوجه أن نشتغل على محاولات غربية لإعادة الحداثة إلى أصولها التاريخية متجاوزيين ما يُكتب في بلادنا عن هذه الأصول(24)، وهو ما ساعدنا على إعادة النظر بمفهوم الموضوعية، واعتباره يعبر عن روحية اقتحامية للواقع تنبسط من التواطؤ بين الله والإنسان لتصبح لغة ممانعة للانتظام دون سلطة خارجية تلك التي تعبر الآن في ظل العولمة عن الانتقال من استبداد القانون إلى استبداد السوق، وهي الإعادة التي نرى فيها آلية منهجية بالغة الأهمية تسمح لنا بالوصول إلى بداية خيط ناظم لتفسير فرضيتنا التأسيسية القائمة على المقايسة بين براغماتيات الشرع وبراغماتيات القانون، غير أن ذلك ما يزال مجملاً أو حتى مبهماً؛ ولكنه يدعو رغم ذلك إلى التأمل أو على الأقل إلى الكف عن تسويق صورة رديئة عن الإسلام بمفرداته(25).
الداخل والخارج: علاقة أخلاقية
وإننا في ختام هذا المحور نريد أن نستكمل هذا التفسير لبلوغ دلالات إضافية تلبي حاجة هذه الفرضية للتوسع أو للقفز إلى أصول جديدة.
يمكننا إذاً أن نمضي في قراءتنا لتوتير النقد الذي يقوم به طلال أسد بإعادته إلى عدم المقايسة وتعريضه في الوقت نفسه لما يحمله مفهوم الذكر من إمكانيات حاسمة لتوسيع نطاقه، وتوسيع نطاق النقد الذي يتجاذب معه، مركزين بصورة أساسية على إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج التي تتجدد بصيغتها القائمة على الثنائية مع الدعوات الغربية الانشقاقية عن القانون، وهو ما يوقع هذه الدعوات في الالتباس ويضع قدرتها التفسيرية على المحك.
ما هي التبدّلات التي طرأت على مفهوم القانون في مصر في ظل المرحلة الاستعمارية وأدت إلى فتح الاهتمام بمفهوم العلمانية؟
ذلكم هو الهم الذي لا يفارق طلال أسد، وهو ما قاده لإرساء مفاصل نقده إلى إعادة قراءة الدعوات المحلية لإصلاح الشريعة، والسعي تزامناً إلى استقدام مدونات قانونية أوروبية، متجنباً تفسير هذا الإصلاح كانتصار لعمل القواعد القانونية أو كتسهيل لتدخل الرأسمالية، أو كصراع مركّب على السلطة بين فاعلين مختلفين، مركزاً في المقابل على أهمية الدولة الحديثة بالنسبة لهذه التبدلات، وعلى كونها من هذه الزاوية ليست سبباً للعلمنة؛ بل صياغة محكمة لها؛ حيث يسعى القانون إلى تحصيل كنه جديد وأدوار جديدة وتوظيف أنواع مستجدة من العنف، وحيث تظهر ثنائية العلاقة بين الداخل والخارج بأوضح صيغة وأكملها كميتافيزيقيا تحديثية بعد تحويلها للشريعة إلى صيغة للأحوال الشخصية(26).
وليس هنا المجال لتفصيل الردود على هذه الدعوات؛ ولكننا نشير إلى أن تعريف طلال أسد لبراغماتيات الشريعة بما هي براغماتيات تعليمية "تربط بطرق مركبة بين الإلزام على الفعل قيمياً والإلزام عليه قانونياً"، هو في صلب هذه الردود، وقد يبدو أن هذا التعريف يقع هنا في التناقض: كيف يتم الربط بين نوعين من مختلفين من الإلزام؟ غير أنه تناقض ظاهري؛ إذ ما يقصده طلال أسد هو بالضبط النتائج العملية للحكم؛ أي إسهامه في صقل السلوك والحيلولة دون إخضاعه كما يجري اليوم للقوالب الجاهزة بتحويله إلى لغة تدخلية، أو بفتحه على مجمل الخطابات الإعلامية والنصائح الحوارية حول ما يجب أن يكون عليه، وليس الإلزام بالفرض الذي يفصل القانون عن الأخلاق، ويعين نموذجه الحديث القائم على العقوبة لا بمعنى ضبط العنف؛ بل بمعنى تفريغ الحكم من أي مكونات تعليمية تجعلها قائمة في حاق الواقع(27).
علينا إذن أن نتوقف ملياً عند هذا التعريف لما يتيحه من إمكانية بالغة الأهمية لصياغة إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج، وتسديدها في مواجهة الروحية الاقتحامية للواقع الناتجة عن آلية التعقب بالعين الديكارتية التي تندسّ في نماذج تفسيرية راهنة يُفترض أن تكون نقيضة لها.
والسؤال الذي نبدأ به هو كيف يكون الإلزام خالياً من الفرض لتتم له القدرة على منع تشكل لغة قانون مكتوبة محصورة التداول، تنفصل عن تطبيق الجماعة لأحكام تشريعية ليس فقط بهدف التنمذج بها؛ بل أيضاً وبالأساس لتحويل العقوبة إلى حالة عرضية، لا ترتب أية مفاعيل اقتحامية للجماعة من قبل السلطة الحديثة التدخلية؟ وإننا ننطلق في إجابتنا عن هذا السؤال من خلو الإلزام من الإنيّة متجاوزين هنا التداولية التي تنطلق من المبدأ نفسه؛ ولكنها تدفعه في مواجهة التحقق بالفرض بالتحقق بالإرادة الذي يقوده في اتجاه الموضوعية لإحكام نظام إقفالها(28). وبالفعل لئن كان الانضباط بالأحكام التشريعية من قبل الجماعة القرآنية يتطلب تغييب الإنيّة؛ فإن هذا التغييب يتعدى تقنياً دوافع الفاعلين ليطال هذه الأحكام نفسها من دون أن يعني ذلك أننا هنا أمام حقل تواصلي لا يتمايز داخله عن خارجه بصورة محكمة وقطعية.
لنوضح إذن هذه النقطة بإزالة الغموض عن معناها للبت بمعنى أن يكون الأمر على هذا النحو وليس على نحو غيره وهو المهم في التفسير.
الشريعة كفعالية بمعيار الذكر:
لعله من الضروري أن نكتشف من هذا المنطلق العلاقة القائمة بين تغييب الإنية ومحافظة الأحكام التشريعية على طبيعتها الخارجية، وإنه ليمكننا -مستندين إلى ما تقدم- أن نصوغ هذه العلاقة بصورة أولية حول ارتباط هذه التغييب بالطابع التعليمي للأحكام التشريعية الذي يحول دون تحولها إلى معطى داخلي تتلبسه الإنية التي تبني موضوعها لتعطّل به نموذج الإلزام الذي لا يتولد في الحقل بما هو إلزام لا يصلح كمنطلق لتحقيق الواقعية بفعالية قسرية تحصر شرعية الواقع بالواقع الذي يُبنى، ولا يسمح من هذه الحيثية بتحويل التشريع إلى عملية تدخلية.
وبالفعل يتيح لنا الانطلاق من هذا الارتباط فرصة الجمع بين خلو الإلزام من الإنية وخارجية الأحكام التشريعية في نقطة؛ حيث مفهوم الواقع لا يقوم على التطابق رغم أهميته في الإبقاء على اللغات المتداولة في أطر الحياة الجمعية بما هي لغات تظهر دلالاتها؛ أي تكتسب شرعية التعبير عن ذاتها؛ بل على الذكر كفعالية تعيد تشكيل عناصر المراتب اللغوية المشككة من موجودية هي كناية عن مفردات ووحدات حدثية دافعة إياها باتجاهات محددة تنتج عنها وضعيات مخصوصة في حقل معين، فيتعين حينها كواقع لا يشتد أو يضعف إلاّ باشتداد وضعف هذه الفعالية. ومن هنا بالضبط ندرك لماذا تشكل التداولية أو ما يدخل في نطاقها من مفاهيم نقدية صيغت في سياق الدعوة إلى التواصل بين الذات والآخر نظام إقفال للموضوعية، فهي بقدر ما تربط بين التوجه القائم على ممانعة استنباط الإلزام من الإنية وتحويل الدال إلى مدلول تدمر طاقة الذكر، وتحول بذلك دون صياغة إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج لتسديدها في مواجهة السلطة التدخلية(29).
لذلك نحن مضطرون هنا إلى القبول مرحلياً بتأسيس هذه العلاقة على الأخلاق متعرضين في هذا المحور ما قبل الختامي لما يقوم به طلال أسد من حجاج منهجي لضبط هذا التأسيس على أسس واضحة ومتينة.
وبالفعل تشكل محاولة طلال أسد تنقية مفهوم الأخلاق من مواضع الخلل التي تولّدها الدعوات الغربية الانشقاقية عن القانون نواة هذا الحجاج المنهجي الذي يقوم به في مواجهة بابر يوهانسن، الذي بقدر ما يركز على "واقعية" الفقه في إطار الحياة اليومية ويفتح بالتالي فرصة فريدة لتحليل الالتحام بين العناصر المكونة للمارسة التقعيدية في الإسلام بعيداً عن الفرضية التطورية التي ما تزال تحكم -وبصيغ أكثر هجومية- التدخل الإرشادي الحديث، فإنه يحصر هذه الواقعية بالاستخدامات الفردية منطلقاً في ذلك من فرضية وهمية حول التعارض القائم بين "العلاقات الاجتماعية والواجبات الدينية المجردة"، حاجباً بذلك السؤال الأساسي حول الطابع الاجتماعي لهذه الواجبات بما هو سؤال يقتضي التبصّر والتأمّل(30).
ن هنا علينا ألا نتسرّع برد هذا الحصر لمفهوم الواقعية بالاستخدامات الفردية وما يؤدي إليه من اعتماد التكاليف الظنية باعتبارها الأصول التي تُقام عليها أبنية نظرية تأسيسية في حقل التفقه اللغوي التشريعي إلى ما يُظن أنه يختزنه من طاقة منهجية تسمح بتحرير الذات من سجن العقلانية الغربية الحديثة، وفي أية حال أن نعي أن دمج الفرد بدورة تنظيم الحياة الجمعية مفيد في قراءتنا، وإن لم يكن بالإمكان التوسع هنا بحيثيات هذا الدمج.
لنتابع إذن الحجاج الذي يقوم به طلال أسد في مرحلته المتقدمة المتمثلة بوضع ما يقوله بابر يوهانسن في سياقه السلبي كموضع اختلال يصيب مفهوم الأخلاق ولا يسمح بتقليب حيثياته المختلفة بحسب النظريات التي يعود إليها: "لنشر هنا إلى أن الجدل الذي يقوم به يوهانسن هو في مجمله جدل معقّد. فمن ناحية هناك الأطروحة التي تشير إلى قيام المشرعين المسلمين تقليدياً بإسناد جميع البراهين الإنسانية... إلى الظن وليس إلى اليقين، فيما نواجه من ناحية ثانية الاقتراح القائل بأن القانون الإسلامي يميز بصورة دائمة بين الأحكام الأخلاقية والأحكام القانونية. وهو يقدم شرحاً مضيئاً لكلا الأمرين الذي يبدو أنهما يرتبطان معاً عبر الفكرة القائلة بأن تأسيس العلم اليقيني على الطاعة- أي على الإلزام الخارجي- الذي يعتمد عليه القانون في مقابل الإلزام الداخلي الذي يشكل مجال "الضمير" وبالتالي الأخلاق. ولا يبدو واضحاً دائماً إذا ما كان اليقين المطلق المشار إليه في هذا الجدل يعود إلى سلطة النص الإلهي أو لتلك التي يقوم عليها الضمير. وعلى أية حال يبدو لنا أنه عندما نتصور "الضمير" كقاعدة خفية للتحكم بالذات؛ فإننا نصبح فجأة أمام شيء ما حديث ومسيحي في الوقت نفسه"(31).
ينتهي هذا النص بكلام بالغ الأهمية يُستفاد منه أن الضمير هو أقرب إلى السريرة، ولكي نوضح ما نقوله علينا ربما أن نضيف هو أقرب إلى أولوية المسدد على الإنجازي التي ارتبطت في تاريخ الإسلام وما تزال ترتبط في الدعوات الإسلامية الراهنة إلى التقريب بفصل التشريع عن الدورة القرآنية، وظهور الأحكام التشريعية كأحكام قانونية لا من منطلق خارجيتها بل من منطلق تدميرها بالفرض لمطواعية التنمذج اللاسلطوية.
هكذا تقودنا هذه الدعوات الانشقاقية عن القانون رغم تحررها من المفاهيم الإسقاطية على الإسلام إلى مفارقة؛ إذ ما إن نقف على واقعية خلو الممارسات التشريعية في الإسلام من العقوبة القانونية حتى نكتشف أننا هنا أمام محاولة للإجابة عما يجب أن تكون عليه الإنية لا تفتح أفقاً لتفسير هذا الخلو، وتُبقي عليه عرضة للتأويلات الإمبيريقية التي تنطلق بالأصل من لا واقعية الشريعة واضطرارها من هذه الحيثية إلى ممارسة القهر. وبالفعل "لا يحتاج الضمير إلى موجه، فأن تملك ضميراً فذلك يكفي"، هذا ما يقوله كانط Kant، وينطلق منه طلال أسد للتمييز ضمن مفهوم الأخلاق بين صيغته الحديثة حيث يبرز اليقين، أي وجوب الوعي بصوابية ما ننوي إنجازه من أفعال كمسلمة من مسلمات الضمير في مواجهة احتمالية الخطأ وصيغته التي ترهن هذه الإنجازية بالعلاقات الاندماجية في الحقل لتبرز كممانعة لسيادة الإنية على نفسها(32).
وبالفعل تكمن الفائدة المنهجية من اتخاذ هذا التمييز كمنطلق لتخطي هذه المفارقة في أنه يسمح -كما يبين طلال أسد- بتجاوز التصور السلطوي الحديث للواقعة العدلية بحيث ينكشف خلو الإسلام من العقوبة القانونية بصورة أفضل نظرياً، وينكشف بذلك زيف تعميم مفهوم الوجود في الخارج.
بهذا المعنى يبدو أن ما هو هام إبستيمولوجياً لا يقوم على الاختلاف بين هاتين الصيغتين من حيث وجود الوقائع العدلية في حد ذاتها؛ بل إنه يتمثل أساساً في كيفية ظهور هذه الوقائع. وهو ما يبعدنا بداية عن النظرة التطورية، ويضعنا أمام عدم المقايسة بين أنظمة مختلفة بحيث لا تصبح هذه النظرة ممكنة إلاّ باندحار أحد هذه الأنظمة، وتمكن الآخر من الاستيلاء على آلياته وتغيير طرق اشتغالها، إذ فيما يتم هذا الظهور بالمعنى الحرفي لهذه الوقائع؛ أي بمعنى انفصالها في ظل سيادة الإنية على نفسها عن حاق الواقع بما هو مجموع الآليات التي تفصل في شروط الإنجازية بين الجماعة الذاتية والسلطة التدخلية؛ فإنه يسلك في إطار ممانعة هذه السيادة سبيلاً مغايراً يجعل من إيقاع العقوبة موضوعاً تعلقياً بالمعنى الذي بيناه عندما عرضنا لملاحظات كاثرين يكستوك حول الحداثة الغربية، وهو ما يفتح أفقاً مضيئاً لصياغة إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج يلحظ قيام الجماعة لتكثيف نفسها وحماية حدودها بتلاوة قواعدها بصورة سابقة على أي إنجازية(33).
غير أنه على الرغم من إمكانية اعتبار الأخلاق جاهزة تلقائياً بعد فرزها لبلوغ هذا الأفق؛ فإن واقع وجودها في حاق الواقع يُظهر أنها لا تتمتع بمثل هذه الإمكانية.
وبالفعل فإن الأخذ بهذا الاستشكال من حيثية أعم تضع الأخلاق بعلاقة غير متساوية بالذكر هو الذي يمكننا من إحداث تقدم منهجي يفتح بصيرتنا على مواضع الضعف في الآمرية بالتخلّق التي تظهر كمواضع اختراق حديثة لمبدأ عدم المقايسة بين براغماتيات الشرع وبراغماتيات القانون، وتؤدي بصورة أساسية إلى الاقتراب من الموضوعية حتى بعد وعينا لزيف ادعائها القدرة على استيعاب أخصامها.
وبالفعل تقوم الأخلاق على نوع من الربط بين الحدثي من المفردات اللغوية/ الأفعال ولغة القواعد يحكم وجودها في حاق الواقع في مقابل الذكر الذي لا يقتصر على كونه غير مُعطى؛ بل إنه موجود قبل المعطيات(34). ولن نعي المقصود بذلك إلاّ إذا تخطينا جوهر الجدل بين طلال أسد وبابر يوهانسن ومن وراءه كانط حول الضمير لنسأل عما يجعل هذا المفهوم -رغم وجهته السلبية المدمرة لعملانية العلاقات الانضباطية- لا يبدو بحاجة إلى ما يجذبه أو يدفعه من خارجه كالتحقق أو الحرية أو الإنجازية الناتجة عن التمييز بين الصواب والخطأ أو بكلام أدق عما يجعله لا ينفكّ عن هذا الربط نفسه؟ وإننا ننطلق للإجابة عن هذا السؤال من فرضية نطرحها في صيغتها الأولية، وهي قابلية الأخلاق للتحوّل إلى معطى داخلي يستدعي الصيغ القانونية التدخلية ويسرّع حلولها مكان الرغبة في الطاعة التي تؤدي إلى الالتحام الذاتي.
علينا إذن إنضاج هذه الإجابة للتمكن في هذا الحجاج الذي يدور حول التنازع على صياغة العلاقة بين الداخل والخارج من بناء رأي ثالث وموقع مستقل.
وإننا نشير من هذا المنطلق إلى أن مفهوماً يبدو شديد الأثر على وجود هذه القابلية، وهو ضعف الطبيعة الخارجية للأخلاق الذي يعود بصورة أساسية إلى وجودها خارج الإنيّة بالتواضع الذي إن كان يؤمّن وقوعها في حاق الواقع قاطعاً بذلك مع الآمرية بالفرض؛ فإنه يجنح إلى ضبط خارجية الأحكام التشريعية "بالمتعارف عليه" الذي يعطّل قدرة هذه الأحكام على تنقية نفسها من تعلّقاتها الحدثية خلال دورة استردادها إلى مقام لغة الذكر بما هو كلام لا يقوم على التواضع؛ بل على أولوية السمع على النظر؛ ليسدّ بذلك السبيل أمام الروحية الاقتحامية للواقع(35).
من هنا فإن أي فصل بين التواضع على الأخلاق واستقلالية الضمير لتدعيم الفصل بين السلطة التدخلية والدوافع الانضباطية للفاعلين يبقى وهمياً؛ إذ قابلية الأخلاق للتحول إلى معطى داخلي لا تؤخذ إلاّ بفعاليتها؛ أي من حيث إنها هي تؤدي إلى تعطيل دمج التشريع بالذكر الذي يمنع اختراق أحكامه بالخطاب الإرشادي الحديث الذي يتميز بالسيطرة وبازدياد مخزون مفرداته المتناسب مع سرعة رواجه في ظل حاكمية السوق النيوليبرالية(36)، وهو ما يعني أن التخلّق القائم على الضمير والتخلّق القائم على التواضع ليسا إلاّ مفهومين للقابلية نفسها، وهذا هو المعنى الفعلي للانضباط المحسوب.
هكذا يتكون لدينا مدخل مفيد لوضع الأخلاق بعلاقة غير متساوية بالذكر يسمح لنا التقدم فيه بالمزيد من الوضوح حول الاستشكال الذي انطلقنا منه، وهو عدم قدرة الأخلاق بجميع صيغها على فتح أفق جديد لصياغة إشكالية العلاقة بين الداخل والخارج، يلحظ قيام الجماعة لتكثيف نفسها وحماية حدودها بتلاوة قواعدها بصورة سابقة على أي إنجازية. ولكن رغم ذلك يبقى النقد الذي يقوم به طلال أسد بالغ الأهمية فهو بقدر ما يجمع بين إثبات واقعية الأحكام التشريعية ولا واقعية الإنجازية التي تقوم على سيادة الإنية على نفسها يقوّض نظم الإقفال المركّبة، ويطال بذلك سياسة القهر في بلادنا بدعوتها الإصلاحية المجردة. ونحن إذ أقدمنا على التبصّر بهذا النقد لم نُقِم التعارض مع بعض مضامينه ونقلاته إلاّ لتوتيره بتعريضه لما يحمله مفهوم الذكر من إمكانيات حاسمة لتوسيع نطاقه وتوسيع نطاق النقد الذي يتجاذب معه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لنشر بهذا المعنى إلى القاسم المشترك بين هذه الحجج وهو فصل الشريعة عن أي واقع مخصوص بها لتُضبط بمفاهيم أخرى تتكثّف بها السلطة الحديثة التدخلية... للوقوف بداية على بعض هذه المفاهيم التي تتطلّب خضوع التشريع لنوع من الحجاج يكون قابلاً للرفض أو القبول من قبل المواطنين انظر:
Abdullah A. An- Nai’im: A theory of Islam, State and Society, in Kari Vogt, Lena Larsen and Christian Moe, Ed: New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition, London, New York: I.B. Tauris, 2009, p. 150.
وحول إسهامات الفكر الإسلامي في إيجاد أصول لهذه المفاهيم التدخلية بتقديم رؤية تطورية للشريعة راجع عبد الكريم سروش: القبض والبسط في الشريعة، ترجمة دلال عباس، دار الجديد، ط1، بيروت، 2002.
(2) للوقوف على بعض الإشارات المهمة التي تأتي في إطار الكلام عن دخول الشريعة في السياقات المعاصرة والتي تُعطي مصداقية لهذا التمييز انظر:
Abbas Amanat and Frank Griffel, Ed: Shari’a: Islamic Law in the Contemporary Context, Stanford: Stanford University Press, 2007, p. 1.
(3) انظر في هذا الخصوص:
Guy Bechor: The Sanhuri Code, and the Emergence of Modern Arab Civil Law, Leiden, Boston: Brill, 2007, p. 43. وهو ما نستشفه من جيل دولوز الذي يركّز مستنداً إلى نيتشة على خلق المفاهيم أي بنائها ضمن حدس مخصوص بها وحيث تقتضي هذه الوجهة البنائية أن يكون كل خلق قائم على أرضية أو في حقل بما هو وجود مستقل وبالتالي أن نَخلُقَ المفاهيم هو أن نفعل شيئاً ما. راجع في هذا الخصوص:
Gilles Deleuze and Félix Guattari: What is Philosophy? Translated by Hugh Tomlinson and Graham Burchill, London, New York: Verso, 1994, p. 7.
(4) ولمقارنة ما نقوله هنا ببعض القراءات المحلية لفكر السنهوري التي تركز على نزعته التحديثية؛ ولكنها تطفئ السؤال الفعلي حول هذه النزعة بما هو سؤال يطال شرعية التقريب بين الشرع والقانون انظر:
Oussama Arabi: Al- Sanhuri’s Reconstruction of Islamic Law of Contract Defects: Error and Real Intent, in Islamic Studies in Modern Islamic Law and Jurisprudence, The Hague, London, New York: Kluwer Law International, 2001, pp. 63- 79.
(5) غير أن هذا المفهوم للطقس بقدر ما يشكل تحدياً للفرضية الامبيريقية يتجاوز النقد الموجه إلى هذه الفرضية الذي لا يقود بصيغته القائمة على المحادثة إلى تشكل السابق على الإنية بما هو يدل على ما هو خارجي وما هو ممانع للسلطة التدخلية بالوقت نفسه. راجع بهذا الشأن:
Charles Taylor: What’s Wrong with Negative Liberty, in Philosophy and Human Science: Philosophical Papers 2, Cambridge: Cambridge University Press, 1985, p. 209.
وكتفريع عن هذا النقد بالنتيجة التي يؤدي إليها حيث تُضبط الإدراة الذاتية للإنيّة بصيغة لا مركزية انظر:
Diana Tietjens Meyers: Decentralizing Autonomy: Five Faces of Selfhood, in John Christman and Joel Anderson, Ed: Autonomy and Challenges to Liberalism: New Essays, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 32.
(6) انظر في هذا الخصوص:
Pierre Bourdieu: Outline of a Theory of Practice, Translated by Richard Nice, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 22.
(7) وإنه لمن المفيد أن نشير هنا إلى ما ينبه إليه بورديو، وهو وجوب ألا ينسينا خلو الطقس من أية قوانين تنتج عن سعي الخبراء لإنشاء معايير حقوقية والعمل على ضمان تطبيقها بالإكراه واقع احتوائه على قدرة لتدعيم الميول الانضباطية للفاعلين بطريقة رمزية ولكن رغم ذلك لا يمكن تجنب التأويلات البراغماتية ما لم نقم بالتبصر في مفهوم الموضوعية الذي يحجبه بورديو بتبنيه مبكراً لجملة دي سوسور: وجهة النظر تبني الموضوع من دون أن يلحظ دورها في ممانعة هذه الميول. راجع في هذا الخصوص:
Pierre Bourdieu, Jean- Claude Chamboredon, Jean- Claude Passeron: The Craft of Sociology: Epistemological Preliminaries, Edited by Beate Krais, Translated by Richard Nice, Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991, p. 33.
(8) للوقوف بداية على ارتباط مفهوم النفس المتألمة بمحاولة المسيحية إنتاج نوع من الأنوية يلبي حاجتها إلى التشكل وتكوين جماعة المتألمين في مقابل الجماعة الاجتماعية التي ميزت العصور القديمة انظر:
Judith Berkins: The Suffering Self: Pain and Narrative Representation in Early Christian era, London and New York: Routledge, 1995, p. 214.
وكإمكانية راهنة لإعادة التفكير في مفهوم البر انطلاقاً مما يسميه بيير بورديو "المجانية" التي تشير إلى ما لا ثمن له ولا سبب له كفعل غير قابل للدخول في السوق النيوليبرالية التي تدفع الآن باتجاه إلغاء أي إنيّة لا تنضبط بالمقاصد التقدمية ولا تخضع بذلك لتحكم اللغة الإرشادية المعولمة راجع:
Pierre Bourdieu: Is Disinterested Action Possible, in Practical Reason: on the Theory of Action, Cambridge: Polity Press, 1988, pp. 75- 91.
(9) للوقوف على نموذج لهذا النقد انظر:
Gilles Deleuze and Felix Guattari: Anti- Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, Translated by Robert Hurley, Mark Seem and Helen R. Lane, London: Athlone, 1984.
وكقراءة لأفكار دولوز تحجب ممانعته لهذه التجربة الذهنية بالتركيز وهمياً على غموض مفهومه لخطة المحايثة راجع:
Christine Kerslake: Immanence and the Vertigo of Philosophy: From Kant to Deleuze, Edinburgh University Press, 2009, pp. 4, 41.
(10) انظر في هذا الخصوص:
TalalAsad: Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, Baltimore and London: John Hopkins University Press, pp. 77- 79.
ولتوضيح ما نقوله حول كون الفضائل نماذج غير صافية بتوفير سند له يتمثل في الحداثة الغربية في اختلاطها بالليبرالية انظر:
Susan D. Collins: Aristotle and the Rediscovery of Citizenship, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 95.
(11) راجع في هذا الخصوص:
Guy Bechor: The Sanhuri code, and the Emergence of Modern Arab Civil Law, Leiden, Boston: Brill, 2007, p. 47.
(12) راجع في هذا الخصوص نظير جاهل: تحرير الدلالة: دروس منهجية في الاقتصاد والاجتماع، المركز الثقافي العربي، ط1، بيروت، 2005.
ولنشر هنا إلى أن الفكر العقلاني عندما ينطلق من تجوهر الحداثة الغربية لا يتمكن من المس بهذه التقنية الانضباطية التراثية، ولا يستطيع مغادرة الإمبيريقية بالكف عن استلهامها تحت عنوان تعطيل التجوهر وإسقاطه على ما يتوفر عليه الإسلام من قدرة انشقاقية عن الحداثة تنبع من نفس ممانعته لمثل هذه التقنية. انظر في هذا الخصوص:
Ian Almond: The New Orientalists: Postmodern Representation of Islam From Foucault to Budrillard, London and New York: I. B Tauris, 2007, pp. 60- 61.
(13) ولنوضح أن ما نعنيه بالتكذيب هنا هو تلك المعايير التي يستخلصها بول فايربند من قراءته لكارل بوبر ويصوغها على الشكل الآتي: "هذه المعايير هي معايير نقدية: إن أي نقاش عقلاني هو حقيقة محاولة للنقد وليس لإثبات الشيء أو جعله محتملاً. فأي خطوة لحماية الرؤية بدرء النقد عنها لتؤمّنها وترسخ قاعدتها هي خطوة تجافي العقلانية. وبالمقابل فأي خطوة تزيد من عطوبتها هي المرحب بها. ومن المفضل ترك جميع الأفكار التي تبيّن خطأها؛ أي ممنوع الإبقاء عليها بعد أن سقطت في مواجهة نقد يتصف بالصلابة وقوة الإقناع إلاّ إذا كان بالإمكان تقديم الحجج المضادة المناسبة". انظر:
Paul Feyerabend: Against Method, London and New York: Verso, 2002, p. 151.
وحول بعض مثالب هذه الفرضية ونقاط ضعفها بهذا المعنى حيث إعادة تنظيم الشريعة قد تم في ظل الغلبة الحديثة على الإسلام وباعتماد مفهوم مغاير لها أدى إلى استبعاد كل ما عدا القانون من لغات تقعيدية راجع:
Rudolph Peters: From Jurists’ Law to Statute or What Happens When Shari’a is Codified, in B. A. Roberson, Ed: Shaping the Current Islamic Reformation, London, Portland: Frank Cass, p. 88.
(14) انظر في هذا الخصوص:
Michael Allen Gillespie: The Theological Origins of Modernity, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2009, p. 14.
وإنه لمن المفيد أن نشير إلى وصف النزعة الاسمية بعقل المطلق الذي يقود إلى لزوم أن تكون "علاقة الفعل بالفاعل حكمية فقط وبالتالي اسمية وليست فعلية ملموسة" لا يحجب فقط هذه النزعة بصيغتها الفعلية القروسطية بل أيضاً بصيغتها الفعلية المتجددة. قارن في هذا الشأن:
Christopher McMahon: Reasonable Disagreement: A Theory of Political Morality, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
(15) راجع في هذا الخصوص:
Michael Allen Gillespie: The Theological Origins of Modernity, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2009, pp. 22- 23.
(16) وإننا نجد في التمييز بين الضرورة المطلقة والضرورة الافتراضية في البرنامج الاسمي حيث التسبب بالعرضي في هذا البرنامج لا يعود إلى الله رغم علمه به بل إلى الاختيار الإنساني الحر مفهوماً تفسيرياً يدخلنا مباشرة في صلب فكرة الموضوعية التي سنعمل تباعاً على توضيحها وبالتالي توسيع مدارك هذا المفهوم. انظر في هذا الخصوص:
Ulrich Langer: Divine and Poetic Freedom in Renaissance: Nominalist Theology and Literature in France and Italy, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1990, pp. 28- 29.
وحول ما يسميه بهذا المعنى هيكو أوبرمان بازدواجية مفهوم العرضي راجع:
Charles trinkaus and Heiko A. Oberman, Ed: The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion, Leiden, E. J. Brill, 1974, p. 13.
(17) ولذلك ليس المقصود هنا وصل الدال بالمدلول بما يؤدي إلى الانتقال من الإقرار بصورة سلبية بما يُعطى للدلالات من تفسيرات تحدد معانيها إلى التأويل الفعال لهذه الدلالات عبر التمييز بين الحداثة والحياة اليومية رغم أهمية ذلك بل إبطال غلبة المسدد على الإنجازي بإنتاج فعالية مضادة لهذه الروحية الاقتحامية. قارن في هذا الشأن:
Henri Lefebvre: Everyday life in the Modern world, Translated by Sacha Rabinovitch, London: Allen Lane, 1972, pp. 24- 25.
(18) انظر في هذا الخصوص:
Catherine Pickstock: After Writing: On the Liturgical Consummation of Philosophy, Oxford: Blackwell Publishers, 1998, p. 90.
(19) راجع في هذا الشأن:
Michael Allen Gillespie: The Theological Origins of Modernity, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2009, pp. 200- 205.
والواقع أن ديكارت حين يحول سيولة التجربة إلى انتظام موضوعي ويعمم هذا الانتظام على رؤيته للخالق فإنه يهدف من وراء ذلك إلى تجاوز ما يبدو صعوبة على هذا الصعيد تعود إلى اقتصار عمل الفكر على ما هو ظني ومخيالي اللذان لا يوصلان إلى شيء وحيث لا بد لذلك من ممارسة التدخل. انظر في هذا الخصوص:
René Descartes: Discourse on Method and Meditations in First Philosophy, Translated by Donald A. Cress, Indianapolis, Cambridge, Hackett Publishing Company, 1993, p. 21.
وحول الأصول الاسمية لديكارت وخاصة تلك التي تعود إلى وليام أُكام وتقوم على الدفع بالمفاهيم إلى نقطة حيث المعرفة الحدسية تتشكل كلياً في إطار الذهن انظر:
Louis Dupré: Passage to Modernity: An Essay in the Hermeneutics of Nature and Culture, New Haven and London: Yale University Press, 1993, p. 81.
(20) راجع في هذا الخصوص:
Catherine Pickstock: After Writing: On the Liturgical Consummation of Philosophy, Oxford: Blackwell Publishers, 1998, p. 91.
(21) وهو ما يعبر عنه عبد الله العروي مفسراً ما حدث في النهضة الأوروبية وما يحدث عندنا كتعبير عن إخفاقنا حيث يقول: "أولاً يبدو لنا... أن السبب أقرب وأوضح مما يدعيه الكثيرون، لم نحسم في أي من المشكلات المطروحة لأن الحسم يتطلب الاعتياد والتمرن على منطق الفعل في حين أننا نطبق على الفعل باستمرار منطق الاسم؛ لأننا نؤمن ونقول منذ قرون إن الموروث من ثقافتنا مبني على العقل إطلاقاً. هذا التعميم والإطلاق في المفهوم يُقلب عند التطبيق العقل إلى لا عقل... وعندما نُرغم على الاعتراف بالخطأ نصيح: هذه مفارقة! هيهات أن تكون مفارقة بل هي عين الموافقة إذ نُخضع مسبقاً الفعل للقول". انظر عبد الله العروي: مفهوم العقل: مقالة في المفارقات، المركز الثقافي العربي، ط1، بيروت، 1996، ص263- 264.
(22) لمقارنة هذا التباين في مفهوم الواقع انظر:
K. L. Schmitz: The Given and the Gift: Two Different Readings of the World, in Jos Kocinski, Ed: Philosophical Papers of Cracow Conference, Lublin: Poland, 1980.
وحول قصور مفهوم الأفعال التعلقية كما يجري استخدامه في الفكر اللغوي عن التقاط هذا النوع من الإنجازية لربطه بين الذات والفعالية بصورة مبسطة لا تُعطي أي تفسير للدوافع الانضباطية للفاعلين مقتصرة في ذلك على الجوانب الحوارية للمقاصد راجع:
R. S. Perinbanayagam: Discursive Acts, New York: Aldine De Gruyter, 1991, pp. 5- 23.
(24) قارن في هذا الخصوص:
ohammed Abed al- Jabri: The Formation of Arab Reason: text, Tradition and the Construction of Modernity in Arab world, Beirut: The Center for Arab unity Studies, 2011.
(25) ولنشر هنا إلى مكمن الفشل في تقديم صورة مضيئة عن الإسلام بمفرداته وهو استهلاك هذا السعي في الاستجابة لمتطلبات الحداثة وإدعاء تجنب تعثراتها باستخدام مفاهيم تفاقم تعثر الإسلام الموروث من نظام التراث بما هي محاولات لضبط الآيات القرآنية بسياقاتها التاريخية. انظر في هذا الشأن:
Donald Berry: Islam and Modernity Through the Writings of Islamic Modernist Fazlur Rahman, Lewiston, New York: The Edwin Mellen Press, 2003, pp. 34- 38.
ولمقارنة هذه الاستجابة الإسلامية للحداثة راجع:
Muhammad Khalid Masud: Islamic Modernism, in Muhammad Khalid Masud, Armando Salvatore and Martin Van Bruinessen, Ed: Islam and Modernity: Key Issues and Debates, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009, pp. 227- 260.
(26) انظر في هذا الخصوص:
Talal Asad: Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford, California: Stanford University Press, 2003, pp. 208- 209, 218, 230.
(27) ومن هنا ندرك لماذا يحتاج الخضوع للعقوبة في النسق السلطوي الحديث إلى تبرير من قبل المعاقَب كتعبير عن إرادته الذاتية بما هي استكمال للإرادة الموضوعية، وهو عدم وجود مفهوم للحكم يقاوم الفرض كالذي تقدمه الشريعة؛ وذلك لاستحالة أي مكونات تعليمية لاصطدام هذه المكونات بالقطع العرضي التي تجد به السلطة الحديثة واقعيتها وصدقيتها بما يكمل لغتها القانونية التدخلية أو الاستراتيجية وفرض الإلزام بها. راجع في هذا الشأن:
Igor Primoratz: Justifying Legal Punishment, London and New Jersey: Humanities Press International, Inc., 1990, pp. 71- 79.
وكمحاولة لتعديل هذا التبرير بإدخال مفهوم الطقس في التحليل انظر:
Christopher Bennett: The Apology Ritual: A Philosophical Theory of Punishment, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
(28) وبالفعل تدعو التداولية مع جون ديوي مثلاً إلى النأي عن استخدام المفردات القانونية التي روجها كانط بين الفلاسقة لصالح الاعتماد على الاستعارات التي تنتج عن اللقاءات بين الناس وليس عن الأحكام التي تصدرها المحاكم ولكن بكلفة كبيرة وهي تبنيها للقطع العرضي بعد وضعه في علاقة تضاد مع الأنوية فيما هو في الواقع مبدؤها الذي تستحيل من دونه. راجع في هذا الخصوص:
Richard Rorty: Philosophy and Social Hope, London: Penguin Books, 1999, pp. 109- 111.
وحول اعتبار المعايير التداولية في النقد معايير ليبرالية وإن لم يكن ذلك بالمعنى العقائدي لليبرالية انظر:
Gray Gutting: Pragmatic Liberalism and the Critique of Modernity, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
ولمقارنة ما نقوله حول تبني التداولية للقطع العرضي من حيث تأسيسه عند ريتشارد رورتي للنيوليبرالية راجع:
Brain May: The Modernist as Pragmatist: E. M. Foster and the Fate of Liberalism, Columbia and London: University of Missouri Press, 1997, pp.65- 71.
(29) ولنوضح هنا أن هذا الجمع بين الإلزام من دون إنية وتحويل الدال إلى مدلول الذي يؤدي إلى تدمير طاقة الذكر يعود كما يتبين من هذه المفاهيم إلى وجود صيغة واحدة للغة هي الصيغة المثالية بحيث لا تنفتح لإعطاء المعنى Signification فرصاً فعلية تحرره من المقصدية باستحضار المطواعية لدي الفاعلين، تلك التي تُحذف وتحوّل إلى حوار وجهاً لوجه بين الذات والآخر تُحكم به العلاقة بين الداخل والخارج. انظر في هذا الخصوص:
Emmanuel levinas: Totality and Infinity: An Essay on Exteriority, Translated by Alphonso, Lingis Pittsburgh: Duquesne Press, 1995. 204- 208.
(30) راجع في هذا الشأن:
Baber Johansen: Contingency of the Sacred Law: Legal and Ethical Norms in Moslem Fiqh, Leiden: Brill, 1999.
ولنقاش مفصل لمصادر الفردية في الحداثة واقتراح حلول نظرية لممانعة هذه المصادر بما يعمق الاستشكال حول شرعية الاستخدامات الفردية انظر:
Charles Taylor: The Ethics of Authenticity, Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press, 1991.
(31) انظر في هذا الخصوص:
Talal Asad: Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford, California: Stanford University Press, 2003, pp. 244- 245.
وإنه لمن اللافت بهذا المعنى أن يستند الجابري في عمله عن العقل الأخلاقي العربي وفي رده على الباحثين من المستشرقين الذين يثيرون مسألة خلو اللغة العربية من كلمة ضمير إلى جان- جاك روسو الذي يعرف الضمير بما هو "مبدأ فطري للعدالة والفضيلة به نحكم على أفعالنا وأفعال غيرنا من الناس بالحسن والقبح" مستنتجاً من ذلك أن "غياب كلمة في لغة من اللغات لا يعني بالضرورة غياب المفهوم الذي تفيده"!. انظر محمد عابد الجابري: العقل الأخلاقي العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، دار النشر المغربية، ط1، الدار البيضاء، 2001، ص120.
ولمقاربة مضمون هذا المبدأ كما يبدو في مفهوم الأنوية الذي يعبر عن قدرة الفاعلين على صياغة وشرعنة القيم التي يحملونها راجع:
Athony J. Cascardi: The Subject of Modernity, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pp. 59- 65.
(32) انظر في هذا الخصوص:
Emmanuel Kant: Religion Within the Limits of Reason Alone, New York: Harper and Row, 1960, p. 172.
(33) وللوقوف في المقابل على ما يُعطى لمفهوم التلاوة في الأدبيات المعتنية بالسرد التاريخي لتطبيق الشريعة حيث يُربط بغلبة الشفاهي على المكتوب وحيث يُطمس كفعالية لتدعيم تملّك الجماعة القرآنية لنفسها راجع:
Sami Zubaida: Law and Power in Islamic World, London, New York: I. B. Tauris, 2003, pp. 27- 29.
ولمقارنة هذا الطمس لمفهوم التلاوة حيث الانتظام وفق النزعة الدستورية الحديثة التي تُستبع لها الشريعة يُستنبط من العقل انظر:
Abdullahi An- Na’im: Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law, Syracuse University Press, 1990.
(34) والمعطى كآلية للقطع مع الذكر هو ما يصوغه أنتوني كاسكاردي بشكل معبر مقارناً مفهوم المنهج بين أفلاطون وديكارت حيث يقول: "يتأسس المنهج الجدلي عند أفلاطون على نموذج لنظام لا يخضع للسياق الأداتي وحيث لا يتوضح الجدل نفسه إلاّ بمفردات وغايات عليا فيما هو بالنسبة لديكارت في المقابل ما نبدأ به. وبكلام أدق تبدأ الإنية الديكارتية من اللاشيء... وبالتالي يؤمّن المنهج البداية حيث لا يوجد بدايات". انظر:
alal Asad: Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford, California: Stanford University Press, 2003, p. 12.
وقارن في هذا الخصوص:
Alan Blum: Theorizing, London: Heinemann, 1974, p. 153.
وحول العلاقة بين اللاشيئية الديكارتية والعدمية راجع:
Alan Blum: Nihilism, New Haven: Yale University Press, 1969.
(35) كمحاولة لصياغة العلاقة بين السمع والنظر بما يستفاد منها اعتبار السمع أوسع من النظر وبالتالي أن لا تبادل بينهما انظر:
Jean- Luc Nancy: Listening, Translated by Charlotte Mandell, New York: Fordham University Press, 2007, p. 10.
(36) يشرح بورديو مرجعية هذه الحاكمية معيداً إياها إلى محاولات كتابة العالم الاجتماعي بلغة رياضية هي اللغة التي كُتب بها اعالم الطبيعي بحسب جاليلي مبيناً بذلك الثورة النيوليبرالية كثورة محافظة من دون أن تعني المحافظة هنا العودة إلى الماضي كما قد يظن البعض بل الإعلان عن نهاية التاريخ. انظر في هذا الخصوص:
Pierre Bourdieu: Political Interventions: Social Science and Political Action, Texts Selected and Introduced by Franck Poupeau and Thierry Discepolo, Translated by David Fernbach, London and New York: Verso, 2008, p. 288.
وحول السوق كمكان لإعادة تعريف الإنيّة انظر:
Talal Asad: Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford, California: Stanford University Press, 2003, p. 158.
