محاولة تحليل ممنهج لظاهرة التطـرف الديني
أضافه الحوار اليوم في
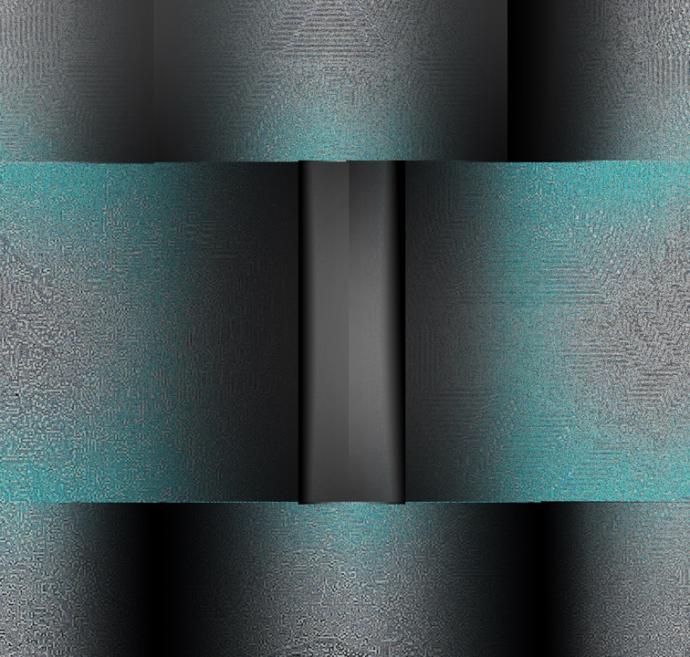
الناصر بن الشيخ
تلخيص لدراسة مطولة قمت بها سنة ١٩٩٠
ننطلق في هذا التحليل من أنّ المجتمع لا يطرح على نفسه إلاّ المشكلات التي يمكنه حلّها، ونتبع هذا المقولة المعروفة لدى علماء الاجتماع بمقولة منهجيّة أخرى و هي أنّ طرح المشكلة بدقّة يساهم بقسط كبير في التوصّل إلى حلّها.
و المتأمّل في ردود الفعل التي أثارها ظهور التطرّف الديني في المجتمع التونسي المعاصر يلاحظ أنّ المشكلة التي يطرحها هذا المجتمع على نفسه منذ أواخر السبعينات إلى اليوم لم يقع النظر لها من وجهة نظر علمية سليمة، من ذلك أنّها اعتبرت في حدّ ذاتها مشكلة عوض أن تعتبر مؤشّرا على وجود مشكلة أعمق. ذلك أنّ التيارات الدينية المتطرّفة لا تمثل، في الواقع، إلاّ مؤشّرا من جملة مؤشّرات عديدة على وجود مشكلة طرحها المجتمع على نفسه و لم يتوصّل بعد إلى وضع التساؤل المنهجي الدقيق الذي يضع الباحث على الطريق الموصلة إلى الحلّ العلمي.
و يرجع هذا الإخفاق، في طرح المشكلة على أسس سليمة، إلى عدم تمكن أغلب المفكرين الذين تعرضوا للظاهرة من الوصول إلى مستوى الصحوة الفكرية الضروري الذي يمكن من الوعي، بأنّ البحث عن الدواء، لمقاومة الداء، لا يتمثل في المقاومة المباشرة للمظاهر البارزة للداء، و إنّما في استقراء هذه المظاهر و اعتبارها مؤشرات يؤدّي تحليلها علميا إلى التعرّف على طبيعة الداء و إلى استنتاج وصفة الدواء الناجع و المناسب.
الدلالات الاجتماعية للتطرّف الديني
يتّفق أغلب الدارسين للتيارات الدينية المتطرّفة في العالم، و التيارات الإسلامية جزء منها، على تزامن ظهور هذه التيارات بمرور المجتمع بما يسمّى بأزمة هويّة عميقة تشكّكه في قدراته على مواجهة تحدّيات الواقع الموضوعي و هي ما نشير إليها عادة بتحدّيات الحداثة أو تحدّيات العصر و إلى أنّ هذه الأزمة كثيرا ما تعطّل، في شرائح هذا المجتمع، حركة الابتكار و الإبداع.
كما يعرّف علماء الاجتماع أزمة الهويّة هذه بأنّها حالة مرضيّة مصدرها خوف من المستقبل و رفض للحاضر و هروب للماضي طلبا للنجاة، و يفسرون ظهور هذه الحالة المرضيّة في المجتمع بحدوث اختلال في نسق النمو بين الواقع الاقتصادي السريع التغيير و التطور، من جهة، و الواقع الثقافي الاجتماعي المتردّي، من جهة أخرى. و المعني هنا بالواقع الثقافي الاجتماعي يتجاوز في محتواه ما تعنيه كلمة ثقافة في مفهومها السائد و الذي يحصر الثقافة في جملة الأنشطة الإنتاجية و التظاهرية و التي تهتم بشؤونها وزارة مختصة في رعاية و تشجيع الآداب و الفنون و التعريف بالتراث و في إقامة المهرجانات الموسمية. كما أن الإشارة إلى البعد الاجتماعي لهذا الواقع تعني تجاوز المفهوم السائد للعمل الاجتماعي و الذي يحصر هذا العمل في جملة من الإجراءات المادية المختلفة من ضمانات اجتماعية متعددة و تأكيد عملي لحقوق الفرد في التّعليم و الصحّة و العمل. فالمعني هنا بالواقع الثقافي و الاجتماعي يتمثل أساسا في حركة الاتصال الاجتماعي بين الأفراد و الجماعات من خلال قنوات اتصالية تربط بين خلايا الجسد الاجتماعي الحيّ، و التي يضمن تواجدها و استعمالها لهذا الجسد قدرته على التجدّد و على تجاوز أزمات التطوّر الطبيعيّة.
و يلاحظ علماء الاجتماع أخيرا، أن الشرائح الاجتماعية التي يمسّها الاختلال قبل غيرها تنتمي في أغلبها إلى نوعين من المجموعات و هما مجموعة المتخصّصين في العلوم التطبيقيّة من المتعلمين من جهة، و مجموعة المهمّشين اجتماعيّا و اقتصاديّا من جهة أخرى.
أولا : المتخصصون في العلوم التطبيقية:
تشير الدراسات التي قام بها الأخصائيون في مراكز البحث العلمي بأمريكا و بفرنسا أن المتعلمين الأكثر تقبلا لنظريات التطرف الديني هم المتخصصون في العلوم التطبيقية. غير أن هذه الدراسات تلاحظ الظاهرة دون البحث عن الأسباب التي تؤهل العلمانيين التقنيين لتقبل مثل هذا الخطاب الديني المتطرف الغيبي و اللاعقلي. و هو ما سنحاول التطرق إليه من خلال تقديم سريع للنمط الفكري السائد لدى هؤلاء المتخصصين في العلوم التطبيقية
يرى علماء النفس و الفكر المعاصر فيما يسمّى بالفلسفة العملية
La philosophie pratique
أن الفكر العلمي التقني السائد يتّصف بالتّركيز على ضرورة الجدوى في التعامل مع الواقع و على التمشي العلمي الناجع في بسط المشاكل التي تعترضه و هذا التمشي يتطلب من المتخصّص أن يحيل عقله إلى آلة. و هو ما يعبّر عنه المفكّر الألماني المعاصر ماكس هركايمر
Max Horkheimer
من مدرسة فرانكفورت التي ينتمي إليها المفكّر الألماني الامريكي ماركوز
H.Marcuse
يعبر عنه بـ
L’instrumentalisation de la raison
أي تحويل العقل الى آلة.
و العقل الآلة يختلف عن العقل العاقل
La raison raisonnante
,فالأول أي العقل الآلة كثيرا ما يكون جاهلا بحدوده و غير قادر على موضع
, نفسه و على التحكم فيها بربط أعماله بغايات ذات صبغة أخلاقية (أنظر كتاب
« La Barbarie
»للفيلسوف الفرنسي المعاصر ميشال هنري
Michel Henri
و أما الثاني وهو العقل العاقل فيكون قبل كل شيء عاقلا لنفسه من عقل الشيء، أي ربطه معترفا بحدوده، أي مرتبطا في أفكاره العمليّة بقيم ذات صبغة روحانيّة إيتيقية ، يتوصّل الى إقرارها من خلال إعماله لملكة التفكير، لا من خلال خضوعه اللاعقلي لقيم أخلاقية تفرض عليه من الخارج.
و يرى الفكر العملي الفلسفي المعاصر أن الوعي الخصوصي بالوجود الذي يتصف به المتخصّص في العلوم التطبيقية، إثر تحويل عقله إلى آلة، يتميّز بالحالات التالية:
الثقة اللامحدودة بعقله الآلة واعتقاده بقدرته الفائقة على القيام بأعمال مجدية لها مردودها المادي الملموس باستنباط حلول تقنية فاعلة في المحيط الطبيعي المباشر. و هو ما يجعله كثيرا ما يخلص إلى القطع المطلق في المسائل المتعلقة بالواقع الإنساني المتصل بالسيّاسة و الاقتصاد و بالتّنظيم الاجتماعي.
اعتبار العلوم الصّحيحة معرفة لا مجال للشك في نتائجها الآنية. و اعتقاده هذا، يحرم المتخصص، الذي يتحول عقله إلى آلة، من القدرة على الابتكار و الإبداع حتى في حقل تخصصه. و يبقى مطبّقا لما تعلّمه دون إمكانية تجاوزه بإثرائه . و هو ما يختلف عن نمط إنتاج الفكر العلمي المعتمد لإبداع التكنولوجيات الحديثة. فالعقل الآلة لا يمكّن صاحبه إلا من استهلاك هذه التكنولوجيات مع الإشارة الضرورية لما ينتج عن هذا الموقف الاستهلاكي من استلاب وحالة تبعيّة كثيرا ما تضرّ نتائجها بالمحيط الخصوصي الذي ينتمي إليه المتخصص.
نتيجة لقبوله المبدئي بالتخصص في العلوم التطبيقية أي بالتقنيات التطبيقية كثيرا ما يقّر هذا المتخصص بعدم فهمه لنمط إنتاج الفكر الثقافي غير النفعي و غير المجدي ظاهريا و الذي يهتم بمسائل أساسية تتصل بالروحانيات و بالفنّ و بكل ما يتعلق بما يسمى بالبعد الوجداني للوجود من أدب و فلسفة و تفكير في مواضيع الحياة و الموت و الحب.
غير أن عدم تفهّم المتخصص التقني لنمط إنتاج الفكر الثقافي يعني في الآن نفسه غربة هذا المتخصص عن ذاته العميقة و فقدان هويته الفاعلة في التاريخ. و الهويّة بهذا المفهوم في علم النفس المعاصر تعني شعور الفرد، العميق، بتّوازنه الداخلي بين شعوره بذاته المفردة و بحاجته للتّغاير. فيكون الشخص المتزن غير الفاقد لهويته مغلقا مفتوحا. مالكا لنفسه و ملكا لغيره. و الغير هنا قد يعني، حسب التّسلسل القيمي، الله ،مالك السموات و الأرض أو المجتمع الذي ينتمي له الفرد، أو الآخر، بمفهوم الفرد المقابل، في إطار العائلة أو وحدة السكن أو وحدة العمل.
تعويض فقدان الهويّة بالتكامل المتناقض بين المادة و الروح.
و تتمثل هذه الظاهرة في أّن غربة المتخصص التقني عن نمط الفكر الثقافي، و التي تنتج عنها غربته عن ذاته العميقة و فقدانه لهويته، تجعل هذا الأخير يشعر بالحاجة الملحّة، على مستوى اللاوعي، لتأكيد هويته الغائبة. و هو ما تعبّر عنه المنظومة الفكرية الغربية بالحاجة إلى الروحانيات إلى جانب إشباع الحاجة للماديات، معترفة بذلك بأنّ البعد الاتصالي و التواصلي للوجود ضروري لاكتمال التوازن الداخلي للإنسان.
و الوعي الثقافي الروحاني بالوجود يمثل على هذا الأساس الوعي الشامل و الموحد لذات الفرد. هذا الوعي الذي يضمن له اكتساب هويته الفاعلة في التاريخ بالمفهوم الإيجابي للفاعليّة. فالفاعلية، بالنسبة للفرد المؤمن، الغير الفاقد لهويته، لا تنتج عن عزل أفعال الإنسان الفرد عن الغايات الربانيّة بل في التوكّل على الله، و التعويل على الذات. و التوكّل يختلف عن التعويل. والمؤمن يتوكّل على الله و يعول على نفسه.لأن الله ، في أ فق نظره، قريب، رحيم، معين. و أينما توجه المؤمن فذاك وجه الله، بالنسبة إليه. و هذا التعريف للفاعلية يختلف عن الفاعلية التقنية الجاهلة بحدودها و المضرّة بالإنسان و بالمحيط.
غير أنّ هذا الشعور بالتوحّد الذي يمكن أن يحس به الفرد يمثل وعيا خصوصيّا بالوجود، اتصف به المتصوفة الوجوديون داخل المنظومات الفكرية الخصوصية للأديان السماويّة، الشرق أوسطية المنبع، وهو تصور يلتقي، في نظرته للوجود، مع تيارات الفلسفة العمليّة التي بدأت تطفو على الساحة الفكرية الغربية منذ أواخر السبعينات اثر تجاوز فكر ثورة 68 دون تجاهل مسبباتها الموضوعيّة. أنظر كتاب
« Soi-même, comme un autre »
الصّادر في مارس1990، للفيلسوف الفرنسي
Paul Ricœur .
أما الروحانيات التي يتحدث عنها الغربيون من خلال الميراث الثقافي اليوناني المتكامل مع ما يسمى بالفكر اليهودي المسيحي
La pensée Judéo-chrétienne
فتتمثل في البعد الغائب عن للوجود. و من هذا المنطلق يتعامل معها نمط إنتاج الفكر الغربي السائد بصفة غيبية، أي لا عقليّة، باعتبارها من الكماليات الروحانية
(Un supplément d’âme)
وليس كحاجة ضرورية يمليها العقل العاقل لنفسه و عليها اعتبارا منه للبعد الأساسي الذي يمثله لديه التكامل بين المادة و الروح للوجود الإنساني.
و بقدر ما يكون الفكر متخصصا في العلوم التطبيقية و مقتصرا على استهلاك النتائج العلمية أو العملية لهذه للعلوم الصحيحة و الجافة، بقدر ما يكون تعامله مع ما يتصل بالممارسات الإنسانية ذات الصبغة الروحانية و الثقافية ،بصفة عامة، إما مبنيا على العاطفة و الاندفاع اللاواعي الذي لا يتحكم فيه العقل أو متجاهلا لهذا البعد الأساسي للوجود.
و هكذا نجد المتخصص التقني يتأرجح بين موقفين متناقضين من القضية الدينية، العقيدية و الثقافية في نفس الآن، و هما الاندفاع العاطفي ،من جهة، و الإلحاد المطلق و احتقار النّمط الفكري الثقافي بصفته غير نفعي و غير مجدي من جهة أخرى. وهو ما يفسّر أنّ الفكر الديني المسيحي اليهودي الغربي مبني على اغتيال العقل، بخلاف الفكر الإسلامي الذي ينبني على اعتماد العقل العاقل الغير العقلاني. كما يتجلى ذالك للعيان من خلال التمشي الإبداعي لنمط فكره الوجودي. فالعارفون بالمسائل الدينية في الغرب يدعون » رجال الدين » بينما العارفون في الإسلام يدعون » علماء » نسبة للعلم الشامل بالوجود و بأبعاده المختلفة و هو مفهوم للعلم يتجاوز معناه مجال العلوم الموصوفة بالصحيحة و لا يتناقض معه
و اعتبارا لكلّ هذا نقول إن الدّين الذي يتحدث عنه المتخصّصون في العلوم الصحيحة ممن استهواهم التطرّف الدّيني من المسلمين يمثّل في الواقع تغريبا للإسلام، و استلابا للمسلمين لا يخدم الحضارة الإسلامية بقدر ما يساعد على تحويلها إلى نظرة ثنائية للوجود تفقدها خصوصيتها الإسلامية التي تأسست عليها .
و ليس غريبا إذا أن نجد الفكر الدّيني المتطرّف الذي يعتبر خطأ أصوليا والذي يعتمد الفكر العقلاني الثنائي في تأويله للوجود، ينتشر بسهولة في صفوف طلبة المعاهد و الكليات المتخصصة في تلقين العلوم التطبيقية و الصحيحة مثل كلّيات العلوم والطب ومعاهد الهندسة إلى آخره. و كما أشرت إلى ذلك سابقا فإن هذا التّعامل اللاعقلي مع التصوّر الإسلامي للوجود يختلف عن التصور الاسلامي الأصيل المبدع الذي يعتمد إعمال العقل حتى في المسألة الدينية.
و من الملاحظ هنا أن الفكر الديني الغيبي ليس غريبا عن المجتمع التكنولوجي الأمريكي مثلا. حيث نجد الإيديولوجية السائدة تعتمد مقولة الأخذ بناصية العلوم الصحيحة المنتجة للتكنولوجيا الحديثة من جهة و العمل بما جاءت به الأناجيل من جهة أخرى. و لا غرابة أن نجد في المجتمع الأمريكي الحديث و المعاصر من يتعاطف مع الفكر الإسلامي المتطرف أو الفكر اليهودي المتطرّف أيضا (أنظر كتاب :
« La revanche de Dieu »
للباحث الفرنسي جيل كيبال
Gilles Keppel.
فالأصوليات بمعنى التطرف الديني تنقض بعضها البعض لكنها لا تتناقض أساسا و تعزّز بعضها البعض من حيث لا تشعر أو تشعر و تتناغم في العمق.
هذا التحليل للمنظومة الفكريّة التقنيّة السائدة لم نورده بغية نقد الفكر الغربي أو الحضارة الغربية بوجه عام و إنما قمنا بتقديمه لتسليط الضوء على مقومات الفكر التقني الذي نعتمده في تكوين مهندسينا و تقنيينا و الكثير من إطاراتنا الجامعية و غير الجامعية و هو تقديم يفسّر إلى حدّ كبير مواطن القوة و مواطن الضّعف فيه.
و من المعطيات الخفية لهذه النظرة التقنية للوجود و ما تعتمده من ثنائية مستلبة للهويّة يمكن الإشارة إلى أن هذا التصوّر الثنائي للوجود هو أساس التوازن المفتعل الذي سمح إلى حدّ الآن للمجتمعات المتقدمة تكنولوجيا بالسيطرة على العالم، متسلّحة بالفكر التقني العلماني و مشبعة حاجتها الضرورية للغذاء الروحي بتحرير التعبير الفردي و العاطفي إلى أبعد الحدود. و ذلك من خلال تطبيق المقولة المعروفة بأن للقلب دوافعه و حججه التي يجهلها العقل. و بأنّ الألوان و الأذواق ليست محلّ نقاش و بأنّ المسألة الدينية تتّصل بضمير الأفراد و غير قابلة للنقاش أيضا.
و يمكن الاستطراد حول هذا الموضوع لتوضيح أبعاده الحضارية بذكر الأزمة الموضوعية التي يعيشها الفكر الغربي المعاصر. و التي أكدت طبيعتها الدلالة الخفية لردود الفعل المختلفة لما يسمى بالرأي العام الغربي عندما جوبه بوقائع حرب الخليج الأولي بصرف النظر عن تفسيرات هذه الأخيرة السياسية أو الاقتصادية أو التاريخية. و ذلك بالإشارة إلى التناقض الذي اعترى شعور المثقفّين الفرنسيين و مفكريهم إزاء هذه الأحداث و هو تناقض تأرجح بين الشعور بالذنب للأبعاد اللاأخلاقية لهذه الحرب من جهة و الشعور بالاعتزاز لما توصّل إليه الغرب من تقدّم تكنولوجي (أنظر ما أوردته جريدة « لوموند ديبلوماتيك
« Le Monde diplomatique »
في عدد خاص بأزمة الخليج تحت عنوان « حرب نظيفة جدا
» (Une guerre si propre).
و تشير عمليات سبر الآراء إلى أن الجماهير الغربية بأوروبا و أمريكا تعاملت مع الأزمة باتخاذ موقفين متناقضين تماما. الأول مؤيد للحلول السلمية قبل بدء ضرب العراق وهو ما جعل الرئيسين الفرنسي و الأمريكي يتظاهران بالبحث عن كل الوسائل الممكنة للتوصل إلى حلّ سلمي بالطرق الدبلوماسية مع مواصلة الإعداد المحكم للقيام بالحرب.
أما الموقف الثاني فتمثل في التحول السريع إلى نقيض الموقف الأول و هو التأييد الشبه الكامل للحلّ الحربي ابتدءا من بدء ضرب العراق في 17 جانفي 1991 . و المتأمل في معنى هذا التناقض يمكنه أن يفسّره بالرجوع إلى طبيعة المنظومة الفكرية السائدة في المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا و التي سبق تحليلها و تقديمها بكونها تعتمد التكامل المتناقض بين عقل آلة جاهل بحدوده و نظرة غيبية عاطفية للقضية الأخلاقية و الإنسانية الثقافية.
فالرأي العام الغربي تعامل مع الأزمة، قبل الحرب، من خلال القيم الأخلاقية الثقافية المعلنة : العدل و السلم و المساواة و حقوق الإنسان إلى آخره، و تعامل مع نفس الحدث، بعد بدء ضرب العراق، من خلال العقل الآلة الذي يبهر بالوسائل دون التفكير في الغايات. و هو ما يفسّر التناقض بين الشعور بالذنب من جهة و الشعور، من جهة أخرى، بالاعتزاز بما حققته آلتهم الحربية و الصناعية من انتصارات علمية و تقنية على كل الذين حدثتهم أنفسهم بمطالبة الغرب بأن يكون موقفه أكثر ملائمة لما يمليه العقل.
ذلك أن هذا الفكر التكنولوجي السائد الذي يعتمد العقل الآلة المتخصص و يضمن توازنه الداخلي بالتعامل الغيبي المبدئي مع القيم الأخلاقية الإنسانية يتخذ من ثنائية نظرته للوجود مصدرا لقوته الفاعلة و الجباّرة دون أن تتمكن مبادؤه المعلنة الأخلاقية و الدينية من التحكم في هذه القوة و لو تحولت إلى آلة دمار و استغلال مجحف للموارد الطّبيعية و تسبّبت في الإخلال الخطير بمقّوّمات الحياة على الأرض.
ثانيا : سكان الأحياء الشعبية الجديدة
ونذكر في هذه المرحلة من التحليل بما أوردناه سابقا من أن الشرائح الاجتماعية التي يمسّها اختلال التوازن بين البعد الاقتصادي المتطور و البعد الثقافي المتردي تنتمي إلى مجموعة المتخصصين في العلوم التطبيقية من جهة و إلى جماعة المهمّشين اقتصاديا و اجتماعيا من جهة أخرى. و نتعرض الآن لذكر المجموعة الثانية بمواصلة التحليل المنهجي للنمط الفكري و التقني السائد.
و نشير إلى أن النظرة الثنائية للوجود التي تؤسس للفكر التقني و لنمط التنمية الذي تعتمده المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا بقدر ما هي مصدر قوة في عملية السيطرة على الموارد الطبيعية و تحويلها إلى سلع
( و معنى السلع يختلف عن معنى الخيرات )
بقدر ما تحدث مضاعفات ثانويّة متلفة للمحيط الطبيعي و للنسيج الاجتماعي.
و لدرء خطر هذه المضاعفات على مقوّمات الحياة الطبيعية على الأرض و على صحة الجسد الاجتماعي يقع تكثيف الجمعيات التحسيسية و الاتصالية المختلفة و هي جمعيات ذات صبغة ثقافية تعني بالمحافظة على المحيط و مقاومة التلوّث و بالتضامن الاجتماعي الغير الرسمي و بالنشاط الثقافي الجماعي.
و المتفحّص في نمط النمو المعاصر و الذي بات من الصعب التخلّي عنه و عدم إتباعه يلاحظ أن إتلاف النسيج الاجتماعي يمكن اعتباره ضريبة ضرورية يجب أن يدفعها كلّ مجتمع يريد التقدم تكنولوجيّا، شريطة أن يتخذ الساهرون على التوازن الداخلي للأفراد و الجماعات داخل هذا المجتمع الإجراءات الضرورية لتعويض غياب الاتصال الاجتماعيّ بالاتصال الثقافي الجماعي.
و يشير علماء الاجتماع ممن درسوا التطّرف الديني في الأحياء الشعبية الجديدة إلى أن المتطرفين الدينيين يعمدون إلى استغلال الفراغ الاتصالي الذي يحدثه إتلاف النسيج الاجتماعي، بتأسيس علاقات اتصالية بين الأفراد المهمّشين، مبنية على أسس التضامن و التكافل و موجهة في الآن نفسه ضد بقية المجتمع.
و إن قلنا بأنّ إتلاف النسيج الاجتماعي حتمي بالنسبة للمجتمعات التي تعتمد هذا النمط الإنمائي التقني فذالك يرجع، حسب اعتقادنا، إلى طبيعة هذا النمط الفكري نفسه. فعمليّة التجزئة الضرورية، بالنسبة لهذا الفكر الثنائي النظرة، تبدأ بالتفرقة بين المادة و الروح و هو ما يبدوا بعيدا عن مشاكل التنظيم الاجتماعي للإنتاج الاقتصادي و استغلال الموارد الطبيعية و استعمال التقنية المتطوّرة.
غير أن التحليل العلمي للمنظومة الفكريّة السائدة نستنتج منه وجود علاقة أكيدة بين هذا التقسيم الأساسي بين المادة الروح والذي يفتح باب التخصص، للعقل، في استغلال المادة بعد إحالة المسائل الثقافية ذات الصبغة الدينية و الجمالية على دائرة الأحاسيس و العواطف ينتج عنه كذالك تقسيمات تسلسلية تمسّ واقع الأفراد و الجماعات بتحولهم في نهاية المطاف إلى ذرّات من الغبار. من ذلك تقسيم المجتمع إلى فئات متخصصة حسب رتبة كلّ واحد منها في المجتمع و حسب مردودية وظيفته في الدورة الاقتصادية أو حسب قدرته على اكتساب الربح الماديّ الصّرف.
و هكذا تتغيّر، شيئا فشيئا، القيم القديمة التي كانت تضمن توازن المجتمع قبل تحوّله إلى مجتمع تقني، فيزاح معلم القرية من مكانته الاجتماعية المحترمة ليعوّض في أعلى الهرم القيمي بالتقني المتخصص أو برجل الأعمال المحلّي المالك للثروة و الموجد لمواطن الشغل. و يبهر الريفي الشاب و الكهل بأنوار المدينة ليقطع صلة الرّحم التي كانت تربط أباه وجدّه بأرضه و بعائلته الكبيرة و ينزح إلى مجتمع الأفراد المعزولين حيث تلفظه دورة الإنتاج لعدم تخصّصه أو تحيله إلى آلة إنتاج لا تمثّل قدرتها الإنتاجية البدنية إلا جزءا صغيرا ممّا توفره الآلة الميكانيكية من منتجات . كما يترتّب عن هذا الانزلاق القيمي
(Glissement de valeur)
أن الخلايا المنبتّة و التي يلفضها المجتمع لعدم قدرتها على إيجاد مكان لها في دورة الإنتاج، تؤسس مجتمعات صغيرة موازية، مبنية على غريزة حبّ البقاء البدائيّة و ذلك باللّجوء إلى أشكال منحرفة من الحياة الجمعياتية المعادية للمجتمع.
التكامل الموضوعي بين الطموح التقني الى السلطة السياسية و طموحات المهمشين الى حياة أفضل
إذا إعتبرنا القيمة المركزية التي يضفيها المجتمع التقني على النشاط المنتج الناجع و المربح، فهمنا القيمة الاجتماعية التي يعترف بها المجتمع للتـّـقني المتخصص. و إذا ما ذكّرنا الى جانب ذلك بطبيعة المنظومة الفكرية التي يعتمدها صاحب العقل الآلة و ما تتضمنه من حبّ للسيطرة و من جهل بشموليّة الواقع الإنساني المعقّد، يمكننا تفسير الطموحات التي قد تستهوي المتخصّص في العلوم التطبيقيّة و تدفعه للمطالبة بتسلّم مقاليد السلطة السياسية. كما يمكّننا كذلك التفطّن للوسائل الناجعة التي سيستعملها لبلوغ مآربه. فالقيمة المؤسسة لمركزه الاجتماعي و هي النجاعة و الفاعلية تؤهله أكثر من غيره إلى استنباط الخطط السياسية ذات الجدوى السريعة. فيحوّل الخطاب السياسي إلى تقنيات تعبئة حديثة، غايتها التوصل إلى إحداث تغييرات كميّة و هامة في الرأي العام و إلى نتائج ملموسة و ذلك بأقل التّكاليف. و يتّخذ استعمال هذه التقنيات شكل مخططات علمية مدروسة لا تأخذ في الاعتبار نوعية الوسائل – إن كانت محرّرة للعقول أم لا بقدر ما تركّز على الفاعلية، مثالها في ذلك النّمط الفكري التكنولوجي السّائد. و طبيعي أيضا أن يفكّر صاحب الفكر العلمي المتخصص، إن كان ينتمي إلى مجتمع مسلم، في اختيار أنجع السبل و اقلّها تكلفة لإنجاح مخططاته السياسية الثورية الانقلابية. فلا يجد أمامه من سلاح أفتك من الخطاب الديّني المتطرف لتعبئة المجتمعات الصّغيرة المهمّشة و رمي النظام القائم بها. و ذلك بعد تفطّنه لمردودية الجمع الناجع بين وسيلة فعّالة و مقنعة في قمعها للعقول و هي الخطاب الديني المتطرّف من جهة و فئات محرومة في أشد الحاجة إلى المشاريع الاجتماعية البديلة. هذه المشاريع التي توصف أو تتصف بالطوباوية و هي بصفتها هذه تتناقض تماما مع مقّومات الفكر التقني و ترفض هذا الواقع المعاصر الذي ينتجه هذا الفكر. ممّا يجعلها مشاريع تعبويّة مرحلية غير ناجعة على الأمد المتوسّط و البعيد.
و لقد دلّت التجربة الإيرانية أن النجاح السياسي لمثل هذه المشاريع البديلة التي تستعمل الجمع بين الخطاب الديني المتطرف و طموحات المستضعفين لا ينتج عنها أي تغيير حقيقي للمجتمع. و لا تؤدي البتّة إلى حلّ مشكلة تهميش الخلايا المنتجة و الغير الصالحة لآلة الإنتاج
. تكون نتيجة هذه المشاريع البديلة وصول المتخصصين في العلوم التطبيقية إلى السلطة السياسية بلبسهم العمامة و عتقهم اللّحي و حملهم البندقية أثناء مرحلة الثورة، و بعدها يتحوّلون الى تقنوقراطيين تيوقراطيين يديرون شؤون المجتمع من خلال الفكر التقني السائد و التعامل اللاعقلي مع الدين على الطريقة الغربية، متنكّرين في آخر المطاف للإسلام المحرّر للذات و الموحد للفرد و المنير للعقول و المفجّر للطاقات الابداعية في المجتمع. و هو التمشي الذي أراد تمريره الرئيس أبو الحسن بني صدر دون أن يفلح في ذلك. و هناك من المؤشّرات الموضوعية ممّا يدلّ على أن النظام الإيراني الجديد و المجتمع الذي أسسّه أقرب للمثال الغربي السائد من الذي كان عليه المجتمع الإيراني تحت حكم الشاه. و ذلك لما كان يشوب مجتمع الإمبراطور من مراجع حضارية تتصل بتاريخ إيران العريق و من عدم تشريكه الكنيسة الشيعية في الحكم و عدم اعترافه بالإطارات الكثيرة من التقنيين الذين كوّنهم في جامعات أمريكا و ألمانيا و وضعهم بعد ذلك تحت إشراف طبقة المقرّبين من القصر. و هو ما يفسّر التحالف الموضوعي بين المهندسين المعمّمين بالضرورة و المؤسسّة الكنسية الشيعية و تجّار البازار الذين كانوا يطمحون لعقلنة النظام الاقتصادي للزيادة في الإنتاجية (أنظر جيل كيبال في كتابه:
La Revanche de Dieu
و يمكننا القول إثر هذا التحليل بأن نجاح الثورة الإسلامية في عالمنا المعاصر ضريبته خيانة الثورة لمبادئها المعلنة
أنظر كتاب بني صدر:
La revolution trahie
بعد وصول قادتها للحكم، و هو ما يفسّر صمت قادة الحركات الإسلامية المتطرّفة عن الإدلاء ببرامجها الاقتصادية البديلة. و الواقع أنّهم لا يملكون بديلا حقيقيّا لا على المستوى الاجتماعي و لا على المستوى الاقتصادي و إنما يقدّمون تصوّرات طوباويّة تساعدهم على تثوير المحرومين و على عسكرتهم و على استخدامهم كوسيلة للتوصّل للسلطة السياسية بشتّى الوسائل. و المحرومون ليسوا غاية بل وسيلة لإبدال النخبة الحاكمة بنخبة أخرى
و المهم هنا أن نشير إلى الظروف الخصوصية التي مكّنت العلمانيين التقنيين الشيعيين من الاستحواذ على مقاليد السلطة و ذلك باستعمالهم لتقنيات تعبويّة معاصرة و استغلالهم لحاجة المستضعفين لمشاريع بديلة و لحاجة التجّار و الصناعيين لنظام سياسي أكثر تفهّما لمفهوم النجاعة الاقتصادية و بتلبيتهم لرغبة الكنيسة الشيعية للوصول إلى السلطة السياسية و هي رغبة يرجع تاريخها إلى قرون.
و كلّ هذه الظروف الخصوصية لا تتوفر في بقيّة المجتمعات الإسلامية و السنيّة منها على وجه الخصوص.
و على هذا الأساس يفسّر علماء الاجتماع إخفاق الثورة الشيعية في تصدير نفسها و فشل المتطرّفين الإسلاميين في توريدها إلى بلدانهم و قد حاول القادة الإيرانيون تصديرها في السنوات الأولى من الثورة قبل أن يجبرهم الواقع الموضوعي على العدول عن مشاريعهم الطوباويّة .
هذا التحليل جزء من بحث قمت به صائفة 1990
المصدر: http://www.naceur.com/?p=2517
الحوار الخارجي:
