عدالة الشريعة الإسلامية
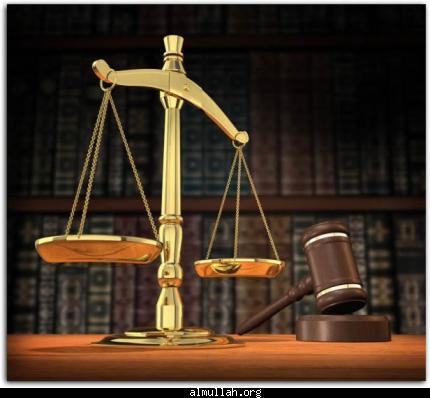
إن لكلمة العدالة تقديسا وإجلالا في أفواه البشر، وفي فطرة الإنسلنية السليمة أيضا، وقد شهد الواقع بذلك في الطبائع الآدمية على تفاوت طبقاتها وأعصارها وتباين بلدانها واختلاف ألسنتها وأجناسها وعلى تخالف كثير أو قليل في فهم العدالة نفسها، وكثيرا ما يسمع من أحد المتنازعين-وقد صدر ضده الحكم التسخط والتأسف، متهما الحاكم بإهانة العدالة وهضم حقها في جانبه.
وقد يكون الأمر كذلك فيما إذا وقع انحراف في تطبيق العدالة، أو كانت بنود القانون من بنات الأفكار البشرية، التي هي عرضة للأخطاء والسهو، أو روعي في وضع القانون صلاحيته لأمة خاصة، اعتبارا بوضعها الخاص.
فمن الأحسن لسعادة البشرية جميعها وجود قانون قد استمد فصوله من العدالة الحقة، المعصومة من الخطأ، ليكفل للأفراد والجماعات حرمتها ونظامها، حتى لا تهدر الحقوق، ولا تسود الفوضى، وينال الكل ما له من الواجبات، ويحترم-عن طيب نفسه- ما لغيره من الحقوق، أينما حل وارتحل من الكرة الأرضية التي قد يصير سكانها في يوم ما-بفضل التقدم العلمي- كعائلة واحدة، أو كأمة واحدة، فمن المعلوم أن لا بقاء لأمة بلا عدل ولا نظام، بل الحيوان والمعدن والسماوات والأرض لا قيام لهل إلا بالعدل والنظام.
ونحن الآن نعيش في النصف الثاني من القرن العشرين، الذي خطت فيه الإنسانية خطوات واسعة في التقدم العلمي والفكري، وقطعت فيه أشواطا كبرى في طريق الرقي المادي، وبلغ النوع البشري في الميدان الاختراعي إلى حد محاولة اختراق الأجواء والطمع في غزو الكواكب السابحة في الفضاء، غير أننا لم نسمع من حاول أن يشق غبار الشريعة الإسلامية في خلق قانون يفوز بالصلاحية لتحقيق حاجيات المجتمع البشري في الميدان العدلي، ولم نر مثل الشريعة الإسلامية في تحقيق ذلك، على اختلاف الأزمان وتباين الأفكار وتباعد الأقطار، ولم نر مثل الشريعة الإسلامية في اجتثات واستئصال كل ما قد تتعثر به العدالة في طريقها إلى القيام بمهمتها، أو يكدر صفوها من الاعتبارات الدينية أو العاطفية، أو القرابة أو غيرها من الأمور التي أعلن الإسلام إهدارها-في جانب العدالة- منذ أربعة عشر قرنا.
لقد أثار المشركون حفيظة المسلمين بالتصدي لهم بالمنع-ظلما وعتوا- في واقعة (الحديبية) من ممارسة الشعائر الدينية، ومزاولة مناسك العمرة، وقد كان من الطابيعي أن ينتقم المسلمون-عند القدرة- رادين على الاعتداء بالمثل، قضاء لحق المظلومية، وإرضاء لغريزة التشفي.
ولكن القرءان ذكرهم بأن روح الإسلام الكريمة تحتم الضرب عن كل ذلك صفحا، ويلفت نظرهم إلى وجوب الوفاء بحق أداء الشهادة لله، واحترام جانب العدالة، واطراح كل ما تقتضيه طبيعة الشنئان والبغض لقوم، ويلفت القرءان الكريم نظرهم إلى وجوب سد كل المنافذ التي قد تتسرب منها عواصف تطفيء نور العدالة، أو عوامل تفل الشهادة لله.
ويعتبر القرءان كل ما خالف ذلك من قبيل الاعتداء الذي لا تعترف به ولا تقره الشريعة الإسلامية، ويعلن أن الواجب يقتضي التعاون على البر والتقوى الذي كان من أبرز مميزاتها-في نظر الإسلام- الأخذ بيد العدالة، وسد باب الملاحظات التي تعرقل السير في سبيل نصرة الحق، وأن التقصير في شيء من ذلك معدود- في رأي الشريعة الإسلامية- من قبيل التعاون على الإثم والعدوان الممقوت في ملة الإسلام، وبالتالي تعتبر الشريعة المتهاونين في أمر القيام بالعدالة كما يجب قد تعرضوا لشدة عقاب الله تعالى الدنيوي والأخروي، اقرأ هذا باعتبار وإمعان في آيات سورة المائدة [الآية 2]، وهي قوله تعالى ?وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ?
على أن شريعة الإسلام لم تقف عند هذا الحد في ميدان تحقيق الحق وإبطال الباطل، بل ذهبت إلى ما هو أوسع من ذلك، فهي تقتلع جذور الجور، وتجتث عروق الحيف وتبيد جميع الطفيليات التي قد تنال من ترعرع شجرة العدالة، وامتداد عروقها ليثبت أصلها، وتصعد إلى السماء فروعها، ويمتد ظلها، وتؤتي سلطتها كل حين.
لقد فرضت العدالة الإسلامية رقابتها حتى على الضمائر، ونادت قلوب المؤمنين طالبة الاستواء على ساق الجد والتيقظ في القيام بالقسط، وأداء الشهادة على وجهها الواقعي، وبكيفية ترضى الله وترضي الضمير، لا على المشهود عليه فقط، بل وعلى ذات الشاهد، وعلى نفسه التي بين جنبيه، وعلى أمه وأبيه وأقاربه الأدنين، وإن داعي الإيمان يوجب التصريح بالواقع المر، من الشهادة على النفس، وعلى الوالدين والأقربين، ولو كانت النتيجة ستنتهي إلى الإعدام وإنهاء هذه الحياة، ورضوان من الله أكبر.
فمن أعظم واجبات النظام الإسلامي-في بساط القيام بحق العدالة وأداء الشهادة- تناسي الاعتبارات كلها، التي منها التماس رضى الغني لغناه، أو مراعاة عاطفة الشفقة على الفقير لفقره، بل الواجب هو الانسحاب من ميادين هذه الاعتبارات كلها، وترك شأنها لله وحده، فهو أولى بالجميع، وإنما نحن مأمورون بإرضاء جانب العدالة، ومجانبة اتباع الهوى الذي قد يضلنا عن الحق وينكبنا طريق الصواب ويقودنا إلى هاوية الحيف.
يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) [النساء: 135].
فأنت ترى من ختام الآية الكريمة، كيف سدت علينا جميع منافذ التملص عن القيام بالقسط وأداء الشهادة على وجهها، بحيث لا يتأتي فيها أدنى التواء أو تحريف أو إعراض عنها وكتمانها، مهددة المخاطبين على كل ما عسى أن يقع من التقصير في ذلك.
وإذا لوحظ سبب نزول الآية الكريمة فسيزداد ذو العقل السليم إعجابا بعدالة الشريعة الإسلامية، ويقر-طوعا وكرها- بأنها العدالة الوحيدة التي لا تقيم وزنا لأي اعتبار عنصري، ولا لأية عدواة دينية مهما ارتقت إلى أقصى درجاتها في الاستحكام والشدة، وإن الواجب يقضي برفع العدالة فوق كل اعتبار.
فقد ذكر المفسرون عن سبب نزول الآية الآنفة الذكر، أن شخصا -يدعى طعمة بن أبيرق- قد هم قومه بالدفاع عنه بالكذب والشهادة على يهودي شهادة زور باطل، وأنت ترى الآية قد ختمت -كما ذكرنا- بتهديد ترتعد له فرائض المتقين.
وبسبب هذه القضية نفسها ورد في القرءان الكريم، نهي عن المرافعة والدفاع عمن ثبتت إدانته وتحققت خيانته؛ قال تعالى: ?وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَاأَنتُمْ هَؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً? [النساء: 105-109]. في حق من يا ترى قرر القرءان الكريم هذه الأحكام؟
إنها في حق قوم يرون أن جميع من سوى جنسهم وكل من ليسوا على ملتهم يباح لهم ماله، وأنه في إمكانهم تناول كل ما يملك متى سمحت لهم الظروف وسنحت لهم الفرصة -بدون خوف تبعة ولا توقع حرج- وقد بين القرءان الكريم نفسه سلوكهم ذلك في هذا الميدان بقوله: (وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ) [آل عمران: 75].
وللشريعة الإسلامية موقف حازم ودقة ملاحظة عند التطبيق واستيفاء حق العدالة حتى لا يتخذ التنفيذ شكلا صوريا أو يتخلله تقاعس، بل يكون التطبيق حقيقيا واقعيا لا هوادة فيه ولا شفقة تعتريه ولا تردد، وفي هذا المعنى يقول القرءان الكريم في شأن القيام بحد من حدود الله:(وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) [النور: 2].
وقد ثبت في كتب السنة الصحيحة أن رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام قد أنحى باللائمة على بعض أعيان المسلمين الذين يرومون الانفلات من قبضة العدالة، والتقصي عن حد من حدود الله، وأقسم بالله إن سرقت بنته وفلذة كبده فاطمة لقطع يدها إرضاء للعدالة، وقد قال عليه السلام في هذا الصدد على ما رواه الشيخان وغيرهما: «إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»، أما نظر الشريعة الإسلامية بالإجلال والتعظيم لمن بر بالعدالة وتوخى رضاها من الحكام، فقد ورد في ذلك آيات كريمة وأحاديث نبوية في الوعد لهم برحمة الله ورضوانه كثيرة، فمن ذلك قوله تعالى: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [المائدة: 42] وقوله عليه الصلاة والسلام، على ماروى مسلم وغيره، «إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمان، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا».
وقد نظر الإسلام بنظر شزر إلى المتهاونين بشأن العدالة وأعد لهم عذابا أليما، فمن ذلك قوله تعالى: (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا)[الجن: 15]، وقوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الشيخان، «ما من عبد يسترعيه الله رعيته، يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة».
إن كل من نظر ودرس عدالة الشريعة الإسلامية يكون مضطرا إلى القطع بأن المسلمين لو حافظوا عليها كما ينبغي، وطبقوها كما يجب، لكانوا حكام الأمم جميعا، ولصاروا سادة العالم بأسره.
كيف لا وهي من وضع الله الذي خلق العوالم فقدرها تقديرا وكان بمصالح عباده خبيرا بصيرا، وليس لمحمد بن عبد الله فيها إلا تبليغها بكامل الأمانة كما أمره ربه؛ فالبشر مهما ارتقوا إلى أعلى الدرجات في سمو التفكير، وأوتوا من العلوم أوفر الحظوظ، وحاولوا وضع القوانين، فلن تغدو أن تصلح -على فرض صحتها- إلا لأمة خاصة لها طبائع وعادات خاصة وفي مكان وزمان خاصين.
فليت شعري كيف يسمح امرؤ -ينتسب للإسلام- لنفسه بارتياد عدالة من غير عدالة الإسلام، أو كيف يقال إنه مؤمن بالله وبرسوله وإنه حسن النية يريد بأمته تقدما ويروم لها إصلاحا، وهو يرضى بحكم غير حكم القرءان، أو يستمد قانونا من سوى كتاب الله العزيز الذي(لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) [فصلت: 42]؛ (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ) [المائدة: 50].
