التجديد الإسلاميّ وخطاب ما بعد الهويّة
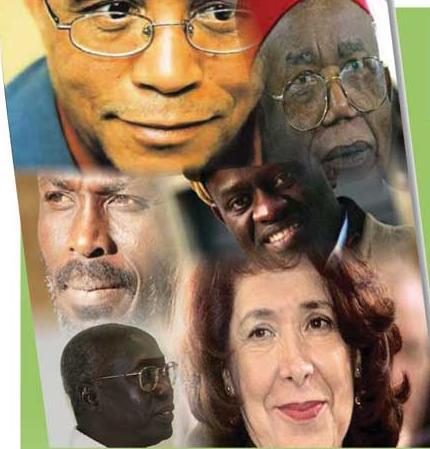
إنّ بروز خطاب "جديد" - بحدّ ذاته - مؤشّر على تأثّر حركة الفكر الإسلاميّ بالأحداث؛ إذ ما إنْ دخل في مرحلة ما بعد الصّراع حتى تولّدت طبيعيّاً حركة فكريّة نشطة تُعيد التفكير في الذات نقداً وتركيباً. وعلى هذا الأساس، لا نستبعد كليّاً أنْ تحصل تأثيرات جرّاء أحداثٍ بحجم أحداث 11 أيلول/سبتمبر - وُضع الفكر الإسلامي في صلب مسؤوليّتها-، ولكن هذه التأثيرات المحتملة يجب أن تقرأ في ظلّ البنية التي تكوّن الخطاب الجديد، وربّما أصبح الآن بمقدورنا دراسة التحوّلات التي ستحصل في العقل الإسلاميّ على ضوء تجربتنا القريبة.
زمن التّجديد.. والخطاب الجديد
من المبالغة وصف أيّ خطابٍ في "التّجديد" بأنّه خطابٌ تجديديٌّ فعلاً، كما أنّه من غير الإنصاف أن يكون كلّ خطاب لا يتحدّث في التّجديد خطاباً غير تجديديٍّ؛ ذلك أنّ الأساس الذي يمكن اعتبار أيّ خطابٍ بأنّه داخل في إطار التّجديد أو لا، هو ابتداء "الإطار المرجعيّ" الذي ينبني عليه؛ إذ يتضمّن هذا الإطار المرجعيّ المسلّمات الكبرى التي تحرّك إطار البحث والتفكير في أيّ خطابٍ.
وإذا كان كلّ خطابٍ إسلاميٍّ يفترض ضمناً عدداً من المسلّمات، يدخل منها في الإطار المرجعيّ: الوحي، والسّلطة المخوّلة للتّعامل معه وتأويله، فإنّ الجديد دوماً ليس في نفي السّلطة الدينيّة (الإكليروس)؛ فذلك مسلمة الخطاب الإسلاميّ على وجه العموم، بل في التسليم بمفهومٍ جديدٍ للزّمن الحاضر يختلف كليّاً عمّا سلف من الأزمنة، هذا الزمن الراهن هو أحد مكونات الإطار المرجعي للخطاب الجديد، بكلّ ما يعني من معرفةٍ وواقع حالٍ.
الغريب أنّ الوعي السلفيّ لا يدرك التناقض الحاصل بين إيمانه بأنّ التاريخ الإنسانيّ "تاريخ متقدّم نحو الأسوأ"، وبين "العودة للإسلام" في صورته الصحيّة النقيّة، بل مع أهمّ مبدأ إيمانيٍّ يؤسّس عليه تمسّكه الدّينيّ: "صلاحيّة الإسلام لكلّ زمان ومكان"! وفي حدود هذا التصور المتناقض يسهل فهم كيف أصبح تفجير برجي التّجارة في نيويورك في 11 أيلول/سبتمبر "غزوة مانهاتن"! في عقل السلفيّة الجهاديّة.
ما كان لدى السلفيّ التقليديّ زمنٌ ثابتٌ أميل لأن يكون زمناً اعتقاديّاً خالصاً، يتّخذ بُعده الواقعيّ في الخطاب الإصلاحيّ والتّجديديّ؛ فالتاريخ أزمنة وصيرورات وليس زمناً واحداً توقّف عن التغيّر، وأوّل اعترافٍ نشهده على صورة إقرارٍ بـ"الانحطاط" أو "التخلّف" في المسلمين مقابل "التمدّن" أو "التقدّم" في الغرب الأوروبيّ، أي في رؤية أزمة التّخلّف بوصفها "فواتاً حضاريّاً"، فقد شكّلت الحداثة صدمةً للوعي الإسلاميّ ووضعته في موضع السّؤال التاريخيّ "لماذا تأخّر المسلمون وتقدم غيرهم؟".
الوعي بالتاريخ هنا ليس في الشعور بالتغير الثوري الذي حدث في العالم، فجميع أشكال الخطاب الإسلامي الإصلاحي والتجديدي "مؤمن" من غير تردد بذلك، لكن تحليل هذا التغير وتفسيره أمر بدا مختلفاً جدّاً في كلّ مرحلةٍ من مراحله، وهي تتّصل بمدى وعيه للحداثة وتطوّراتها المتسارعة قرباً وبُعداً، ففيما الخطاب النهضويّ لحظ التقدّم الغربيّ في شقّه التنظيميّ والماديّ (الطهطاويّ والتونسيّ) لم يرَ ضرورة في تطوير الخطاب الإسلامي، فمسألة "الإصلاح الديني" لم تستبعد وحسب، بل استهجنت ورُفض التفكير فيها، وسرعان ما أدرك الإصلاحيون "عبده وتلامذته" في إطار الحقبة الكولونيالية (الاستعمارية) أن المسألة أبعد من مجرد نقل للحضارة الغربية، وأن الفجوة الواسعة والمطردة بيننا وبين الغرب ليست مجرد تطورات تقنية وإدارية تنظيمية؛ إنها أيضا مسألة تطور في المعرفة الإنسانية وليس في العلوم المادية فحسب، إلا أن تفسير التقدم الغربي بوصفه تطورا عن الصراع مع الكنيسة، وضع الإصلاحيين والخطاب الإصلاحي -بمنطق المقايسة بجامع "علة" متمثلة في النهضة الحديثة- أمام خيار إعادة إنتاج للنهضة على الإيقاع الغربي نفسه، وهكذا قرر زعماء الإصلاحية (عبده وتلامذته) أنّهم لا بد أن يُمارسوا دوراً لوثريّاً، بل لقد صرّحوا بأنّ الإصلاح الدينيّ هو مثيل الإصلاح البروتستانتيّ تماماً! هنا يبدو أنّ الزّمن بدأ يُصبح في الوعي الإصلاحيّ زمنَ الغرب وحضارته، وليس زمننا الخاصّ.
لكن هذا الوعي بالزّمن كان ينبغي أن يقود إلى تحوّلاتٍ عميقة في الخطاب الإصلاحيّ، إلّا أنّ هذه الرؤية للتاريخ المفترض أنّها تؤدّي إلى نمطٍ تفكيريٍّ مشابه للإصلاح الديني اللوثري ما لبثت أن اصطدمت بالواقع الفعلي لمركب الدين الإسلامي: غياب سلطة دينية، ومشكلة مع العلم لا تماثل البتة المسيحية في القرون الوسطى! وسرعان ما أدى ذلك إلى انقلاب دراماتيكي للزمن في الإصلاحية إلى زمن السّلف الصّالح! فأصبح الإصلاح الدينيّ يعني العودة بالدين إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة على هدي العقل. إنّه انقلابٌ لا نعدم أن نلحظ تأرجح مفهوم الزّمن فيه، في مفهوم "العقلانية" الذي ينتمي إلى السلف والحداثة في لحظةٍ واحدةٍ! صحيح أن مسألة العقلانية ليست وافدة على الفكر الإسلاميّ وإرثه الفكريّ، لكن العقلانية -كما تبدو في تجليّاتها عند الإصلاحية- هي العقلانية الغربية الماديّة غالباً، فالتفسير المادي للغيبيات معناه أنّنا أصبحنا في عالمٍ حداثويٍّ تماماً، على الأقلّ بالنسبة للإصلاحيّة، التي أصبح بإمكاننا القول إنّها "تلفيقيّة" دون تأنيب الضّمير.
ما بين "وفاة" الإصلاحيّة وميلاد خطاب التجديد ما يقرب من ثلث قرن، تطوّرت فيه المعرفة الغربية الحداثيّة خطوات جبّارة، خصوصاً في المعرفة الإنسانيّة بنتائج تجربة تطبيق مبادئ العلوم التجريبية على حقولها، فأصبح الغرب هنا غرباً أعقد، ومسألة المقايسة مع اللوثريّة وصلتها بالنّهضة والتّقدّم ما عاد لها نفعٌ، لا بل إنّ هذه المقايسة ذاتها أصبحت مستهجنة، يعود ذلك ليس إلى إخفاق التّجربة الإصلاحيّة التّلفيقيّة فحسب، بل إلى حصاد التّجربة الحرجة من الصّراع الأيديولوجيّ "الأوّل" مع العلمانيّ المحلّيّ (الذي كان ليبراليّاً، ثمّ أصبح يساريّاً ماركسيّاً) بعد ظهور الدولة الوطنيّة بانقضاء الاستعمار. فقد تبنّى الحداثيّ العربيّ على الأقلّ المقايسة على التاريخ الغربي للنهضة والتقدم إلى أقصاها، ليبرر التعجّل إلى النتائج، التي ما لبثت أن أصبحت بفعل إخفاق الدولة الوطنية المحدثنة في التنمية إلى أيديولوجيا فوق تاريخية، وضعت الفكر التجديدي أمام إعادة تفكير جدية بالإصلاح الديني اللوثري، وإعادة مَوْقَعَة للتفكير بالذات.
ولا يبدو أن قطيعة مع رؤية الزمن جاثياً في الغرب الذي ولد مع الإصلاحيّة أمرٌ ممكنٌ، لكن ثمّة مسافة أخذت من هذا الزّمن، حيث بدا أنّ الصّراع الأيديولوجيّ أفرز عنصراً جديداً في مكوّنات الفكر التّجديديّ هو "الهويّة" والخصوصيّة. وهكذا أسس أهمّ منظّري الخطاب التجديدي في ذلك الوقت (مالك بن نبي) مفهوم الزّمن كجزءٍ من مفهوم "الحضارة" وهويّتها. ولأنّ المعرفة بالغرب لم تكن على ذلك العمق الذي يُمكن من استثمار الزّمن الغربيّ ممثلاً بنتاج حداثته في العلوم الإنسانيّة، فقد أصبح لزاماً أن نتصوّر كيف أنّ الزّمن الحداثيّ أصبح باهتاً للغاية، عندما بقي الإرث السّلفيّ هو الوحيد فعليّاً المحرّك للفكر التّجديديّ آنذاك، فشهدنا ظهور تيّارٍ تصالحيٍّ ساذجٍ عرف بـ"الوسطيّة" و"الاعتدال"، فطالعتنا كتابات غاية في السّطحيّة، تحمل عناوين حداثيّة ومحتويات سلفيّة رخوة، مثل: علم الاجتماع الإسلاميّ، علم النّفس الإسلاميّ،... إلخ.
ليس غريبا بعد أن أصبح مفهوم الزمن الغربي المفارق أمراً مسلما في خطاب التجديد أن نعود لنشهد إعادة تركيب لـ"زمن الحداثة" في حضور "أنا" في طور جديد؛ إذ خلقت الوسطية وكتاباتها السطحية وعلاقتها الباهتة بالزمن الغربي انطباعاً سيئاً للغاية بمعرفة زائفة بهذا الزمن. أعيد هذا التركيب في صورة تأسيس نظري واسع النطاق للعلاقة مع المعرفة الحداثية الممثلة لزمنها في مشروعات متفاوتة الأهمية، لكن أهمها -على الإطلاق- مشروع "إسلامية المعرفة"3 الذي حاول بناء صورة واضحة عن هذا الزمن وامتلاكه من خلال تأسيس علاقة حضور "الأنا" بالعصر عبره ومن خلاله، لكن هذا الـ "عبر" و"الخلال" جزء من عبور مكونات هوياتي، فـ "استعمال مصطلح الإسلامية في "إسلامية المعرفة" [بُرر] في محاولة لتأكيد الهدف التحريضي من جهود الأسلمة والإسلامية في العمل العلمي والمعرفي المعاصر، والهدف النقدي والتقويمي للمعرفة المعاصرة وإحالاتها الفلسفية وأسسها النظرية، والهدف العملي في توظيف المعرفة للأغراض المشروعة في الواقع الإسلامي"4.
لقد لقي هذا المشروع نقدا أبستمولوجيّاً حادّاً، لكنه كان بمثابة "الفتح" في التنظير للتعاطي مع الزمن الغربي، فالحصار الذي وجد هذا الخطاب التجديدي نفسه فيه في الثمانينيات ما لبث أن فتح الأفق ليتشكل خطاب جديد في التسعينات مع استراحة العقل المسلم من أزمة الهوية بانقضاء الصراع الأيديولوجي مع الماركسيّة؛ إذ صاحب هذا التكون ولادة حركة نقدية واسعة للحداثة الغربية، كان المثقفون الإسلاميون الجدد على مقربةٍ منها، فاللغة ما عادت حاجزاً؛ إذ تطوّرت حركة ترجمة بالغة الأهمية توجهت نحو نتاج الغرب الليبرالي الفلسفيّ والمعرفيّ (حقل العلوم الإنسانيّة)، ممّا ساعد على تكوين رؤية أكثر عمقاً بالحداثة ذاتها، فلم يَعُد زمن الحداثة الغربية على صورته الأسطوريّة، كما لم تَعُد المعرفة الإنسانيّة ذاك المجهول المرغوب، هذه المعرفة "الجديدة" بالغرب ما كانت متيسّرة من قبل، بل ما كانت ممكنة أساساً، فقد أصبح الانفتاح على الغرب انفتاحاً يسمح بالتعرّف على حدود "الهويّة" للأنا والآخر، وأصبح مُمكنا التّفكير والتّعاطي مع المعرفة الغربية باقتدارٍ دون هتكٍ للهويّة أو الخوف من الانسياق مع الزّمن الغربيّ الخالص والأسطوريّ.
المعرفة الحداثيّة وتكوين الخطاب الجديد
خلقت رؤية العالم الجديد خطابا على صورتها ومثالها، وهي صورة لم تخلف جديدا في عناصر الخطاب التجديدي في طوره الثالث والذي ورثته مكتمل العناصر، لكنه اكتمال نظري، أصبح في مركب الخطاب الجديد جزءا فعليا بدأ يأخذ حظه من الفعل والتأثير. فلقد انتهى المركب المكون للخطاب التجديدي الإسلامي إلى تشكل بنية مؤلفة من علاقات لعناصر ثلاثة: التراث، المعرفة الحداثية، النص (الوحي) بوصفه مرجعا. يحكمها نظام ناشئ من فهم مكونات هذه العناصر ذاتها، ولا شك أن معالم الخطاب الجديد تتضح من خلال تركيبة نظام العلاقات بينها.
وإذا كان النظر إلى النص بوصفه حاكما للمعرفة الدينية لم يطرأ عليه تغيير في مفهومه، في مجمل التطورات الحاصلة فيه، ليس إلا امتدادا طبيعيا للرؤية التقليدية في نهاياتها القصوى، فالموقف من النص ما زال نظريا -ابتداء من التقليدي السلفي وصولا إلى الخطاب الجديد الذي نحن بصدده- يقف على مسافة من القارئ هي: مسافة اللغة التي تكسوه بالموضوعية، وتحيده عن ذات القارئ إلى درجة ما مبدئيا، ومسافة العقل (وفق مبدأ: درء تناقض العقل والنقل) التي تمنحه القدرة على الاستمرار والبقاء وتوليد المعنى، مع ملاحظة أن مساحة فعل العقل ليست دوما في موافقة ما يقوله النص، بل فيما لا يقوله النص أيضا، وبالتالي فإن التطور الفعلي حاصل في عنصري التراث والمعرفة الحداثية دون غيرها.
ما بين تصور التراث وتصور العلم نسبة هي نسبة الهوية للمعرفة، لا تختلف هذه النسبة - في أهميتها- عن المعرفة الحداثية التي ترتبط بحضور العصر والتفاعل معه، فالانفصال عنها يعني الارتكاس إلى الماضي والانقطاع عن الراهن وتصبح صورتنا غريبة غربة "طالبان" عن العالم.
لقد تجاوزت المسألة في الخطاب الجديد مجرد التلقي، أيا كان شكل هذا التلقي، سواء بعد الفلترة الأيديولوجية أم من دون ملاحقة هذه النهايات الفلسفية المادية؛ فالمعرفة الحداثية أضحت ممارسة فعلية نامية باطراد. هنا تحولت الدعوات "العمومية" الموجهة للمثقفين المسلمين ليتفهموا "الحضارة الغربية فهما شموليا دقيقا من غي إعجاب وانبهار وذوبان فيها، أو اتهام وإعراض عن عجز أو جهل" من أجل أن يكونوا قادرين على "التعامل مع نتاج الغرب بالطريقة البناءة"5 إلى حقيقة، فلقد بدأنا نشهد عددا من التجارب تتعامل جديا مع الغرب في مختلف حقول المعرفة الإنسانية الحداثية، وإن أبرز سمات التفاعل في الخطاب الجديد تراجع مسألة "الهوية" إلى موقع خلفي، حيث تخرج عن كونها مركزا لخطاب أيديولوجي، وعقدة مقابلة لمركزية الغرب، تراجعت إلى حيث ليس بالإمكان قبول أن تكون المعرفة الغربية معرفة كونية وحسب، وهنا تتخذ الهوية موقعها في تغذية النقد وتقوية السؤال الأبستمولوجي عن الممكن وغير الممكن في الذات والآخر. صحيح أن الحداثة الغربية طموحة إلى درجة تنميط العالم على مثالها، إلا أن مفهوم "الهوية" يكبح جماحها نحونا.
وحينما نقول: إنه بدأ تعامل فعلي مع المعرفة الغربية الحداثية في إطار مشروع الإصلاح الديني، فعلينا أن نتوقع تحولات جديدة في الوعي ونتاجا جديدا في المعرفة الدينية؛ فـ "الفهم الديني يتغذى ويتلاءم مع المعارف البشرية، وهناك أخذ وعطاء في الجدلية الدائمة بين المعرفة الدينية والمعارف غير الدينية، وإذا حصل قبض أو بسط في المعارف غير الدينية فإن فهمنا الديني [ذاته] عرضة للقبض والبسط"، و"إذا حصل تموج وتحول في زاوية من زوايا بحر المعارف البشرية الهائج فلن تبقى بقية الزوايا هادئة، وسيكون [ذلك] مؤثرا في إدراك الأقسام الأخرى".
بإمكاننا مشاهدة كيف أثر الوعي الإصلاحي -الناشئ من التعامل مع العلوم الإنسانية- في إنتاج معرفة دينية ما كان من الممكن تصورها ولا التفكير فيها لولا هذا الانخراط في هذه العلوم، وخصوصا في حقل التفسير وإعادة قراءة القرآن. وعندما نتحدث عن تفسير القرآن فإننا نمسك - في مسألة الإصلاح الديني- بالمحرك المرجعي الذي لا يقبل التفاوض، وهذا يعني -بحد ذاته- توقع تحولات فكرية من المحتمل أن تكون من سمات فكر جديد آخر، هو نتاج تطبيقات العلوم الإنسانية في المعرفة الدينية.
استراتيجيات الممانعة والوعي المضاد
لقد وقف السلفي التقليدي من استخدام العلوم الإنسانية موقف المكفر أحيانا، على أساس أن "في تراثنا الغنى"؛ فهذه العلوم ما تزال من أنماط التفلسف الغربي، وبالتالي فإن نقل هذه العلوم أو استخدامها يسهم في تحقيق "ما هو شر من أهداف التبشير والاستعمار، بنقل الكفر بأثوابه الجديدة لتتسمم به عقول أبناء أمتنا"، ومن الأفضل النظر إليها -بحسب الوعي السلفي المختزل- على أنها "عقائد غازية"! وهذا الوعي يجد في ملاحظة هذه العلوم دليلا على أن الخطاب الجديد خطاب مشبوه، هدفه "مسايرة الحضارة الغربية فكرا وتطبيقا"، وأنهم علمانيون في الحقيقة، أو بينهم وبين العلمانية فاصل -إن وجد- "رقيق جدا"!
ليس بعيدا عن النمط السلفي الإسلامي التقليدي، يشتغل عقل الحداثي العربي في طبعته الجديدة المنقحة؛ إذ ما زال يفكر أن يكون الإصلاح الديني حصان طروادة، ويعقد آماله على ما عجز عنه هذا الخطاب الجديد، في "تبيئة" المفاهيم الحديثة، ونزع سمة "التفرنج" أو "الخارجية" عنها، من قبيل التعرف عليها كما لو أنها "معلومة مسبقا في النص"! فهو ما يزال يلحظ مرجعيته النصية التي تجعل منه سلفيا تقليديا بامتياز، فمهمته التي تستحق الدعم هي سحب "القبة الرمزية" (حسب اصطلاح الأنثروبولوجي جورج بالاندييه) وتوسيعها لتوطن مفاهيم الحداثة عبر بوابة خلفية.
ما استطاع الخطاب الإسلامي الجديد تكوين نموذجه المعرفي (Paradigm) بعد، لكن عناصر مكونات وآلية ترابطها وعملها تنبئان عن إمكانية قريبة. نقول "نموذج معرفي" ونحن ندرك تماما معنى أن يتشكل نموذج جديد في انطلاقة ثورية للمعرفة الدينية الإسلامية وربما النهضوية العربية على وجه العموم.
إنه ليس لنا أن نتوقف عن المراهنة على مستقبل هذه النقلة التي أحدثها الخطاب الجديد، ذلك أن المكاسب التاريخية لا تقبل التراجع والنكوص، إلا أن المهم فعلا هو إدراك تأثيرات ومآلات أحداث سبتمبر والدعوة الأمريكية الصريحة لإصلاح الخطاب الديني، في سياق حربها على ما أسمته بـ"الإرهاب" ، التي فهمت فعليا على أنها حرب "ضد الإسلام" والمسلمين.
طيلة الستة العقود الماضية دفع الصراع الأيديولوجي الماركسي - الإسلامي إلى تحول الفكر الإسلامي نحو موقف نفسي وجودي، فوجدناه يمضي شيئا فشيئا نحو هوس "الهوية" الذي عطل المشاريع التجديدية والإصلاحية في الفكر الإسلامي لصالح الدفاع عن الهوية، (كان هناك مثلا في الشام مفكرون مثل: مصطفى السباعي ومصطفى الزرقا ومحمد المبارك ومعروف الدواليبي ومحمود مهدي إستانبولي وآخرون يبشرون بمستقبل جديد للفكر الديني في سوريا)، لكننا وجدنا أنهم سرعان ما غابوا وانتهت آثارهم في زحمة الصراع الأيديولوجي المرير، لا بل كانوا عرضة لانتقادات لاذعة وصلت حتى اتهامهم بالخيانة والعمالة للغرب... إلخ! ثم شاهدنا بعدها المفكرين الإسلاميين كيف انقلب جميعهم إلى مفكري هوية.
فمن المؤكد -بالنسبة لنا على الأقل- أن مستقبل التطور في هذا الخطاب (تسارعا أو بطأ) رهن بمدى استقلاليته عن الفعل السياسي وانفراج قضية الهوية أمامه.
المصدر: إسلام أون لاين.
