قصة الغرب و"الآخر"
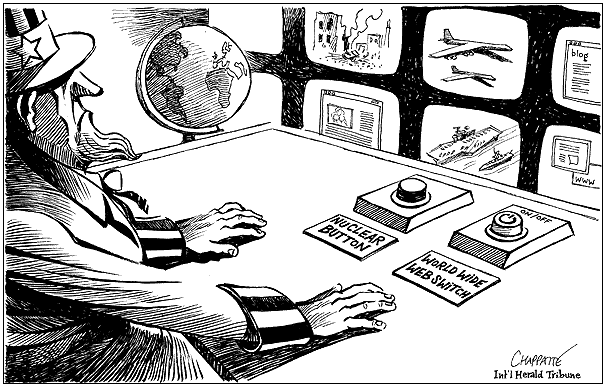
قصة الغرب و"الآخر"
قبل سنوات قليلة اجتاحت العالم العربي والإسلامي حمى كلمة "الآخر"، وأصبح من النادر أن تجد مثقفًا أو صحفيًا أو نصف مثقف أو نحو ذلك لا يذكر كلمة "الآخر". بعض هؤلاء –وليسوا بالقليل- يذكرون كلمة "الآخر" بخشوع وإخبات، ويستطردون في ذكر محاسنه وحقوقه وإيجابياته وما له علينا وماذا يجب علينا تجاهه، وكيف نُحسن صورتنا أمامه، وننظفها من العار والشنار الذي لحقها من قِبَلِنا، حتى أصبحت صورتنا غير نظيفة أمام "الآخر".
وحيثُ إنَّ للآخر قصة يُستحسن أن نعرفها، وكيف نشأ مصطلح "الآخر"؟ ومن المقصود به؟ وما الذي نشأ قبله؟ وفي أي شيءٍ استخدم؟ هذه الأسئلة مهمة حتى لا تُستخدم الألفاظ في غير معانيها، أو تُقتطع من سياقاتها التاريخية، فتفقد قيمتها أو معانيها أو حتى دلالاتها الخطرة.
مصطلح "الآخر" مصطلح وُلِدَ في الغرب، وكان وجوده هناك مسبوقًا بوجود مصطلح "الأنا"، لأن الغرب يرى أنه هو "الأنا" وهو مركز الكون والحضارات، وبقية العالم تُسَمَّى "الآخر"، فنشأ ذلك المصطلح كدلالة على الاستعلاء الغربي تجاه الآخرين، وأصبح العالم يُرى من قِبَلِ زاوية "الأنا" الغربية كالآخر!
و"الأنا" الغربية هي نقطة البداية وزاوية الرؤية التي تُقيَّم من خلالها جميع الأشياء، وهذه الرؤية تأتي انطلاقًا من تمركز الفكر الغربي على الذات، الذي نشأ عنه اعتقاد الغربيين "بمركزيَّة الغرب"، ومن ثم أنتج استعلاءً على الآخرين، وكانت المدوَّنات الأدبية والفلسفيَّة الغربية سجلاً حافلاً وموثقًا سُجِّلَ فيه بكل دقة ملامح الاستعلاء الغربي على "الآخر"، الذي يتمثل في الحقيقة والواقع في الشرقي أو بعبارة أدق غير الغربي. ومن هذه النظرة الفلسفية أصبحت العلاقات قائمة على عدم المساواة، بل على غيرية تامة إلى درجة العداوة.
ويرى كثيرٌ من المراقبين أنَّ هذه الرؤية ليست حديثةً، بل لها جذورها الضاربة في القِدَم. فأرسطو – مثلاً – يرى أن (الآخر) هو الغريب، أما أكثر الفلاسفة المتأخرين فيرون أن (الآخر) هو الشخص غير الطبيعي، أو العدو، أو الشيطان، أو البربري، أو المتوحش، أو الخطر المميت، أو الشر، أو الإرهابي، أو الأجنبي محل الريبة!
ومن فلسفة الغرب لمصطلحيّ "الأنا – الآخر" انطلقت الحملات الاستعمارية تحت مسميات مختلفة، فتارة: حملات صليبية، وتارة: حملات ضد البرابرة، والعامل المشترك هو: أن "الآخر" ليست له قيمة مساوية للغربي، فهو بربري أو متوحش بلا قانون أو إيمان، ولذا فإن الحق في أخذ ما في يديه وما تحت رجليه وسرقة ماله وحقوقه حقٌ مشروع.
وقد بيٍّن (فرنسوا شاتليه) في كتاب "أيديولوجيا الغزو" أن الغرب قد نظر للشعوب -التي قصد بلادها الأصلية لاستعمارها- بوصفهم وحوش وبرابرة، فقد عرف الغرب –على حد قوله- أنواعاً من المتوحشين وخاض معهم تجربة؛ كمتوحشي أمريكا وكندا، أي السكان الأصليين الهنود.
وحينما عَرَّفَت الموسوعة الغربية L ENCYCLOPEDIE (المتوحش) -في مقال خاصٍ بالتعريف بالمتوحشين- فقالت: إنه من الشعوب البربرية التي تعيش بلا قانون ولا شرطة ولا دين. ثم تُعطي مثالاً على ذلك بأمريكا التي ما تزال مأهولة بأمم الهنود الحمر المتوحشة –على حد وصفها- بدون ملك ولا قانون ولا إيمان!
لقد كان هذا كافيًا لأن تقوم الجيوش الغربية بغزو أمريكا الشمالية وإبادة الهنود الحمر إبادة لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، مع أنَّ بعض الباحثين يؤكدون على أنَّ شعوب الهنود الحمر في أغلبيتهم من الشعوب المسالمة والطيبة، وأنه من الثابت بلا شك أنها شعوب لها لغتها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها.
ولذلك، تجد أن الأعداد الهائلة للهنود الحمر قد اختفت، بسبب الإبادات الجماعية أو بسبب نشر الأمراض بينهم بطريقة مدروسة ومتعمدة وموثقة تاريخيًا. ومع أنه لم يتبق إلا القليل منهم في أمريكا، وطنهم الأصلي، فإنهم اليوم يُعانون الغربة والتهميش والاحتقار، وأنهم هم الغرباء في أمريكا.
أما التصوير الغربي وبالأخص الأمريكي للهنود الحمر، كما تبينه عدد من الدراسات، فإنه تصوير قائم على ثنائية التجريم أو الاحتقار، فالمنتجات الثقافية الغربية-الأمريكية ؛كالأفلام والقصص والرسوم المتحركة، تُكرس في المراحل العمرية الأولى صورة الهندي الغبي والمغفل والأحمق، لكن في المراحل العمرية اللاحقة يتحول الهندي الأحمر إلى مجرم حقير مُدنس للأعراض وقاطع للطريقة و"سالخ لفروة الرؤوس"، وحش بلا رحمة ولا قلب ولا يعترف بقانون.
يقول الكاتب الغربي "ريزارد كابوتشينسكي" في مقالٍ بعنوان "التلاقي بالغريب" 2006م: (لم يكن الإنسان الأبيض، الأوروبي، يغادر قارّته إلا بهدفٍ واحد: هو الاحتلال. كان يخرج من دياره ليصبح سيّداً على أراضٍ أخرى وللحصول على عبيد أو المتاجرة أو التبشير. غالباً ما كانت تتحوّل رحلاته إلى حمّامات من الدماء، كما جرى لدى اجتياح كريستوف كولومبوس للأميركيّتيْن، تبعها حملة المستعمرين البيض الآتين من القارّة العجوز، ثمّ اجتياح إفريقيا وأستراليا، إلخ(
وبناءً على نظرة الغرب لنفسه "كأنا" ونظرته لغيره "كآخر"؛ تشكلت سياسته تجاههم بوصفهم: إما برابرة يجوز احتلال أرضهم وإهدار جميع حقوقهم الإنسانية، لأنهم –كما يقولون- لا يحق لهم ملك الأرض لأنهم بلا قانون ولا إيمان، وإما مجرد عبيد خلقهم الله لخدمة الرجل الأبيض.
يقول فرنسوا شاتليه: (ما نعرفه من أفريقيا، ممالك الغرب التي تنظم بنفسها توريد العبيد، لا يُسمح بتصنيف الأفارقة في عداد المتوحشين، ويُقال عن الأفريقي: إنه خُلق ليخدم(.
ولعل هذه النظرة الدونية هي التي دفعت المجتمع الأبيض في أمريكا "الأنا" إلى النظر إلى إخوانهم السود "الآخر" كعبيد لا قيمة لهم، أو لعل قيمتهم تقترب من قيمة الحيوانات التي تُستخدم في الزراعة ونحوها!
يقول "مالكم إكس" مخاطباً الأمريكان السود: (من أنتم سوى عبيد سابقين، أنتم لم تأتوا على "المايفلاور"، أنتم أُتي بكم على سفينة عبيد مقيدين بالسلاسل مثل الخيول والبقر(
طبعًا "المايفلاور" MAYFLOWER هي السفينة التي نقلت المهاجرين والحجاج الإنجليز الأوائل من "بلايموث" في إنجلترا إلى شمال فيرجينيا في أمريكا في عام 1620م.
ولم تكن العنصرية -والتي شكلت موقف الغرب تجاه "الآخر"- مقتصرة على التجار الجشعين، أو رجال السياسة البرجماتيين، بل كانت –أيضاً- تحظى بدعم فلسفي وتبرير عقلي من أعمدة الفكر الغربيين، والتي وضعت الأسس الأخلاقية لهذه القضية، وقدمت الدعم المنطقي المبرر لموقف "الأنا" من "الآخر".
يقول منتسكو في كتابه الشهير "روح القوانين" مُبينًا حجة من يرى استعباد السود: (إذا كان علي أن أدافع عن حقنا في اتخاذ الزنوج ذوي البشرة السوداء عبيداً، فإنني أقول: إن شعوب أوروبا وقد أفنت سكان أمريكا الأصليين لم يكن أمامها إلا أن تستعبد شعوب إفريقيا، لكي تستخدمها في استصلاح أرجاء أمريكا الشاسعة، وما شعوب إفريقيا إلا جماعات سوداء البشرة من أخمص القدم إلى قمة الرأس، ذات أنوف فطساء إلى درجة يكاد من المستحيل أن ترثي لها، وحاشا لله ذي الحكمة البالغة أن يكون قد أودع روحاً أو على الأخص روحاً طيبة في جسد حالك السواد(
ويؤكد "بندكت أندرسون" أنَّ الأساس الأخلاقي-الليبرالي الذي قدمه الليبرالي الكولومبي "بيدرو فيرمين دو فارجاس" في مطلع القرن التاسع عشر من أجل تبرير استبعاد وإبادة الهنود هو في قوله: "إن كسل الهنود، وغباوتهم، ولا مبالاتهم تجاه الجهود الإنسانية الاعتيادية تدفع المرء إلى الاعتقاد أنهم ينحدرون من عرق منحط(
ويقول الفيلسوف "رينان" هذا الاعتقاد فيقول: (جنس واحد يلد السادة والأبطال هو الجنس الأوروبي، فإذا نزلت بهذا الجنس النبيل إلى مستوى الحظائر التي يعمل بها الصينيون والزنوج فإنه يثور، إن الحياة التي يتمرد عليها عمالنا يسعد بها صيني أو فلاح من جنس آخر(
وبالإضافة إلى المبررات التجارية والسياسية والفلسفية العقلانية، تم إضافة المبرر الديني لتكريس موقف الغرب "الأنا" المجحف من "الآخر"، فبحسب البحوث والدراسات العلمية فإنَّ الغرب –وخصوصاً الأمريكي الأبيض- يرى أن الله كرمه وفضله على خلقه، وأن الله كما منح العبرانيين "اليهود" أرض كنعان والقدس، وطرد منها أهلها الأصليين "الفلسطينيين"، فقد منح أمريكا للأوروبيين المهاجرين إليها، وطرد منها سكانها الأصليين، الهنود.
يقول "جون آدمز" في كتاب " أيديولوجيا الغزو": (إن استعمار أمريكا، بداية تحقيق مشروع العناية الإلهية الذي يعني تدفق النور(
ويقول فرنسوا شاتليه: (إن تكوين التعابير التي تعني: أمريكا، أمريكي، أمرك. يُشكل الدلائل على هذا التصميم الإلهي. إن أمريكا هي في نفس الوقت كنعان الجديدة، القدس الجديدة، وفيما يخص الأمريكيين، فهم تحت الحماية الإلهية، إن شعباً مختاراً، فقط، هو الذي يستطيع الإقامة في هذا البلد الموهوب بكرم، لقد عاملهم الله مثل العبريين(
ومن هذه الرؤية الغربية الضيقة والمتعالية تجاه "الآخر" أصبحت الحضارة الغربية هي المحور والمرتكز للحضارات البشرية، بل لا يوجد حضارة إنسانية غير الحضارة الأوروبية الغربية، وما عداها فقطيع من الشعوب المتوحشة والبربرية أو العبيد.
ثم إن "الأنا الغربية" ظهرت في أوروبا بقوة، وانتشرت كالنار في الهشيم، وتبناها ودافع عنها كثير من العلماء والفلاسفة، وهي نظرة –كما سبق- قائمة على "مركزية الحضارة الأوربية" بحيث تستبعد كل ما سواها، فلا حضارة إلا حضارة الغرب
.
وترى الدراسات والبحوث أنه لأجل أن يُبرر الغربي تفوقه، فقد ذهب العديد من المؤرخين الغربيين إلى ادعاء تأثير جنس بشري مخصوص له خصائص معينة في صناعة التاريخ، إذ لم يتردد البعض في الزعم بأن الجنس الأوروبي هو أفضل الأجناس على الإطلاق، وأنَّ باقي الأجناس الأخرى أقل قدرة في صناعة التاريخ.
يقول الفرنسي "جوبينو" في رسالة له حول عدم تساوي الأجناس: (إن الآريين وحدهم هم بناء الحضارة والمحافظون عليها). وكان "جوبينو" لا يعترف بحضارة سوى الحضارة البيضاء، ويؤكد ذلك فيقول: (أن التفاوت العنصري كاف لتفسير مصائر الشعوب(
وذهب كل من "جوزيف آرثر" و"هوستن" إلى أن كل الحضارات الأساسية هي من عمل الآريين. وهذه "الأنا" هي التي دَفَعتْ "بلومباخ" إلى تأسيس نظريته الشهيرة التي زعم فيها أن هناك توافقًا بين العبقرية وبين طبيعة العقل الأوربي. ويقول "إفيريت" -أستاذٌ في جامعة هارفارد-: (العرق الأنجلوساكسوني متفوق على نحو لم يسبق له مثيل، ولا يدانيه أحد(!
وهذه "الأنا" الغربية –نفسها- هي التي دَفَعت علماء وفلاسفة الغرب إلى تغليف تفوقهم العنصري المزعوم بغلاف البحث العلمي، فالنازيون الألمان يرون أن تفوقهم يُفسر بناءً على عرقهم، وأنهم أفضل العروق وهم السادة ، أما الآخرين فهم العبيد!
وحينما سيطرة فكرة "الأنا" على عقل النازية، جعل هتلر يقول بتفوق الألمان بالطبيعة على جميع أجناس البشر، وتقوم فلسفته العنصرية أو "الأنا الألمانية" على فكرة تفوق الجنس "الآري الجرماني" على باقي الأجناس التي أنجبتها الطبيعة، حيث يرى أن الشعب "الآري" فوق الجميع لذلك يجب الحفاظ على نقاوتها. ولذا فقد منع هتلر زواج الألمان من الأجناس الأخرى؛ حتى لا يختلط دمهم النقي بدماء غيرهم الفاسدة.
وذهب النازيون إلى أن العروق ليست مختلفة فقط بل متفاوتة، أفضلها وأرقاها وأنقاها العرق الآري، الفرع "النورديكي"، وأدناها وأحطها الأفارقة السود.
ويبيّن "ريزارد كابوتشينسكي" أن هذه النظرة العنصرية "للآخر" هي التي دفعت النظام الأبيض الكريه –على حد تعبيره- في جنوب إفريقيا إلى تأسيس علاقاته بالآخرين على مبدأ التمييز العنصري (apartheid)، ثم يُفسر هذا التصرف -القائم عدم قدرة على التفاهم مع الآخرين والتطبّع بطباعهم، والرغبة في ببناء الأسوار الضخمة وحفر الخنادق العميقة، للانعزال عن الآخرين- "بأنه فشل للكائن البشري في علاقاته".
ثم تتابعت –بعد ذلك- النظريات الغربية لتكريس "الأنا" والبحث عن مسوغات علمية لاستعباد "الآخر" وتبرير شن حروب إبادة وإقصاء في حقه؛ لأن "الآخر" ليس إلا عبدًا لا قيمة له، وتذهب الدراسات إلى أنَّ هذه الأيديولوجية الغربية تُفُسر دواعي الحوادث العنيفة والدموية في التاريخ الغربي، فإبادة الهنود الحمر، والحروب الصليبية، ومحاكم التفتيش، والحروب الأخرى تطبيقٌ عملي لمفهوم الغرب للآخر، ذلك "الآخر" الذي لا ذنبَ له إلا أنه صُنِفَ غربيًا "بالآخر"، مما يعني أنه مجرد عبد أو بربري في نظر الغرب.
يقول فرنسوا شاتليه: (كان على النظام –أي الغربي- إنكار إنسانية العبد، إنه لا يَعْرِفُ، بوصفه حيواناً أو آلة أو كافراً، كيف يشارك في دائرة السوق التي هو مع ذلك دولابها الحاسم، يفترض اقتصاد النخاسة عدم تماثل صارم: "إنسان=أبيض=حر"، "دون الإنسان=غير أبيض= عبد"(.
لقد تم رسم ملامح "الآخر" بوضوح في الذهنيَّة الغربية بناءً على تصورات الرجل الأبيض، فهو الذي حدد المفاهيم ومن ثم رسم العلاقات بدقة مع الآخرين، فالزاوية الوحيدة التي يُنظر للآخرين من خلالها هي زاوية الغربي، وعين الأبيض، وتقييم الأوروبي، وهذا–كما بُيِّنَ سابقاً- مبني على مفاهيم قائمة على المفهوم الغربي "للأنا" القائمة على التناقض بينها وبين "الآخر".
يقول الكاتب الغربي "ريزارد كابوتشينسكي": (لقد تمّ تحديد مفهوم "الآخر" بحسب وجهة نظر الإنسان الأبيض، الإنسان الأوروبي(.
ويقول فرنسوا شاتليه: (ثمة معيار أبيض وفيما بعد "آري" يكون منقوشاً على سطح الكرة الأرضية، يكون هذا النقش تناقضياً، تناقض بين الأبيض وغير الأبيض(
ويذكر فرنسوا شاتليه أنَّ هناك: (تقسيماً كونياً للعمل: للأبيض النظام والحرية والمثابرة، أما الأصفر فهو جسور وضعيف ولكنه عملي، في حين يكون الزنجي شره وموسيقي وكثير النسل وغير مستقر(.
لقد لخص بعض الغربيين –قديماً وحديثاً- رؤيتهم وموقفهم من "الآخر"، حيث اعتقدوا أنَّ "الآخر" بكل اختصار هو (الجحيم) الذي لا يرغب أحد في الذهاب أو التعرف إليه أو إقامة علاقات وديَّة أو إنسانية معه. وهذه التصورات المغلوطة والمتجنية تجاه الآخرين هي ما دفعت الكاتب "إدوارد ألبى" في مسرحيته (قصة حديقة الحيوان) إلى تكرار عبارة: (إن الجحيم هو الآخر) على لسان أحد شخصياتها. وكذلك "جون بول سارتر" في مسرحيته (الجلسة السرية) حيث قال بكل وضوح: (إن الجحيم هو الغير(.
لقد أرجع "ريزارد كابوتشينسكي" التصورات المغلوطة عند الرجل الغربي عن "الآخر" إلى جهل الرجل الأوروبي الأبيض بكلّ ما له علاقة بالشعوب الأخرى وثقافتها، ومنها كوّنوا فكرة خاطئة عنه، مليئة بالغطرسة والاحتقار.
إن خلاصة مصطلح "الآخر" -كما قيل سابقًا- أنه مصطلح غربي يدلُّ على السلبية والعدوانية، في مقابل "الأنا) الغربية الدالة على العلوّ والزهو والتغطرس.
هذا جزءٌ ضئيلٌ مما في التراث الغربي عن "الآخر"، ويبقى السؤال الذي قد يُطرح هو: ماذا عن الممارسات الغربية المعاصرة تجاه "الآخر"؟ وهل هناك أي تزحزحٍ في المواقف الغربية تخالف ما هو مسطورٌ في التراث التاريخي؟ هذه الأسئلة مُلحةٌ جدًا وتحتاج إلى إجابات علمية رصينة، لأنه يُمكن أن يُقال: إن ما قيل آنفا ليس إلا تعبيرًا عن مرحلة غربية-تاريخية مضت وتصرمت، ولم تَعد تُلقي بظلالها على الذهنيَّة الغربية في الوقت الحاضر، خصوصًا مع شهرة الغرب بمساندة قضايا حقوق الإنسان ودفاعه عن الديمقراطية والحريات.
كثيرٌ من المراقبين يؤكدون أنه حتى مع وجود القوانين المدنية الغربية وحقوق الإنسان في العصر الحديث، والتي يُعتقد أنها تُقيد "الغربي" من ممارسة ثُنائية "الأنا- الآخر"، فإنَّ الإنسان "الغربي" يُحاول جاهدًا أن يتفلت من أسرها كثيرًا؛ إما بعدم تطبيقها خارج حدود "بلاد القانون"، أو بالتلاعب بالقوانين داخل حدود "بلاد القانون"، أو أنَّ الإنسان "الغربي" يرى وجوب التمييز بطريقة ما بينه وبين "الآخر"، أو في نهاية المطاف يرى "الغربي" أن هذه القوانين والحقوق هي من ابتكاره ولذا فهو صاحب المنة واليد العليا.
