معوقات التجديد الديني
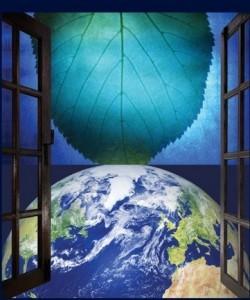
توطئة
ضغط التراث الديني بحمولته السجالية، وثقله العصباني الطائفي، على حاضر المسلمين، وبدّد جهود وتطلعات كوكبة المجدّدين في هذه الأمة المنكوبة، فمازال التراث الماضوي ساحة حرب المسلمين وليس حاجات الحاضر وآمال المستقبل، إذ مابرحت غالبية الأمة تتغذى على التراث العبء، حتى بتنا ـ نحن أبناء الحاضر ـ نلوك تراثاً لا صلة له بواقع المسلمين المعاصر سوى ما يزيد في تخلفهم وخروجهم من التاريخ من موضوعات عفى عليها الزمن، وأحياها المتساجلون في حروب هوجاء ثم أضفى عليها التعصب قيماً إضافية على حساب قيم الإسلام الأصيلة، إذ نجد أن الموضوعات التاريخية تتردد في كل القرون الهجرية وتتعاظم ككرة الثلج المدفوعة منذ قرون.
فكان من طأة التراث العبء، أننا أقفلنا أبواب حاضرنا على المستقبل وشرعناها باتجاه ماضٍ تعاقدنا معه على تزويدنا بكل تناقضاته من مطاحنات مذهبية، وموضوعات تيولوجية متهالكة من جهة، ومن خوارق ومعاجز للأولياء والصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن والاهم إلى يوم الدين من جهة أخرى، حتى بتنا نألف الشيء ونقيضه ـ في آن واحد ـ في تراثنا بأفكاره ورجاله ووقائعه. وهكذا غفلنا عن حاضرنا وكأننا مقطوعون عنه، وأهملنا مستقبلنا وكأن مسيرنا إلى غيره، أوكأن التاريخ قذف بنا إلى الحاضر لنحيي آثاره، ونبعث ما اندثر منه ونجدد معاركه.
وإذا كانت مسارات البشرية قد تبدّلت بفعل الثورات العلمية والصناعية والفكرية وتالياً تبدّل صورة العالم، ظل في الشرق الإسلامي مسارٌ وحيدٌ صامداً لم يطرأ عليه أي تبدّل، متمثلاً في النكوص الفكري والمعرفي الذي أعاد إنتاج نفسه في الأجيال المتعاقبة، وتمظهر في أشكال اجتماعية شتى، تارة في حملات تصفية دموية متبادلة، أوفي حملات كراهية وإقصاء متبادل حيث احتكار الحقيقة المطلقة على قاعدة نفي الآخر وإثبات الذات.
إن هذا المنطق الإقصائي بكل متوالياته وتعالياته، كان سبب عطالتنا التاريخية والحضارية، إذ لم يعد بالإمكان تغيير العالم من حولنا، بل يلزم القول أيضاً: أن التغيير بكل أشكاله لا يتم عبر التوسّل بتراث غير قابل للتجديد إلا بمحو كل تاريخ العقم المعرفي منه، والذي أسفرت معالجاته عن تشوّهات واختلالات، ولا سبيل، حينئذ، إلا بالعودة إلى المصادر الأولى والكبرى التي لم تطلها يد بشر.
ويعود السبب في اعتماد خيار راديكالي من هذا القبيل إلى حقيقة أن التشرذم المذهبي ارتد بأبناء الإسلام إلى أزمنة سحيقة، وعوضاً عن أن يحافظ الإسلام على ديناميته باعتباره حركة تجديد دائبة، ومشروع تغيير شامل ومتطور، ويجب أن يبقى دائماً كذلك، أفضت الانهيارات العظمى التي أصابت حركة المسلمين من الداخل، فتركت تأثيراتها على حركة الإسلام نفسه فتوارت ينابيعه الصافية، بفعل التمحور على الذات، وأصبح كل مذهب يهب أتباعه حق فتح باب الاجتهاد ويقفله بوجه نظرائه، وصولاً إلى اعتبار كل مذهب اجتهاداته الحق المطلق واجتهادات غيره الباطل المطلق.
لقد أضفى كل فريق على تراثه المذهبي وشاحاً من القداسة، وبات متردداً في مراجعته، فضلاً عن التشكيك فيه، لاعتقاده بأن ما يشتمل عليه ينضوي في دائرة المقدس، الذي يعد المساس به أو مراجعته تشكيكاً في أصل ديني ثابت كالقرآن الكريم، وعقيدة التوحيد، ولذلك درجت كل جماعة مذهبية على اعتبار ما يصدر عن أهل دعوتها كافياً حتى ضمرت الحاجة إلى التجديد أو حتى التحقيق، فمثلاً تمسك الشيعة لقرون بمقوله مزعومة عن الإمام المهدي بشأن كتاب (الكافي) للشيخ الكليني (الكافي كافٍ لشيعتنا)، وتمسك علماء السنة بمقولات مماثلة عن كتابي (البخاري) و(مسلم)، ولذلك لم يبذل العلماء ولقرون عديدة جهداً في تحقيق روايات هذه الكتب، سنداً ومتناً.
من جهة ثانية، أضفى المتساجلون على رموز المذهب ذات القداسة، فلا فرق بين قوله وبين شخصه، فنقد قوله كنقد شخصه، وهذه الشخصنة للآراء تؤول إلى تصنيمها، وأن الخروج عليها أو الاقتراب منها يفضي إلى تفجير خلاف لا قبل لنا به، ولا مناص حينئذ من فصل بين مقام الرمز وأقواله، إذ لا علاقة بين رد القول وتقدير الشخص. وقد تعطّلت حركة التجديد الفقهي في المذاهب الإسلامية في مراحل تاريخية عديدة بسبب هيمنة آراء فقيه معين، فذهل اللاحقون عن مجرد النظر فيها فضلاً عن تطويرها، ما تسبب في استقالات مدرسية شاملة رهنت المذاهب كافة لآراء غابرة قد تنطوي على عناصر تفجير في العلاقات بين المذاهب الإسلامية.
وفي واقع الأمر، أن ثمة انحباساً في العلاقة بين النص والقائل، ألهب توترات في الحقول المذهبية الإسلامية، فمنهم من رأى في زعيم أو زعماء مذهبه نصّاً مجسداً يمشي على الأرض، فما يقوله/أو يقولونه حجة لا تقبل الرد والنقاش، ومنهم من رفض النص لصدوره عن شخص لا ينتمي لمدرسته، ولعلنا نجد في المخالفات بين السنة والشيعة مثالاً صارخاً في هذا الصدد، فقد خالف السنة رأياً للشيعة، بصرف النظر عن صحته وسقمه، وخالف الشيعة رأياً للسنة لنفس السبب. فقد تبنى الشيخ ابن تيمية، على سبيل المثال، الرأي الفقهي الشيعي القائل باحتساب الطلقات الثلاث في مقام واحدة طلقة واحدة، ولكن هذا الرأي لقي معارضة شديدة من أهل دعوته ورجال عصره، ولقي العنت من أهل السلطان، كما تعرّض الشيخ ابن جنيد الإسكافي لحملة ضارية من علماء الشيعة في القرن الرابع الهجري لأنه قال بالقياس وفتح باب الاجتهاد على الأصول العقلية وأخذوا عليه بأنه ينسج على منوال أهل السنة أو ينقل عنهم.
ولعل واحدة من التحصينات المنيعة التي تحول دون ظهور اتجاهات تجديدية وفتح الطريق المسدود أمام حركة الإسلام المجتمعية، هو مبدأ الإجماع والخوف من خرقه، إذ بات التمسّك بالإجماع أماناً من سهام العامة، وحملات التشهير والتكفير. ولذلك، نجد أن علماء المسلمين وخشية أن يكونوا غرضاً لألسنة الجهلة الحداد، يضطرون لأن يتنازلوا عن يقينهم الراسخ لصالح الإجماع، وأن يخالفوا مقتضى النص الديني قطعي الدلالة لصالح الإجماع، كما حصل بالنسبة للعالم الشيعي المقدّس الأردبيلي في صلاة الجمعة حيث وجد أن كل الآيات والروايات تؤكد بما لا يقطع اليقين على وجوب إقامة صلاة الجمعة في الغيبة أو الحضور، ولكنه مع ذلك أخذ في نهاية الأمر بالإجماع فقال بالوجوب التخييري(1). وقد فشا في لسان الفقهاء على حد محمد تقي الحكيم (إن خارق الإجماع يكفر)(2) وهو مبدأ ينحبس فيه علماء المسلمين الشيعة والسنة سواء بسواء.
كما تمخّض اللجوء إلى التاريخ السجالي عن ظواهر متطرّفة داخل مجتمع المسلمين، فكانت تستعين كل جماعة بشواهد من التاريخ ما تؤكد به ذاتها وتقصي سواها، وهذا ما أضفى على التاريخ قدسية غير عادية وأخذ شكلاً نصيّاً يضاهي ـ وقد يفوق في أحيان كثيرة ـ في سطوته ومركزيته النص الديني، ما يؤكد على أن الخلاف لا علاقة له بالدين بقدر ما هو توظيفاً لنصوص مبتسرة لشرعنة الإنطواءات المذهبية.
إن التراث الذي ينتج بعضه حالياً أو يعاد إنتاجه هو الوجه المظلم، وليس الوجه المضيء منه، كما أن علاقة الحاضر بثقافة الماضي خصامية، فنحن لم نفد من الماضي في بناء حاضرنا واستشراف مستقبلنا، بل استعرنا من الماضي ما يبدّد جهوداً حاضرة عاجلة، وآمالاً وتطلعات قادمة آجلة.
معوّقات التجديد الديني
ثمة معوّقات خطيرة تهدّد حركة التجديد الديني، يمكن إجمالها في التالي:
ـ الانحباس المدرسي.
ـ تماهي العلماء مع سلطة الدولة.
ـ اندكاك العلماء في إرادة العامة.
ورغم أن الحديث عن الانحباسات المدرسية يتطلب جهداً بحثياً مستقلاً وعميقاً، ولكن يمكن القول باختصار شديد: ليس بالإمكان السير في خيار التجديد فيما تحاصر الإملاءات المدرسية المجدّدين، فقد اشتغلت المدارس الفكرية طيلة التاريخ الإسلامية على إرساء تحصينات بالغة التعقيد درءً لمخاطر الاختراق أو النفوذ، الأمر الذي جعل أتباع كل مدرسة ينشغلون بتأكيد الذات عن تطويرها.
أما تمظهرات العلاقة المتضادة بين العلماء من جهة والسلطة السياسية والعامة من جهة أخرى فقد نجمت، في نهاية المطاف، عن إفقار خيارات العلماء، وقصر أدوارهم على ما تمليه إرادة السلطة السياسية أو العامة، وعوضاً عن أن يكون العلماء مصدر توجيه وإثراء يتحوّلون تحت ضغط هاتين القوتين إلى مجرد جهاز آلي مستلب. وبحسب فهمي هويدي (أصبح علماؤنا ـ أو الأغلبية الساحقة منهم ـ جزءً من مؤسسة الحكم، أو موظفين كباراً إن شئنا الدقة، وبالتالي فإن إرادتهم المستقلة يشوبها قدر غير منكور ولا خاف من التجريح)(3).
وقد قال الشاعر عبد الله بن المبارك:
وما أفسد الدين إلا الملوك **** وأحبار سوء ورهبانها
فمنذ تحقق الفصل الفعلي بين السلطة والشريعة، ونجحت الدولة في مدّ سلطانها على المؤسسات الدينية أصبح لأهل الحكم اليد الطولى في تقرير أعمال العلماء وتوجيه أنشطتهم، وتوظيفهم، أيضاً، في الخصومات السياسية، فنجد أن تصعيداً مذهبياً خطيراً جرى في نهاية الدولة العباسية، حيث عمل أبو بكر الباقلاني (ت 403هـ) في سياق السياسة العباسية للإحياء السني أيام القادر بالله وهاجم الشيعة الإسماعيلية والمعتزلة وطلب إليه الخليفة القادر بالله التأليف ضد الباطنية (=الإسماعيلية) وفي نصرة الخلافة العباسية، ومن مؤلفاته (الفرق بين المعجزات والكرامات) و(التمهيد) و(رسالة الحرة) و(الإنصاف) وفعل الشيء ذاته أبو سعيد الإصطخري (ت 404هـ) الذي كتب بناء على طلب الخليفة القادر رداً مستفيضاً على الباطنية(4)، وكافأه الخليفة القادر بوقفٍ حبسه من بعده على بنيه(5). وحاول القادر بالله تعضيد سلطان الخلافة العباسية عبر توظيف العلماء في مواجهة الدولة الفاطمية التي بثّت الدعاة في أرجاء بلاد المسلمين دعوة للخليفة الفاطمي المستنصر، وتأليباً على الخليفة العباسي المستظهر بالله، فقويت شوكة الإسماعيلية في أيامه..
وفي زمان الدولتين البويهية والسلجوقية، أقحم علماء السنة والشيعة في أتون معارك مذهبية تتغذى على دعم كل من الدولتين، وكان بدء ظهور الدولة البويهية على المسرح السياسي في العشرينات من القرن الرابع الهجري ونجح بنوبويه في إقامة دولة لهم سيطرت على فارس والعراق زهاء قرن وربع، وتمكّنوا من السيطرة على مقدّرات الخلافة العباسية، وعمد معز الدولة أحمد أمير العراق، والأخ الثاني لعلي بن بابويه مؤسس الدولة، إلى تأجيج الصراع المذهبي بين السنة والشيعة بوتيرة لا مثيل لها، فشهدت البلاد أعنف الفتن الطائفية التي كان لها تأثير كبير في تخريب الحياة الاقتصادية وتعميم الفوضى(6). وقد شجّع معز الدولة بعض جهّال الشيعة عام 443هـ ـ على كتابة شعارات على الأبراج ـ بعد سيطرة البويهيين على بغداد ـ من قبيل (محمد وعلي خير البشر فمن رضى فقد شكر ومن أبى فقد كفر) فاضطرمت الفتنة وأخذت ثياب الناس في الطرق وغلّقت الأسواق واندلعت معارك بين الطرفين فقتل جماعة ونبشت عدة قبور للشيعة مثل العوني والناسي والجذوعي، وطرحوا النيران في التراب، وعمد بعض جهّال الشيعة إلى خان الحنفية فأحرقوه وقتل مدرسهم أبا سعد السرخسي (7).
وعلى الجبهة المقابلة، قامت دولة السلاجقة التي اعتنقت المذهب الشافعي عقب سيطرة طغرل بيك على بغداد عام 1055م، بإثارة النزعة الطائفية وشنّت حملات كراهية ضد أتباع المذاهب الأخرى، وكان الإمام أبو حامد الغزالي يعمل في خدمة السلطة السلجوقية، فقاد معركة سياسية بالنيابة ضد الشيعة الإسماعيلية، وألّف الكتب ضدهم، وكما يقول الإمام الغزالي (أما بعد فإني لم أزل مدة المقام بمدينة السلام متشوقاً إلى أن أخدم المواقف المقدسة النبوية الإمامية المستظهرية ضاعف الله جلالها، ومدّ على طبقات الخلق ظلالها ـ بتصنيف كتاب في علم الدين أقضي به شكر النعمة، وأقيم به رسم الخدمة، وأجني بما أتعاطاه من الكلفة ثمار القبول والزلفة، لكني جنحت إلى التواني.. حتى خرجت الأوامر الشريفة المقدسة النبوية المستظهرية بالإشارة إلى الخادم في تصنيف كتاب في الرد على الباطنية.. فرأيت الامتثال حتماً والمسارعة إلى الارتسام حزماً(8).
وهكذا، فإن كل الدول التي ظهرت بعد القرن الثالث الهجري كانت تتخذ مذهباً يضفي عليها شرعية دينية، وتستخدمه في ردع خصومها، وورث العثمانيون والصفويون ذلك المنزع، فكان تمذهب الدولتين المتخاصمتين مدفوعاً بالرغبة في تحصين الدولة، وفي هذه الحالة أصبح هناك إسلام سني عثماني وإسلام شيعي صفوي، وأخذ كل منهما من الإسلام ما يعزز سلطانه السياسي ومشروعيته الدينية. وبفعل اعتصام الدولتين المتصارعتين العثمانية والصفوية بالعناوين المذهبية، تم إقحام علماء المسلمين في أتون سجالات جانبية كان التجديد أول ضحاياها، فبينما كان القادة يدركون بأن صراعهم سياسي محض وما المذهب إلا سلاحاً من أسلحة هذا الصراع، كان العلماء وأنصارهم يخوضون صراعاً مذهبياً محض، وراح ضحية هذا التطييف السياسي في الصراع العثماني ـ الصفوي ثلة من علماء المسلمين السنة والشيعة، وأهرقت دماء الأبرياء من الطرفين بصورة مفزعة.
أما على مستوى العامل الثاني، أي اندكاك العلماء في ميول العامة، أمكن القول بأن ثمة سلطة جبروتية تفرضها العامة على العلماء، تحول دون انطلاق حركة التجديد الديني بصورة فاعلة، فصار العامة ينظّرون لفكرة الامتثال للماضي، تراثاً وأشخاصاً. وقد عانى علماء المسلمين من هيمنة هذه السلطة قديماً وحديثاً، ففي القرن الثاني عشر الميلادي نقد ابن الجوزي (ت 1201م) أحد أشكال سلطة العامة على العلماء بما نصه (ومن العوام من يقول هؤلاء العلماء يحافظون على الحدود، فلان يفعل كذا، وفلان يفعل كذا، فأمري أنا قريب وكشف هذا التلبيس أن الجاهل والعالم في باب التكليف سواء فغلبة الهوى للعالم لا يكون عذراً للجاهل) وفي مكان آخر يقول (وقد لبّس إبليس على جمهور العوام بالجريان مع العادات وذلك من أكثر أسباب هلاكهم، فمن ذلك أنهم يقلدون الآباء والأسلاف في اعتقادهم على ما نشأوا عليه من العادة فترى الرجل منهم يعيش خمسين سنة على ما كان عليه أبوه ولا ينظر أكان على صواب أم على خطأ)(9). وكتب الإمام الشوكاني ت 1250هـ (فإذا تكلم عالم من علماء الاجتهاد بشيء يخالف ما يعتقده المقلدة قاموا عليه قومة جاهلية، ووافقهم على ذلك أهل الدنيا وأرباب السلطان، فإذا قدروا على الإضرار به في بدنه وماله فعلوا ذلك وهم بفعلهم مشكورون عند أبناء جنسهم من العامة والمقلدة، لأنهم قاموا بنصرة الدين بزعمهم، وذبوا عن الأئمة المتبوعين وعن مذاهبهم التي قد اعتقدها أتباعهم فيكون لهم بهذه الأفعال التي هي عين الجهل والضلال من الجاه والرفعة عند أبناء جنسهم ما لم يكن في حساب)(10).
وكتب في العقد الأول من هذا القرن الماضي العالم الشيعي السيد هبة الدين الشهرستاني في مجلته (العلم) مقالة بعنوان (علماؤنا والتجاهر بالحق)، فبعد كلام حول تحرر إرادة العلماء فيما مضى من سالف الزمان قال ما نصه: (وأما في القرون الأخيرة فالسيطرة أضحت للرأي العام على رأي الإعلام. فصار العالم والفقيه يتكلم من خوفه بين الطلاب غير ما يتطلف به بين العوام وبالعكس، ويختار في كتبه الاستدلالية غير ما يفتي به في الرسائل العملية، ويستعمل في بيان الفتوى فنوناً من السياسة والمجاملة خوفاً من هياج العوام)، وينتهي من ذلك مندداً بهذه المهادنة والاستجابة لضغط العوام كونها (تهدّد الدين بانقراض معالمه، واضمحلال أصوله، لأن جهّال الأمم يميلون من قلة علمهم، ونقص استعدادهم، وضعف طبعهم، إلى الخرافات وبدع الأقوام والمنكرات، فإذا سكت العلماء ولم يزجروهم أو ساعدوهم على مشتهياتهم، غلبت زوائد الدين على أصوله، وبدعه على حقائقه، حتى يمسي ذلك الدين شريعة وثنية وهمجية تهزأ بها الأمم)(11).
لم يضع مرور الزمن حداً لسلطة العامة، بل ثمة ما يوحي بتعاظمها ورسوخها، كما تبدو واضحة في تصريحات المجدّدين أنفسهم، فقد حمل الشيخ مرتضى مطهري على ما أسماه بـ (آفة الإصابة بالعوام)، والتي اعتبرها (أشد بلاءً من الإصابة بالسيول والزلازل أو لسع العقارب والحيات)، وقال موضحاً لخطورتها (إن من سمات العامة أنهم لا يفارقون القديم الذي اعتادوا عليه، بل يتمسكون به دون تمييز بين حق وباطل، ويعتبرون كل جديد بدعة، وإتباعا للأهواء..يخافون من كل جديد..ويحافظون على الوضع القديم دائماً)(12).
ونذكر هنا بعض ما جرى في الأربعينات من القرن الماضي، حين كتب السيد محسن الأمين العاملي رسالته المسماة بـ (التنزيه) حصر فيها الأمور المبتدعة التي دخلت في مجالس ذكر سيد الشهداء الحسين (ع) فيقول: ( فمنها الكذب: بذكر الأمور المكذوبة المعلوم كذبها وعدم وجودها في خبر ولا نقلها في كتاب وهي تتلى على المنابر وفي المحافل بكرة وعشياً ولا من منكر ولا رادع.. ومنها إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها بضرب الرؤوس وجرحها بالمدى والسيوف حتى يسيل دمها وبضرب الظهور بسلاسل الحديد وغير ذلك. وتحريم ذلك ثابت بالعقل والنقل وما هو معلوم من سهولة الشريعة وسماحتها الذي يمدح به رسول الله (ص) بقوله (جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء) ومن رفع الحرج والمشقة في الدين بقوله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج..الآية). (ومنها الصياح والزعيق بالأصوات المنكرة القبيحة)..ومنها كل ما يوجب الهتك والشنعة مما لا يدخل تحت الحصر ويختلف الحال فيه بالنسبة إلى الأقطار والأصقاع إلى غير ذلك.
فإدخال هذه الأشياء في إقامة شعائر الحزن على الحسين (ع) من المنكرات التي تغضب الله ورسوله (ص) وتغضب الحسين (ع) فإنما قتل الحسين في إحياء دين جده (ص) ورفع المنكرات فكيف يرضى بفعلها لاسيما إذا فعلت بعنوان أنها طاعة وعبادة)، ثم يقول (وعرض بنا بسوء القول لنهينا عن قراءة الأحاديث المكذوبة عن هذا الفعل الشائن للمذهب وأهله والمنفر عنه والملحق به العار عند الأغيار والذي يفتح باب القدح فيه وفي أهله ونسبتهم إلى الجهل والجنون وسخافة العقول والبعد عن محاسن الشرع الإسلامي واستحلال حكم الشرع والعقل لتحريمه من إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها حتى أدى الحال إلى أن صارت صورهم الفوتوغرافية تعرض في المسارح وعلى صفحات الجرائد. وقال أئمتنا عليهم السلام:"كونوا زيناً لنا ولا تكونوا شيناً علينا" وأمرونا بأن نفعل ما يقال لأجله "رحم الله جعفر ابن محمد ما أحسن ما أدب أصحابه". ولم ينقل عنهم أنهم رخصوا لأحد من شيعتهم في ذلك ولا أمروهم به ولا فعل شيء من ذلك في عصرهم لا سراً ولا جهراً)(13).
وفي رد فعل على رسالة الأمين، أفتى السيد أبو الحسن الأصفهاني، من علماء الشيعة الكبار في القرن الماضي، وكان يقطن مدينة كربلاء، بما نصّه: (إن استعمال السيوف والسلاسل والطبول والأبواق وما يجري اليوم من أمثالها في مواكب العزاء بيوم عاشوراء باسم الحزن على الحسين إنما هو محرم وغير شرعي)(14). وقد تسبّبت الفتوى في تحريض واسع ضد الأصفهاني، وعمد أحد الخطباء المشهورين في العراق بإشاعة الفتاوى المضادة، مفيداً من المجلس الحسيني وأثار المشاعر العامة المتحفزة في مثل هذه المناسبة ليسدد ضربة قاصمة للسيد الأمين ولمرجعية السيد الأصفهاني، وانقسم الناس إلى فريقين اصطلح عليهما العوام بـ(علويين)، و(أمويين)، فصنّف الأمين والأصفهاني وأتباعهما مثل الشيخ محسن شرارة والسيد مهدي القزويني والسيد هبة الدين الشهرستاني (صاحب مجلة العلم)، في خانة الأمويين، ويقول من حضر بعد عام من الحادثة في مناسبة عاشوراء (أما شيعة العراق فقد ازداد فيها عدد الضاربين بالسيوف والسلاسل وازداد استعمال الطبول والصنوج والأبواق وكثرت الأهازيج والأناشيد التي تتضمن النقمة والتحدي لتلك الحركة الإصلاحية)(15).
وواجه السيد علي الخامنئي قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية حملة مماثلة عام 1994 إثر فتوى له صدرت في بداية محرم عام 1415هـ بحرمة استعمال التطبير وما يؤدي إلى الإضرار بالنفس وتشويه الإسلام، فصدرت المنشورات والفتاوى المنددة، ودشنت مؤسسة جديدة باسم (مؤسسة المنبر الحسيني) في بيروت وبدأت أعمالها بطبع كتاب بعنوان (فتاوى علماء الدين حول الشعائر الحسينية) جُمعت فيه فتاوى بخط اليد عن كبار مراجع الشيعة من السابقين واللاحقين في حليّة التطبير.
وبصورة عامة، فقد ابتلى المسلمون ـ باختلاف مذاهبهم ـ بداء التعصب الذي تسرب بدوره إلى القواعد الشعبية، وحارب بعضها الخوض في حوادث التاريخ الإسلامي درءً لتهمة التقصير، ورفض بعض آخر القبول بالحقائق العلمية والتمسك بشدة بما ورثه من تصورات لنفس السبب، وحمل بعض ثالث على العلماء الداعين إلى تجديد الفكر الإسلامي بحجة ضعف الإيمان والتفريط بأصول المعتقد.
فقد أصاب الأعضاء البارزين في (لجنة التقريب بين المذاهب) الأذى من العامة. ونخصّ هنا الشيخ محمد الغزالي، الذي واجه حملة تحريض من المتعصّبين بعد إصدار كتابه (ليس من الإسلام) طالب فيه بطي معارك الماضي، وتضييق شقة الخلاف بين السنة والشيعة بقوله (إن الشيعة لا يفترقون عن الجمهور في اعتماد الأصول.. وبعد ما سكنت فتن النزاع على الخلافة، والشقاق حول شخص الخليفة أصبح من العبث بقاء هذا التفرق وأصبح كلام الشيعة لا يزيد عن كلام أي مذهب إسلامي في فقه الأصول والفروع)(16). وهو رأي حمله العالم الشيعي الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه (مع الشيعة الإمامية) عن السنة. ولكن هناك من الغارقين في سجالات الماضي من لا يرضون للخلاف أن يهدأ فأنكروا ذلك كله وبحثوا في التاريخ ما يزيد في آوار الخلاف ويوقف حركة التجديد في الفكر الديني.
خلاصة لما سبق يمكن القول: تنوّعت أسلحة العامة وضغوطاتها على العلماء، فتارة تأتي في هيئة رفض لكل جديد إذا خالف مسلمات موروثة، وتارة في هيئة إملاء على العالم طريقة في التحصيل العلمي، بل وفي طريقة بثه وتبليغه. وهناك شكل في الإملاء بات الآن مكشوفاً، متمثلاً في طبيعة الأسئلة الملغومة التي يرفعها العامة إلى العلماء، أسئلة تحمل في طياتها نوع الإجابات المأمولة، والتي تفضي إلى تطويق خيارات العلماء ومواقفهم، وإبقائهم مجرد تابعين، ومنها أيضاً الاستفتاءات بلغة موجهة مشحونة بكل مفردات التجريح والتسقيط والتشهير، فتأتي الإجابات من سنخ الأسئلة.
ومن المؤسف القول أن علماء الدين يخضعون أحياناً لعملية إغواء من قبل العوام لقلة إطلاعهم على حقيقة الأوضاع العامة، ولثقة تسليمية مفرطة في (النقلة) فيرتّبون الأحكام الجزافية على مجرد النقل والسماع، متوسلين بدعوى أن نبأ المؤمن لا يلزم التبيّن من صحته، لأنه ثقة.
و كيما تحتفظ كل فرقة بأتباع ومناصرين وخصوصاً إبان الصراعات العقدية، وحين يتعرض المذهب إلى تحدٍّ خارجي، يستهدف زعزعة إيمان وثبات صفوف المؤمنين والأتباع بجدارة اعتقاد ما، تتجه كل الفرق إلى رفع ذرى العقائد الكبرى وتوسعة دائرة المقدس التي يجب أن تحتوي المؤمنين وإخضاعهم لدورة إيمانية ناشطة تحبط التهديدات الخارجية، فيما تقوم بعمل كثيف لجهة بناء مستودعات الأسئلة المراد طمسها وإرمائها في دائرة المستحيل التفكير فيه، بحيث تتشكل مساحات ممنوع التفكير فيها حتى تصبح بمرور الوقت مناطق لا محظور الاقتراب منها لتحصين الأتباع من خطر زلازل التشكيك الناشئة بفعل خارجي بالدرجة الأولى، وحجب الأضواء عن كل ما من شأنه إضاءة موضوعات مغفولة، حتى لا تتعرض للتفكير فيها من قبل الآخر/ الخصم.
وحينئذٍ يتوارى العقل، وتدخل العاطفة كعنصر فاعل وضروري في التكوين الفكري للجماعات، ما يفتح الطريق أمام نشوء حلقة مفرغة، تفضي إلى الصرامة العقلية وتوهّج النزعة الدوغمائية التي ترتكز أساساً على ثنائية ضدية من الإيمان أو العقائد/ واللاإيمان واللاعقائد، حسب المفكر الأميركي ميلتون روكيش.
وهنا نأتي على واحدة من النقاط الحاسمة في موضوع التجديد الديني، فالتنوع المذهبي داخل الإسلام التاريخي انطلق تعبيراً عن الاعتقاد بوجود مساحة كافية من الحرية داخل الإسلام تسمح بالتجديد، ولكن بمرور الوقت وبسبب الامتلاءات المذهبية، وما ينشأ عنها من إملاءات صارمة وإكراهات عقدية حادة، وترسم حدوداً فاصلة داخل هذا التنوع، تحبس الأتباع وتشدّهم داخل مجال التأثير المذهبي، فنشأت احتكارات مذهبية. فكل مذهب رأى في نفسه المالك الوحيد للمعرفة المطلقة الحقة، والناطق الرسمي باسم رسالة السماء، والممثل الشرعي والوحيد للإسلام، وهكذا تنامت النزوعات الدينية المتطرّفة، وما يتلوها من مصادرات وإقصاءات متبادلة، حتى يتحول التنوع على أساس الحرية الإسلامية إلى سلوك باحتكار الحق المقدس والحقيقة المطلقة ونفي الآخر حقاً وحقيقة، فيصبح الإسلام العملي ضد الحرية والتجديد والتنوع، بعد انقلاب الأتباع على المتَّبعين. وبينما وهبت الحرية في الإسلام مبدأ الاجتهاد وتالياً التعددية والتجديد، صنع التعصب المذهبي معاشر المقلدين.
وبسبب إتباع التلاميذ لشيوخهم، وتمذهب الدولة في التاريخ الإسلامي من الناحية العملية منذ القرن الثالث الهجري، ثم اندلاع الحروب الأهلية على قاعدة مذهبية، وتفاقم العصبيات المدرسية، ولا ننسى رمزية العصر المكتنز المليء بالثروة الفقهية في القرون الثلاثة الأولى، والذي شكل مرجعية ثرية يستند إليها الأتباع، أفضى ذلك كله إلى الانغلاق والركون بصورة شبه نهائية، دون مراكمة وإثراء للموروث، فعززوا خيار الإتباع والتقليد، ثم جاء القرار بإغلاق باب الاجتهاد بعد الأئمة إيذاناً بتشريع هذا الخيار الصارم والقهري في الأمة.
ولا نغالي في القول أن المذاهب الإسلامية كافة كانت حين انطلاقتها مشاريع تجديد في زمانها، ونبذت التقليد أو التوسل بالإكراه في تعميم وفرض معتقداتها. ولكنها تحولت، بفعل الاستقطابات المدرسية والصراعات السياسية، إلى حركة تقليد، وبالتالي إلى مشاريع جمود، فتحولت المذاهب من حركات تحرير إلى حركات تقليد وتقييد.
ولعل من المفارقات الخطيرة التي ظهرت بفعل الاستقطابات المذهبية الحادة، أن جنوحاًَ متعاظماً نحو تنزيه كل فرقة لتراثها المذهبي، واستعمال أدوات مزدوجة في التعامل مع الموضوعات الدينية، بحيث باتت الأدلجة سمة طاغية وغالبة على المقصد الأعلى للدين نفسه. فسنجد في موضوع الطبقات (طبقات القضاة والرواة..) أن ثمة معايير صارمة تحكمه، فلم يخضع لمعايير التجريح والتعديل التي يجري استعمالها مع الحديث من حيث كونه صحيحاً أو ضعيفاً أو مشكوكاً فيه، فكل كتّاب الطبقات من أتباع كل مذهب ينزّهون رجال طبقاتهم، فكاتب الطبقات الشافعية ينزه طبقاته، وكذلك الحال بالنسبة لبقية المذاهب، ما يجعل من كل مذهب حقلاً نهائياً لأتباعه ومقفلاً في وجه خصومه، وتالياً إلغاء المشترك (= الإسلام) بينها، بكل مقاصده وأغراضه العليا والوظائف التي يضعها للمؤمنين به، واغتيال دور العقل لحساب الحضور العاطفي الممتلئ كآلية للاعتقاد والالتزام بالمعتقد، تكون مبرراً لتشكّل إطارات اجتماعية تكتنف الأتباع وتخضعهم لمنظومة تعاليم وعادات وقوانين خاصة. وهنا يصدق ما قاله روكيش حول العقائد الدينية التي تعوّض عن هشاشتها العقلانية عن طريق صرامة الضبط النفس والاجتماعي الذي يتحكم بهذه العقائد.
وهذا يستدعي التحول الجوهري في حركة الإسلام الاجتماعية والتاريخية، فقد مرّت المنظومة الفكرية الإسلامية بمرحلتين: التأسيس الفكري المنفتح على الواقع وحركة الزمن، فكانت المنظومة الفكرية حرة طازجة قريبة من منابتها، وكانت تسمح بحرية التفكير والممارسة والخلق والإبداع، وكانت الظروف التي تخوضها المنظومة تفرض عليها القبول بوجود الآراء المخالفة من أجل مجادلتها ومناظرتها. ومرحلة الإتباع، والذي يمتد إلى زماننا، حيث خبت حركة الإبداع، وتقهقرت حماسة المجدّدين بفعل طغيان التقليد على التجديد.
وإجمالاً، نجد أن التيار الانشقاقي العريض الممتد داخل الأمة والذي ينزع إلى تأصيل تاريخانية الإتباع والتقليد يضغط بشدة على كل المتنورين في طرفي التيار الإسلامي للتماهي مع السجال التاريخي المذهبي، على أنه في الوقت نفسه لا يفوتنا الإشادة بتلك المساعي النبيلة لعلماء الدين والمفكّرين الذين أصرّوا على تحمّل الأذى إيماناً منهم بأن التجديد الديني لن ينجح ويستمر دون تضحيات.
الهامش: المصادر:
1. أنظر: المولى أحمد المقدس الأردبيلي ـ شرح إرشاد الأذهان، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ـ إيران 1413هـ الجزء الثاني ص 361
2. محمد تقي الحكيم ـ الأصول العامة للفقه المقارن، مؤسسة آل البيت (ع) للطباعة والنشر، الطبعة الثانية آب (أغسطس) 1979ج1ص 292
3. فهمي هويدي ـ المذهبية ووحدة المسلمين: في ندوة رسالة الإسلام والتحديات المعاصرة، منشورات مجلة رسالة الجهاد، مالطا، الطبعة الأولى محرم الحرام 1398 ـ سبتمبر 1988 ص 177
4. أبو الحسن الماوردي ـ قوانين الوزارة وسياسة الملك، تحقيق ودراسة الدكتور رضوان السيد. المقدمة ص 58، 62
5. أبو حامد الغزالي ـ فضائح الباطنية، حققه وقدّم له عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية الكويت ـ حولي (د.ت) المقدمة ب
6. د.حسن منيمنة ـ تاريخ الدولة البويهية:السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، الدار الجامعية 1987 ص 174
7. أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، القاهرة 1350هـ الجزء الثالث ص 270
8. الإمام أبي حامد الغزالي، فضائح الباطنية، المكتبة العصرية، راجعه محمد علي القطب، صيدا ـ بيروت، 2001، ص 12 ـ 13
9. الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي ـ تبليس إبليس، دار الرائد العربي، بيروت ـ لبنان (د.ت) ص 392، 399
10. محمد بن علي بن محمد الشوكاني، القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، تحقيق الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، دار القلم – الكويت، 1396هـ ص 46
11. أنظر: د. علي الوردي ـ دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، انتشارات الشريف الرضوي قم الطبعة الأولى 1413هـ ص 232 عن مجلة العلم، السنة الثانية ص 266ـ 267
12. الأستاذ الشهيد مرتضى المطهري ـ الاجتهاد في الإسلام، محاضرات في الدين والاجتماع ـ 2، ترجمة جعفر صادق الخليلي، من منشورات قسم الإعلام الخارجي لمؤسسة البعثة، طهران (د.ت) ص 54
13. دعوة التقريب بين المذاهب الإسلامية ـ منشورات جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية لعدة مؤلفين، عن دار الجواد ـ بيروت لبنان (د.ت) ص 50 ـ 51
14. جعفر الخليلي ـ هكذا عرفتهم، منشورات الشريف الرضي، قم ـ إيران المجلد الأول الطبعة الأولى 1412هـ الجزء الأول ص 207 عن رسالة السيد أبي الحسن الفارسية، الطبعة الأولى
15. السيد محسن الأمين: سيرته بقلمه وأقلام آخرين، حققه وأخرجه ولده حسن الأمين، مطبعة العرفان صيدا 1957 ص 116 ـ 117
16. الشيخ محمد الغزالي ـ ليس من الإسلام، دار الشروق، بيروت 1998، ص 57
المصدر: http://www.islammoasser.org/islammou3aser/ArticlePage.aspx?id=258
