الإسلاموية أو دحض الشمولية الدينية : ليس القرآن كتابا في الفيزياء، ولا هو كتاب بحثي في العلوم الطبيعية
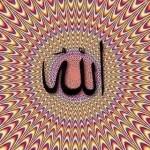
الإسلاموية أو دحض الشمولية الدينية:
ليس القرآن كتابا في الفيزياء، ولا هو كتاب بحثي في العلوم الطبيعية
ترجمة: حمزة محفوظ
لا يراد من هذا الكتاب بشكل يقيني التهجم على الإسلام بوصفه إيمانا، فإدعاء ذلك هو بطبيعة الحال ليس بذي معنى، لكنه تفكير في محاولة الخلط بين المجالات، واستغلال العقيدة التي يختار أحدهم الايمان بها، واعتناقها، تلك العقيدة التي تدخل في مجال ما فوق المفكر فيه، وغير القابل للتقييد داخل المفردات أو الانتقادات أو المرافعة، واستغلالها كمطية أو غطاء. ف «حيث يوجد « غير القابل للتعبير»، وجب علينا أن نصمت»، تقول حكمة الفيلسوف، لكن إن كان لهذه الحكمة من قيمة ذهبية، فهي بالضبط في مجال الإيمان.
لكن الشيء الذي بوسعنا التفكير فيه، والحديث عنه، بل ويجب علينا ذلك، هو بالضبط خطر الأصولية والتفكير الرجعي الذي تستعمله «الإسلاموية»، والتي تشكل الخطر المعاصر بشكل يضبب المستقبل. هذا التعبير الذي لم يكن متداولا قبل بضع عقود، وظهر تحديدا لما حصل آية الله الخميني على السلطة في إيران، لكن هذه الكلمة أصبحت اليوم تستعمل على نطاق واسع، وتكتسي معان جديدة في كل يوم.
ما زلت أذكر جيدا برنامجا تلفزيا، على قناة تلفزية مغربية، طلع فيه أستاذ جامعي بثقة بالنفس، ليقول بدون أدنى قدر من الحياء، إن الجغرافيا، كمبحث علمي، تجد أصولها في القرآن. ثم تابع إن حجته على ذلك الآية القرآنية: «قل سيروا في الأرض»، وأن الآية لم تقُل (سيروا على الأرض).
وعلى الرغم من أن وجود فرق في هذا السياق مشكوك فيه، إذ يمكن لأي متخصص أن يؤكد لنا أن لا إختلاف بين «على» و «في» في هذا السياق، وأنه حتى إذا كان هذا الفرق فلا يمكنه أن ينتج مبحث الجغرافيا.
إن هذه التصريحات التي تدعي العلمية، وتضعها على الدين عنوة، هي في حقيقة الأمر، تقوم بأكبر أمر سلبي ممكن تجاه تلك النصوص، بأن تنسب لها ما لا تحتمل. وهي في الواقع تستغل السذج وتظلمهم، اذ يكفي القليل من التكوين في المعرفة العلمية، لمعرفة أن هذه التصريحات تمثل حمقا استثنائيا، ، فلا يوجد أي جغرافي في العالم، انتسب لهذا المبحث، بعد أن وضع الآية 137 من سورة آل عمران بين عينيه.
فدون الإغراق في الاختلافات بين المباحث العلمية، وحتى بالبقاء في مستوى نظرية المعرفة، فالجميع يعرف – في الحقيقة وجب أن يكونوا يعرفون- أن النظرية العلمية تتميز بخصائص، هي غير تلك التي تتميز بها الدينية، فمنذ بوبر وكوهن ولاكتوس وفيرابند.. تغير مفهوم العلم بشكل جذري، لينفك عن مجال اليقيني.. وأجمع هنا أربع أمثلة للتأمل لإبراز الفرق:
1-النظرية العلمية لا تكون كذلك «علمية»، إلا حين يكون بالوسع دحضها في أي لحظة من قبل نظريات علمية أخرى، وهي في الأصل تكون نتاجا لدحض نظريات علمية سبقت عليها (بوبر)، بينما القرآن هل هو يقبل الدحض؟
2- هناك صيغ (براديغم)، تنبني على افتراضات نظرية، نغيرها ساعة تتوقف عن ملاءمتنا بشكل كافي حسب كوهين، وهذا على سبيل المثال ما حدث في حالة الكوبرنيكية والداروينية.. في حين هل القرآن براديغم يقبل أن نغيره بغيره؟
3- بالنسبة لفيرابند، «كل شيء يتحرك»، كل الوسائل جيدة، كل الطرق جيدة، لا توجد فعليا أي طرق إرشادية في العلم، فهو متحرك، و يقبل الترقيع أحيانا، فهل القرآن يقبل أن يكون علبة أدوات للترقيع؟
4- وقبل هؤلاء، نجد بوانكاري، وهو أحد أكبر العلماء الخالدين، الذي أظهر أن العلم يقوم على مجموعة من التوافقات والتقاليد، في حين هل يقبل القرآن أن يطوعه البشر تبعا لتوافقاتهم ؟
يتبدى من خلال كل تلك الأمثلة، أن الكلام الذي يقول إن القرآن والعلم متداخلي المجالات والطرق، لا ينتج عنه سوى نسبة اللايقيني والمتغير والمرتبط بغيره والمتحكم فيه بالقرآن، وهذا الكلام لم يكن ليجرأ عليه حتى أكبر أعداء الاسلام !
ويقول المتنورون من المسلمين، إن الاسلام يحض على اتباع العلم .
صحيح «اطلبوا العلم ولو في الصين»، هو حديث قال به الرسول، هنا يطرحون السؤال عن لماذا يتهم الدين بالتخلف، بأن الأخذ به في العلم رجعية ما دام يحرض على الدين بهذا الشكل.
وللإجابة على هذا السؤال هناك ملاحظتان أساسيتان:
الأولى: تخص كلمة «علم»، وهي أيضا لا تخلو من «الابهام»، فليس المراد منها العلوم الطبيعية، أو على الأقل إنها ليست هي العلوم الطبيعية بالدرجة الأولى، بل يراد به العلم الشرعي. لماذا نترك مكة والمدينة لنذهب إلى الصين إذا كان العلم الشرعي هاهنا.
هذه القاعدة العجيبة، التي تجعل العلم الشرعي متقدما عن المعرفة العلمية، صارت العادة الأكثر انتشارا بين الدول المسلمة، بمبرر من الشرع، اذ نحن نجد مثلا، أن المغرب هذا البلد النامي الذي ينتمي للعالم الثالث، والذي يدعي أنه حداثيا، أو الأقل أنه في طريقه إليها، يمكننا أن نحصي ساعات الدراسة لمختلف المواد لسنة 2005، في أقسام الإعداديات، نجد أن التربية الاسلامية تأتي على رأس تلك المواد، سواء في الابتدائي أو الاعدادي، إن التلاميذ يحصلون على ما مجموعه 884 ساعة فيها، في مقابل 409 ساعة للتاريخ والتربية الوطنية، بينما في مواد الفيزياء والعلوم الطبيعية 714.
يضاف إليه أن التربية الاسلامية هي المادة الوحيدة التي تدرس في كل مستويات التي يقطعها التلميذ المغربي، إلى جانب اللغة العربية، من قسمه التمهيدي إلى آخر سنة في الباكلوريا.
نلاحظ إذن أن العلم (صيونس)-العلوم الطبيعية وفهم العالم من حولنا، وعلم المنطق، والحساب.. ليس هو المقصود بالحديث، وإنما العلم (الشرعي)، أو على الأقل ذلك ما تثبته ميولات المسلمين، انسجاما مع ما فهموا.
الملاحظة الثانية: أن هذا الحديث حتى وإن كان يخبرنا بما علينا فعله، فإنه لا يعلمنا الطريقة، سافر إلى الصين أو إلى منطقة بعيدة في العالم، ماذا ستجد، أرض مختلفة غريبة، مختلفة، ستتوه ولن تتعلم أي شيء، لذلك فعادة الناس لا يمر عبر خلدهم حتى خاطر الذهاب لما يسمعون الحديث.
مجالان مختلفان:
لاشيء يجمع بين المجالين، تطرح السؤال كيف عاش المسلمون في فترة معينة، عصرهم الذهبي في علاقتهم بالدين، ذلك ما سنعالجه في الورقة اللاحقة، لأبين أنهم لم يعيشوه إلا في تلك اللحظات المحدودة التي فصلوا فيها بين المجالين، في ممارستهم للعلم.
فؤاد العروي
ما زلت أذكر جيدا برنامجا تلفزيا، على قناة تلفزية مغربية، طلع فيه أستاذ جامعي بثقة بالنفس، ليقول بدون أدنى قدر من الحياء، إن الجغرافيا، كمبحث علمي، تجد أصولها في القرآن. ثم تابع إن حجته على ذلك الآية القرآنية: «قل سيروا في الأرض»، وأن الآية لم تقُل (سيروا على الأرض).
وعلى الرغم من أن وجود فرق في هذا السياق مشكوك فيه، إذ يمكن لأي متخصص أن يؤكد لنا أن لا إختلاف بين «على» و «في» في هذا السياق، وأنه حتى إذا كان هذا الفرق فلا يمكنه أن ينتج مبحث الجغرافيا.
إن هذه التصريحات التي تدعي العلمية، وتضعها على الدين عنوة، هي في حقيقة الأمر، تقوم بأكبر أمر سلبي ممكن تجاه تلك النصوص، بأن تنسب لها ما لا تحتمل. وهي في الواقع تستغل السذج وتظلمهم، اذ يكفي القليل من التكوين في المعرفة العلمية، لمعرفة أن هذه التصريحات تمثل حمقا استثنائيا، ، فلا يوجد أي جغرافي في العالم، انتسب لهذا المبحث، بعد أن وضع الآية 137 من سورة آل عمران بين عينيه.
فدون الإغراق في الاختلافات بين المباحث العلمية، وحتى بالبقاء في مستوى نظرية المعرفة، فالجميع يعرف – في الحقيقة وجب أن يكونوا يعرفون- أن النظرية العلمية تتميز بخصائص، هي غير تلك التي تتميز بها الدينية، فمنذ بوبر وكوهن ولاكتوس وفيرابند.. تغير مفهوم العلم بشكل جذري، لينفك عن مجال اليقيني.. وأجمع هنا أربع أمثلة للتأمل لإبراز الفرق:
1-النظرية العلمية لا تكون كذلك «علمية»، إلا حين يكون بالوسع دحضها في أي لحظة من قبل نظريات علمية أخرى، وهي في الأصل تكون نتاجا لدحض نظريات علمية سبقت عليها (بوبر)، بينما القرآن هل هو يقبل الدحض؟
2- هناك صيغ (براديغم)، تنبني على افتراضات نظرية، نغيرها ساعة تتوقف عن ملاءمتنا بشكل كافي حسب كوهين، وهذا على سبيل المثال ما حدث في حالة الكوبرنيكية والداروينية.. في حين هل القرآن براديغم يقبل أن نغيره بغيره؟
3- بالنسبة لفيرابند، «كل شيء يتحرك»، كل الوسائل جيدة، كل الطرق جيدة، لا توجد فعليا أي طرق إرشادية في العلم، فهو متحرك، و يقبل الترقيع أحيانا، فهل القرآن يقبل أن يكون علبة أدوات للترقيع؟
4- وقبل هؤلاء، نجد بوانكاري، وهو أحد أكبر العلماء الخالدين، الذي أظهر أن العلم يقوم على مجموعة من التوافقات والتقاليد، في حين هل يقبل القرآن أن يطوعه البشر تبعا لتوافقاتهم ؟
يتبدى من خلال كل تلك الأمثلة، أن الكلام الذي يقول إن القرآن والعلم متداخلي المجالات والطرق، لا ينتج عنه سوى نسبة اللايقيني والمتغير والمرتبط بغيره والمتحكم فيه بالقرآن، وهذا الكلام لم يكن ليجرأ عليه حتى أكبر أعداء الاسلام !
ويقول المتنورون من المسلمين، إن الاسلام يحض على اتباع العلم .
صحيح «اطلبوا العلم ولو في الصين»، هو حديث قال به الرسول، هنا يطرحون السؤال عن لماذا يتهم الدين بالتخلف، بأن الأخذ به في العلم رجعية ما دام يحرض على الدين بهذا الشكل.
وللإجابة على هذا السؤال هناك ملاحظتان أساسيتان:
الأولى: تخص كلمة «علم»، وهي أيضا لا تخلو من «الابهام»، فليس المراد منها العلوم الطبيعية، أو على الأقل إنها ليست هي العلوم الطبيعية بالدرجة الأولى، بل يراد به العلم الشرعي. لماذا نترك مكة والمدينة لنذهب إلى الصين إذا كان العلم الشرعي هاهنا.
هذه القاعدة العجيبة، التي تجعل العلم الشرعي متقدما عن المعرفة العلمية، صارت العادة الأكثر انتشارا بين الدول المسلمة، بمبرر من الشرع، اذ نحن نجد مثلا، أن المغرب هذا البلد النامي الذي ينتمي للعالم الثالث، والذي يدعي أنه حداثيا، أو الأقل أنه في طريقه إليها، يمكننا أن نحصي ساعات الدراسة لمختلف المواد لسنة 2005، في أقسام الإعداديات، نجد أن التربية الاسلامية تأتي على رأس تلك المواد، سواء في الابتدائي أو الاعدادي، إن التلاميذ يحصلون على ما مجموعه 884 ساعة فيها، في مقابل 409 ساعة للتاريخ والتربية الوطنية، بينما في مواد الفيزياء والعلوم الطبيعية 714.
يضاف إليه أن التربية الاسلامية هي المادة الوحيدة التي تدرس في كل مستويات التي يقطعها التلميذ المغربي، إلى جانب اللغة العربية، من قسمه التمهيدي إلى آخر سنة في الباكلوريا.
نلاحظ إذن أن العلم (صيونس)-العلوم الطبيعية وفهم العالم من حولنا، وعلم المنطق، والحساب.. ليس هو المقصود بالحديث، وإنما العلم (الشرعي)، أو على الأقل ذلك ما تثبته ميولات المسلمين، انسجاما مع ما فهموا.
الملاحظة الثانية: أن هذا الحديث حتى وإن كان يخبرنا بما علينا فعله، فإنه لا يعلمنا الطريقة، سافر إلى الصين أو إلى منطقة بعيدة في العالم، ماذا ستجد، أرض مختلفة غريبة، مختلفة، ستتوه ولن تتعلم أي شيء، لذلك فعادة الناس لا يمر عبر خلدهم حتى خاطر الذهاب لما يسمعون الحديث.
مجالان مختلفان:
لاشيء يجمع بين المجالين، تطرح السؤال كيف عاش المسلمون في فترة معينة، عصرهم الذهبي في علاقتهم بالدين، ذلك ما سنعالجه في الورقة اللاحقة، لأبين أنهم لم يعيشوه إلا في تلك اللحظات المحدودة التي فصلوا فيها بين المجالين، في ممارستهم للعلم.
