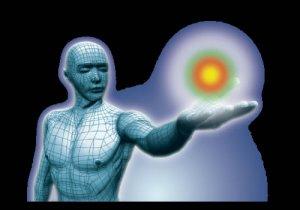كنت أعيد قراءة الكتاب الهام للمفكر العربي جورج طرابيشي، والذي حمل عنوان( المثقفون العرب والتراث) هذا الكتاب الذي شكل علامة فارقة في تناول هذا العنوان لأنه اعتمد على التحليل النفسي، مدارسه واجتهاداته أيضا. وكانت المرة الأولى التي قرأت فيها هذا الكتاب، هي في سجن صيدنايا العسكري شمال دمشق. حيث وصلتنا في بداية التسعينيات نسخة واحدة من هذا الكتاب، و أثار ازدحاما لدينا لأننا كنا أكثر من 150 معتقلا، وعلى نسخة واحدة فقط، ومن حسن حظي أنني كنت مسئولا عن مكتبة الجناح، وصاحب السلطة مهما كانت يستفيد منها، فقرأته قبل غيري. وأثار نقاشا غنيا بيننا، ولكنه كان يغلب على هذا النقاش أجواء الهم السياسي في الحقيقة. وكيفية إعادة صياغة رؤيتنا للعالم من جديد بعد الإحباط الذي أصاب أكثريتنا من سقوط السوفييت- رغم أننا بالمجمل أبدا لم نكن سوفييتيين- وشكل في الحقيقة هذا الكتاب علامة مهمة في إعادة قراءتي للذات وللعالم الذي نعيش فيه. كما تابعنا الجدال العميق بين المفكر المغربي محمد عابد الجابري في نقد العقل العربي، وفي(نقد- نقد العقل العربي- ردّا موسوعيا من جورج طرابيشي) أيضا وصلتنا من كل كتاب نسخة واحدة، ومن الطبيعي أن تجد بيننا من كان في صف الجابري، ومن كان في صف الطرابيشي، ومن قرأ النصين من خارجهما، إي باختصار تعددت القراءات وتعددت بالتالي وجهات النظر من السجال العميق هذا، والغني معرفيا في الحقيقة، وخاصة عند صاحب الرد، وهذا طبيعي لأن المشروع الأصلي كان في حينها يعتبر فتحا معرفيا من قبل محمد عابد الجابري ولازال لدى الكثير. وعلى هامش هذا التواجد كانت تتواجد قراءة أخرى للمشروع الغربي، والتي هي قراءة المفكر العربي مطاع الصفدي، والذي رغم اختلاف الكثير منا مع النتائج التي كانت تترتب لدى مطاع الصفدي على هذه القراءة، أقصد النتائج السياسية، وموجود بالطبع مشاريع الطيب تيزيني، وكتب صادق جلال العظم، ومحمد أركون، وحسن حنفي الخ الكوكبة التي أغنت المكتبة العربية والفكر العربي ولازالت تغنيه حتى اللحظة، رغم تباين القراءات وتعدد المرجعيات الفكرية والسياسية، وبالتالي المنهجية. وهذا ما طرح سؤالا ولازال يطرحه حتى اللحظة: وأنا أعتقد أنه سؤال غاية في الأهمية، هذه النخبة وغيرها تحولت بالنسبة لنا إلى فضاء مرجعي ولازالت، ورغم تعدد المناهج والمرجعيات أرى أنهم جميعا لديهم قاسم مشترك واحد وهو أنهم جميعا قرؤوا، وكتبوا انطلاقا من مرجعيات غربية، وبلغات غربية أو باللغة المنتجة نفسها لهذا الفكر الغربي الذي تحول إلى مرجع لكل مدارس الفكر العربي، واغتنت اللغة العربية بانجازاتهم المعرفية والأيديولوجية؟ هل كان لهم إمكانية في قراءة الواقع العربي داخل هذا العالم وفيه بدون منتجات الفكر الغربي؟ الطريف بالأمر الآن، أنه حتى عتاة السلفيين في الفكر العربي المعاصر، تجدهم يستندون بوعي أم بدونه على منتجات الفكر الغربي نفسه. في الواقع يجد المرء نفسه أمام معضلة أساسية وهي أن الخلاف ليس على قراءة الواقع العربي فقط، وإنما على قراءة كيف يفكر الغرب بنا؟ ومن نحن بالنسبة إليه؟ وهل يمكن لنا اشتقاق فهما واحدا لهذا الغرب بنا؟ ملاحظاتي ستكون على هذه النقطة في الحقيقة، مع العلم أنه لدى كل واحد من نخبنا العربية قراءته الذاتية لكيفية تعاطي الغرب معنا، ولكنها قراءات لا تعدو أن تكون محددة تبعا لما يريده القارئ نفسه من الواقع العربي. وبشكل أكثر عمومية نستطيع القول أن هنالك اتجاها رئيسيّا يجمع الجميع تقريبا، بأن الغرب يفكر بنا بالمحصلة كمادة استعمارية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. من مقدمتي هذه يمكن أن استنتج بشيء من الاعتباط والقسر المنهجي، أننا أمام حدين:
الأول السجن السلطوي بما يمثله من رمزية وواقع عربي متخثر عليه، حيث النخب مسجونة في فضائها الخاص عبر السجن المادي من جهة وعبر سجن الفكر والتنوير ومنعه عن المؤسسات التعليمية أو التي تصل إلى المواطن العادي، فالسلطة عندما تحتكر أجهزة التعليم والثقافة فإنما تسجن المثقفين والنخب بعيدا عن موجب الفكر الأساس وهو أن يحقق سلطة عبر هيمنته الأدبية والفكرية على المواطن العربي. والحد الثاني أننا أمام حضارة قوة بات لها حضور قوي وكوني، أسميناه قوة الحضارة، ولا يوجد حضارة بدون قوة. وإذا جاء الغرب إلينا محمولا على عسكره، فإنه شكل لنا مرجعا في كل شيء. وهذا سر قوة حضارة الغرب في تعددها وقدرتها على استيعاب هذه التعددية. والتعددية هنا تطال كل مجالات الحياة. ندري أولا ندري نحن نصطف في داخل هذه التعددية، والتي لم نقتنع بعد بأنه لا مجال أمامنا دون هذا الاصطفاف في تعددية الغرب ومشروعه الذي أضحى كونيا، ولا مجال للعودة إلى الخلف، إلا بنهاية الحضارة والعودة إلى أيام السيف والترس، وعصر نبوءات جديد، يعيد حاجة البشرية إلى أنبياء جدد، وهذا في الحقيقة ما قضى عليه المشروع الغربي. أنه حمل البشرية إلى حالة يمكننا تسميتها حالة عدم حاجة البشرية إلى أنبياء، وعدم حاجتها إلى أوصياء من خارج هذه البشرية في إدارة شؤونها في الحرب وفي السلم، في العلم وفي المدنية، في خرق حقوق الإنسان في توطيد هذه الحقوق، في تعايش المختلفين، وفي تضارب مصالح البشر..الخ إننا أمام وضعية لم نعد نستطيع الخروج منها، ويجب ألا نخرج منها، لكي لا نصبح خارج التاريخ، وهذه بالضبط وظيفة السجن لدى السلطة العربية، والتي مشكلتها الآن أن هذا الغرب يريد مصلحيا إخراجنا من هذا السجن الذي ساهم فيه عن جدارة وقوة في السابق، وهذا أيضا هو اتجاه وليس كل الغرب، هذه الوضعية تقتضي أيضا العمل مع هذا العالم وفيه وبأدواته التي أنتجها ويمكن له أن ينتجها، دون حاجة إلى أوصياء سواء من القرآن الكريم أو من الإنجيل أو من التلمود البهي في غزة.
-2-
أصبح لدينا الآن ما يمكننا من القول أن قوة الحضارة، بات لها حضورها اللا عسكري، وهذا ما عنى ويعني لي النموذج الياباني على سبيل المثال، فهو نموذج يعبر عن قوة هذه الحضارة الآن، وليس عن حضارة القوة، إن البشرية الآن لا يقودها المشروع الغربي- الكوني، بقوة السلاح، بل بات له مساحة من الهيمنة السياسية والثقافية والفكرية والعلمية والحقوقية، حتى لو لم تتدخل الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان عسكريا، فهي لم تتدخل لفرض النموذج الغربي بالقوة، ولكنها دخلت نتيجة لعدة عوامل ذات بعد سياسي مباشر، يتعلق بمسرح تنافس القوى على الصعيد العالمي. وما حدث أن تدخلها وإن كان ترك نتائج مختلف على كارثيتها، ولكنها لم تستطع دعم قوة الحضارة هذه بتدخلها بل ما نتج أعاد للأذهان عصور الاستعمار التقليدي كما عبر عن جوهر هذا الأمر الأمير الرابع في العائلة المالكة الإنكليزية، وطالب الأمريكان أن يستفيدوا من تجربة الانكليز ولا يقوموا بإعادة التجربة الاستعمارية مرة أخرى. قوة الحضارة أن تتحول قيمها إلى مشروع لكل البشر، دون عملية قسر عنفي. مع ذلك لازالت حضارة القوة حاضرة في ممارسات بعض مراكز القوى على الصعيد الدولي- أمريكا نموذجا- لأن قوة الحضارة تعتمد على السلم واللا عنف في مشروعيتها بينما حضارة القوة هي التي تعتمد العنف والقوة العسكرية على فرض نموذجها، مع ذلك هنالك من المثقفين والنخب العربية، ترى أن استخدام القوة هذا هو لمنع هذه الشعوب من أن تأخذ بنموذجها هذا وليس لفرض هذا النموذج عليها، ويصبح الحديث هنا عما يسمى سياسة النهب الإمبريالي. مع ذلك عندما نتحدث عن سياسة النهب الإمبريالي فمرجعيتنا هي من لدن هذا المشروع ذاته. مثال آخر، إن الجابري يستند فيما يستند عليه هو مركزية العقل الغربي، بينما نجد الأمر مختلفا عند جورج طرابيشي الذي يستند على التنوير وكل مرجعيات الفكر الغربي ليبرز عالمية هذا الفكر وهذا العقل وقيمه من خلال تأكيده على عالمية الإنسان أصلا. العلمانية عند الجابري أمر مشكوك بقدرتنا على تبيئته، إن لم يكن مرفوضا أصلا وهذا جوهري في مشروعه! ولكن العلمانية قيمة تكاد تكون مطلقة وتجربة عالمية عند جورج طرابيشي. وهذا أمر يجعلنا نعود لطرح السؤال مجددا وإن بغرض آخر: ما الذي يريده العرب من الغرب ومن العالم؟ ولهذا يمكننا القول لغالبية التيارات الإسلامية، أن إعادة قيام مشروع إمبراطوري جديد، لا يتم إلا من خلال وجودنا داخل هذا العالم وبأدواته وثقافته ومنتجاته، فإن كانت سلطنا عبر تراكم قوة إمساكها بمجتمعاتنا كانت قادرة نسبيا على الانتقائية في التعامل مع هذه الحضارة ولازالت تحاول، تنتقي فنون تشكيل رأي عام يتوافق تماما مع مصالحها الضيقة، وتنتقي كل وسائل التعذيب المنتجة في الغرب، وترفض انتقاء شرعة حقوق الإنسان. فإننا بتنا في زمن حتى السلطة عندنا لم تعد قادرة على هذا الاختيار الآن كما كانت تفعل في العقود الماضية، ومأزق السلطة هذا انعكس على المجتمعات العربية ونخبها المأزومة أصلا وبكل تياراتها. لهذا هنالك شبه إجماع عند هذه التيارات من الخوف من انهيار هذه المجتمعات التي لم يتسنّ لها الاجتماع بعد! ويبقى السؤال معلقا، كيف يفكر الغرب بنا؟
-3-
إذا كان المشروع الغربي بدأ بالسيف، فإنه وصل إلى حالته الكونية مستندا على هذا الإرث الإنساني، والتقني المتقدم على كل ما سبقه من حضارات. كونية هذا المشروع، قوة هذه الكونية جعلت الثقافات الأخرى تعيد صياغة علاقتها في العالم وبالعالم من جديد، أمر لا بد منه لكي تعيد موضعة إرثها هذا داخل هذه الكونية، وهذا في الواقع، لم يشكل مآسيه الكثيرة، إذا قورنت بمآسي الحالة العربية والإسلامية، والتي لازالت عبر نخبها، كلها التي تتحرك بمرجعيات مفهومية غربية في غالبيتها، تقاوم هذا (السحر) الكوني، والذي يتم التعامل معه جملة وتفصيلا: أنه الطرف المنتصر، والذي يقابله الطرف المهزوم( نحن)، ونتوارث الهزيمة عبر نخبنا هذه، في محاولة يائسة لتغيير العلاقة بين طرفي المعادلة، حيث تترسخ ال(نحن) هذه كمنتصر، وبقية العالم كمهزوم. ونبقى نداور على موضوعة الخصوصيات الثقافية والدوائر الحضارية المغلقة أساسا، بالنسبة لنا، فتارة نتجه في أمثلتنا نحو الشرق وتارة نتجه فيها نحو الجنوب. لماذا بقيت الدائرة العربية لإسلامية، تدور في حلقتها المفرغة هذه؟ وهذا ما نعتقد أنه شأن تاريخي حديث ومعاصر، وليس شأنا ثقافيّا سرمديّا. وإذا كنا نريد الدخول إلى عوامل المنع هذه وما تمثله ثقافات الممانعة لدينا، وقلنا ثقافات الممانعة ولم نقل ثقافة الممانعة، لأنها فعلا ثقافات، فمنها الممانع ماركسيا ومنها الممانع إسلاميا ومنها الممانع قوميا، ومنها الممانع الذي يحاول التركيب بين هذه الأنساق وغيرها، ليضعها على قاعدتها الأساس(نحن) أبناء مشروع كوني مهزوم علينا تغيير المعادلة. الموضوع ليس ثقافيا، بقدر ما هو عوامل تاريخية راهنة ، حديثة، ولازالت رابضة على الأرض تحاول دوما إيجاد معبر ثقافي عنها، وهذه المحاولات تأتي أيضا من صلب هذه العوامل التاريخية المتضافرة والتي جعلت من معاناة شعوبنا، تراجيديا لا أحد يستطيع التكهن بعمق الانشراخات التي تركتها في الفرد العربي أو الإسلامي إن شئت. علينا البحث في مربع جهنمي، سواء كانت أطرافه أوجدتها الصدفة الطبيعية أو أوجدتها فعاليات المشروع الغربي ذاته! لم يعد مهما، لأن قوة حضورها الطاغي تمنع التفكير فيها على هذا النحو، وهذا المربع المحكوم بزواياه الأربع في تداخل، تراكم عبر عقود من الزمن، لينتج هذا الخلط المشين لدينا: الغرب، النفط، إسرائيل، السلطة العربية. داخل هذا المربع يمكننا البحث الأساسي، وتواضعاته في كل بلد على حدة، وعلينا أن نخرج نظريا على الأقل خارج الدائرة، لنرى عن أية ثقافة نتحدث، وبأية خصوصية ثقافية ندعي، إنه الثراء والسلطة اللاعقلانية، واللا شرعية، ووطن اليهود القومي الذي لم نعرف حتى اللحظة أين هي حدوده، ومتى سيكف عن ابتزاز العالم بالدم الفلسطيني؟ ومتى نستطيع الإجابة عن سؤال كيف يفكر الغرب بنا، الغرب الذي لم يعد غربا بل صار العالم كله؟ عندها يمكننا أن نلمح بقوة تاريخية السلطة العربية المعاصرة وقوة حضورها فينا والأنكى من ذلك أنها تحضر بنا، على مواطن منتهك مقموع ومقهور، ومشتت، هل هذا مواطن له خصوصية ثقافية، خارج تشتته وخوفه الدائم من القدر السلطوي الذي حل محل الله، ولبس لبوسه وأسماءه الحسنى واشتقاقاتها حتى، الخالد، القوي، المفدى، الماكر، الفذ..الخ ونحن تائهون بين حضارة القوة وقوة هذه الحضارة نبحث فيها عما يجدد خصوصيتنا الثقافية التي هي السلطة؟.