حتمية الحوار
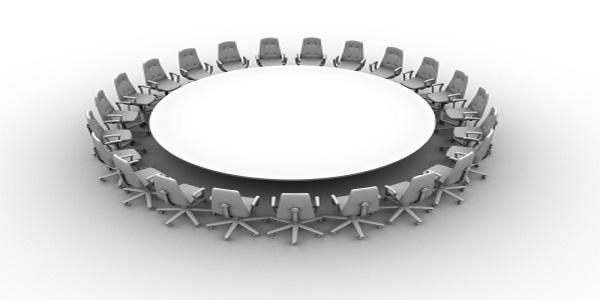
راغب الحنفي السرجاني
من المؤكد والمبرهن من قبل أنَّ الإنسان سائرٌ في طريق الحياة بين اختيارين: إمَّا التعارف لتحقيق المصلحة المشتركة، وإمَّا التقاتل لتحقيق المصلحة الذاتيَّة، وقلنا: إنَّ الأسلوب الأوَّل هو أسلوب الأسوياء، وأنَّ الثاني أسلوب الأشقياء.
ومن أبرز آليَّات التعارف لتحقيق المصلحة المشتركة: الحوار، ولسنا نعني هنا الحوار التقليدي؛ الذي هو مجرَّد تبادل الكلمات بين الطرفين، وإنَّما نقصد الحوار الإيجابي المثمر، الهادف إلى تحقيق نتائج عمليَّة متمثِّلة في المصلحة المشتركة، حتى لو كانت هذه المصلحة مجرَّد المعرفة بالشعوب الأخرى، وسماع تعريفها لنفسها؛ فهذا في حدِّ ذاته مصلحة للإنسانيَّة كلِّها.
إنَّ الإنسان -كما يُقال بحقٍّ- عدوُّ ما يجهل؛ لذا فالتعارف هو الضمانة دون أن يتحوَّل الإنسان المختلف إلى عدوٍّ، ولن يكون تعارف حقيقي ما لم يجرِ حوارٍ حقيقي بين الشعوب.
والعقلاء الذين يُريدون صلاح الإنسانيَّة لا يختلفون على قيمة الحوار وأهميَّته؛ حتى إنَّ أفلاطون يعتبر الحوار هو "العلم الأعلى الذي ليس بعده مناقشة"؛ لأنَّه المنهج الذي به يرتفع العقل من المحسوس إلى المعقول، دون أن يستخدم شيئًا حسيًّا؛ بل الانتقال من معانٍ إلى معانٍ بواسطة معانٍ[1].
الحوار الناجح
لم يبدأ مذهب من المذاهب ولم تنتشر فكرة من الأفكار في بادئ الأمر إلَّا عن طريق الحوار والإقناع، وبهذه الطريقة وحدها تجمعُ الأتباعَ والمتحمِّسين والمعجبين، ثُمَّ تبدأ رحلتها في عقول البشر؛ إمَّا بالحوار إلى نهاية الأمر، وإمَّا أن تضطر إلى المواجهة والصدام لتنشر نفسها، أو أن تكون بطبعها فكرةً صداميَّةً فتبدأ بحمل السلاح، فتكون بهذا قد اختارت شكل الحوار والمواجهة التي تُريد، إلَّا أنَّ البداية الأولى كانت دائمًا من الحوار.
منذ أقدم المصلحين -وأسماهم الأنبياء عليهم السلام- لم يكن شأن أحدهم إلَّا أن يقول وينصح، ويُبَيِّنُ ويُحَاوِر قومه بألين عبارةٍ وألطف حديث، ولقد سَجَّل القرآن الكريم كيف كان الأنبياء يسلكون كلَّ السُّبُل في دعوة قومهم بالحوار وحده، حتى إنَّ نوحًا عليه السلام لبث في قومه (أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا) [العنكبوت: 14]، وعلى الرغم من هذا (مَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ) [هود: 40]. وبمثل هذا كان حال أنبياء الله هود وصالح وإبراهيم ولوط وغيرهم، وظلَّ الأنبياء لا يستعملون غير الحوار مع أقوامهم، وكان الله يُهلك مَنْ لم يُؤمن.
حتى الحكماء الذين وضعوا -أو نُسبت إليهم- المذاهب والديانات الوضعيَّة كان سبيلهم الأوَّل هو الحوار؛ يستوي في هذا بوذا وفلاسفة الهند، وكونفوشيوس وفلاسفة الصين، كذلك فلاسفة اليونان الذين كانوا من أبرز بني الإنسان تحليلًا لفنون الحوار؛ لأنَّهم كانوا في بيئة السوفسطائيِّين الذين "اخترعوا لأوربَّا النحو والمنطق، وهم الذين رَقَّوْا فنَّ الجدل، وحلَّلُوا أشكال الحوار، وعَلَّمُوا الناس كيف يكشفون الخطأ المنطقي، وكيف يُمارسونه، وبفضل ما بعثوه في اليونان مِنْ حافزٍ قوي، وما ضربوه بأشخاصهم من أمثلة، شُغِفَ مواطنوهم بالمناظرة والاستدلال"[2].
ولم يزل الفلاسفة والمصلحون في كلِّ عصرٍ يتخذون سبيل الحوار حتى وصل الأمر إلى ما يُشبه الثورة عند هيجل، الذي اعتبر أنَّ تاريخ البشريَّة إنَّما هو سلسلةٌ من الحوار والجدال بين الأفكار، حتى لقد عُرف منهجه بالمنهج الجدلي، وعنده أنَّ الوعي يسبق المادَّة، وأنَّ الفكرة -مع استمرار الحوار والجدال- يتولَّد منها نقيضها ثُمَّ لا يزالان يتجادلان حتى يتولَّد منهما فكرةٌ أخرى جديدة، هي نفسها -وبأثرٍ من الحوار والجدال معها- ستلد نقيضتها... وهكذا[3].
ومن ثورة هيجل الذي جعل التاريخ كله تاريخًا من الحوار، حتى لحظتنا الحاضرة التي تعترف فيها الإنسانيَّة بضرورة الحوار والتواصل بين البشر، وبحتميَّة هذا الحوار لعالم أفضل، لا سيَّما بعد ظهور نظريَّات تصادميَّة مثل نظريَّة هنتنجتون؛ ومن ثَمَّ كثر الحديث عن حوار الحضارات وتعايش الحضارات وتكامل الحضارات.. وما إلى ذلك[4].
الحوار في ظلال النظرية:
في ظلِّ نظريَّة "المشترك الإنساني" سنرى أنَّ البشريَّة تحتاج إلى الحوار بشكلٍ دائم، في كلِّ المشتركات الإنسانيَّة ثمَّة مساحات للحوار فيها الأخذ والردُّ.
المشترك الأسمى: وهو أعلى المراتب التي تُعالَجُ بالحوار، بل هو -كما أوضحنا من قبل[5]- لا سبيل إلى معالجته بأيِّ شكلٍ آخر إلَّا الحوار؛ فهي المنطقة الحساسة المشتعلة التي لا يقبل الإنسان أن تُنتهك أو تُهَان، والعقيدة حين تُنتهك إنَّما تُفَجِّر طاقات المقاومة بكلِّ عنفوانها وقوَّتها وقسوتها، والحرب الدينية هي أخطر وأشرس وأطول أنواع الحرب جميعًا.
من أجل ذلك كانت تعاليم الإسلام تُوصي أن يكون الحوار مع أهل الكتاب -ليس بالحسنى فقط بل- بالتي هي أحسن، قال تعالى: (وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [العنكبوت: 46]. ولا يقتصر هذا الأمر على أهل الكتاب فقط، بل حتى في الحوار مع المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى حذَّر القرآن الكريم من التعرُّض إلى معتقداتهم بسوء، وهو تحذيرٌ يكشف عن أنَّ مجرَّد التعرُّض بالسوء -ولو على مستوى الألفاظ- إلى العقائد الأخرى كفيلٌ بأن يفتح باب اشتباك، قال سبحانه وتعالى: (وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ) [الأنعام: 108]. ثُمَّ تأتي الحكمة الربانيَّة لتكشف عن أنَّ كلَّ قومٍ راضون عن معتقداتهم، ومتعلِّقُون بها ويستحسنونها، وأنَّ الفصل في هذا الأمر سيكون عند الله في يوم القيامة: (كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام: 108]. لذا فالمنهج الإسلامي العامُّ للحوار في أمر العقيدة هو ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [النحل: 125]. وفي قوله سبحانه وتعالى: (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الإسراء: 53].
بل نهج القرآن الكريم منهج النزول في الحوار فقال تعالى: (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ * قُلْ لاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ * قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ) [سبأ: 24-26]. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلم على وجه اليقين أنه على الحقِّ والهدى، ومع ذلك أمره الله في تحاوره مع المشركين أن يقول لهم: (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ). وإنَّها الأرضية المشتركة التي نقف عليها، أحدنا على حقٍّ والآخر على باطل، فلنتناقش ولنتحاور حتى نصل إلى الحقيقة الغائبة؛ إنها طريقة الحوار المثلى، وغاية الأدب، ومنتهى سموِّ الأخلاق، ثم يُعَلِّمه الله عز وجل أن يخاطبهم في أدب جمٍّ، فيقول لهم: (لاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلاَ نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ). فقد أُمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينسب (الجُرْم) إلى نفسه، وهو عادةً يأتي في الأخطاء والزَّلاِّت، وينسب لفظ (العمل) لهم، وهو يحتمل الصلاح أو الفساد، ثم يُسَلِّم الأمر كلَّه بعد ذلك لله عز وجل، فيقول: إنَّ الله عز وجل سيجمع بيننا جميعًا يوم القيامة، ويحكم بيننا بالحقِّ الذي يراه، فنعرف ساعتها مَنِ الذي أصاب، ومَنِ الذي أخطأ، وهذه -ولا شكَّ- أرقى وسيلة ممكنة من وسائل التحاور، لا تحمل أيَّ صورةٍ من صور العصبيَّة والتَّزَمُّت؛ إنَّما فيها كلُّ الأدب، وكلُّ التقدير للطرف الآخر[6].
ومن الأمثلة القيِّمة؛ ذلك الموقف الرائع الذي دار بين النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعتبة بن ربيعة الذي جاء مساومًا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك الإسلام؛ إذ قال: "يا ابن أخي؛ إنَّك منَّا حيث قد علمتَ من السِّطَة في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك أتيتَ قومك بأمر عظيم فرَّقت به جماعتهم، وسفَّهت به أحلامهم، وعِبْتَ به آلهتهم ودينهم، وكفَّرت به مَن مضى مِن آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها؛ لعلَّك تقبل منها بعضها".
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قُلْ يَا أَبَا الْوَلِيدِ أَسْمَعْ". قال: "يا ابن أخي؛ إنْ كنتَ إنما تُريد بما جئت به من هذا الأمر مالًا جمعنا لك من أموالنا؛ حتى تكون أكثرنا مالًا، وإن كنتَ تُريد به شرفًا سوَّدناك علينا؛ حتى لا نقطع أمرًا دونك، وإنْ كنت تريد به مُلكًا ملَّكناك علينا، وإنْ كان هذا الذي يأتيك رِئيًا تراه لا تستطيع ردَّه عن نفسك طلبنا لك الطبَّ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نُبْرِئك منه؛ فإنَّه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُدَاوى منه".
حتى إذا فرغ عتبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال: "أَقَدْ فَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟" قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: "فَاسْمَعْ مِنِّي". قال: أفعل. فقرأ صلى الله عليه وسلم: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ * وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ) [فصلت: 1-5]. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرؤها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها، وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليهما يسمع منه، ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها، فسجد ثم قال: "قَدْ سَمِعْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ مَا سَمِعْتَ فَأَنْتَ وَذَاكَ".
فقام عتبة إلى أصحابه، فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلمَّا جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أنِّي قد سمعتُ قولًا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشِّعْر ولا بالسِّحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش؛ أطيعوني، واجعلوها بي، وخَلُّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوه، فوالله ليَكُونَنَّ لقوله الذي سمعتُ منه نبأٌ عظيم، فإن تُصِبْهُ العرب فقد كُفِيتُمُوهُ بِغَيْرِكُمْ، وإن يظهر على العرب فمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ، وعِزُّه عِزُّكُمْ، وكنتم أسعدَ الناس به. قالوا: سَحَرَك والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم[7].
وهذا الحوار في غاية الأهميَّة؛ بل يُعتبر دستورًا في الدبلوماسيَّة والتفاوض، فعلى الرغم من أنَّ عتبة بن ربيعة كان قد قدَّم كلامه بمجموعةٍ من التُّهَم الموجَّهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلَّ على هدوء أعصابه، ولم ينفعل، إنَّما واصل الاستماع في أدبٍ واحترام، على الرغم من أنَّ عتبة عرض على النبيِّ صلى الله عليه وسلم التنازل عن دعوته مقابل ما يعرضه عليه من مغريات الدنيا، فقَبِلَ أن يستمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم إليه، بل وقال له: "قُلْ يَا (أَبَا الْوَلِيدِ) أَسْمَعْ". فهو يُكَنِّيه بِكُنْيَتِهِ؛ أي يُناديه بأحبِّ الأسماء إليه ويُلاطفه ويُرَقِّق قلبه، ولَمَّا عرض عتبة بن ربيعة الأمور التي جاء بها لم يُقاطعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم مع سفاهة العروض وتفاهتها؛ بل إنَّه صبر حتى النهاية، وقال في أدبٍ رفيع: "أَقَدْ فَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟" قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: "فَاسْمَعْ مِنِّي".
لقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرصة كاملةً لعتبة؛ لكي يتكلَّم ويعرض وجهة نظره، وبعد انتهائه تمامًا بدأ هو في الكلام؛ ليضرب لنا بذلك أروع الأمثلة في التحاور مع الآخرين، وإن كانوا مخالفين تمامًا في العقيدة والدين.
لقد أطلنا -عن عمد- في أمر الحوار حول المشترك الأسمى وهو العقيدة؛ لِمَا لهذا الجانب من خصوصيَّة تجعله لا يحتمل المعالجة إلَّا بالحوار.
المشتركات العامة:
على الرغم من كون هذه المشتركات ثوابت أصيلة في الطبيعة الإنسانيَّة، مستقرَّة في نفس كلِّ البشر، فإنَّ تفاصيل كثيرة تندرج تحت هذه القيم تحتاج إلى أن تكون على مائدة الحوار؛ لمزيدٍ من التعارف والالتقاء بين الشعوب.
فالعدل -على سبيل المثال- وهو من الأخلاق الأساسيَّة المندرجة في المشتركات الإنسانيَّة العامَّة- قيمةٌ كبرى وأصيلة، غير أنَّ معنى العدالة وتحقُّقها بالشكل الأمثل وشروط القائمين على تنفيذها ومدى سلطاتهم وصلاحيَّتهم موضوع نقاش، أين يقع الخطُّ الفاصل بين العدل والرحمة؟ وأين هذا الخط بين العدل والقسوة؟
كيف نُوَفِّق بين الحرية -التي هي -أيضًا- معنى كبير وحقٌّ أصيل ومن المشتركات العامَّة- وبين إقرار النظام؟ أين يقع الخط الفاصل بين حريَّات الأفراد وسلطات الدولة؟ وكيف نضمن ألَّا تتعدى الدولة على الحقوق الأصيلة للأفراد؟ ثُمِّ وفي الوقت نفسه كيف نضمن ألَّا تتحوَّل حريَّات الأفراد إلى غولٍ ضخمٍ من الفوضى والهرج؟
كلُّها أسئلة يُجاب عليها في كلِّ شعبٍ بإجابات أصلها واحد وتفاصيلها متنوِّعة، وعند كلِّ شعبٍ إبداعٌ في الإجابة أو طريقةٌ في الحلِّ تستحقُّ أن تُعمَّم على غيره من الشعوب، ثُمَّ لكلِّ شعبٍ ثقافةٌ وخصوصياتٌ أخرى تجعل إجابته على السؤال أو طريقته في الحلِّ لا يُمكن استنساخها في مكانٍ آخر.
ولعلَّ من أبرز الأمثلة الدالَّة على هذا ما يتَّضح في الانقسام القائم على عقوبة الإعدام مثلًا، ففي حين يرى أُناس أنَّ الإعدام هو العقوبة الوحيدة العادلة للقاتل المتعمِّد، وأنَّ هذا المعنى من الوضوح إلى الحدِّ البدهي والمنطقي والفطري، يرى آخرون إلغاء عقوبة الإعدام حتى للقاتل المتعمِّد؛ ونظريَّتهم أنَّه لا يجوز مقابلة جريمة بجريمة أخرى مثلها.
التملُّك.. الكرامة.. العلم.. العمل، كلُّها أصولٌ كبرى مُتَّفقٌ عليها، إلَّا إنَّ لها أنماطًا متنوِّعةً بتنوُّع الرؤية والثقافة والمعتقدات والأعراف والعادات والتقاليد، "ونستطيع القول: إنَّ كلَّ أُمَّةٍ من الأمم كان لها إسهاماتها الكبيرة في إثراء التنوُّع الثقافي عبر العصور، وكانت كلُّ أُمَّةٍ مكمِّلةٍ لغيرها، وكلُّ تراثٍ حضاريٍّ مهما كان تنوُّعه أو اختلافه فهو ناشئٌ بفعل التأثير والتأثُّر، ويقع تحت مضمون الأخذ والعطاء"[8].
المشتركات الخاصة:
ذكرنا من قبلُ أن ثمَّة ثابتٌ ومتغيرٌ في المشتركات الإنسانيَّة، فالمشتركات العامَّة لا تتغيَّر؛ إذ لن يأتي زمان يتخلَّى فيه الإنسان عن الطعام والشراب، ولن يتخلَّى الإنسان عن كرامته -وإن أُهِينت- أو عقله.. وما إلى ذلك، إلَّا إنَّ المشتركات الخاصَّة مع المشترك الأسمى تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان والظروف والقناعات، وذكرنا أنَّه يجب الحذر من أن تتغير هذه المشتركات بصورةٍ قسريَّةٍ غير مستساغة أو مقبولة من الشعوب؛ لأنَّ التجارِب التاريخيَّة تُثبت أنَّ التغيير بالقوَّة يُؤَدِّي إلى حروب وصراعات.
إذًا؛ فإنَّ سبيل الأسوياء لتغيير المشتركات الخاصَّة لا يكون إلَّا بالحوار والتراضي، وهو حوارٌ يستمرُّ طوال أجيال أو حقب، ويصحبها كثيرٌ من الأحداث والظروف والتغيُّرات التاريخيَّة والسياسيَّة والبيولوجيَّة وما إلى ذلك، ونستطيع أن نضرب على هذا مثالًا بتاريخ الحضارة الإسلاميَّة؛ ففي ظلِّ هذا التاريخ لا نجد قسرًا للشعوب على تغيير لغاتها أو ثقافتها أو عاداتها وتقاليدها أو أرضها؛ ومن ثَمَّ رأينا أنَّ كثيرًا من الشعوب خرجت من لغاتها فاختارت اللغة العربيَّة؛ مثل: المصريِّين، وشعوب الشمال الإفريقي، ثمَّة شعوبٌ أخرى لم تتكلَّم بالعربيَّة واحتفظت بلغاتها مثل الأتراك، وفي كلا الحالين لا بأس، ولم يُمثِّل هذا أمرًا ذا حساسيَّةٍ تخشى منه الدولة الإسلاميَّة.
حدث تزاوج وانصهار عرقي بين العرب وسائر الشعوب المفتوحة، وبين هذه الشعوب وبعضها، نشأت أجيال ذات أعراقٍ جديدة، نشأت عادات وتقاليد أخرى، وبقيت عادات وتقاليد قديمة كذلك، نشأ تاريخ جديد وعلاقات جديدة بين الأقطار، تَكَوَّنت ثقافة جديدة وبقيت ثقافات قديمة أيضًا.. كلُّ هذا تمَّ دون قسرٍ أو إجبار.
الخلاصة أنَّ كلَّ هذا تغيُّر عَبْرَ التاريخ والأجيال دون عُنفٍ أو قهرٍ أو إجبار إنَّما كان عن طريق الحوار؛ وذلك ما جعل كلَّ هذه التغيُّرات عميقة وخالدة وراسخة في الوجدان الجمعي للشعوب الإسلاميَّة.
المشتركات الداعمة:
وأمَّا المشتركات الداعمة فهي المجال الإنساني الأرحب والأوسع للحوار؛ فالفنُّ والسياحة والرياضة إنَّما هي -في التحليل الأخير- حوارٌ خاصٌّ بين الشعوب المختلفة؛ الفنُّ حوارٌ مع المواهب والإبداعات والأنماط الثقافيَّة والاجتماعيَّة والحضاريَّة للشعوب المختلفة، والسياحة حوارٌ مع التاريخ والجذور والماضي العريق للشعوب القديمة، وهي كذلك حوار مع الحاضر والحداثة والتقنية والتقدُّم التكنولوجي للشعوب الحديثة، تلك التقنيات التي خلقت من "الأرض البكر" -إن صحَّ التعبير- مزارات سياحيَّة جذَّابة، والرياضة حوارٌ مع القدرات والإمكانيَّات العضليَّة والذهنيَّة وأساليب التفكير والتخطيط والمناورة.
فالمشتركات الداعمة مساحات مفتوحة للتعليم والتعلُّم، يأخذ كلُّ قومٍ من غيرهم أفضل ما لديهم من تطوُّرات، ثُمَّ يأخذ منهم غيرهم أفضل ما يملكون أيضًا، ومن المميِّزات التي تختصُّ بها هذه المشتركات أنَّها ساحة أبعد ما تكون عن التعصُّب، فلا بأس عند أيِّ أحدٍ أن يأخذ من الآخر ما يرى أنَّه مفيدٌ له ما لم يكن مصطدمًا مع خصوصيَّةٍ دينيَّةٍ أو ثقافيَّةٍ أو اجتماعيَّة.
__________
المصدر:
كتاب المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب، للدكتور راغب السرجاني.
[1] يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص94، وما بعدها.
[2] ول ديورانت: قصة الحضارة 7/217.
[3] انظر في تحليل فلسفة هيجل ومدى تأثيره على مسار الفلسفة الغربية، وهربرت ماركيوز: العقل والثورة.. هيجل ونشأة النظرية الاجتماعية. هذا على الرغم من أنَّ هيجل لم يكن أوَّل القائلين بهذا بل سبقه الفيلسوف الألماني فيخته. انظر: رونالد سترومبرج: تاريخ الفكر الأوروبي الحديث، ص360.
[4] عبد الله العليان: حوار الحضارات في القرن الحادي والعشرين، ص211.
[5] راجع فصل "المشترك الأسمى" من الباب الثاني.
[6] راغب السرجاني: التعامل مع غير المسلمين في السنة النبوية، بحث غير منشور، ص85.
[7] مسند أبي يعلى (1818)، وابن هشام في السيرة (1/293-294)، والبيهقي في الدلائل (1/230،231)، وأبو نعيم في الدلائل (182)، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (14/295-296)، وعبد بن حميد في المنتخب (1123)، والحاكم (2/253)، وصحَّحه ووافقه الذهبي. انظر: المطالب العالية (4285). وقال الهيثمي في المجمع (6/19-20): رواه أبو يعلى، وفيه الأجل الكندي، وثَّقه ابن معين وغيره، وضعَّفه النسائي وغيره؛ فهو حسن الحديث إن شاء الله، وبقية رجال الحديث ثقات.
[8] هدى درويش: تقارب الشعوب، ص30، 31.
