أصول الرؤية الإسلامية للعالم والعلاقة مع الآخر
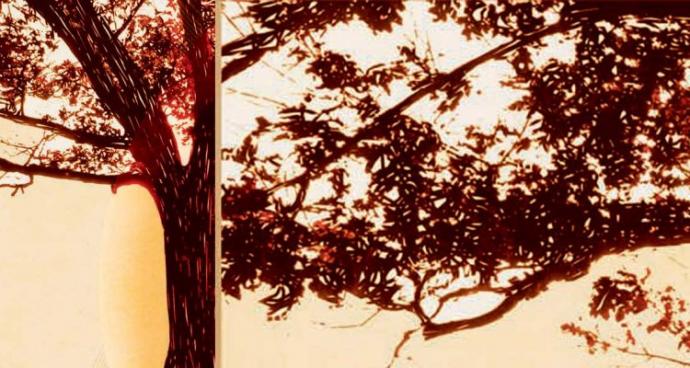
تنبع الرؤية الإسلامية للعالم من أصل عقَدي إيماني هو “التوحيد”؛ الذي يعني الإقرار بوجود الله وبوحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه هو خالق هذا الكون ومالكه الحقيقي الوحيد ولا شريك له، وهو الذي خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض ليعمرها وليتصرف فيها طبقاً لأوامره عز وجل وامتثالاً لإرادته سبحانه: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾(الأنعام:18)، ويتضمن الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى، كمال العقيدة من جهتي الربوبية (الخلق والتربية) والألوهية (العبادة).
ولكن كيف تؤثر هذه العقيدة التوحيدية على رؤية العالم في المنظور الإسلامي؟
إن تأثيرها يبدو من خلال هيمنة مبدأ “الوحدة” (Unity) والوئام على الرؤية الإسلامية للعالم، ومن ثم نبذ التجزئة والصراع، مع عدم التواني عن ردع أو منع الاعتداء من المحيط الخارجي. ولا يعبر مبدأ الوحدة عن مجرد فكرة نظرية أو فلسفية مثالية (Utopia)، وإنما هو متجذر اجتماعيًّا في وحدة الجنس البشري، وروحيًّا في وحدة الدين ورسالته من حيث مصدرها وغايتها معاً، وبيان ذلك كالآتي:
وحدة الجنس البشري
قرر الإسلام وحدة الجنس والنسب للبشر جميعاً، فالناس لآدم عليه السلام، “ولا فضل لعربي على عجمي ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى” (رواه البخاري). وحكمة التقسيم إلى شعوب وقبائل إنما هي التعارف لا التخالف، والتعاون لا التخاذل، والتفاضل بالتقوى والأعمال الصالحة التي تعود بالخير على المجموع والأفراد، والله سبحانه وتعالى رب الجميع يرقب هذه الأخوة ويرعاها، هو يطالب عباده جميعاً بتقريرها ورعايتها، والشعور بحقوقها والسير في حدودها.
ويعلن القـرآن الكـريم هـذه الحقيقة بمعانيها جميعاً في وضوح فيقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾(النساء:1)، ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾(الحجرات:13)، ويقول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في أشهر خطبة له في حجة الوداع: “إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظمها بالآباء والأجداد، الناس لآدم وآدم من تراب” (رواه البخاري)، ويقول: “ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية” (رواه أبو داود).
وبهـذا التقرير نفى الإسلام أية شرعية لكل دعاوى التعصب للأجناس أو الألوان أو الأعراق، وعقيدة الإسلام وحدها هي التي تقرر على هذا النحو -بوضوح وقطعية- وحدة الجنس البشري في إطار التنوع البنَّاء.
وحدة الدين
قرر الإسلام وحدة “الدين” في أصوله العامة، وأكد على أن شريعة الله سبحانه وتعالى للناس تقوم على قواعد ثابتة من الإيمان والعمل الصالح والإخاء، وأن الأنبياء جميعاً مبلّغون عن الله سبحانه وتعالى، وأن الكتب السماوية جميعاً من وحيه، وأن المؤمنين جميعاً -في أية أمة كانوا- هم عباده الصادقون الفائزون في الدنيا والآخرة، وأن الفرقة في الدين والخصومة باسمه إثم يتنافى مع أصوله وقواعده، ويتناقض مع غايته ومقاصده.
وإن واجب البشرية أن تتدين، وأن تتوحد بالدين، وأن هذا الدين الموحد هو الدين القيم وفطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي ذلك يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾(الشورى:13)، ويقول الله تعالى مخاطباً النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اَللهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اَللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لاَ حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾(الشورى:15)، وفي قـول للنبـي صلى الله عليه وسلم تصوير بديـع لهذا المعنـى حيث يقـول: “مثلي ومثل الأنبياء قبلي، كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون لـه، ويقولون هـلا وُضعت هـذه اللبنة! فأنا تلكم اللبنة وأنا خاتم النبيين” (رواه البخاري).
وهكذا نرى الإسلام يقدم للإنسانية مبدأ “وحدة الدين”، ويدعو إليها في وقت كانت الدنيا تشتعل بنيران الأحقاد الدينية، وتضطرم بسعير الخصومات المذهبية… وفي هذا المعترك الروحي المتأزم بفعل الخصومات والجهالات، يطلع القرآن على الناس بهذه الدعوة الجديدة؛ دعوة التآخي في الدين والاجتماع على أصوله الحقة، والإيمان به كوحدة ربانية؛ إن اختلفت فيها الفروع بحسب الأزمان، فقد اتفقت فيها الأصول الخالدة الباقية، لأنها من الفطرة التي لا تقوم إنسانية الناس إلا عليها.
ونظراً للأهمية البالغة لمبدأ وحدة الدين ودورها في بناء الرؤية الإسلامية للعالم، وانعكاسها على منظومة القيم العليا الحاكمة للعلاقات بين الأمم والشعوب من منظور هذه الرؤية، فقد يكون من المفيد الاستطراد قليلاً في بيان الأسس المعرفية العقدية لهذه الوحدة، وأهم مجالاتها التطبيقية المفترضة في إطار العلاقة مع الآخر غير المسلم.
إن آيات القرآن تنص صراحة على وحدة الدين، وتأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بأن يكونوا أول المؤمنين بهذه الوحدة. فالمسلم يجب عليه أن يؤمن بكـل نبي سبق، ويصدق بكل كتاب نزل، ويحترم كل شريعة مضت، ويثني بالخير على كل أمة من المؤمنين خلت، قال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾(البقرة:136)، ثم يقفى على ذلك بأن هذه هي سبيل الوحدة، وأن أهل الأديان الأخرى إذا آمنوا كهذا الإيمان فقد اهتدوا إليها، وإن لم يؤمنوا به فسيظلون في شقاق وخلاف، وأن أمرهم بعد ذلك إلى الله فيقول: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾(البقرة:137).
دعم الوحدة الدينية
وثمة أساسان قويان لدعم الوحدة الدينية، وإزالة كل شبهة يمكن أن تؤدي إلى جعل تعدد الرسالات السماوية مصدراً للصراع أو الحرب باسم الدين. وقد نص القرآن على هذين الأساسين كالآتي:
أولاً: إن ملة إبراهيم عليه السلام هي أساس للدين، ومرجع الأنبياء الثلاثة الذين عُرفت رسالتهم وهم: ساداتنا موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام.
الثاني: تجريد الدين من أغراض البشر وأهوائهم، والارتفاع بنسبته إلى الله سبحانه وتعالى وحده.
نقرأ عن ذلك في سورة البقرة قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾(البقرة:130) إلى آخر آية: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(البقرة:141)، ونقرأ في آيات أخرى من سورة الأحزاب (آية:69)، ومن سورة النساء (آية:75)، ومن سورة آل عمران (آية:46)، ومـن سـورة المائدة (آية:44، وآية:75)، وفي آيات أخرى من سور أخرى حيث نجدها تثني على الأنبياء جميعاً، وتقول إن التوراة والإنجيل فيهما هدى ونور وموعظة للمؤمنين.
علاقة المسلمين مع غيرهم
ومن تلك الآيات ومن غيرها نخرج بنتيجتين تطبيقيتين في مجال علاقة المسلمين مع غيرهم هما:
1- إن التعامل بين المسلمين وغيرهم من أهـل العقائد والأديان إنما يقوم على أساس المصلحة الاجتماعية والخير الإنساني، يقول الله تعالى: ﴿لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾(الممتحنة:8).
2- إن الحوار أو الجدال بالتي هي أحسن -وليس الحرب- هي الوسيلة المثلى للتفاهم بشأن قضايا الإيمان والعقيدة، قال تعالى: ﴿وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾(العنكبوت:46)، وإذا كان الحوار هو الوسيلة المعتمدة في مثل هذه القضايا على خطورتها وأهميتها، فإنه يكون أولى بالتطبيق فيما دونها من القضايا والمشكلات، وأولى أن يكون مبدءاً عاماً من مبادئ معالجة معضلات العلاقات الإنسانية بما فيها العلاقات الدولية.
ومما سبق يتضح أن الأصول المعرفية للرؤية الإسلامية للعالم، تنفي كـل مصادر الفرقة والحقد والخصومة والنـزاع بين الناس من أي دين كانوا، ولم تقف عند حدود التمهيد النظري أو الخطاب العاطفي، بل فتحت باب التعاون العملي والتواصل الفعلي والعمل المشترك والتعايش السلمي…والأمثلة علـى ذلك كثيرة؛ منها -مثـلاً- ما يشير إليه قـول الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾(المائدة:5).
أصالة السلام الإسلامي
إن مقتضى الرؤية الإسلامية للعالم -التي تقوم كما أسلفنا على أساس عقيدة التوحيد الديني، ووحدة البشرية- هـو أن تكون رسالة الإسلام عالمية: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾(الأنبياء:107)، وليست قطرية أو إقليمية أو عرقية.. وأن يكون “السلام” مركباً هيكليًّا في صلب البناء العالمي الذي ينشده الإسلام، وليس أمراً طارئاً أو استثنائيًّا. وبالتالي فإن الحرب هي الاستثناء، والصراع هو الخروج على القاعدة.
ونؤكد -مرة أخرى- على بنيوية فكرة السلام وأصالتها في الرؤية الإسلامية على كافة المستويات؛ ابتداءاً من الفرد، مروراً بالأسرة والجماعة والمجتمع والدولة، وصولاً إلى النطاق العالمي بأسره. إنها رؤية متكاملة يدعـو الإسلامُ للنظر من خلالها إلى العالم باعتباره كلاًّ متناسقاً. والسلام قرين التناسق، ولا تأتي الحرب إلا بالخروج من هذا التناسق بالبغى والظلم، أو بالفساد والتنازع، فترده الحرب الموقوتة إلى السلام الدائم من جديد.
وليس يكفي لتحقيق هذا السلام العالمي الذي يدعو إليه الإسلام أن تكون مثاليته معلقة في السماء، ولا أن يكون التزام المسلمين التزاماً دينيًّا ومصلحيًّا، بل لابد من معرفة طرق تحقيقها على الأرض، وفي حياة الناس والمجتمع الدولي. وهذه الطرق تخضع للاجتهاد حسب اختلاف ظروف الزمان والمكان، ولكنها في كل الأحوال يجب أن تكون منضبطة في إطار منظومة من القيم والمبادئ المعيارية المجردة التي تكون حاكمة لها وليست محكومة بها، وأهم هذه المبادئ هي: العدالة، والمساواة في الأخوة الإنسانية، والحرية، والوفاء بالعهود، والتعاون بين بني الإنسان جميعاً.
المصدر: https://hiragate.com/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D...
