عن ثقافتنا وعدم فهم الآخر
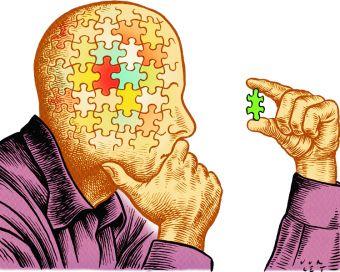
أستاذة يابانية عملت لأكثر من خمسين سنة على دراسة الشخصية اليابانية، قدمت خلاصة أبحاثها لأكثر من عشرين باحثاً غربياً مخضرماً في العلوم الإنسانية. لم تتمكن من إيصال الأفكار التي كانت تقدمها مع أنها تتكلم الإنكليزية بطلاقة وتدرس في جامعة أميركية. هذه المشكلة تتكرر في أكثر من سياق ومجال. هناك على ما يبدو صعوبة مبدئية في فهم الآخر، أي آخر: في الانتماء والجنس والعمر والعرق والدين والتخصص العلمي والثراء وغيرها من أسس الاختلاف. حتى إذا افترضنا أن الفرد، أو المجموعة، مستعد وراغب ومنفتح لفهم الآخر، كما كان العشرون باحثاً في محاضرة الأستاذة اليابانية، فهناك عوائق تتجاوز الرغبة في الفهم، عوائق يمكن تخطيها ليس فقط بالعمل على اكتساب المعرفة بالآخر تمهيداً لفهمه كما حاول عدد كبير من المنظرين والفلاسفة خصوصاً في الثقافات الغربية، ولكن عبر طرق أخرى من التقارب والانفتاح والتعاطف.
مقدمتي هذه تمهد لما بعدها من ملاحظتي أن ثقافتنا العربية – الإسلامية وفي شكل خاص ثقافتنا المعاصرة مقصرة في شكل رهيب في محاولة فهم الآخر. جميعنا اشتكينا مع إدوارد سعيد من أن الغرب فهمنا خطاً ولم يزل من خلال التراث الاستشراقي الملتبس والطويل. لكن قلة قليلة من مفكرينا، مثل عزيز العظمة وصادق جلال العظم، حاولوا أن ينبهونا إلى أننا، كثقافة متطاولة في الزمن، لم نحاول فهم الآخر في مراحل طويلة من تاريخنا، ولم نزل كذلك على ما يبدو. بل إن بعض المحللين، وعلى رأسهم زعيم المستشرقين المعاصرين برنارد لويس، أوّلوا الأمر على أنه نقص وراثي لحب الاستطلاع في تكويننا النفسي والبيولوجي الجماعي في واحدة من أكثر النظريات الثقافية عنصرية.
لكن دحض هذه النظرية، وهو ما لم يتم بالدرجة الكافية، أدى أيضاً إلى إهمال البحث في الأسباب الموضوعية والتاريخية لتقاعسنا الواضح عن فهم الآخر.
فتاريخنا يزخر بنماذج من قلة الاهتمام بمعرفة الآخر أو فهمه. رحالتنا في العصور الذهبية قلما تخطوا حدود العالم الإسلامي كما عرفوها باستثناء قلة قليلة من أمثال ابن فضلان في القرن العاشر، الذي كان في نهاية الأمر مبعوثاً في مهمة رسمية أخذته إلى تخوم روسيا الحالية، وابن بطوطة هذا المسافر الفريد نسيج وحده الذي طبق آفاق آسيا وأفريقيا في القرن الرابع عشر. أما معظم الآخرين فاكتفوا بإيراد لمحات مقتطفة من قصص البحارة والتجار الذين زاروا البلاد البعيدة وقابلوا الناس الغرباء وأصبحت قصصهم أساطير تروى عن المخلوقات العجيبة والظواهر الخارقة. حتى في عصر الاكتشافات، عندما ابتدأ الرحالة الأوروبيون باستكشاف العالم ابتداءً من القرن الخامس عشر تمهيداً للسيطرة عليه، تقاعس حكام الدول الإسلامية عن المشاركة في هذه الكشوف على رغم ظهور بعض الأفراد الأفذاذ الذين حاولوا معرفة العالم الواسع. خذ مثلاً بيري ريس، القبطان العثماني الذي حفظ لنا وللتاريخ أول خريطة للعالم الجديد من صنعه عام ١٥١٣، كتب عليها أنه استقى معلوماتها من خريطة الإفرنجي كولومبو (التي فُقدت)، ما يدل على تواصل بين البحارة العثمانيين والبحارة الأوروبيين ومعرفة بالاكتشافات الجغرافية الحديثة. بيري ريس، الذي حقق انتصارات بحرية مهمة ضد البرتغاليين في الخليح وبحر العرب، أُعدم في مصر عام ١٥٥٣ لأسباب واهية. أو خذ مثلاً آخر قصة السلطان أبي الحسن المريني الذي سمع من بحارة جنويين عام ١٣٤٠عن قصة اكتشاف الجزر الخالدات (جزر الكناري اليوم) فأرسل واحداً من قباطنته لاحتلالها، لكن القبطان فشل وعاد ثم توقف السلطان عن معاودة المحاولة وصارت هذه الجزر القريبة من الساحل المغربي اسبانية ولا تزال حتى اليوم.
أو لننظر إلى اهتمام علمائنا وفقهائنا بمعرفة عقيدة الآخر، ليس فقط الآخر البعيد والغريب، ولكن القريب من أهل الكتاب الذين شكلوا جزءاً لا يستهان به من سكان دار الخلافة ودور السلطنة في ما بعد مع أن الكتاب المقدس، بعهديه، قد تُرجم إلى العربية ابتداءً من القرن السابع الميلادي ومع أن هناك عدداً لا يستهان به من علماء المسيحية واليهودية الذين اعتنقوا الإسلام منذ أيامه الأولى. ولكن هنا أيضاً نجد أن نماذج العلماء المسلمين الذين حاولوا فهم عقيدة هذا الآخر قليلة جداً، مثل أبو الريحان البيروني الذي لا يوجد له معادل في تراثنا، على عكس كهان أوروبا ابتداءً من عصر الحروب الصليبية، وربما بسببها أيضاً، الذين اهتموا بمعرفة الإسلام معرفة علمية من طريق ترجمة وقراءة وتحليل القرآن وغيره من كتب العقيدة الإسلامية.
بل ما زال فقهاؤنا حتى اليوم على جهل مطبق بالديانتين السماويتين، المسيحية واليهودية، إضافة إلى الديانات الأخرى التي يعيش أهلها معنا مثل اليزيدية والصابئة المندائيين، يروون عنها القصص وينسبون إليها ما ليس منها ولا يكلفون أنفسهم عناء تمحيص الترهات التي يرددونها.
لا بد أن هذا التراث الطويل من اللامبالاة، والذي ربما كانت له مبرراته عندما كانت الحضارة الإسلامية ظافرة في صراعاتها مع الإمبراطوريات الأخرى وكانت المسافات بعيدة والاتصال صعباً، قد أثر في ثقافتنا المعاصرة وجعلها غير مهتمة بالآخر وثقافته وطرائق تفكيره. فنحن مقصرون في شكل مخزٍ حتى بالنسبة إلى معرفتنا بالآخر الغربي، الذي هو نظير تاريخي ونموذج حاولنا تقليده لأكثر من قرن. والحال ذاته في ما يخص إسرائيل التي ما زلنا في صراع مصيري معها. فنحن حتى وقت قريب لم نكن نعرف شيئاً عن إسرائيل مع أن هناك أكثر من مليون فلسطيني يقيمون هناك ويتكلمون العربية والعبرية بطلاقة. لكننا عزلناهم عن مجتمعاتنا مع أن قلوبهم تنبض بالانتماء العربي الفلسطيني حتى بعد ٧٠ سنة من الاحتلال والتهويد. ولولا جهود بعض فلسطينيي الداخل والخارج الحثيثة لفتح نافذة صغيرة على ثقافة اسرائيل، وبدعم من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الثقافية عندما كانت لا تزال منظمة تحرير، لما عرفنا شيئاً عن المجتمع الإسرائيلي وعن تفكيره ومعتقداته وغيرها من ضرورات الفهم، على حين تزخر إسرائيل بالباحثين المتخصصين بكل ماهو عربي أو إسلامي.
مؤخراً صعدت إلى سطح ثقافتنا المتعثرة آراء أصولية وفقهية مغرقة في نرجسية عمياء تحاول محو الآخر وإلغاءه، بل إنها في لحظات تجليها ترفض أن ترى وجوداً لآخر لا ينتمي إلى معتقداتها ويطبق مبادئها. ليس شططها هذا نابعاً بالضرورة من تاريخنا الثقافي المشغول بنفسه على حساب التقاطع مع الثقافات الأخرى، ولكنه قطعاً اتكأ عليه عبر عملية انتقائية حدية تمكنت من تجميع مبرراتها من التراث الطويل من التقصير في فهم الآخر والتعاطف معه، وهو ما يجب أن نفعله إذا أردنا أن يكون لنا مكان في العالم المعاصر.
المصدر: http://hewarpost.com/?p=1685
