إشكالية العدالة و الدولة و القانون في اللاهوت المسيحي في العصر الوسيط
أضافه الحوار اليوم في
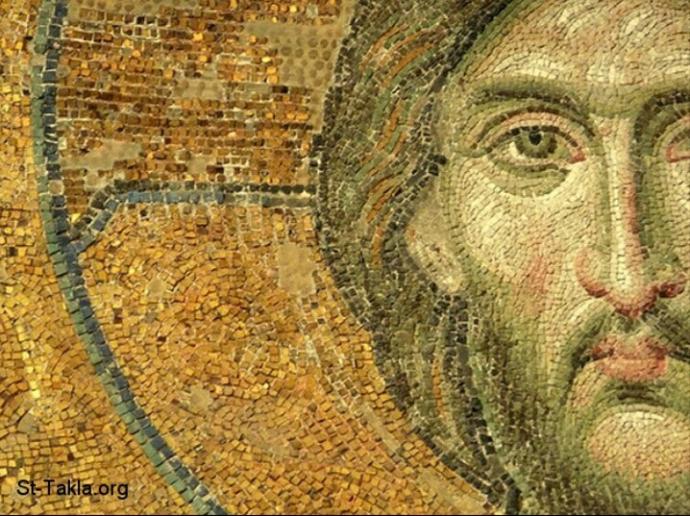
الأستاذ الدكتور عزالعرب لحكيم بناني
مقدمة:
تهدف المقالة إلى مناقشة إشكالية العدالة و حقوق الإنسان في الديانة المسيحية بوجه عام، و في اللاهوت و الفلسفة المسيحية على وجه الخصوص. لا يخفى علينا كذلك أنّ المسيحية الغربية قد استوردت عقائدها و مذاهبها الدينية و الفلسفية من المسيحية الشرقية التي عرفت النور في الشرق الأوسط و في شمال أفريقيا على وجه الخصوص.[1] نعتبر بهذا الخصوص أنّ المسيحية الأولى قد انتقلت من الشرق إلى الغرب. فقد قامت المسيحية “بعد اقتحامها السلطة في روما باستبطان المفاهيم الفلسفية و التصورات العامة للدفاع عن شرعية فكرية تريد اكتسابها، و لا غرابة أيضا أن لا تتجه إلى الميتافيزيقا أساسا، بل إلى الخطابة و البلاغة و إتقان الحوار و النقاشات العمومية من ناحية و إلى تفسير القوانين و ضبطها و دراسة صياغتها، ثم إلى المنطق عامة و تمظهراته في القول و الخطاب.”[2] و قد ضمّ فلاسفة قرطاج قائمة رجال الدين الذين وضعوا أركان الكنيسة الكاثوليكية و وجهوا مسارها و عقائدها و منظومة شعائرها، و نذكر من بينهم أبيلوس تيتوس Lucius Apulieus Thesus (125-180) و تيرتوليانوس Tertullien الذي ولد حوالي سنة 150 و كاسيليوس سيبريانوس Caecilius Cyprianus (210-258) أرنوب Arnobe (236- 327) و لاكتنسيوس Lactance (250 ?- 325)و أغطينوس St Augustin (354-430). و قد شرع مؤسسو الكنيسة الكاثوليكية في البحث في الميتافيزيقا من خلال المرجعيات الفلسفية التي ورثوها عن اليونان و عن المذاهب الأفلاطونية الجديدة و المذاهب المانوية، فخصّصوا دراسات هامة للعلاقة بين النفس و العالم و لجدلية الإنساني و الإلهي و لمفهوم الوحدة و للهياكل المؤسّساتية داخل الكنيسة في قرطاج و للوثنية و لمنزلة العقل. غير أنّ الفكر المسيحي سيعرف نقلةً كبيرةً بفضل المشائية العربية، ومساهمة فلاسفة الإسلام في إحياء قضايا الميتافيزيقا و المنطق و الطبيعيات اليونانية و الأرسطية على وجه الخصوص.
و نحن لن نعالج الفكر المسيحي الوسيط من زاوية العلم الطبيعي أو ما بعد الطبيعة، بل من زاوية مفهوم الدولة و العدالة.
و قد رجعت في هذه الدراسة إلى المصادر الفلسفية الألمانية التي تُقوّم الفكر المسيحي الوسيط بناءً على خلفية المسار السياسي الخاص الذي عرفته البلدان الناطقة بالألمانية. و هذا ما انعكس على نظرة الأنوار إلى التنوير. فالتنوير الألماني لم يُترجم مباشرة إلى ثورة، كما هو الحال مع الثورة الفرنسية. فقد عقد التنوير الألماني تحالفاً قويّاً مع الملكية المستبدّة[3] و أدّى إلى ظهور الاستبداد المتنوّر. لم يكن “الفكر المحافظ” – في نظر لينك، أثناء دراسة الانتقال من المسيحية إلى الدولة الحديثة- مستعدّاً آنذاك لإحداث ترابط بين “النظرة المتنوّرةٍ إلى الدين و بين الثورة و إلغاء طبقات النبلاء و ‘ديمقراطية العوامّ’ – وصولاً إلى المقصلة.”[4] غير أنّ إشكالية هذا الترابط بين العقيدة و الثورة لم تكن قائمةً خلال مرحلة الأنوار، بل كانت إشكاليّةً عامّةً في العصر الوسيط كذلك.
إنّ النظرة التي تبناها لينك نظرةٌ سياسيّة، بينما ننظر من جهتنا إلى المسيحية الوسيطة من زاوية المرجعية القانونية في علاقة الدين بالدولة و المواطن، دون أن نتجاهل أنّ مستويات القانون و الأخلاق و السلطة و الدين لم تكن آنذاك متمايزة بوضوح كافٍ، كما أصبح عليه الحال في العصر الحديث مع تطور العلوم الإنسانية و القانونية.
إشكالية الحبّ و العدالة:
إنّ المسيحية لم تكن خلال العصر الوسيط ديانة الضمير الفردي، بل تجسدت في الكنيسة، و أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية. و نحن في الغالب ما نتغافل هذا المعطى عندما نعود إلى المعالجة العقلانية للمسيحية داخل المثالية الألمانية (في كتابات كانط و هيغل). بالمقابل، إذا أردنا أن نفهم نظرة المسيحية إلى الدولة و العدالة، يجب علينا أن ننظر إليها كمنظومةٍ تشريعيةٍ و باعتبارها سلطةً تناقش القيم الدينية من زاوية الطاعة و العصيان و تطبيق العدالة. أعتبر من هذا المنظور أنّ العدالة مفهومٌ قانونيٌّ قبل أن يكون مفهوماً أخلاقيّاً. و هذا ما ينسجم مع الثقافة الألمانيّة التي تُعتبر ثقافة القانون، على خلاف الفكر الفرنسي الذي تغلب عليه الثقافة السياسية. و بما أنّ الدولة المدنية هي التي تحتكر السياسة في فرنسا، فإنه سيتمّ في كثير من الأحيان اختزال الدين إلى الحبّ.[5] و قد كان الرجوع إلى الحبّ يهدف لدى كلّ من كانط و هيغل إلى إبراز تميّز المسيحية عن اليهودية و الإسلام، على اعتبار أنهما ينتميان إلى ديانات التشريع. كانت مرجعيّةُ الحبّ موجهةً من زاوية العدالة الجنائيّة ضدّ اليهودية التي تسعى إلى تحقيق العدالة بواسطة الانتقام و معاملة الشر بالشر.[6] و هكذا، اعتقد كانط على سبيل المثال أنّ اليهودية كانت مجرّد “تجسيد للقوانين الشرعية Inbegriff bloß statutarischer Gesetze التي أقيم دستور الدولة عليها.”[7] على خلاف اليهودية، قامت المسيحية على أسس أخرى غير القانون كما تمّ تصوره لدى اليونان.[8] و قد ألمح كانط إلى أنّ التمييز بين الديانة و الأخلاق كان موجودا لدى الطوائف العقدية السياسية الأولى، كما كان الشأن مثلا مع العقيدة اليهودية. “حتّى و لو سلّمنا بوجود إضافات أخلاقية ألحقت منذ البداية بالعقيدة اليهودية أو أضيفت إليها بعد ذلك، فإن هذه الإضافات الأخلاقية لا تنتمي إلى جوهر اليهودية بما هي يهودية.”[9] إن المسيحية هي الديانة الوحيدة التي ظلت وفيّةً للجوهر الأخلاقي الذي قام عليه الدين، إذا ما سلمنا بأن مفهوم “الحياة الجماعية الأخلاقية”، كما جاء في عنوان الفقرة الثالثة من الفصل الأول في الفقرة الثالثة، يحيل إلى مفهوم شعب الله الذي يمتثل للقوانين الأخلاقية.[10]
إنّ التصور الأخلاقي الذي أقام عليه كانط صرح المسيحية، و هو التصور الذي نرمز إليه عادةً بمذهب اللاهوت الأخلاقي Ethico-théologie لا يستقيم مع معنى القانون الأخلاقي أو القانون الوضعي لدى أقطاب المسيحية في العصر الوسيط. لا ينسجم مع تصور الكنيسة الكاثوليكية و لا مع تصوّر البروتستانتية لمفاهيم العدالة و الدولة.[11] و سنحاول من جهتنا، من زاوية فلسفية و ليس من زاوية لاهوتية، أن نفحص صلة العقيدة المسيحية بالعدالة من زاوية مفهوم الدولة و المؤسسات السياسية، بالرجوع إلى القديس أغسطينوس و طوماس الأكويني و مارتن لوثر. فقد واجهت الكنيسة مواقف شائكة عندما اضطرت إلى التكيف مع أنظمة سياسية تتعارض مع مرجعيتها الدينية، قبل أن تحكم قبضتها على مقاليد الحكم داخل أوروبا. و لعلّ الامتياز الخاص الذي يتمتّع به مؤسسو المذاهب الكبرى، مثل أغسطينوس و طوماس لأطويني و مارتن لوثر، يعود إلى أنّ الحاجة إلى التفكير في السلطة الدنيوية قد أجبرتهم على مراجعة المنظومة اللاهوتية في جوانبها الأخلاقية و القانونية. فكيف نظرت المسيحية في البداية إلى مفهوم العدالة و كيف تعاملت مع الحكم السياسي في هذا الشأن؟
الصور الأولى لتمييز الدين عن الدولة:
من أراد أن يطلع على معرفة تصور المسيحية الأولى للدولة، عليه أن يبتدئ في البداية بالرسالة الشهيرة إلى مؤمني روما: “على كل نفس أن تخضع للسلطات الحاكمة. فلا سلطة إلا من عند الله. و السلطات القائمة مرتّبة من قِبل الله. حتى إن من يقاوم السلطة، يقاوم ترتيب الله، و المقاومون سيجلبون العقاب على أنفسهم. فإن الحكام لا يخافهم من يفعل الصلاح بل من يفعل الشر (…) و لذلك من الضروري أن تخضعوا، لا اتّقاءً للغضب فقط، بل مراعاةً للضمير أيضا. فلهذا السبب تدفعون الضرائب أيضا، لأن رجال السلطة هم خدّامٌ لله يواظبون على هذا العمل بعينه. فأدّوا لكلّ واحد حقّه، الضريبةَ لصالح الضريبة و الجزية لصاحب الجزية، و الاحترام لصاحب الاحترام، و الإكرام لصاحب الإكرام.” [12] تنبني هذه الفصول على تصور مخصوص للفضيلة السياسية. إذ يصعب علينا أن نقدّم صورةً ملموسةً عن الأخلاق المسيحية ما لم نعرف صلة المواطن بمؤسسات الدولة. و قد أورد تفسير الكتاب المقدس ثلاثة تأويلات متدرجة لوجوب الخضوع للسلطات الحاكمة. يفيد التأويل الأول أنه إذا ما دبّ الفساد إلى الدولة، يجب على المؤمنين أن يظلوا مواطنين صالحين، طالما أن ذلك لا يسيء إلى معتقداتهم. غير أنهم يمتنعون عن الخدمة في الحكومة أو عن المشاركة في الانتخابات. و يفيد التأويل الثاني، الذي انطلق الفلاسفة و المؤرخون بناءً عليه من القديس أغسطينوس و أتباعه، أن رفع المسيح و تخلي الكنيسة عن التحكم في السلطة السياسية قد شكلا الوجوه الأولى في صيرورة الدهرنة sécularisation أو فصل الدين عن الدولة[13]. يعتقد هؤلاء “أن الله قد منح الدولة السلطة في مجالات معينة و منح الكنيسة السلطة في مجالات أخرى. و يمكن للمسيحي أن يخضع لكليهما و أن يخدمهما كليهما، و لكن يجب ألا يخلط بينهما.”[14]
الطاعة هي رأس الفضائل لدى أغسطينوس
عندما نقترب من المسيحية من زاوية الفلسفة السياسية في العصر الوسيط، نبرز في البداية ماذا يميزها عن الفلسفة اليونانية. يظهر ضعف التصور السياسي لأرسطو، كما انتبه إلى ذلك آباء الكنيسة، في كونه لم يستند إلى التعليل الطبيعي في تفسير العلاقات الغائية القائمة بين الحياة الاقتصادية و القانون و الدين، “بل لم يستطع أن يوجد تفسيراً لتلك العلاقات إلا من خلال تصورات ضعيفة للغائية المبثوثة في الطبيعة.”[15] لكن العصر الوسيط لم يكن مستعدّاً لدراسة كلّ منظومة ثقافية على حدة، مثل القانون أو الأخلاق أو اللاهوت، بما أنّ الواقع الاجتماعي لم يكن يميز بوضوح بين هذه المستويات المختلفة. لم يكن الدين و لا الحقيقة العلمية أو القانون و الأخلاق تخصّصات مستقلة عن بعضها البعض، بل كانت تلتقي كلُّها داخل منظور غائي هو الذي يُظهرها بصورةٍ واقعيةٍ أثناء تجسّده الفعلي. و هكذا، كان الله و هو الغاية العقلية المثلى و مصدر الحقّ الطبيعي و المعايير القانونية الملزمة. و لذلك، لم يكن بالإمكان، كما يرى ديلتاي[16]، دراسة خصائص الأخلاق و القانون دون ترجمتها إلى قضايا الميتافيزيقا. فقد عمل آباء المسيحية على ترجمة ميتافيزيقا المجتمع، كما استخرجوها من الكتاب المقدّس، إلى نظرةٍ شموليّةٍ للمنطق الذي يحكم وحدة التاريخ. أكّد أغسطينوس على وحدة تاريخ العالم كما يلي: “ليس من المعقول أن الله (…) أراد أن يُقصي ممالك الإنسان و سياقات الحكم فيها و علاقات التبعية الموجودة فيما بينها من تشريع عنايته الربانية.”[17] و قد لاحظ أغسطينوس أنّ مخطّط العناية موجود في البداية و الوسط و النهاية، كما يدلّ الكتاب المقدّس على ذلك. و هكذا، فسّر وقائع التاريخ تأويلاً غائيّاً. فمسار التاريخ لا يخضع لتسلسل العلل، بل يحقّق مخطّطاً مسبقاً. بناءً على وجود هذا المخطّط يفسر أغسطينوس التغيرات التي دخلت على الديانات الملهمة بتطور الجنس البشري الذي يشبه انتقال الإنسان في حياته من طورٍ إلى طور. و قد ظلّ هذا المنظور الغائي للتاريخ مبهماً و غير مضبوط، بالمقارنة مع وقائع التاريخ الملموسة التي لا تثير أي إشكال، إلى أن ظهر التمييز بين تمثلات ترتبط بالدين و تمثلات ترتبط بالدنيا. اكتسبت التجربة الدينية مشروعيتها من وجودها الفعلي في حياة المؤمن، على غرار التجربة الجمالية و التجربة الأخلاقية. و أصبحت الحياة الدينية الجماعية ذات وجود قائم الذات. و بذلك كان فصل المجال الدنيوي للمجتمع عن المجال الديني اعترافاً بوجود المؤسسة الدينية إلى جانب الإمبراطورية الرومانية. و قد اتّضحت أهمّية السلطة الدينية، إلى جانب سلطة الإمبراطورية الرومانية مع أغسطينوس، بعدما تحوّلت صورة العشاء الأخير إلى سرّ التجسّد، و هو ما تحقّق فعليّاً في مؤسّسة الكنيسة. و ما يميّز تصور أغسطينوس هو استدعاء فكرة التفويض: يتلقى الراهب قدرة روحانيّةً تؤهّله للقيام بالخدمات الدينية و تصبح الكنيسةُ واقعاً ملموساً باعتبارها الجسد الذي يجسّد سرّ المسيح corpus mysticum Christi[18].
و بما أنّ الكنيسة تجسّد مدينة الله civitas dei في مقابل مدينة الأرض civitas terrena، فإننا لا نستوعب مفهوم الدولة- المدينة إلا بفضل مفهوم التفويض الإلهي و صلاحيات ممارسة السلطة التي تختصّ بها السلطة السياسية للكنيسة. يشرح ديلتاي التفويض الإلهي في صيغته القانونية، معتبراً أنّ الروح الفاعل من فوق السماوات هو مرجع تفويض السلطة، على نفس النحو الذي يتمتّع فيه جسدُ المسيح بنفس التفويض في الكنيسة. و المسئولية التي تنتقل إلى رجل الدين من خلال مباركته تتلقى الحق ممارسة في السلطة الكنسية و واجب القيام بذلك داخل إطارٍ مادّيٍ مضبوطٍ و ضمن حيّزٍ مكانيٍّ مضبوط، بناءً على التفويض الذي يتمّ تبليغه باستمرار. ” إنّ صلاحيات ممارسة السلطة الكنسية في المجتمع هي من جهة أولى صلاحيات قد تتّخذ شكل بنودٍ قانونيةٍ يمكن تضمينها في النصّ التشريعي الدّيني، و تتمتع من جهة ثانية بقوّة النفاذ، بما أنّ الله هو الذي ألهمها.”[19] و بينما طوّرت الكنيسة نظرية التفويض، تشبثت سلطة الإمبراطورية الرّومانية بالقانون الرّوماني. و عندما تعرّض الرّومان لهجوم البرابرة الجرمان، و استطاعوا الحفاظ على وجودهم، كتب أغسطينوس كتابه حول دولة الله. و قد طبّق أغسطينوس في كتابه نفس مفهوم التفويض على السلطة السياسية في الإمبراطورية الرومانية، على أساس أنّ التفويض هو آلية ممارسة الحكم. و عليه، فإنّ شرعيّة الحكم مرتبطة بمشروعية التفويض؛ و سواءً كانت السلطة دينيةً أو دنيويّةً، فإنّ سلطة التفويض تخلق التزامات تّجاه السلطة الحاكمة. و كلّ تمرّد على السلطة الحاكمة يُعتبر عصياناً يعاقب عليه القانون.
و قد خصّص أندرياس بوتمان كتاباً هامّاً لموضوع العصيان المدني و معنى المواطنة من زاوية المنظور المسيحي. و قد تفرّغ هذا الكتاب لشرح ما معنى أن يلتزم المسيحي بالولاء للدولة الديمقراطية الدستورية. لم يعالج الكاتب القيم المسيحية من زاوية القيم الأخلاقية التقليدية، بل من زاوية الفضائل السياسية التي تدافع عنها الفلسفة الليبرالية المعاصرة، و هي فضائل الولاء للدولة و احترام المؤسسات الدستورية و الامتثال للقوانين. من هذه الزاوية، يظهر أن العصيان المدنيّ يمثل حقّاً استثنائياً، بالمقارنة مع واجبات المواطنة.و لذلك، يعترض الكاتب على مذاهب لاهوت التحرير التي تطورت داخل بعض المذاهب المسيحية في أمريكا اللاتينية، حينما اعتبرت أن محاربة الاستبداد السياسي تجيز استعمال الإرهاب و التحالف مع الإيديولوجيات العنيفة. و قد سعى بوتمان إلى تعزيز رأيه بالرجوع إلى آباء الكنيسة الأوائل.
من هذه الزاوية، اعتبر أغسطينوس، بناءً على مبدأ التفويض، أن طاعة الحكام هي “أمّ الفضائل و حاميتها”، و هي توجد على رأس هرم الفضائل.[20] يحضّ أغسطنوس على طاعة السلطة السياسية الأرضية، حتى و لو كانت سلطة جائرة، ما دامت لا تسعى إلى التحكم في ضمائر الناس و عقيدتهم الدينية، على اعتبار أنّ العقيدة تحتكم إلى مملكة السماء و لا شأن للسلطة السياسية بها. و قد دلّل أغسطينوس على وجوب الطاعة بالعودة إلى سيرة السيد المسيح حينما رفض أن يمتثل أتباعه لأوامر الإمبراطور جوليان بعدما دعاهم إلى عبادة الأصنام، بينما تصبح طاعة الإمبراطور واجبة كلما أمر المسيحيين بحمل السيوف ضدّ عدوّ خارجي. يتبيّن أنّ طاعة ملك ظالم لا تتعارض في ذاتها مع الامتثال لأمر الله. لكن أغسطينوس لم يكن متخاذلا و لا ساذجاً في نظرته إلى الدولة. فقد اعتبر في “مدينة الله” أنّ الدولة التي لا تحقّق العدالة و الإنصاف لا تختلف في شيء عن قطّاع الطرق magna latrocina. و قد كان هذا التشبيه بليغاً و استشهد به أغلب فقهاء القانون الذين اعتبروا أنّ الأوامر التي تصدرها العصابة و تطلب من الناس الانصياع لها ليست أوامر شرعيّةً، لأنها لا تحتكم إلى القانون، كما أنّ الجهة التي تصدرها لا تتمتع بأيّ تفويض شرعي.[21] يشترك الانصياع المباشر للحاكم و لو كان ظالماً مع الامتثال الفوري لتهديد المجرم في نقطة جوهرية تجمع بينهما، و هي طاعة الأوامر. غير أنّ الطاعة في حالة الانصياع للحاكم تنتج عن وجود مستوى معياري يشعرنا بواجب الامتثال، بينما نضطر في حالة الانصياع للعصابة الإجراميّة إلى الاذعان نتيجة التهديد.[22] و قد أورد بوتمان ثلاثة حجج أوردها أغوسطنوس للدفاع عن فضيلة الولاء للحاكم. فقد اعتبر أولا أن الله يهب الحُكم لمن يشاء، مؤمنا كان أو وثنيا، لحكمة لا يعلمها إلا الله؛ ثانيا، قد يكون حكم الظالم تصريفاً إلهيا من أجل تهذيب النفوس و صرفها عن الشعور بالكبْر؛ و قد يكون الظالم أو الوثني مجرد وسيلة يسعى الله من خلالها إلى استتباب الأمن و السلام في الحياة المشتركة بين المواطنين. و مع ذلك، عندما يتجاوز الظلم حدّاً لا يُطاق، يصبح العصيان واجباً. غير أنّ المقاومة تظلّ روحية، ما دام أنّ الظلم لا يُثني عن محبة العدو، مهما عظُم الظلم.[23]
طوماس الأكويني (1225-1274):
يشير بوتمان إلى أنّ “الرسالة إلى مؤمني روما” كانت إلى حدود القرن الثاني عشر هي المرجعية المعتمدة في رفض عدم الانصياع للسلطات.[24] ظهر بعد ذلك حقّ تدخل الكنيسة في القضايا السياسية للدولة. و قد ظهرت حدّة التدخل بعد أن أدان البابا غريغور السابع هنري الرابع سنة 1076م. و ظهرت بعد ذلك اجتهادات دينية تسمح بعزل الطغاة أو بقتلهم. و لكن تصور طوماس الأكويني لعلاقة الدين بالدولة السياسية كان اجتهادا غير مسبوق لا يزال قائما إلى اليوم. سعى في البداية إلى التقيد بوصايا الرسالة إلى مؤمني روما. ذلك أنّ الانصياع للحاكم يضمن حفظ الأمن داخل الحياة الجماعية، كما أنّ الفرد الواحد لا يضمن الأمان إلا داخل الجماعة. و عليه فإن “وجود الدولة ضروريٌّ و يدخل في طبيعة الأشياء.”[25]و لذلك، فإن إيمان المؤمنين بالمسيح لا يُعفيهم من الخضوع لسلطة الحكم المدني. و مع ذلك، توجد حالات خاصة يحقّ فيها للمحكومين أن يتمرّدوا على الحاكم. من الواجب على الحاكم أن يسعى إلى توفير الخير العام bonum commune و إلى تحقيق العدالة iusticia. غير أنّ معايير العدالة ظلت دينية، بما أنّ الدين هو منطلق العدالة و هو منتهاها و علتها. تفترض العدالة وجود قوانين أزلية lex aeterna لدى طوماس الأكويني و هي قوانين تنبع من الحكمة الإلهية. و لذلك، يتوجب على القوانين الوضعية lex positiva أن تحتكم إلى القانون الإلهي و إلى الحقّ الطبيعي حتّى تصبح هذه القوانين ملزمةً. و عليه، يملك الحاكم الحقّ في إصدار الأوامر إذا ما ظلّت ممارسة السلطة منسجمة مع القانون؛ بينما يملك المحكوم الحقّ في المقاومة إذا ما انتهك الحاكم منزلة العدالة ordo iusticia يحقّ للمحكومين أن يتمردوا على سلطة الحاكم لسببين رئيسيين، و هما إذا ما اغتصب الحاكم السلطة و استولى عليها بالقوة من غير وجه حقّ أو إذا ما أصدر الحاكم أوامر ظالمة، بالرغم من أنّ الجميع يعترف بأن حكمه شرعي. يشير طوماس الأكويني إلى مبرّرين رئيسيين يدفعان إلى شقّ عصا الطاعة، و هما عدم شرعية الحاكم و عدم عدالة القوانين. الدافع إلى العصيان سياسيٌّ في الحالة الأولى، بينما هو فلسفيٌّ في الحالة الأخيرة. عندما أجاز طوماس الأكويني أن يتمرد المحكومون على حاكم اغتصب السلطة، عزّز حجج لاهوت التحرير، بعدما وضع بين يديه مبرّرات لاهوتية لمقاومة الاستيلاء على الحكم. جوهر الاعتراض على الحاكم هو أنه لا يملك تفويضا يجيز له إملاء سلطته، سواء كان التفويض إلهيا أو كان تفويضا تنازل المواطنون بموجبه عن سلطتهم.[26] إنّ الدافع السياسي إلى العصيان المدني، كما نشهده اليوم، هو عدم احترام القوانين التي تنظم تفويض السلطة (قواعد الديمقراطية الإجرائية)، بينما اعتبر طوماس الأكويني أن القوانين غير العادلة لم تكن يوما ما قوانين إلهية[27]، و لذلك يجوز مناهضة الحاكم بسببها، بل و يجوز قتله[28] أو نفيه[29]، و لكنه يعترض على شرعية التمرد seditio ، لأنه يعتبره ظلما و إثما عظيما. ذلك أنه عندما أجاز العصيان ضد الحاكم المستبد، ميّز بين نوعين من الاستبداد: النوع الأول هو المستبدّ الذي اغتصب الحكم و استولى عليه بالقوة، و يدعوه usurpator ؛ أمّا النوع الثاني فهو الحاكم الذي وصل إلى الحكم بطرق شرعيّة، غير أنه تحوّل بعد ذلك إلى حاكم مستبدّ. بينما لا يتمتّع المتسلط على الحكم بأدنى مشروعية و يجب تنحيته، يصبح الحاكم الظالم بمثابة سيف الله المسلول على المذنبين، عقاباً لهم على آثامهم التي اقترفوها. إنّ تحوّل الحاكم من العدل إلى الظلم بعد مدّة من الحكم، يفيد أنّ المشيئة الإلهية قد غضّت الطرف عن ظلمه. لكن الفرد الواحد يملك مع ذلك الحقّ في أن يبادر إلى التمرد على الأفعال العنيفة، شريطة ألا تكون مخلفات التمرد أسوأ من آفات الشطط في استعمال السلطة.
و قد أوجز بوتمان الشروط التي أجاز فيها طوماس الأكويني التمرد و اعتبره مشروعاً. يصبح التمرد مشروعاً في البداية ضد حاكم اغتصب السلطة tyrannus usurpationis، و كذلك عندما ينتهك المتسلط منزلة العدالة ordo iusticia و يتعارض من خلال ذلك مع الخير المشترك أو الصالح العام. غير أن السلطة العمومية، و هي الكنيسة في ذهن طوماس الأكويني، هي من يحق لها أن تتمرّد على الحاكم الظالم و ليس الفرد المعزول، بما أنّ التمرد لا ينبني على أهواءَ شخصيّةٍ و لا على إملاء الضمير الفردي؛ و يهدف التمرّد في الأخير إلى تحقيق الخير العام. و في حالة ما أدّى فيها مراد العدالة إلى الفتنة أو الفوضى، يجب تفضيل حفظ النظام العام على تحقيق العدالة.
و قد وضع طوماس الأكويني معايير للعدالة من حيث الهدف و المصدر و المضمون. تهدف العدالة إلى حفظ الصالح العام، بينما يسعى المشرع غير العادل إلى الاستفادة الذاتية من التشريع. أما من حيث المضمون، فإنّ العدالة توزع المسؤوليات بصورة متناسبة و متوازنة، بينما يختل ميزان العدل حينما توزع الحقوق و الواجبات بصورة غير متوازنة بين السادة و العبيد، في غياب مساواة الجميع أمام القانون. و في الأخير، قد نكون أمام نصّين قانونيين، إلهي و بشري. نختار في حالة التنازع الانصياع للقانون الوضعي، إذا ما كان عدم الانصياع يؤدّي إلى ضرر أكبر من ضرر الانصياع. غير أن طوماس الأكويني أشار إلى حالة لا يُعتبَر فيها القانون عادلا و لا يجوز فيها الانصياع له، و هي الحالة التي يتجاوز فيها القانون الوضعي حدود صلاحياته. يحقّ للحاكم أن يضع قوانين تضبط السلوك الظاهر للأفراد، غير أنه لا يجوز له أن يتحكم بواسطة القانون في ضمائر الناس و حياتهم الباطنية، لأن هذا المجال من اختصاص القانون الإلهي غير البشري.
نستشفّ ممّا سبق أنّ العدالة تفيد تحصيل الصالح العام، كما تفيد العدل، و أعني بذلك إصدار القوانين أو الأحكام وفق إجراءات متفق عليها.[30] علاوةً على المعاني السابقة، تفيد العدالة الإنصاف (epikie اليونانية أو aequitas اللاتينية) و أن نعطي لكلّ ذي حقّ حقّه. بناءً على هذا التصور للعدالة يميّز طوماس الأكويني بين ظاهر النص القانوني و روحه، و يعتبر أن القانون الوضعي لا يستوعب غير الأفعال الإنسانية التي تقبل التعميم. و لكننا عندما نكون أمام حالات خاصة لا يستغرقها التعميم يجوز لنا من الناحية الأخلاقية أن نتأول ظاهر النص بما يتّفق مع ما تمليه العدالة و المنفعة العامة. لا يقبل فقهاء القانون المعاصرون إقامة مفهوم العدالة على أحكام قيمة ترتبط بالنفع العام، لأنه يتعارض مع العدالة بما هي حرص على تطبيق القواعد القانونية بصورة صحيحة. و مع ذلك، لا يعتقد الأكويني أن تصوره للعدالة يتعارض مع تحقيق الأمن القانوني، ما دام أن الإنسان الذي خلقه الله على صورته قد يصل إلى درجة النضج التي تتيح له حسن تطبيق المعايير القانونية. فما هي انعكاسات “خلق الإنسان على صورة الله” imago dei لدى الأكويني على نظرية العدالة و الحق الطبيعي؟
القانون الأزلي و القانون الطبيعي لدى طوماس الأكويني:
إنّ تأويل مذهب الأكويني قد تأثر باستمرار بالمرجعيات الدينية المختلفة. يهتمّ الفيلسوف المسلم بالأكويني من جانب صلته بالفلسفة المشائية، و بابن رشد على الخصوص. و هي صلةٌ تتجاوز مساجلات الأكويني ضدّ ابن رشد. فقد ارتبطت عظمة الأكويني ابتداء من العقد الثالث من القرن الرابع عشر في ذهن اللاهوت المسيحي بانتصاره على ابن رشد.[31] غير أنّ صورة الأكويني قد تأثرت سلبياً بتأويل علماء الاجتماع البروتستانت مثل ماكس فيبر [32]Weber و ترولتش[33]Troeltsch بشأن القانون و العدالة. و قد سعى الفيلسوف هونفيلدر[34] إلى تصحيح صورة الأكويني في ضوء نظرية العقل العملي و القانون في مقابل العقيدة. يعتبر ترولتش في كتابه الذي نشره حول النظريات الاجتماعية في الكنيسة أنّ “تأثير مفهوم الحقّ الطبيعي الرواقي على الأخلاق المسيحية لا يقلّ أهميةً عن تأثير مفهوم العقل على علم العقيدة المسيحي”. و قد استدعى الأكويني القانون الأزلي lew aeterna من أجل التفكير في مبادئ الأفعال الإنسانية. ذلك أنّ الكائنات تتصرّف بحكم طبيعتها وفق الغايات التي أُهّلت لها، بناءً على القانون الأزلي الذي يُعتبر بمثابة مخطّط مسبق. غير أنّ القانون الأزلي لا يتحكم مباشرةً في السلوك البشري. عندما يشارك الإنسان الله في القانون الأزلي لا يعني ذلك أنه يعلم وجوده مباشرةً، بقدر ما يعني أنّه يتوفّر على عقل عملي. و يهدف المنظور اللاهوتي، من وراء القانون الأزلي، “إلى إبراز استقلالية واجهة المعرفة التي تقود الأفعال الإنسانية من زاوية العقل العملي”.[35] و إذا كان الله هو مصدر القانون الأزلي فإن العقل العملي لدى الإنسان يتوفر على القانون الطبيعي الذي يشترك مع الله في القانون الأزلي، أي في المخطّط الإلهي؛ بمعنى أن الإنسان بحكم عقله العملي و بحكم مبادئه يعلم ما هو الخير و ما هو الشر. و هنا نجد تفسيرين مختلفين لمبادئ الأخلاق لدى الأكويني: عمل ترولتش من جهته على تأسيس الأخلاق على الميتافيزيقا، أي على نظرية الوجود و الموجود؛ بينما عمل هونفيلدر على تجنب المغالطة الطبيعية الناجمة عن استنباط الوجوب من الوجود، كما سعى من جهة ثانية إلى تأويل أخلاق الأكويني بصورةٍ لا تتعارض فيها مع مستجدّات فلسفة القانون المعاصرة. فالمخطّط الإلهي المسبق قد مكّن الانسان بالاعتراف[36] بوجود بنية معيارية مستقلة للخير و الشر (و هي تتجسّد في مقولة الخير المشترك bonum commune ). غير أنّ إدراك مضمون الخير و الشر متروك لاجتهاد prudentia ، phronesis العقل العملي و سرعة البديهة . معنى ذلك “أن المعرفة الضرورية التي تتمتّع بصلاحية كونية في مجال الأفعال الإنسانية لا تتعلّق إلا بالمبادئ العليا الكلية و بالمحرّمات الكلية التي تترتّب عنها مباشرةً. عندما ينزل العقل العملي إلى حقل الجزئيات تتعاظم احتمالات التعدّد و التغيّر، و يتعاظم إمكان الخطأ كذلك.”[37] و بما أن القانون الجنائي يقوم في جوهره على تحديد الأفعال التي يعاقب عليها القانون، اعتبر هونفيلدر على غرار باحثين آخرين[38] أن قيم الأخلاق تمتلك خاصية معيارية فوقية metanormativ بعدما جعلت مجال الأخلاق “نسقاً مفتوحا من الغايات” يسمح فقط بوضع قيود على مجال الأفعال الإنسانية. لا تملي هذه البنية المعيارية على الإنسان ما يجوز له أن يفعله (بما أن دائرة الإباحة غير محدودة)، بقدر ما تحدّد لائحة المحرّمات. بهذا الخصوص، لا يحقّ لقانون الدولة أن يتدخل في تصور المؤمن للحياة الفاضلة، (بما أنّ مسألة الضمير تدخل في نطاق العلاقة الخاصة بين العبد و ربه)، و أن يقتصر دوره على معاقبة الأفعال التي تحدث ضرراً بالحياة المشتركة. فإذا كان الإنسان يشترك مع الله في “القانون الأزلي”، فإنّ هذه المشاركة تسمح باستقلالية الإنسان، أي باستقلالية “القانون الطبيعي” الذي يتعرف عليه الإنسان في ذاته، سواءً كان مؤمناً او غير مؤمن. يتوسط القانون الطبيعي بين القانون الأزلي و الأفعال الإنسانية من خلال التمييز بين المبدأ و القاعدة الملموسة التي يحتكم إليها الفعل و التمييز بين القانون و الفضيلة و بين مبدأ الفعل و الشروع في الفعل. يهدف هونفيلدر في الأخير إلى تأويل طوماس الأكويني على نحو لا تتعارض فيه نظرية القانون الطبيعي و القانون الأزلي مع مكتسبات فلسفة القانون المعاصرة. كما سعى إلى مواجهة التأويل البروتستانتي الذي خضع له طوماس الأكويني من قِبل ماكس فيبر و ترولتش. لكنّه بالمقابل، لم يقم بتأويل جديد على خلفية فلسفة القانون المعاصرة فحسب، بل عمل بكذلك على تقريب طوماس الأكويني من نظرية المملكتين لدى لوثر. “لم يستغلّ الأكويني مقالته حول القانون من أجل تنزيل القانون الإلهي داخل منظومةٍ اجتماعيّةٍ محدّدةٍ و داخل أفعالٍ سياسيّةٍ ملموسةٍ، بل من أجل الإقدام على تمييز واضح (…) بين القانون الإلهي و القانون البشري.”[39] و النتيجة التي يخلص إليها بشأن الأكويني هي أنّ النظام الاجتماعي و السلوك السياسي هما شرط حياة الإيمان و لا يكتفيان بتجسيد الإيمان. غير أنّ التساؤل يظل مطروحا حول مدى قوّة الحجج التي تسلح بها هونفيلدر لمناهضة نموذج الدولة الدينية في فكر طوماس الأكويني. و التساؤل الذي نوجّهه إليه في صورة اعتراضٍ هو الآتي: لو كانت الحظوة التي تمتع بها القانون الطبيعي اتجاه القانون الأزلي قادرةً بالكامل على ضمان استقلالية مجال الأفعال الإنسانية لما ظهرت الحاجة إلى الإصلاح الديني.
مارتن لوثر: مملكة السماء و مملكة الأرض
كان طوماس الأكويني يؤكد على أنّ الهدف من وجود الدولة و القانون هو الحفاظ على الصالح العام. و كان أثناء ذلك يفترض أن وجود الدولة يمتثل لغاية محدّدة، و هي السهر على خلاص النفس. و قد استمر هذا التصور إلى العقود الأولى من القرن السابع عشر.[40] و قد قدّم الأكويني صورة مجازية للخلاص من خلال صورة سفينة الدولة التي يقودها الحاكم، على اعتبار أنه هو ربّان السفينة الذي يمتثل لتوجيهات الله مالك السفينة، بهدف نقل البضاعة، أي نقل الناس الذين ائتمنه الله عليهم إلى محطة الوصول. لقد ظلت أسئلة كثيرة مفتوحةً: هل كانت السلطة الكنسية ناطقة حقيقة باسم الإرادة الإلهية؟ و هل كان الحاكم يمتثل بالفعل للإرادة الإلهية؟ غير أنّ القضية الثابتة التي لم يبادر أحد إلى التشكيك فيها هي أنّ “النظام السياسي الدنيوي يجب أن يسهر على خلاص المواطن”[41] ، و هو الهدف، أي ‘خلاص’ المواطن الذي لم يعد مطروحا في فجر الحداثة مع لوك Locke بإنجلترا و بوفندورف Pufendorf بألمانيا.
غير أن دراسة نظرية الدولة في المسيحية لا تستقيم إلا بعد أن نستعرض منعرج الإصلاح الديني عند نهاية العصر الوسيط، بعد أن اقترح مارتن لوثر تصوراً جديداً لعلاقة المواطن بالدولة و بالمنظومة القانونية و العدالة. و لكنه أثناء ذلك عاد إلى نفس الإشكاليات التي طرحت مع القديس أغسطينوس و طوماس الأكويني في مقالته الشهيرة التي تحمل عنوان: “بشأن السلطة الحاكمة الدنيوية و إلى أيّ حدّ يجب أن ندين لها بالطاعة (1523).[42] يمسّ هذا السؤال جانباً أساسياً بخصوص صلة المسيحية باليهودية. فقد أعتبرت المسيحية الكاثوليكية أنّ المحبة جاءت لتعوض الشريعة الموسوية، و أوجدت حلا يُلزم المؤمن بالخضوع للسلطة الدنيوية القائمة، مع محافظتها على سلطتها الدينية. أمّا مارتن لوثر فقد قام بقراءة جديدة للشريعة اليهودية، و قد كانت قراءةً نجمت عن رفض السلطة الكنسية كسلطة سياسية و مذهبية معصومة عن الخطأ.
و عليه، عندما تساءل لوثر عن مدى احترام القانون، أعاد الأهمية إلى منزلة القانون داخل المسيحية، و تجاوز النظرة الساذجة التي تفيد أنّ المسيحية قد عوّضت القوانين السلطوية اليهودية بالمحبة المسيحية.
ينبني هذا المنظور الساذج على الفصل 12، 19: “لا تنتقموا لأنفسكم”؛ و جاء في إنجيل متّى 5، 39: “لا تقاوموا الشر بمثله، بل من لطمك على خدّك الأيمن، فأدِر له الخدّ الآخر؛ و من أراد محاكمتك ليأخذ ثوبك، فاترك له رداءك أيضا.” و قد ظلّ موضوع احترام القانون و الامتثال للسلطات صلب الخلاف بين الكاثوليك و البروتستانت في نظرتهما إلى شريعة موسى. و هنا وجب التأكيد على المنظور الرسمي الذي تبنّته الكاثوليكية في الموضوع، و هذا ما أريد الإشارة إليه من خلال الكتاب الذي خصّه البابا راتسينغر مؤخراً لحياة المسيح. فقد اعتبر يوسف راتسينغر (البابا بينيديكتوس الرابع عشر المستقيل) أن المسيح قد جاء بتوراة جديدة لتتميم شريعة المسيح. و قد كان هدف المسيح برأيه هو تحرير المؤمن من الشريعة :[43] “إنّ المسيح قد حرّرنا و أطلقنا في سبيل الحرية. فاثبُتوا إذن، و لا تعودوا إلى الارتباك بنير العبودية.” (الرسالة إلى مؤمني غلاطية 5، 1). و ذهب راتسينغر إلى أن الدعوة إلى الحرية ليست ذريعةً لإرضاء الجسد، بل لأن يصبح المسيحيون عبيداً للمحبة. و قد خصّص فصل الموعظة على الجبل حيزاً هامّاً لموضوع التحرّر من الشريعة، بعدما انتقدت الرسائل الأخرى طقوس الختان و الطهارة و الصوم، و اعتبر راتسينغر أن التمسك بها يُعتبر بمثابة تراجع عن رسالة عيسى. و لكن راتسينغر لا يعتبر أن توراة المسيح قد تراجعت عن توراة موسى، بقدر ما عملت على تكميلها، كما جاء في (متّى5، 17).[44] و العدالة هي التي تكمّل الشريعة.[45] لا ندري في الحقيقة ماذا يعني بعبارة “استكمال الشريعة بعدالة أكبر من أجل العدالة”، لاسيما و أنّ راتسينغر يدعو المسيحيين إلى أن يصبحوا “عبيدا للمحبة”. و هنا نبدي ملاحظتين بشأن مفهوم المحبّة و احترام القانون، حتّى نفهم تميّز البروتستانت عن غيرهم من المذاهب.
نتساءل بخصوص المحبة، كيف ينسجم مبدأ “محبة العدو” مع إقرار المسيحيين بوجود سلطة دنيوية تحكم بحدّ السيف؟ ناهيك عن أنّ “محبة العدو” تفترض أن المحبة تُعفي من العقاب و الزجر و الانتقام، و تُفضي إلى تصوّر جديد للعدالة. “و لكن المحبة التي تُمثّل هذه العدالة ليست عاطفةً بشريةً ندعوها محبّةً. و لا يرجع ذلك فقط إلى أنّ فكرة محبّة العدوّ لا تتقبّلها الطبيعة البشرية، بل كذلك إلى أنّ المسيح يرفض بكلّ تصميم عاطفة المحبّة التي تجمع الرجل بالمرأة و الأبوين بأبنائهما (…) إنّ المحبّة التي يبشر بها المسيح ليس محبّةً إنسانيّةً.”[46]
يُسعفنا النقد الذي وجّهه كيلزن لفكرة المحبّة في فهم مرامي لوثر. يتعيّن علينا في ذهن لوثر أن نفهم معنى المحبة فهماً جديداً، بناءً على نظرية المملكتين: مملكة السماء و مملكة الأرض. فقد أعاد لوثر تأويل عقيدة المحبة، حينما أخذ بعين الاعتبار معضلة تدخل الدولة المستمر في حقل الإيمان، سواءً كان تدخلا من قِبل البابا أو من القيصر، و لاسيما بعد أن تبيّن أنّهما معاً يتجاهلان رسالة الإنجيل. و لذلك رام لوثر تحقيق هدفين بعيدين في الظاهر عن روح الدين: و هما أن يحدّ من السلطة الحاكمة، و لاسيما سلطة الكنيسة و أن يستدلّ من الإنجيل نفسه على شرعية السلطة الحاكمة الدنيوية.
تشمل الملاحظة الثانية إعادة الاعتبار إلى الشريعة أو القانون. فتأكيد عدم تراجع عيسى عن الشريعة ينسجم مع مبدأ احترام القانون، و نحن نخضع لواجب الانصياع للقانون (« the duty to obey the law »)[47]. و لكننا نتساءل مع ذلك عن الدافع إلى ذلك، هل هو الخوف من عدم الامتثال، كما كان يرى أوستين Austin في القرن التاسع عشر، أم هو الالتزام الأخلاقيّ؟[48]
تعود بنا المرجعية الفلسفية للقانون إلى جذور الفلسفة اليونانية التي تُلزم المواطن باحترام القانون حتى و لو اعتبرنا أن القانون كان ظالما (كما هو الحال مع سقراط). و عليه، يظهر أنّ مارتن لوثر قد رجع إلى السؤال الأساس حول موقف الدين من الدولة و من القانون في ضوء مفهوم العدالة.
لقد قرأ لوثر الكتاب المقدّس بطريقة تختلف عن قراءة الكاثوليك و استنتج منه أدلّةً على مشروعيّة وجود السلطة الحاكمة، كما جاء في الرسالة إلى مؤمني روما؛[49] و على إباحة الثأر؛[50] و على تشغيل الجنود المأجورين.[51] و قد قسّم الناسَ إلى فئة تنتمي إلى مملكة الله و فئة تنتمي إلى مملكة الدنيا. و من ينتمي إلى الفئة الأولى لا يحتاج إلى “السيف الدنيوي”.
حينما ميّز لوثر بوضوحٍ بين المملكتين و بنى الفصل بينهما على ضرورة احترام القانون، لا يعني ذلك أنّ لوثر ينتمي من خلال مؤلفاته اللاهوتية إلى العصر الحديث، لاسيما وأنّ فكرته عن القانون ظلت مرتبطة بمرجعية العصر الوسيط، و أنّه بوّأ السلطة الحاكمة منزلة قطب الرّحى في منظومة الدولة و القانون. تجدر الإشارةُ إلى أن مذهب المملكتين يمثّل خطوةً أولى قام بها الإصلاح الديني في آخر عقود العصر الوسيط على طريق تأسيس الدولة المدنية و القانون الطبيعي المتحرّر من اللاهوت.[52]
لقد جمع أحد الباحثين جلّ المقالات التي خصّصها مارتن لوثر لمذهب المملكتين و قام بشرحها.[53] يناقش لوثر في تلك المقالات على التوالي واجب الانصياع للسلطة الحاكمة الدنيوية، و دعوة ثورة الفلاحين إلى الحفاظ على السلم و حقّ المحاربين في الاستفادة من النعمة الإلهية؛ كما قام بتفسير مزمور داود (101)، بحكم أنّ داود كان في ذات الوقت ملكا و نبيّاً.
و قد تمسّك لوثر بوجوب الانصياع للسلطة الحاكمة على امتداد كتاباته اللاهوتية المذكورة، على نحو أعطى معه الانطباع أحيانا أنه كان يقف إلى جانب السلطة السياسية أكثر ممّا كان يناصر المظلومين. و من بين الأسباب التي دفعته إلى ذلك نجد وجوب حفظ السلم و النظام العام و كبح الشر. يترتّب على ذلك أنّه من الواجب على المؤمن أن يتخلى عن الحق في دفع الظلم، بينما يجب عليه بالمقابل أن يمتثل لأوامر السلطة حينما تأمره بحمل السلاح ضدّ الأعداء، ما دام الحكام يسعون إلى استتباب الأمن. و قد يكون العنف أداة تحقيق ذلك، ما دام ظاهرةً اجتماعيّةً موجودةً مثل وجود الزواج و الطعام و الشرب، و ما دام أنّ الشرع قد سكت هن هذه القضايا، فلم يحرّمها. و هنا ميّز لوثر بوضوح بين حرية العقيدة و واجب الانصياع للسلطة. فالسلطة الدنيويّة ليست معنيّةً بعقيدة المؤمن و لا يحقّ للحاكم أن يفرض على المواطن اعتناق ديانة بعينها و لا أن يحارب الهرطقة. بالمقابل، لا يحقّ لرجال الكنيسة أن يتحملوا وظائف سياسية، لأنهم لا يشكلون سلطة. يجب على “الكنيسة أن تصبح بنيةً خاليةً من العنف.”[54] و الدليل على ذلك في نظر البروتستانت أن المسيح و الرّسل لم يؤسّسوا كنيسةً، بل أسّسوا جماعة قائمة على المحبّة، و هي جماعة تقوم على وجود معلّمين و مريدين، كما يقول لينك، و لم تقم أبداً على علاقة حاكمين بمحكومين. و عندما يتدخل الأمراء في شؤون الدين يحقّ للمؤمن أن يشقٌ عليهم عصا الطاعة، بينما لا يحقّ الاعتراض على قوانين الأمراء التي قد لا يرضى الله عنها، ما دامت في خدمة مصالح الدنيا. يتبيّن من ذلك أنّ مارتن لوثر قد ربط الإصلاح الديني بمشكل توزيع السلطة و الحكم السياسي. فقد دعا سنة 1522 إلى عدم مواجهة الكاثوليك، ما دام التمرّد يصيب الأبرياء و المذنبين معاً و ما دام الله قد نهى عن التمرّد و العنف ضدّ البابا نفسه، بالرغم من كونه على ضلال. و لكنّ المقالة التي تصدّت بصورة مباشرة لعصيان السلطة الدينية كانت بمناسبة ثورة الفلاحين (1524-1526).[55] لا يحقّ للفلاحين أن يثوروا على السلطة، لأننا ” نرى كيف أنّهم لم يتصرّفوا باسم المسيحيّة، بقدر ما بذلوا كامل جهدهم من أجل اقتناص مصالح دنيوية بالقوّة.”[56] و لذلك كان من الواجب عليهم أن يدافعوا عن مصالحهم دون أن يلطخوا رسالة الكتاب المقدّس و دون أن يواصلوا التمرّد باسم المسيح. ندّد الفلاحون المتمرّدون مثلا بوجود الأقنان، بما أنّ المسيح كان قد حرّر الجميع من الأغلال. غير أنّ لوثر اعتبر أنّ هذا التنديد لا تصله صلةٌ بالمسيحية، بما أنّ وجود الأقنان واقعٌ لا يختلف مثلا عن واقع وجود المرضى و السجناء؛ و مع ذلك فهم كلّهم مسيحيّون. و لذلك لم يكن يحقّ للفلاحين أن يتمرّدوا باسم المسيحية، بينما تمرّدوا في الواقع باسم الشيطان و قاموا بأعمال النهب و السطو. و التمرّد أشبه بالنار المشتعلة التي تلحق الدمار بكلّ شيء. و لذلك، لم يتبادر إلى ذهن مارتن لوثر أن يضع علامة استفهام على حقّ الحكم السياسي في مواجهة ثورة الفلاحين. و هو أثناء ذلك لم يكن يتحامل على الفلاحين، بقدر ما كان يرفض أن يتحول المتمرّدون إلى قضاة. ذلك أنّ الشعب “لا يملك الحقّ في أن يقرّر بطريقة أحادية ما هو القانون الذي يتطلب النفاذ.”[57]
خاتمة:
لقد رأينا كيف أحدث أغسطينوس فصلا بين مدينة السماء و مدينة الأرض. و قد كان هذا الفصل مناسبةً لتحديد اختصاصات الدولة و الكنيسة، على أساس أن تتكامل فيما بينها؛ و هناك من أوّل هذا الفصل على نحو آخر؛ ذلك أن المدينة “الأرضية تقوم على مبادئ زائلة، مادية و مستمدة من العالم الحسي، بينما تتميز المدينة السماوية بقيامها على حقائق أبدية و روحية و مصدرها سماوي.”[58] لكن التكامل قد يتحوّل إلى تداخل مقلق، و قد يبتعد عن أهداف العدالة و الدولة المدنيّة. كان أغوسطينوس قد أكّد على وجود تكامل بين السلطتين، لكنه لم يعترض على الإمبراطور المسيحي حينما تدخل في الحركات الدينية المنشقة عن الكنيسة، و قام باضطهادها، ما دام أن الانشقاق يعتبر هرطقة و خروجا عن الحقّ.[59] و قد ظهرت نتيجة الاضطهاد بعد ذلك في الادعاء الذي رفعته الكنيسة حينما اعتبرت أنها تمتلك الحقيقة، و حينما منحت نفسها مشروعية الدعوة إليها بالقوة. و يظهر لي أنّ المشكلة الرئيسة لا تتجلى في ادّعاء امتلاك الحقيقة – ذلك أن كلّ ديانةٍ تعتبر أنّها هي الدّين الحقّ- بل في توزيع السلطة بشكل متوازن و عادل و على قدم المساواة بين كلّ الأطراف التي ترفع هذا الادّعاء. و قد رأينا كيف انبثق الحلّ الناجع من التمييز الذي أقامه آباء الكنيسة الكاثوليك و البروتستانت بين الدين و الدولة المدنيّة. و عليه، أصبحت إشكالية الحقيقة مرتبطةً في ذهني بالفلسفة السياسية و بالمنظور القانوني إلى الدولة، فيما يخصّ احترام القانون أو الحقّ في العصيان. و هكذا، اعتبرنا أنّ إشكاليّة العنف متلازمة مع مراعاة أسس العدالة التي تقوم عليها الدولة. فالعنف الذي تمارسه الحقيقة الدينية لا يرتبط مباشرةً بادعاء امتلاك الحقيقة الدينية بما هي حقيقة. و قد كان الفيلسوف الإيطالي جاني فاتيمو (المنتمي إلى ما بعد الحداثة و الذي يعتبر نفسه فيلسوفاً مسيحيّاً بدون عقيدةٍ مسيحيّةٍ) قد تبنّى موقفا فلسفياً جذريّاً في هذا الاتجاه و تخلى عن مفهوم الحقيقة، سواءً كانت حقيقةً مبثوثةً في الأسفار الدينية أو في اجتهاد علماء اللاهوت.[60] تخلّى التصور الذي اقترحه عن تمييز أغسطينوس بين مدينة الله و مدينة الأرض، بدعوى الاستغناء عن مفهوم الحقيقة الدينية. و الحقّ أنّ المشكلة لا تتعلق بالحقيقة ذاتها، بل بمدى استغلال الحقيقة الدينية لمناهضة السلطات السياسية و قوانينها. و النتيجة هي أن تصورين مختلفين ظهرا إلى الوجود، أملاً في ضبط علاقة الكنيسة بالدولة: قامت الكنيسة في البداية باعتبارها فاعلا سياسيّاً بالاستحواذ على السلطة السياسية و تعيين الملوك و الأباطرة؛ و لكن الفلاسفة و رجال اللاهوت اللامعين، مثل طوماس الأكويني و مارتن لوثر، عالجوا إشكالية الخضوع للسلطة الحاكمة من جديد باسم الحقّ الطبيعي الإلهي أو باسم تعزيز شرعية السلطة السياسية.
لقد قامت المسيحية على حقيقة المسيح، بعدما قال “أنا هو الحقيقة”.[61] غير أنّ الاستبداد بالحقيقة أصبح يتعارض مع التعدّدية الدينية في العالم. و لا تكفي الدعوة إلى التسامح الديني طريقاً إلى تحقيق المصالحة بين الحقيقة الواحدة و التّعدّدية الدينية. فإذا كانت المسيحية مع أغسطينوس و مارتن لوثر قد أعادت توزيع السلطة بينها و بين السلطة الدنيوية، من أجل تحقيق العدالة، فإنّ العلاقة بين الشريعة الإلهية و القانون الوضعي تُعتبَر من بين أهمّ المعضلات المطروحة اليوم. تطرح على أتباع الكاثوليكية اليوم مشكلة الحريات الشخصية، و هي قضايا لا تزال الكنيسة تعترض عليها، مثل تحديد النسل و زواج القساوسة و استعمال العازل الطبي و تعميد المطلقين بعد زواجهم و إباحة الإجهاض و هلمّ جرّا.[62] أصبحت هذه القضايا مطروحةً بإلحاح على واجهة القانون الكنسي، بما أن القانون الوضعي لم يعد يعرف تمييزاً في البنود القوانيية ما بين الحلال و المندوب و الحرام، بل اكتفى بالتمييز بين المباح و غير المباح. و قد كان الإصلاح الديني خطوةً أولى على طريق تعميم الأفعال الجائزة داخل المملكة الدنيوية. [63] من هذه الزاوية القانونية، قام البروتستانت بمناهضة القانون الكنسي droit canonique. غير أن مؤرخي القانون يعتقدون أنّ القانون الطبيعي قد حقّق بطريقته الخاصّة لدى طوماس الأكويني مخطّط القانون الأزلي، بناءً على إيمانه العميق بالحقّ الطبيعي.[64] كما لم يخْفَ على الباحثين المعاصرين إدراك الصّلة الوثيقة التي جمعت بين ميلاد القانون الوضعي الحديث و دور المسيحية في تكييف العقيدة الدينية مع مقتضيات القانون و تجريم العصيان. كما كان تمييز القوانين السماوية عن القوانين الأرضية، و فصل العدالة الإلهية عن العدالة البشرية، مناخاً مناسباً لتطوير العدالةِ الأرضيّةِ. إنّ هذه العدالةٌ لم تولد مكتملةً، لكنها توجد على طريق الاكتمال، ما دامت من صنع الإنسان و تسعى إلى خلق عدالة كونية تلتقي فيها مع القيم المشتركة بين كلّ الأديان.
*أستاذ التعليم العالي- شعبة الفلسفة فاس – جامعة سيدي محمد بن عبد الله
[1] الفلسفة في تونس. 1. فلاسفة قرطاج. تقديم فتحي التريكي و مساهمة لطفي الحجلاوي و محمد علي الكبسي و معز المديوني و مملوك معاوية و عادل الغربي و دليلة بلحارث و إدوارد سميثر. الفيلاب تونس 2010,[1]
[2] نفس المرجع، ص. 14.
[3] Christoph Link : Christentum und moderner Staat. Zur Grundlegung eines freiheitlichen Staatskirchenrechts im Aufklärungszeitalter. In: Christentum und modernes Recht. Beiträge zum Problem der Säkularisierung, G. Dilcher & Ilse Staff: Suhrkamp, 1984, 110.
نفس المرجع، 110.[4]
[5] راجع الارتباط الذي أقامه ريكور بين العدالة و المحبة في المسيحية: .بول ريكور: الحب و العدالة. ترجمة حسن الطالب، دار الكتاب الجديد، 2013. حينما نعود إلى الحروب الصليبية نكتشف أن البابوات تصرفوا في تلك الحروب كرؤساء دول، سعيا منهم إلى نشر تعاليم الدين المسيحي و إلى استرجاع القدس بالقوة، هادفين من وراء ذلك إلى تغيير موازين القوى السياسية داخل أوروبا. فقد كانت الاضطرابات الداخلية، السياسية و الاقتصادية التي شهدتها أوروبا هي المحرك الذي دفع الكنيسة إلى إعلان الحروب الصليبية.
[6] بالرجوع إلى قانون الانتقام la loi de talion.
[7] Kant : Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, AA VI, 125.
[8] “القانون في معناه اليوناني ليس اتفاقا و لا عقدا، و لم يتمّ ابتكاره بين الناس أبداً من خلال صيرورة الأخذ و الردّ و التفاوض. و عليه، لم يكن القانون ينتمي إلى المجال السياسي في معناه الدقيق، بل كان في جوهره ثمرة تفكير بعض المشرعين و كان من اللازم أن يصبح موجوداً بالفعل قبل أن ننتقل بعد ذلك إلى البُعد السياسي في معناه الدقيق.” راجع حنّة آرنت:
Hannah Arendt : Was ist Politik ? München: Piper 2003, 111.
[9] نفس المرجع، ص. 111.
[10] Azelarabe Lahkim Bennani : Gewohnheit, positives Recht und Demokratie. In: Demokratie, Pluralismus und Menschenrechte. Transkulturelle Perspektiven. Sarhan Dhouib Hsg. Velbrück Wissenschaft, 2014, 142.
[11] نثير الانتباه في الأخير إلى أنّ تأويل قيم العدالة و الدولة في الكنيسة الكاثوليكية المنتمية إلى العصر الوسيط أو لدى البروتستانت لم يكن يوما ما محايداً على الدوام و ظلّ متأثراً على الدوام بالمرجعية اللاهوتية للباحث الكاثوليكي أو البروتستانتي، أو بالمرجعية الإسلامية.
[12] الرسالة إلى مؤمني روما، 13، ص. 2408. التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، شركة ماستر ميديا، International Bible Societyا، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية 1998، ص.
[13] Gianni Vattimo : Jenseits des Christentums. Gibt es eine Welt ohne Gott ? Carl Hanser Verlag, 2002.
[14] التفسير التطبيقي، 2408.
[15] Wilhelm Dilthey : Gesammelte Schriften I. Einleitung in die Geisteswissenschaften: Vanderhoeck & Ruprecht in Göttingen. 9. Auflage 1990, 332.
[16] الأعمال الكاملة المجلد الأول ص. 333.
[17] نفس المرجع، ص. 334.
[18] ديلتاي، مرجع سابق ص. 338.
[19] ديلتاي، نفس المرجع، ص. 339.
[20] Anderas Püttmann : Ziviler Ungehorsam und Bürgerloyalität. Konfession und Staatsgesinnung in der Demokratie des Grundgesetzes: Ferdinand Schöningh, 1994, 145.
[21] Hart : Der Begriff des Rechts : Suhrkamp, Berlin 2011, 142.
[22] من هذه الزا وية يميّز هارت بين being obliged حينما أخضع للتهديد، و بين to have an obligation حينما أشعر بوجود واجب يدفعني إلى الامتثال. راجع هارت (نفس المرجع) ص. 102.
[23] Püttmann, 146.
[24] Anderas Püttmann : Ziviler Ungehorsam und Bürgerloyalität. Konfession und Staatsgesinnung in der Demokratie des Grundgesetzes: Ferdinand Schöningh, 1994, 147.
[25] Saint Thomas d’Aquin : de regimine principum, 1 Buch, 1. Kapitel. Deutsch : Über die Herrschaft der Fürsten : Stuttgart, 5. In: Püttmann, 148.
[26] يعتبر المنظور السياسي للعصيان المدني أن عدم احترام قواعد الديمقراطية و عدم مشاركة المواطن في التشريع يبرّر اللجوء إلى العصيان العنيف:
Robin Celikates : Ziviler Ungehorsam und radikale Demokratie. Konstituierende vs. Konstituierte Macht? In: Das Politische und die Politik. (Th. Bedorf & K. Röttgers Hsg.): Suhrkamp, 2010, 292-293.
[27] Püttmann : 149.
[28] و ذلك عندما قام طوماس الأكويني بشرح أحكام بيتروس لومباردوس.
[29] Hans Maier : Das Recht auf Widerstand. In: Katholische Zeitschrift Communio 3/ 1984, 233. In: Püttmann: 149.
[30] هذا هو التصور الوحيد للعدالة Gerechtigkeit الذي يقبله أقطاب المذهب الوضعي في القانون، معتبرين أن العدالة هي احترام المساطر القانونية، ما دام أنّ الهدف هو ضمان المساواة بين المتقاضين و الأمن القانوني. و أشهر أعلام هذا المذهب هو هانس كيلزن:
Hans Kelsen : Was ist Gerechtigkeit ? Stuttgart, Reclam, 2000.
[31] Kurt Flasch : Meister Eckhart. Die Geburt der « Deutschen Mystik aus dem Geist der arabischen Philosophie. »: C.H. Beck, 2006, 44.
و قد كانت أعمال الأكويني تعتبر بمثابة انتصار الحكمة على الشر Sapientia vincit malitiam، لاسيما بعد أن حرّر كتابه الذي أعلن انتصار العقيدة الكاثوليكية على ابن رشد و ابن ميمون. بالرغم من هذه المساجلات عمل الباحثون على إبراز معالم الاتصال و الانفصال بين ابن رشد و الأكويني، ضمن المشروع الفكريّ الذي يدرس المشائية على الواجهتين الإسلامية و المسيحية معاً.
[32] Max Weber : Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss einer verstehenden Soziologie. Studienausgabe hg. J. Winckelmann, Tübingen 1972.
[33] Ernst Troeltsch: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Ges. Schriften, Bd. 1, Tübingen, 1923.
[34] Ludger Honnefelder : Die ethische Rationalität des mittelalterlichen Naturrechts. Max Webers und Ernst Troeltschs Deutung des mittelalterlichen Naturrechts und die Bedeutung der Lehre des natürlichen Gesetzes bei Thomas von Aquin. In: Max Webers Sicht des okzidentalen Christentums. Interpretation und Kritik. Wolfgang Schluchter (Hsg.), Suhrkamp, 1988, 254-275.
[35] Ludger Honnefelder, 257.
260[36]
[37] Ludger Honnefelder 264.
يستند هونفيلدر هنا إلى فلسفة القانون التي تفيد أن القانون لا يوجه الإنسان إلى ما هو خير و ما هو شرّ، بل يعاقبه على القيام بأفعال محظورة. راجع: Wolfgang Kerting : Wohlgeordnete Freiheit, mentis, Paderborn, 2007, 151
[38] W. Korff : Norm und Sittlichkeit. Untersuchungen zur Logik der normativen Vernunft: Freiburg, 1985, 51, 72-112. In: Honnefelder, 261.
[39] Honnefelder, 269.
[40] Christoph Link : Christentum und moderner Staat. Zur Grundlegung eines freiheitlichen Staatskirchenrechts im Aufklärungszeitalter. In: Christentum und modernes Recht. Beiträge zum Problem der Säkularisierung, G. Dilcher & Ilse Staff: Suhrkamp, 1984, 112.
[41] لينك، نفس المرجع
[42] Von weltlicher Obrigkeit
[43] Joseph Ratzinger Benedikt XVI. : JESUS von Nazareth : Herder 2007, 131.
“لا تظنوا أني جئت لألغي الشريعة أو الأنبياء. ما جئت لألغي، بل لأكمّل. فالحق أقول لكم: إلى أن تزول الأرض و السماء، لن يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتمّ كلّ شيء.”[44]
“فإنّي أقول لكم: إن لم يزد برّكم على برّ الكتبة و الفريسيين، لن تدخلوا ملكوت السماوات أبداً. (متّى، 5، 20). [45]
[46] Hans Kelsen : Was ist Gerechtigkeit? Reclam [1953] 2000, 30.
[47] M. B. E. SMITH: The Duty to obey the law. In, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory. Edited by Dennis Patterson, Blackwell, 1996
[48]“whether citizens have a distinctive moral duty to obey the law.” Smith 1996, 465.
أكّد روس Ross على وجوب طاعة قوانين البلد، من باب الامتنان لأيادي البلد علينا، و رجع بنا بهذا الخصوص إلى محاورة أفلاطون كريتو Crito، حينما رفض سقراط أن يُظهر العصيان تّجاه قوانين بلده.
[49] “على كلّ نفس أن تخضع للسلطات الحاكمة. فلا سلطة إلا من عند الله. و السلطات القائمة مرتّبةٌ من قِبل الله. حتّى إنّ من يقاوم السلطة، يقاوم ترتيب الله، و المقاومون سيجلبون العقاب على أنفسهم.”
كما جاء في متّى (26، 52): “فإنّ الذين يلجأون إلى السيف، بالسيف يهلكون.”[50]
[51] “و سأله بعض الجنود: و نحن ماذا نفعل؟ فأجابهم: “لا تظلموا أحداً و لا تشتكوا كذباً على أحد و اقنعوا بأجوركم.” (لوقا3، 14)
[52] بعدما تمسّك علماء اللاهوت الكاثوليك منذ العصر الوسيط بالحقيقة الإلهية كما تجلّت لهم في مثل هذه المحرمات، ظهر الإصلاح الديني مع لوثر ليرسم معالم منظور قانونيٍّ جديدٍ يخالف الكاثوليك. فما دام لا يوجد نصً قانونيٌّ يُحرّم ممارسةً ما من بين الممارسات المذكورة، يظلّ الأصل فيها هو الإباحة. و هكذا انتقل مبدأ الإباحة بعد ذلك من مرجعيته داخل اللاهوت إلى قانون العقل (كانط) و القانون الوضعي. و قد أحدث أصبح القانون الوضعي يتوفر على القاعدة القانونية الأسمى التي تحتكم إليها كلّ المنظومات القانونية، ممّا يسمح بوجود القانون الكنسي، دون أن يتعارض في وجوده مع القاعدة القانونية العليا. و هكذا، يتجسّد مضمون القانون اليوم في الأفعال الواجبة و هي الأوامر أو في الأفعال المحايدة أخلاقيا و هي الجائزة. و هذا ما يذكره برانت حينما يتساءل عن الأفعال التي تخضع لقانون الجواز. “لو كان هذا القانون واجباً، لما كان التفويض يخص فعلا مهمَلاً (adiaphoron). لا يحتاج مثل هذا الفعل المهمَل إلى قانون خاصّ، إذا ما فحصناه من زاوية القوانين الأخلاقية (كانط). إن الفعل المهمَل لا يحتاج إلى قانون خاصّ. فالجائز موجود إلى جانب الأمر و النهي. و تتحقّق العدالة كلّما توافقت التشريعات الدينية مع مقاصد المُشرّع في القوانين الوضعيّة. Rechtsphilosophie der Aufklärung. Symposium Wolfenbüttel 1981. Reinhard Brandt Hsg. Walter de Gruyter Berlin New York 1882. P. 242
[53] Malte Diesselhorst : Zur Zwei-Reiche-Lehre Martin Luthers. In: Christentum und modernes Recht. Beiträge zum Problem der Säkularisierung, G. Dilcher & Ilse Staff: Suhrkamp, 1984, 129-181 :
Von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig ist (1523); Eine treue Vermahnung Martin Luthers zu allen Christen, sich zu hüten vor Aufruhr und Empörung (1522); Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben (1524-1526); Ob Kriegsleute auch in seligem Stand sein Können (1526); Auslegung des Psalms 101 (1534). In Weimarer Ausgabe.
[54] Christoph Link : Christentum und moderner Staat. Zur Grundlegung eines freiheitlichen Staatskirchenrechts im Aufklärungszeitalter. In: : Christentum und modernes Recht. Beiträge zum Problem der Säkularisierung, G. Dilcher & Ilse Staff: Suhrkamp, 1984, 123.
[55] Malte Disselhorst. In : : Christentum und modernes Recht. Beiträge zum Problem der Säkularisierung, G. Dilcher & Ilse Staff: Suhrkamp, 144.
[56] نفس المرجع 145
[57] نفس المرجع 153.
[58] إدوارد سميثر: إقناع أم إكراه. موقف أغسطينوس من كيفية التعامل مع الأديان و الهرطقات. في كتاب: الفلسفة في تونس. ص. 231.
[59] لقد قام الإمبراطور قسطنطينوس باضطهاد حركة الدوناتيين التي تعود في جذور نشأتها إلى سنة 303 م. و قد اعتبرت الحركة أنها تمثل الكنيسة الحقيقة في إفريقيا. نفس المرجع، 234.
[60] Richard Rorty & Gianni Vattimo : Die Zukunft der Religion : Suhrkamp, 2006, 58.
“كما أنّ الإنجيل ليس كتاب كسمولوجيا، كذلك ليس كتابا في الأنتروبولوجيا و لا كتابا في اللاهوت. لا يستهدف الإلهام الإلهي المكتوب إلى أن يسمح لنا بمعرفة من نكون و لا بمعرفة ما هي خصائص الله، و لا ما هي “طبيعة” الأشياء، و لا يبتغي إطلاعنا على قوانين الهندسة، كما لو كان يسعى إلى عتقنا بواسطة ‘معرفة’ الحقيقة. إنّ الحقيقة الواحدة و الوحيدة التي يلهمنا الكتاب المقدس إياها (…) هي حقيقة المحبة caritas.”
[61] لا تنظر الكنيسة إلى الحقّ في الحياة من زاوية حقوق الإنسان، كما شهدها العصر الحديث، بل من زاوية التمييز بين الحق و الباطل و بين الخير و الشر. فالحسن هو ما حسّنه الله و القبيح هو ما قبّحه الله. “من يؤمن بالله، ينبغي له أن يأخذ الشر من المنظور الإلهي و أن ينظر إليه من نفس المنظور، على أساس أنه ما لا يجب أن يكون، و سيقف في هذه المسألة إلى جانب الله ضدّ الشر.” Bernhard Welte : Religionsphilosophie : Frankfurt am Main, Knecht : 1997, 235.
[62] و لكن كثيراً من الفلاسفة و علماء اللاهوت يعتبرون أنّ القرارات الرسولية بخصوص قضية الإجهاض ترتبط بهاجس الحفاظ على النفس و تحريم القتل.
[63] “يحقّ لنا أن نأتي كلّ الأفعال التي لا يمنعها القانون (…) و لكننا نملك كذلك الحقّ المقابل في ألا نقوم بها.” راجع:
Wolfgang Kersting : Sittengesetz und Rechtsgesetz. 149-150. In : Rechtsphilosophie der Aufklärung. Symposium Wolfenbüttel 1981. Reinhard Brandt Hsg. Walter de Gruyter Berlin New York 1882. P. 151-2.
[64] وهذا ما سمح للحقوق Rechte، بدل الواجبات Pflichten أن تصبح موضوع الحق الطبيعي.
Wolfgang Kersting : Sittengesetz und Rechtsgesetz. 149-150. In : Rechtsphilosophie der Auklärung. Symposium Wolfenbüttel 1981. Reinhard Brandt Hsg. Walter de Gruyter Berlin New York 1882.
الحوار الخارجي:
