محاورات حضارية
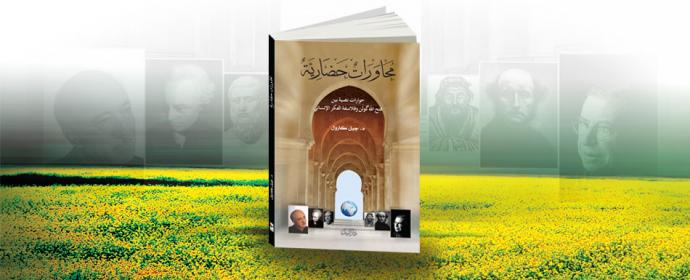
حوارات نصية بين فتح الله كولن وفلاسفة الفكر الإنساني
مقدمة:
في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2004، سافرت إلى تركيا لمدة عشرة أيام ضيفة على "معهد الحوار بين الأديان" (Institute for Interfaith Dialog - IID) بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وكان بصحبتي حوالي عشرين من الأساتذة الجامعيين ورجال الدين وقيادات المجتمع من ولايات تكساس وأُوكلاهوما وكنساس. لم يكن أينا قد زار تركيا من قبل ولم يكن أينا يعرف ماذا يمكن أن يتوقع، فكل واحد منا سبق -بطريقة أو بأخرى- أن جاءه واحد أو أكثر من الشباب التركي سواء في المدرسة أو الكنيسة أو في أي مكان آخر في المجتمع الذي يعيش فيه وسأله عن إمكانية السفر إلى تركيا للمشاركة في حوار الأديان كضيوف على المنظمات التي يتبع لها هؤلاء الشباب. وقد تعرف بعضنا بشكل أفضل قليلاً على هؤلاء الشباب وزوجاتهم من خلال تناول العشاء معهم في منازلهم أو حضور حفلات الإفطار الجماعي التي يرعاها "معهد الحوار بين الأديان" في شهر رمضان، وقد قبلنا جميعًا الدعوة من منطلق شعورنا بأن هؤلاء الشباب وزوجاتهم والمنظمة الداعية هم جميعًا موضع ثقة.
وما لم أكن أعرفه في بداية تلك الرحلة -ولكنني اكتشفته فيما بعد- هو أن مؤسِّسي "معهد الحوار بين الأديان" والمتطوعين فيه وكذلك منظِّمي رحلتنا سواء في الولايات المتحدة أو تركيا كانوا جميعًا متطوعين في حركة متعددة الجنسيات من الأشخاص الذين ألهمتهم أفكار عالِم مسلم تركي يدعى فتح الله كولن، وأن خطبه ومحاضراته تنتشر منذ عقود في جميع أنحاء تركيا وخارجها منذ أصبح واعظا رسميًا في عام 1958 وتم تعيينه في وظيفة بمدينة إزمير غربي تركيا. وقد زرنا العديد من المدارس وإحدى المستشفيات ومنظمة معنية بالحوار بين الأديان، وجميعها مؤسسات أنشأها أفراد من محبي كولن. وتناولنا الوجبات مع أسر تركية في منازلهم، وفي كل مرة كنت أسأل المضيفين عن كيفية سماعهم بأفكار كولن وما الذي ألهمهم تحديدًا للانخراط في تلك الحركة، فكانت الإجابة واحدة في مضمونها. فكبار السن منهم كانوا يعيشون في إزمير عندما بدأ كولن في ممارسة الوعظ، وقد تأثروا واقتنعوا برسالة التربية والتعليم وروح الإيثار التي كان يدعو لها. أما الأشخاص الأصغر سنًا ممن لديهم أطفال في سن المدارس فقد تعرفوا على الحركة من خلال مدارس قريبة منهم لديها سمعة تعليمية ممتازة، وبذلك أصبحوا ملتزمين بالرؤية الخاصة بالسلام العالمي والتقدم من خلال التعليم والحوار بين الأديان. وهناك آخرون كانوا طلابًا في مدارس أسسها رجال أعمال تأثروا بأفكار كولن، ويقومون الآن بدعم المدارس والأعمال الأخرى الخاصة بحوار الأديان من خلال رعايتها بطرق مختلفة. وفي كل مرة، كنت ألمس مدى عمق تأثر الشخص الذي أتحدث إليه برسالة كولن ورؤيته وتعهده بنشرها في جميع أنحاء العالم.
رجعت إلى هيوستن -مقر "معهد الحوار بين الأديان"- ووطدت علاقتي بالمعهد، وقد استضاف "مركز بونيوك لدراسة وتعزيز التسامح الديني" (Boniuk Center for the Study and Advancement of Religious Tolerance) التابع لجامعة رايس -حيث أعمل- مؤتمرًا حول أفكار كولن في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 حضره علماء من الولايات المتحدة وأوروبا ووسط آسيا، وتعاوَنَّا مع "معهد الحوار بين الأديان" في عدد من المشروعات والمحاضرات والاجتماعات الأخرى. وقد عدت إلى تركيا مرة ثانية في مايو/أيار عام 2005 ويوليو/تموز عام 2006، والتقيت بالمزيد من الأشخاص ممن تأثروا بأفكار كولن، وهو ما زاد من فهمي لأفكاره وتأثيرها على الأفراد في تركيا وعلى تركيا نفسها. فمنذ رحلتي الأولى إلى تركيا، قرأت كثيرًا من أعمال كولن المترجمة وجرت بيني وبين أصدقائي الأتراك الكثير من الحوارات بشأن أعماله. ورغم أنني مازلت لا أعد خبيرة في أفكار كولن أو في تاريخ تركيا الحديث أو في الصوفية، فإنني مع ذلك متخصصة في الدراسات الدينية (الفلسفة العامة للدين) ومتخصصة في الأديان العالمية ولديَّ معرفة عامة في ميدان العلوم الإنسانية. وقد قمت بتدريس بعض المقررات العامة أو "الدراسات الإحصائية" في مجال الإنسانيات ضمن مناهج الجامعات والدراسات العليا طوال ما يقرب من خمسة عشر عامًا. وتتضمن هذه المقررات الأدب العالمي المقارن وعلم الأخلاق والفلسفة القديمة والكلاسيكية والفلسفة السياسية الحديثة، علاوة على تدريس مقررات "أمهات الكتب" في مجالات التاريخ والفلسفة والدين والأدب سواء في الغرب أو الشرق. ويتسع مجال اختصاصي ليشمل الفكر "الشرقي" وكذلك "الغربي"، وذلك بسبب تخصصي في الفلسفة الدينية. وبالتالي، عندما بدأت في قراءة خطب كولن ومقالاته المترجمة، بدأت الأجراسُ تدق في عقلي بسبب أوجه الشبه العميقة التي لاحظتُها بين أعماله وبين أفكار بعض الفلاسفة والمفكرين العظماء في التاريخ الفكري العالمي.
وتتلخص مهمتي في هذا الكتاب في وضع أفكار فتح الله كولن في سياق العلوم الإنسانية الأوسع، فأنا أسعى بالتحديد إلى إقامة محاورة نصية بين نسخ منشورة من مقالاتٍ أو مواعظ أو خطب مختارة ألقاها كولن من ناحيةٍ وبين نصوص لمجموعة منتقاة من المفكرين أو الكتاب أو الفلاسفة أو المنظرين في مجال الخطاب العام في العلوم الإنسانية أو ما يعرف بالإنسانيات من الناحية الأخرى. وهؤلاء المفكرون هم كونفشيوس وأفلاطون وإيمانويل كانط وجون ستيوارت ميل وجان بول سارتر. ويدفعني موقع أفكار كلٍّ من هذه الشخصيات في مجال الإنسانيات (في مقابل العلوم) إلى وصفهم -بمن فيهم كولن- كمفكرين إنسانيين، رغم أن هذا التوصيف قد يبدو مثيرًا للجدل، على حسب التعريف الذي يتم تبنيه لـ"لفلسفة الإنسانية" (Humanism). وقد اخترت في هذا العمل أوسع تعريف ممكن للفلسفة الإنسانية، وهو تعريف لا ينظر إليها باعتبارها النقيض الضروري لوجهة النظر الدينية أو الإيمانية. وقد أطلق الفلاسفة ومؤرخو الحركة الفكرية وَصْفَ "الإنسانية" على كل أفكار أو نُظم فكرية تمتد إلى العصور القديمة منذ عصر الفيلسوف الإغريقي بروتاجوراس صاحب المقولة المشهورة: "الإنسان هو مقياس كل شيء". وبروتاجوراس لم يكن ملحدًا لا هو ولا أيٌّ من الفلاسفة الإغريق الكلاسيكيين الآخرين الذين عاشوا في القرن الخامس قبل الميلاد والذين حولوا محور تفكيرهم من التساؤلات عن الطبيعة وعناصر الكون (الماء والهواء والمادة إلخ) إلى التساؤلات عن معنى الحياة والقيم الإنسانية وطبيعة الحياة الصالحة ومكونات المجتمع الإنساني العادل. وهذه القضايا هي التي تميز عادةً الفلسفة أو الفكر الإنساني، والعديدُ من الفلسفات والرؤى -سواء الدينية أو اللادينية- تنتمي إلى الفلسفة الإنسانية في هذا السياق.
وقد قامت الفلسفة الإنسانية في عصر النهضة -التي أحيت أفكارًا كانت موجودة في العالم القديم- بتحويل محور اهتمامها من الله إلى "الإنسانية" (humanity)، إلا أن الفلاسفة الإنسانيين بشكل عام في هذه الفترة لم يكونوا ملحدين ولم ينادوا بالإلحاد كمظلة لرؤيتهم "الإنسانية". كل ما في الأمر أن التركيز على القدرة والإنجاز الإنسانيين -وما صاحبه من رؤية تقلل من التدخل الإلهي في الأشياء- فتح الطريق لظهور وجهة نظر علمية في الغرب مكنت البشر من اكتشاف نواميس الكون -التي هي نفسها من خلق الله-. وقد توصل المفكرون الأوروبيون في تلك الحقبة إلى هذه الرؤية بالطبع في إطار التعاليم الدينية الأوسع للمسيحية، وهم مدينون للعلماء المسلمين من الأجيال السابقة الذين بلغوا بالفعل أعلى مستويات التقدم في الطب والفلك والرياضيات وعلم النبات والكثير غيرها من ميادين العلم في إطار التعاليم الدينية للإسلام. وفي كلتا الحالتين، لم تأت الفلسفة الإنسانية لتنادي بعلو القوة الإنسانية فوق قدرة الله أو ضدها، بل على العكس يشهد البشر بقدرة الله عندما يستعملون إمكاناتهم التي وهبها الله لهم للكشف عن أسرار الكون التي خلقها الله ويستخدمون هذه المعرفة في سبيل تقدم المجتمع البشري وازدهاره بأكمله. إذن، فإن هذا الشكل من الفلسفة الإنسانية لا ينكِر بأي حال فكرةَ الدين أو الإيمان بالله، بل إن العلماء المسلمين -والعلماء المسيحيين السائرين على خطاهم- يعدون أمثلة كبرى على هذا الشكل الواسع من الفلسفة الإنسانية المتدينة.
صحيح أن الأشكال الأخرى من الفلسفة الإنسانية علمانيةٌ أو ملحدة تمامًا؛ ففي فترة ما بعد عصر النهضة، انشقت عن الفلسفة الإنسانية الأوسع فلسفاتٌ ترفض بالذات أيَّة رؤية دينية أو غيبية للعالم، إلى درجة العداء للدين. فالفلسفة الإنسانية العلمانية هي فرع ملحد انشق عن الفلسفة الإنسانية لا يتوافق مع وجهة النظر الدينية إلى حد كبير. ولا يمكن وصف كولن -ولا أي مفكر ديني آخر- بأنه فيلسوف إنساني ضمن هذا التعريف للفلسفة الإنسانية، وكذلك كانط ومِيل وكونفوشيوس؛ فهؤلاء جميعًا يشار إليهم عادةً كفلاسفة إنسانيين وإلى أفكارهم كشكل من أشكال الفلسفة الإنسانية، إلا أن أحدًا منهم لم يكن ملحدًا. وبالتالي، فقد أصبح من الواضح أن التعريف الإلحادي العلماني الضيق للفلسفة الإنسانية الحديثة ليس هو التعريف الإجرائي الذي نتبناه في هذا الكتاب.([1])
ولذلك، فإنني أستخدم تعريفًا أوسع للفلسفة الإنسانية في هذا الكتاب، تعريفا يستطيع -بدقة أكبر من التعريفات الحديثة المتواترة- أن يعبر عن تاريخها الطويل وعن الإنجازات الكبرى التي حققها البشر في الدين والفلسفة والأدب والأخلاق والفن والعمارة والعلوم والرياضيات في ظل قاعدتها الرئيسية، وهي التركيز على الإيمان بأهمية الإنسان وقدرته ومكانته وسلطته، وهو إيمان لا يتناقض بأي حال مع المعتقدات المحورية أو مع تاريخ الديانات الموحدة الثلاث الكبرى. وفي ضوء ذلك، فإنني أصنف كولن ضمن هؤلاء المفكرين الإنسانيين الآخرين، لأن أعماله -مثل أعمالهم- تركز على القضايا المحورية عن وجود الإنسان التي ظلت طويلاً جزءًا من خطاب الفلسفة الإنسانية سواء في شكلها الديني أو اللاديني. وبعبارة أخرى، إن هؤلاء المفكرين يهتمون بالتساؤلات الأساسية عن طبيعة الواقع الإنساني والحياة الإنسانية الصالحة والدولة والمبادئ الأخلاقية، كما توصلوا إلى نتائج متشابهة في العديد من هذه القضايا والتساؤلات بعد دراستها والتفكر فيها ضمن السياق الثقافي والتراثي الخاص بكلٍّ منهم.
و"التشابه" الذي أقصده هنا لا يعني "التطابق"، فهؤلاء المفكرون قادمون من خلفيات وفترات زمنية وسياقات ثقافية ووطنية وتقاليد دينية وروحية شديدة الاختلاف، وهم يختلفون عن بعضهم البعض بطرق معينة حتى إنهم في مواضع معينة من مؤلفاتهم قد يرد بعضهم على آراء البعض الآخر (وهو ما يحدث مع الكُتَّاب المتأخرين) أو قد يتخيل المرء أن الواحد منهم قد ينتقد الآخر في العديد من النقاط إذا كان هناك حوار حقيقي دائر بينهم (وليس مجرد حوار "مركب"). فكولن في معظم أعماله ينتقد سارتر والوجوديين وغيرهم من الفلاسفة الملحدين بشكل متكرر. ورغم أنني أكتفي في هذا الكتاب بوضع كلٍّ من هؤلاء المفكرين في محاورة نصية مع كولن وحده وليس مع بعضهم البعض، فلنا أن نتخيل قدر المحاورات التي قد تنبع من اختلافاتهم الكبيرة، فميل ينادي بنوع من الحرية يمكن أن يجده أفلاطون أمرًا بغيضًا في جمهوريته الفاضلة، وعلى العكس قد يجد ميل في جمهورية أفلاطون الفاضلة استبدادًا وظلمًا في كثير من الجوانب. وأعمال سارتر تنتقد أية تفكير في "جنة الأفكار" (heaven of ideas) العالمية والغيبية، سواء جاءت من جانب أفلاطون أو كانط أو كولن. أما كونفوشيوس -القادم بوجهة نظر صينية من القرن السادس- فليس لديه سوى القليل من الأفكار المشتركة مع المفكرين الغربيين في عصري التنوير وما بعد التنوير مثل كانط أو ميل.
والذي يهمني بشدة هو المحاورة بين أفراد لديهم وجهات نظر متباينة، كما أنني أُومِنُ بأن هذا النوع من الحوار هو ما نحتاج إليه في هذا العصر الذي دَفعت فيه العولمةُ ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الأفرادَ والجماعاتِ إلى التجمع معًا بطريقة لم يشهدها التاريخ الإنساني من قبل. فالبشر في القرن الحادي والعشرين يتفاعلون ويتأثرون أكثر من أي وقت مضى بأفراد وجماعات مختلفة عنهم تمام الاختلاف. ونحن نواجه بشكل متزايد أفرادًا وجماعات أفكارهم تختلف تمامًا عن أفكارنا، وهؤلاء الأفراد هم جيراننا وزملاؤنا في العمل وزملاء لأولادنا في الدراسة وأصهارنا وعملاء لدينا ورؤساؤنا في العمل وغيرهم. ونحن غالبًا ما نحاول أن نقلل احتكاكنا بالأفراد المختلفين عنا حتى لا نضطر للخروج من الحدود المريحة بالنسبة لنا، وقد نعزل أنفسنا ونضع سفينة حياتنا في مدارات مألوفة بالنسبة لنا تضم أفرادًا يشبهوننا في المظهر والتفكير والحديث والاعتقاد والصلاة. لكن هذه العزلة أو هذا التقليل للاختلاف ليس حلاً عمليًا في جميع الأحوال، ففي هذا العصر الذي يتميز بترابط عالمي، يجب علينا تطوير القدرة على الحوار وإنشاء نقاط اتفاق مع من يختلفون عنا بشكل كبير. وجزء من هذا المشروع هو إيجاد أفكار ومعتقدات وأهداف ومشروعات... إلخ يمكننا من خلالها تحقيق تفاهم مع بعضنا البعض. وهذا لا يعني أنه يجب أن نكون متشابهين معهم بالكلية، ولكن ينبغي علينا أن نجد قدرًا كافيًا من التشابه بيننا يمكِّننا -لمسافة معينة- من أن نضم أيدينا معًا كرفاق في رحلة هذه الحياة، مع وعينا الكامل باختلافاتنا في الكثير من الأمور.
لقد كان كولن خلال مسيرته كواعظ في تركيا وكعالم ومعلمٍ ومصدرِ إلهام للناس في جميع أنحاء تركيا وخارجها مناصرًا للحوار كالتزام ونشاط ضروري في العالم المعاصر، لذلك فإنه من المناسب وضع كولن -من خلال كتاباته- "في محاورة" مع مفكرين وكتاب آخرين لديهم رؤى مختلفة عنه تمامًا. فمثل هذا المشروع يقدم لنا كقراء سبيلاً للشعور بالراحة مع الاختلاف، لكن الأهم هو أن مثل هذا الحوار بين أشخاص معروفين بعلمهم ومواهبهم يمكن أن يساعد جميع من يهتم بهذه الأشياء على التركيز بشكل أعمق على القضايا الكبرى الأزلية في الحياة الإنسانية. فرغم أن حياة البشر تختلف في تفاصيلها من عصر لآخر، فإن الطبيعة العميقة للحياة الإنسانية -وما تستثيره من تساؤل وقلق- لم تتغير. فنحن اليوم نطرح نفس التساؤلات التي طرحها أجدادنا عن معنى الوجود وقيمة الحياة البشرية وعن كيفية بناء مجتمع وعن حدود الحرية. وأملي هو أن تسهم هذه المحاورة التخيلية بين كولن والآخرين الذين سبق ذكرهم في مَنْحِنا -نحن الذين يقع المستقبل على عاتقهم- الفرصةَ لكي نتحمل مسؤولية صياغة أنفسنا ومجتمعنا والعالمِ وفقًا لأسمى وأفضلِ المثُل الممكنة.
وقد نظمتُ المحاورةَ بين كولن والمفكرين الآخرين حول خمسة أفكار أساسية ترصد القضايا والهموم الأساسية الخاصة بالحياة الإنسانية في العالم، وهذه الأفكار هي:1- القيمة الإنسانية المتأصلة والكرامة الأخلاقية و2- الحرية و3- الإنسانية المثالية و4- التعليم و5- المسؤولية. وهذه الأفكار معروفة جيدًا لأي من الطلاب المتخصصين في الخطاب العام للعلوم الإنسانية، سواء من العصر القديم أو العصر الحديث، وسواء من أوربا أو آسيا أو إفريقيا، وسواء من وجهة نظر دينية أو علمانية. وفي كل فكرة، أقوم باختيار واحد من المفكرين السابق ذكرهم ليدخل في تفاعل نصي مع كولن. وقد اخترت هؤلاء المفكرين على أساس حجم التشابه بين تعبيرهم المحدد عن موضوع المحاورة وتعبير كولن عن نفس الموضوع من منظوره الإسلامي. وقد كان يمكن أن أختار مفكرين آخرين وأحقق نفس النتيجة -في الغالب- بإيجاد تعبير قوي عن الأفكار الكلاسيكية الدائمة والتشابه مع كولن في تلك الأفكار، لكنني اخترت المفكرين الذين سنتناولهم لأنني شعرت بأنهم كانوا أكثر براعة في تعبيرهم، وبصراحة بسبب إعجابي العميق واحترامي الشديد لعملهم بعد تدريسي لأفكارهم في قاعات الكلية طوال خمسة عشر عامًا حتى الآن. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الحوارات تُناقش موضوعات أعتقد أنها ذات أهمية قصوى بالنسبة لدراستنا العلمية والمدنية.
وفصول هذا الكتاب مترابطة فيما بينها ترابطًا موضوعيًا وبعضها يحيل إلى بعض في نقاط معينة، إلا أن هذه الإحالات قليلة، فالفصول في أغلبها مستقلة عن بعضها البعض بحيث يستطيع القارئ أن يقرأ الكتاب بأي ترتيب يريد أو أن يقرأ الفصول التي تجذب اهتمامه فقط دون أن يفقد شيئًا من ترابط الكتاب وتماسكه، فالقارئ الذي سيقوم بذلك لن "يتوه" في النص. وقد قمت بتأليف هذا الكتاب لجمهور أكثر عمومية ممن تستهدفهم الكتب الأكاديمية، وأنا لا أفترض أن يكون القارئ قد قرأ كتابات كانط أو سارتر أو كونفوشيوس أو أفلاطون أو ميل أو حتى كولن، ولذلك لا أقضي وقتا كثيرًا في إيراد معلومات عن حياة هؤلاء الفلاسفة لأن هذه المعلومات متاحة للقراء من مصادر متعددة، لكن هدفي هو شرح أفكار هؤلاء المفكرين وتبسيطها لجمهور من المتعلمين بشكل عام قد تكون لديهم خلفية في العلوم الإنسانية كما يتم تدريسها في الغرب أو قد لا تكون لديهم هذه الخلفية. ولهذا السبب اخترت التغاضي عن العديد من التفاصيل التي كان يمكن أن تحتل قدرًا كبيرًا من الصفحات والهوامش لو أنني كنت أكتب كتابًا علميًا أكثر تقليدية. وبهذا، آمل أن أكون قد وضعت بين أيديكم كتابًا مفيدًا ومهمًا وممتعًا يجده من يهتمون بتاريخ الأفكار والتاريخ الفكري العالمي وحوار الثقافات نافعًا وملهمًا للأفكار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] للمزيد من المعلومات عن الفلسفة الإنسانية وفروعها المختلفة وعلاقتها بالدين والإسلام، انظر: جوثري (Guthrie)، 1969، ورابيل (Rabil Jr.) 1988، وديفيدسون (Davidson)، 1992، وفخري (Fakhry)، 1983، وجودمان (Goodman)، 2003، وكراي (Kraye)، 1996.
الفصل الأول: القيمة الإنسانية المتأصلة والكرامة الأخلاقية بين كولن وكانط
إن "الفلسفة الإنسانية" (Humanism) تضع الإنسان -كفرد وكمجموع وكنوع وكشكل للوجود- في مركز اهتمامها؛ ولذلك كان أكثر ما تنادي به الفلسفة الإنسانية هو أن الحياة الإنسانية بشكل عام -وحياة كل إنسان بشكل خاص- تتضمن شكلاً من أشكال القيمة الإنسانية المتأصلة، واحترام هذه القيمة الإنسانية المتأصلة -في العديد من النظم الإنسانية- يشكل المنطلق أو الأساس للمبادئ الأخلاقية الأساسية. ولم يؤكد أحد على هذا المعنى بقوة واتساق أكثر من الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط الذي عاش في القرن الثامن عشر؛ فقد حاول في كتابه "أسس ميتافيزيقا الأخلاق" (Grounding for the Metaphysics of Morals) الذي نُشر عام 1785 التعبير عن "المبدأ الأسمى للمبادئ الأخلاقية" (the Supreme Mrinciple of Morality).([1])
وقد قصد كانط التعبير عن هذا المبدأ من الناحية العقلانية البحتة -وليس الإمبريقية (التجريبية)- حتى لا يُفهم أن الأفعال الأخلاقية تعتمد على الأحوال أو المشاعر أو الأهواء أو الظروف الإنسانية. ولا يتسع المجال هنا لتناول مزايا طريقة كانط أو استنتاجاته فيما يتعلق بالأخلاقيات العقلانية في مقابل الإمبريقية أو لتلخيص أفكاره وأطروحاته بشكل كافٍ، لذا سنركز على تلك النقاط الأكثر ارتباطًا بمناقشته لموضوع البشر كغايات في ذاتهم وبالتالي أصحاب قيمة متأصلة لا يجب المساس بها.
وترتكز جدلية كانط في كتاب "أسس ميتافيزيقا الأخلاق" على ثلاثة مفاهيم محورية وهي: العقل والإرادة والواجب، وقد ربط كانط بين هذه المفاهيم الثلاثة بطريقة محددة للغاية، وتنقّل من مفهوم إلى آخر بشكل منطقي حتى يشكل السياق العام لفلسفته الأخلاقية. ويبدأ كانط بالإرادة، فالإرادة -وخصوصًا الإرادة الصالحة- شيء مطلوب في أي مفهوم عن المبادئ الأخلاقية، وهذا ما يؤكده كانط في أول جزء من مؤلفه، فيقول:
"ليس ثمة احتمال على الإطلاق بالتفكير في أي شيء في العالم -أو حتى خارجه- يمكن اعتباره صالحًا بدون مسوغ لذلك إلا الإرادة الصالحة، فالذكاء والفطنة وحسن التمييز وكل ما يرغب المرء في ذكره من المواهب العقلية هي بلا شك صالحة ومرغوبة من نواحٍ عديدة، تمامًا كالصفات المزاجية مثل الشجاعة والعزم والمثابرة. لكنها قد تكون أيضًا سيئة وضارة للغاية إذا كانت الإرادة -التي يفترض أن تستفيد من هذه المواهب الطبيعية والتي في قوامها الخاص تسمى الشخصية- غير صالحة... فرؤية كائن لا يتحلى بلمسة من الإرادة الصالحة والنقية لكنه يتمتع بحالة من النجاح المتواصل لا يمكن أن يسعد المشاهد العقلاني المتجرد. وبناء عليه، فإن الإرادة الصالحة يبدو أنها تمثل الشرط الذي لا غنى عنه حتى لاستحقاق الشعور بالسعادة".([2])
لا يمكن، إذن، أن يوجد شيء صالح من دون الإرادة الصالحة، بغض النظر عن المواهب والقدرات الأخرى التي قد يمتلكها الفرد؛ فالإرادة الصالحة هي حالة أساسية للشخصية، ولا غنى عنها في السلوك الأخلاقي.
ويواصل كانط تحليله بالانتقال إلى مفهوم العقل، فهو يرى أن العقل هو ما يفرق البشر عن الحيوانات بشكل عام، لكن العقل -بتحديد أكبر- يعمل في البشر بطريقة توضح اختلافًا أساسيًا أكبر بين البشر وغيرهم من الكائنات الحية. ويتناول كانط المبدأ القائل إن الطبيعة تضع التكوين الخاص بكل كائن معقد بحيث لا يوجد أي عضو في الكائن لا يحقق هدفًا، وبحيث يكون هذا العضو وحده هو الأصلح لتحقيقه بأعلى وأفضل الإمكانيات. وبعبارة أخرى، كل عضو له هدف وهو يحقق هذا الهدف أفضل من أي عضو آخر في الكائن الحي. وينظر كانط إلى العقل باعتباره نوعا من الأعضاء، ويتساءل عن الهدف الذي يحققه للحياة الإنسانية، فيقول:
"والآن، لو كانت المحافظة على هذا الكائن أو رفاهيته أو -باختصار- سعادته هي الغاية الحقيقية للطبيعة في حال امتلاك العقل والإرادة، لكانت الطبيعة قد اختارت ترتيبًا سيئًا للغاية في جعل عقل هذا الكائن يحقق ذلك الهدف، لأن جميع الأفعال التي يتعين على هذا الكائن القيام بها في ظل هذا الهدف وكذلك القاعدة العامة لسلوكه، كانت ستُفرض بشكل أكثر صرامة من خلال الغريزة، ولكان تحقيق الهدف المقصود يتم بالغريزة أكثر مما يتم بالعقل".([3])
هنا يؤكد كانط على أن تحقيق السعادة بمفهومها الذي يدور حول المحافظة على بقائنا أو رفاهيتنا ليس وظيفة العقل لدى البشر أو الكائنات التي تمتلك العقل والإرادة؛ فالرفاهية أو البقاء أو السعادة يمكن تحقيقها بالغريزة مثلما يمكن تحقيقها بالعقل إن لم يكن أفضل، حيث إنها توجد لدى الحيوانات أيضًا. ولذلك يقول كانط: "إن للوجود هدفًا آخر أهم بكثير خُلق العقل من أجله، وليس من أجل السعادة".([4]) وينتهي كانط إلى أن الهدف من العقل هو إنشاء الإرادة الصالحة، فيقول: "يعتبر العقل أن أعلى وظائفه العملية هي إنشاء الإرادة الصالحة، والتي من خلالها يكون العقل فقط قادرًا -في سعيه لتحقيق تلك الغاية- على الوصول إلى نوع الإشباع الخاص به".([5])
إذن ما هي الإرادة الصالحة؟ وكيف يمكن تعريفها؟
باختصار، يعرِّف كانط الإرادة الصالحة في البشر بأنها: القدرة على التصرف من منطلق الواجب وحده وليس بوازع من أي ظروف أو انفعال. وينبهنا هذا التعريف إلى ما يمكن أن نعتبره الهم الأساسي لكانط في مقالته، وهو البحث عن أساس ثابت للأخلاق. فالنظم الأخلاقية التي ترتكز على اللذة أو السعادة أو الانفعالات لا تقدم، من وجهة نظره، أساسًا كافيًا للأخلاقيات، نظرًا لأنها أشياء عابرة تخضع للكثير من المتغيرات في حياة الإنسان، فانفعالاتنا قد تتغير تبعًا للظروف، وما كان مصدرا للمتعة في السابق قد لا يظل كذلك. فهذه المتغيرات لها تأثير ضئيل في عالم الحياة الدنيوية، إلا أن تأثيرها يكون كبيرًا في عالم الأخلاق. فطالما أن الأخلاق توجِّه وترشد تصرفاتنا تجاه الناس، فإن المبادئ التي توجهنا قد تتغير حسب حالتنا المزاجية أو أهوائنا أو ظروفنا إذا كانت تقوم على المشاعر أو المتعة، فقد نشعر أحيانًا بعدم الرغبة في قول الحقيقة أو في إبداء التعاطف أو العدل في تعاملاتنا مع الناس. وبالنسبة لكانط، فإن تأسيس الأخلاق على المشاعر أو اللذة هو بمثابة بناء بيت فوق رمال متحركة، وهو ما يُعد مخاطرة بكل شيء. لذلك يبحث كانط عن أساس أكثر أمنًا للأخلاق. وهو يؤمن أنه يستطيع أن يجد هذا الأساس في العقل والإرادة والشعور بالواجب، والتي تُفهم بشكل ملائم عندما تتفاعل وتتلاحم في الحياة الإنسانية.
وباختصار، يستحيل، بالنسبة لكانط، وجود الخير بدون الإرادة الصالحة، وقد خلق العقل فينا لتنمية تلك الإرادة، وهي قدرة البشر على التصرف من منطلق الواجب فقط، بغض النظر عن المشاعر أو الظروف أو المتعة المكتسبة. ويفرد كانط معظم أطروحته لشرح تلك المفاهيم الجوهرية الثلاثة، وهي العقل والإرادة والواجب، وعملها في إطار افتراضي من الأخلاق يستطيع البشر من خلاله صياغة مبدأ أخلاقي عام يوجه كل أفكارهم وأفعالهم. هذا المبدأ العام يسمى "الواجب المطلق" (categorical imperative)، وهو يأخذ في تلك الأطروحة عدة أشكال، أكثرها شيوعًا هو أنه "لا يجب أبدًا أن أتصرف إلا بالطريقة التي يمكن أن أريد أن يصبح سلوكي فيها قانونًا عامً".([6])
ولكن ما هي علاقة كل ذلك بالقيمة الإنسانية المتأصلة؟ يرى كانط أن البشر كائنات عاقلة، وهم يمتلكون في طبيعتهم الأساسَ الحقيقي للأخلاق، وبالتالي فهم يمتلكون قيمة متأصلة في داخلهم. أما خارج نطاق البشر ككائنات عاقلة فليس هناك أي مفهوم عملي للخير الأخلاقي، إذ لا يمكن لأي كائن حي أن يحددها عقلانيًا وأن يطبقها على مستوى عام باستثناء البشر. فالكائن العاقل هو كائن يحدد بنفسه ما هو القانون الأخلاقي العام، وهذا الكائن الذي يضع المبادئ القيمية هو قيمة أو خير في ذاته. وبحسب تعبير كانط: "الطبيعة العاقلة توجد كغاية في حد ذاته".([7])
وفي الحقيقة، يرسم كانط صورة للواجب المطلق تتمركز حول المحور التالي: "تصرف بالطريقة التي تتعامل بها مع الإنسانية، سواء في شخصك أنت أم في شـخص أحـد آخر، باعتبـارها دائمًا غاية وليسـت مجرد وســيلة".([8]) يتصور كانط وجود "مملكة من الغايات"، أي مجتمع منتظم حول تلك المبادئ الأخلاقية التي يشرِّع فيها البشر -ككائنات عاقلة وأيضًا كغايات في ذاتهم- القانون الأخلاقي العام، بالنظر إلى البشر كغايات في ذاتهم وليس كمجرد وسائل. وفي هذه المملكة، يكون لكل شيء إما ثمن أو كرامة، أي قيمة سوقية (Market Value) أو قيمة متأصلة (İnherent Worth). ويشرح كانط ذلك قائلاً:
"أي شيء ذي ثمن يمكن استبداله وإحلال شيء آخر مكافئ محله، ولكن في المقابل فإن أي شيء أسمى من أي سعر -وبالتالي ليس له مكافئ- تكون له كرامة. فأي شيء له علاقة بالميول والحاجات الإنسانية العامة يكون له سعر سوقي... لكن ما يشكل الحالة التي يمكن فيها فقط لشيء ما أن يكون غاية في ذاته، لا تكون له مجرد قيمة نسبية -أي سعر- بل تكون له قيمة أصيلة وجوهرية -أي كرامة- والآن نجد أن الأخلاق هي الحالة التي يمكن فيها وحدها لكائن عاقل أن يكون غاية في ذاته، لأنه بذلك فقط يمكن أن يكون عضوًا مشرِّعًا في مملكة الغايات. وعليه، فإن الأخلاق والإنسانية -بقدر ما يمكنها الالتزام بالأخلاق- لهما كرامة وحدهما. فالمهارة والجد في العمل لهما سعر سوقي، لكن الذكاء واتساع الخيال وروح الفكاهة لهما قيمة وجدانية، في حين أن الوفاء بالوعود وحب الخير على أساس من المبادئ (وليس بالغريزة) لهما قيمة جوهرية.([9])
إن القيمة الإنسانية غير قابلة للمساومة، فهي ليست شيئًا يباع ويشترى أو شيئًا نسبيًا في قيمته على حسب ظروف السوق. فصياغة كانط للإنسان تجعلنا ننظر إلى الفطرة الإنسانية "باعتبارها الكرامة، وتجعلها أعلى بشكل مطلق من أي سعر، بحيث لا يمكن وضعها موضع المنافسة أو المقارنة دون انتهاك قدسيتها - إذا جاز التعبير".([10])
ويكمل كانط قائلاً:
"إن الطبيعة العقلية تتميز عن باقي الطبيعة بأنها تمثل غاية في حد ذاته"،([11]) لذا فهناك بعد آخر للواجب المطلق وهو "أن الكائن العاقل نفسه يجب أن يكون الأساس لكل النماذج السلوكية، وبالتالي يجب ألا يُستخدم أبدًا كمجرد وسيلة بل باعتباره الحالة العامة التي تحكم استعمال كل الوسائل، أي أن يبقى دائمًا غاية في الوقت نفسه".([12])
وكما ذكرنا سابقًا، يعتبر البشر غايات في ذاتهم، لا مجرد وسائل لتحقيق غاية أحد آخر، فلا يمكن أن يُستعمل إنسان كأداة كي يخدم بها أهداف شخص آخر أو خططه أو أيديولوجيته. صحيح أنه يمكن توظيف البشر في تلك الجهود، ولكن لا يمكن معاملتهم باعتبارهم مجرد موظفين في مشروع، فهم دائمًا وفي الوقت نفسه غاية في ذاتهم، وهم يحملون كرامة وقيمة متأصلة بغض النظر عن أي ميزة أو منفعة يخدمون بها مشروعات أي شخص آخر أو خططه.
وقد كان كانط بطرحه لتلك الرؤى يقدم أفكارًا جذرية بالنسبة لعصره، فهو يعزز حوارًا معينًا في الغرب بدأ قبله بجيل أو نحو ذلك مع فلاسفة مثل جون لوك الذي نادى بنظام حكومي لا يَحكم بموجب حق إلهي، ولكن بالإرادة السيادية للمحكومين، أي أفراد المجتمع السياسي. والطريقُ الوحيد الذي جعل هذه الأفكار معقولة ومتسقة مع المنطق هو أن يُعطَى البشر قيمة حقيقية كبشر. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تشديد كانط على القيمة الإنسانية لم يكن مبنيًا على أساس ديني رغم أنه نفسه كان مسيحيًا، كما أن مقولات لوك لم تكن مسيحية هي الأخرى، رغم إيمانه الشخصي. فكلاهما أراد أن يطرح نظريته عن القيمة الإنسانية بعبارات غير دينية، لتحصينها بقدر الإمكان ضد ما رأوه أهواء في الدين. ويتعين هنا أن نتذكر أن كليهما عاش في فترات الحروب الدينية في جميع أنحاء أوروبا، حين كان يتم إعدام الناس بسبب اختلاف ديانتهم عن ديانة الملوك الذين كانوا يحكمون بالحق الإلهي، ولم يكن للشعوب ملاذ يلجأون إليه للقصاص لمظالمهم ضد هؤلاء الملوك. وعلاوة على ذلك، كان كانط يدرك جيدًا تلك الهالة العاطفية التي تحيط بالدين في الغالب، وبالتالي لم ير في الاعتقاد الديني أساسًا مستقرًا بما يكفي للمبادئ الأخلاقية، والتي تتضمن الكرامة المتأصلة لدى كل الناس. وقد ألف كتابًا كاملاً عنوانه "الدين في حدود العقل وحده" (Religion Within the Limits of Reason Alone) حاول فيه استخلاص الممارسة والقناعة الدينية وفصلهما عن مشاعر وميول التدين، ثم ربطهما بشكل حصري مع تكوين الشخصية ذات الخلق والسلوك الأخلاقي القائم على المبادئ. كان شغله الشاغل في هذا الكتاب هو إبراز القيمة المتأصلة للبشر بأكثر السبل عمومية -والتي رأى أنها تتأتى باستخدام العقل الذي يملكه جميع البشر- حتى يصبح وجود منظومة أخلاقية مستقرة أمرا ممكنًا في العالم، بغض النظر عن الحالات الطارئة في الحياة، كتغيير نظام الحكم واعتناق أديان جديدة، واختلاف الأذواق الشخصية وما إلى ذلك.
وقد ناصرتْ حركةُ التنوير الغربي -التي كان كانط جزءًا منها- الأفكار حول الكرامة الإنسانية المتأصلة، وهو ما أحدث تغييرات اجتماعية جذرية في القرن الثامن عشر وما بعده. وبالطبع، فإن هذه الأفكار ليست خاصة بالتنوير الغربي فحسب، إذ يؤكد المفكرون والكتَّاب في شتى أنحاء العالم على تلك المفاهيم في إطار قواعدهم الفلسفية أو الدينية أو الثقافية الخاصة بهم. فالعلماء المسلمون -على سبيل المثال- منذ قرون مضت ومن مختلف أنحاء العالم، يفسرون القرآن بتفسير يعبر عن القيمة الإنسانية الأصيلة والكرامة الأخلاقية. ويعتبر عمل كولن مثالاً للباحث الإسلامي الذي يؤكد على "الصوت" القرآني، مع الإصرار على الجمال والقيمة المميزين للبشر. وفي الحقيقة، يجد كولن في القرآن وغيره من المصادر الإسلامية إشارات قوية إلى الكرامة الإنسانية في المقام الأول، وهو لا يربط مثل هذه الإشارات بالقرآن بعد تحديدها عن طريق وسائل أو مصادر مختلفة. ويشير كولن بشكل متكرر إلى أجزاء من القرآن عند الإجابة على أسئلة عن الجهاد والعنف والإرهاب واحترام الحياة الإنسانية بشكل عام (وليس حياة المسلم فقط). وفي هذه الأقسام من أعماله، يتضح تناغم كولن مع أفكار كانط، رغم أن كلاً منهما يؤسس تعبيراته الخاصة عن القيمة الإنسانية الأصيلة والكرامة الأخلاقية من منظورات مختلفة اختلافًا كليًا.
ويتحدث كولن في مختلف أعماله عن القيمة السامية للبشر، فيبدأ إحدى كتاباته بهذه العبارة القوية:
"إن البشر -وهم أعظم مرآة تعكس أسماء الله وصفاته وأعماله- يمثلون مرآة لامعة، وهم إحدى ثمار الحياة الرائعة، ومصدر للكون بأكمله، وبحر يبدو كقطرة صغيرة، وشمس تشكلت كبذرة ضئيلة، ولحن عظيم رغم مكانتهم المادية المتدنية، وهم سر الوجود كله مجموعًا في جسم صغير. إن البشر يحملون سرًا مقدسًا يجعلهم يساوون الكون بكامله بما يمتلكونه من ثراء في شخصيتهم، وهو ثراء يمكن أن يتطور إلى تفوق".([13])
ويستمر كولن فيقول: "إن الوجود بكامله يصبح كتابًا مفتوحًا مع الفهم والبصيرة الإنسانية فقط... فالبشر -بجميع ما فيهم وما حولهم- ... شهود يشهدون لمولاهم".([14]) وينهي كولن هذه الفكرة بقوله: "عندما يتصل هذا الكون غير المحدود -بكل ما فيه من ثروات ومقومات وتاريخ- مع الإنسانية، يتضح لماذا تتجاوز قيمة البشرية قيمة أي شيء آخر... فالبشر -في الإسلام- لهم السيادة ببساطة لأنهم بشر".([15])
في هذه العبارات، يتحدث كولن عن أن للبشر القيمة العظمى -في مقابل الملائكة أو الحيوانات- بصفتهم شهودًا ومفسرين للكون. فكونهم شهودًا يجعلهم انعكاسًا لبعض صفات الله ومرايا للكتاب السماوي للكون. ومن دونهم لا تكون هناك معرفة بالكون ولا يكون هناك أحد أصلاً لكي يعرف الكون.
وفي موضع آخر، يكرر كولن أن البشر هم مركز الكون ومعناه، وبالتالي فهم يمتلكون قيمة أكبر حتى من قيمة الملائكة، فالبشر -من خلال أوجه نشاطهم وتفكيرهم- يعطون للحياة جوهرها. فيقول:
الإنسان هو جوهر الوجود والعنصر الحيوي فيه، وهو المؤشر والمقوم الأساسي للكون، فالبشر هم مركز الخلق، وكل ما عداهم -سواء كان حيا أو غير حي- يشكل دوائر متمحورة حولهم... وبالنظر إلى كل ذلك التكريم الممنوح للإنسانية مقارنةً بكل ما عداها من مخلوقات، يجب أن يُنظر إلى الإنسانية باعتبارها الصوت الذي يعبر عن طبيعة الأشياء، وطبيعة الأحداث، وبالطبع طبيعة تلك الذات العلية التي تقف وراء كل شيء، وفهمُها باعتبارها القلب الذي يسع كل الأكوان. فبوجود البشر عثرت الخليقة على من يفسرها، وتم تحليل المادة من خلال معارف البشر وصولاً إلى مضمونها ومغزاها الروحي. فمراقبة الأشياء قدرة يتميز بها البشر وحدهم، وقدرتهم على قراءة كتاب الكون وتفسيره امتياز ينفردون به، ونسبتهم كل شيء إلى الخالق نعمة عظيمة يتمتعون بها. فتأملهم بصيرة، وكلامهم حكمة، وتفسيرهم الحاسم لكل الأشياء محبة.([16])
إذن، فيما ينادي كانط بوجود قيمة متأصلة للبشر تنبع من كونهم كائنات عاقلة من خلالها يصبح للقانون الأخلاقي وجود عملي في هذا العالم، يتحدث كولن عن قيمة البشر باعتبارهم الخلفاء الوحيدين الذين يمكن من خلالهم التعرف على كتاب الله من المخلوقات، والتعبير عن عجائب الوجود. وفي الحالتين، نجد البشر -كأفراد أو كمجموعات- لا غنى عنهم بالنسبة للمقومات الأساسية للوجود، والتي هي الأخلاق التي يدركونها بالعقل أو جميع أشكال المعرفة والحكمة والمحبة التي يكتسبونها من كونهم انعكاسًا لأسماء الله وصفاته.
علاوة على ذلك، نجد أن كلاً من كولن وكانط يعد القيمة والكرامة الإنسانية هما الأساس في تعريف السلوك الشرعي وغير الشرعي تجاه أفراد المجتمع، رغم أن كولن يبني دعواه على القرآن لا على العقل وحده، على خلاف كانط. ففي إحدى كتاباته حول حقوق الإنسان في الإسلام، يؤكد كولن أن الإسلام يتضمن التصور الأمثل لحقوق الإنسان العامة، ولا يتفوق عليه في ذلك أي ديانة أو نظام أو هيئة، فيقول: "يعتبر الإسلام أن قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعًا، فقتل شخص واحد يجيز فكرة أن أي شخص يمكن قتله".([17]) ويدلل كولن على ذلك بطريقة شائعة عند معظم المفكرين والفلاسفة الدينيين، وهي أنه يجوز قتل من يقتلون غيرهم ومن يحاولون تدمير المجتمع، وهكذا. ففي هذه الحالة لا يكون القتل جريمة بل عقابًا أو دفاعًا عن النفس. وقد شرح ذلك في موضع آخر من وجهة النظر الإسلامية، فقال:
كل إنسان -سواءً كان رجلاً أم امرأة، صغيرًا أم كبيرًا، أبيض أم أسود- له حرمته ويحظى بالاحترام والحماية، ولا يستحل ماله أو عرضه، ولا يجوز طرده من أرضه أو سلب حريته، ولا يجوز منعه من أن يعيش وفق مبادئه ومعتقداته. وما يحرم على غيره يحرم عليه أيضًا ارتكابه بحق الآخرين؛ فلا يحق له إيذاء تلك الهبة (أي الإنسانية) التي وهبها الله له، لأن هذه النعمة ما هي إلا أمانة أودعها لديه الله وحده الذي يملك كل شيء... ويجب على الإنسان أن يدافع عن تلك الهبة وأن يحافظ على سلامتها؛ فهي مقدسة بالنسبة له، فلا يحق له الإضرار بها أو السماح بأن تتعرض للضرر. وعليه أن يقاتل وأن يموت من أجلها إذا لزم الأمر.([18])
هنا أيضًا نجد أن كولن ينسب القيمة الإنسانية إلى الله، فالإنسانية أو الوجود الإنساني هبة لا يجوز التعدي عليها أو انتهاكها، ومن ثم فهي الأساس في كل ما أمر به الله -كحماية الناس والحفاظ على حياتهم- وكل ما نهى عنه -كإيذاء الناس أو سرقة مالهم-. ويرى كولن أن هذه النواهي تتعارض تمامًا مع روح المحبة التي يصفها بأنها "قلب الإسلام"، فيقول:
"الحب في الحقيقة هو زهرة عقيدتنا.. هو قلب لا يشيخ أبدًا. فكما نسج الله ذلك الكون على مغزل الحب، فإن الحب هو دائمًا ذلك اللحن الساحر الذي يتردد في صدر الوجود".([19])
هذا الحب يتمثل في شكل مشاعر إنسانية تزرع داخل الناس المحبة تجاه الآخرين وتجاه جميع المخلوقات، وتجعلهم يظهرون تلك المحبة بتقديم الدعم والخدمة إلى كل العالم، وهذا هو ما يصفه كولن بأنه جوهر الإسلام. إلا أن هذه الفكرة للأسف قد أُهملت أو أفسدت تمامًا، وهو يوضح ذلك قائلاً:
"الفلسفة الإنسانية عقيدة تدعو إلى المحبة والإنسانية، ولكنها أصبحت تفسَّر في عصرنا هذا بشكل خاطئ، ويمكن التلاعب بها بسهولة من خلال التفسيرات المختلفة لها... ومن الصعب التوفيق بين الفلسفة الإنسانية وذلك السلوك الغريب بتغليب "الشفقة والرحمة" مع من يتورطون في نشر الفوضى والإرهاب لتقويض وحدة بلد من البلدان، أو مع من يقتلون الأبرياء بدم بارد في حركات دامت قرونا بهدف تدمير رفاهية أمة من الأمم، أو الأفظع من ذلك مع من يفعلون هذا باسم القيم الدينية ومن يتهمون الإسلام عن جهل بالإرهاب".([20])
يشير كولن هنا إلى ذلك النفاق والعنف الموجودين في الكثير من حركات الحداثة التي تدعي أنها إنسانية، وقد ذكر بشكل عابر من يرتكبون فظائع مماثلة باسم الدين، وما نلاحظه في الحالتين هو غياب "عقيدة المحبة والإنسانية" الصادقة التي ينبني عليها كلاهما في شكلهما الحقيقي. هنا يأتي الإسلام -في رأيه- ليشترك مع "الفلسفة الإنسانية الحقيقية" في الالتزام بحب الإنسانية، مع الفارق في أن الإسلام يستمد ذلك الالتزام من القرآن الذي نزل به الوحي، بينما تستمده الفلسفة الإنسانية من مصادر أو طرق أخرى.
وتبدو روح منهج التحليل الخاص بكانط واضحة لدى كولن، وإن كانت تنبع من إطار مختلف تمامًا، وهو نظرة الإسلام الفلسفية الدينية للعالَم. فالقيمة المتأصلة للإنسانية -والتي تصل إلى حد القداسة- تتطلب حماية شاملة وتحرِّم بشكل مطلق أيَّ اعتداء عليها. وفي الغرب، وَجدت أفكار كانط (ولوك أيضًا) عن الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية المتأصلة تجسيدًا سياسيًا من خلال الديمقراطية الليبرالية للدولة القومية الحديثة، في حين طَبقت المجتمعات الإسلامية التزامها تجاه الكرامة الإنسانية بطرق أخرى. ولكن رغم هذه الاختلافات بين الغرب والبلاد الإسلامية، لا يرى كولن أي تعارض أصيل بين الإسلام والديمقراطية بشكل عام؛ فالالتزامات الأساسية تجاه البشر وحقوقهم الجوهرية تتسق مع بعضها البعض، رغم اعتمادها على منطلقين مختلفين (الأول ديني والآخر علماني). إلا أن كولن يؤكد أن الإسلام يمكنه الارتقاء بالديمقراطية في نواحٍ مهمة؛ حيث يَعتبر أن الديمقراطية في العصر الحديث قد تزاوجت مع فلسفات مختلفة من حولها -مثل المادية الجدلية والتاريخانية- يعتبرها كولن "فلسفات مدمرة". كما أن النُّظم الديمقراطية يمكن أن تخلق حالة من الفردانية الطاغية التي تقوض أركان المجتمع بأكمله، وإن كان كولن يؤكد أنه في الإسلام "جميع الحقوق مهمة، ولا يمكن التضحية بحقوق الفرد بها في سبيل مصلحة المجتمع".([21]) وأخيرًا يرى كولن أن الإسلام هو مجموعة شاملة من المبادئ المستمدة من الدين يمكن أن توجه الديمقراطية في عملية نموها ونضجها المتواصل. ويوضح ذلك قائلاً:
"لقد تطورت الديمقراطية مع الوقت، وكما مرت بالعديد من المراحل المختلفة في الماضي فإنها ستستمر في التطور والتحسن في المستقبل. وخلال مسيرتها هذه، ستتشكل الديمقراطية لتصبح نظامًا أكثر إنسانية وعدلاً، لتكون نظاما قائما على الصلاح والحق. فإذا نُظر إلى البشر ككل، من دون تجاهل البعد الروحي لوجودهم وحاجاتهم الروحية، ومن دون إغفالِ أن الحياة الإنسانية لا تقتصر على هذه الحياة الفانية، وأن كل الناس يتوقون بشدة إلى الخلود - فإن الديمقراطية يمكنها أن تصل إلى ذروة الكمال، وأن تجلب المزيد من السعادة للإنسانية. وتستطيع المبادئ الإسلامية مثل المساواة والتسامح والعدالة أن تساعد الديمقراطية في تحقيق ذلك.([22])
وكما هو واضح، فإن كولن يرى نقاط ضعف في الديمقراطية يستطيع الإسلام أن يعالجها، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا الإنسانية وكيفية النظر إلى البشر. فالديمقراطية تميل إلى إهمال الأبعاد الروحية للحياة ذاتها وللطبيعة الإنسانية أيضًا، وهي الصفات التي تتطلب احترامًا عامًا بل وتبجيلاً من البشر أنفسهم. قد يستنكر كانط هذا الطرح من كولن، على الأقل لسبب واحد هو أن الأخير يؤصل المجتمع بأكمله -بما في ذلك أنظمة العدالة والأخلاق- على أساس رؤية دينية للعالم، وهو ما يعني وضع المجتمع في يدي شيء لا يمكن في النهاية -من وجهة نظر كانط- إثباته عقلانيًا وبشكل مؤكد، وبالتالي يقع في نطاق الضمير أو الإيمان، ولا يمكن فرضه دون استعمال العنف ضد الإنسانية نفسها التي يسعى للدفاع عنها وتكريمها. ومن ناحية أخرى، كان كانط ربما سيسعد بنتائجِ أية رؤية دينية للعالم تضفي قداسة واحتراما أكبر على البشر، بحيث تصبح قيمتهم المتأصلة حقيقة مقدسة، لكنه حينها كان سيقول ببساطة: إن هذه النظرة الشاملة تقف على أساسٍ أقلَّ قوة مما كان يرجو، نظرًا لأنها مبنية على العواطف أو الإيمان الذي لا يمكن إثباته في نهاية المطاف.
ورغم كل شيء، يمكننا القول: إن تلك النظريات عن القيمة المتأصلة للكرامة الأخلاقية للبشر -سواء قال بها مفكرو التنوير الغربي أم علماء إسلاميون يتبعون تفسير القرآن أم غيرهم من أي مذهب كان- تلعب دورًا حيويًا في هذا العصر. فالدعاوى وحدها لا تحقق شيئًا. وكما نرى من حوادث التاريخ، قد يحدث أن ينتظم الناس تحت رايات وشعارات سامية مثل "الإنسانية" و"حقوق الإنسان" و"المواطن العادي" ثم يرتكبون فظائع وحتى إبادات جماعية ضد نفس البشر الذين يدعون احترامهم، وهذا هو النفاق بعينه والخطيئة التي تُلوث الحياة الإنسانية. ولكن عندما يكرس البشر أنفسهم بصدق وبإخلاص لتلك الدعاوى، ويحددون تصرفاتهم وفقًا لها، تصبح الثقافة والمجتمع أقل وحشية وأقل دموية وأقل بهيمية. ويبين لنا التاريخ أيضًا -بخلاف الاضطهاد والإبادة الجماعية- أن المجتمعات التي تُبقي القيمة الإنسانية المتأصلة حية في صميم وجودها السياسي والثقافي تسمح لأبنائها ومواطنيها بدرجة من السلام والاستقرار، وقد وُجدت هذه المجتمعات في كل زمان ومكان عبر التاريخ الإنساني. وعندما تُسقط تلك المجتمعاتُ نفسَها في الاضطهاد والإبادات الجماعية، يكون ذلك في أغلب الأحيان لأنها تركت مبادئ القيمة الإنسانية المتأصلة والكرامة الأخلاقية.
وبالتأكيد على القيمة المتأصلة وكرامة الإنسانية، فإننا نؤكد أيضًا بشكل ضمني على الشروط التي تدعم تلك الإنسانية وتحافظ عليها، فتكريم الإنسانية يعني الالتزام بالنظم الفلسفية والروحية والاجتماعية والسياسية التي تغذي تلك الإنسانية وتصل بها من خلال نموها وتطورها هي إلى أقصى درجات التجسد في الأفراد والجماعات. وأحد تلك الشروط هو الحرية، حرية التفكير والتعلم والتعبير واختيار الحياة المناسبة، وهذه الفكرة هي موضوع الفصل التالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals, 5. (كانط، أسس ميتافيزيقا الأخلاق.)
[2] المصدر السابق، ص 7.
[3] المصدر السابق، ص 8.
[4] المصدر السابق، ص 9.
[5] المصدر السابق.
[6] المصدر السابق، ص 14.
[7] المصدر السابق، ص 36.
[8] المصدر السابق.
[9] المصدر السابق، ص 40-41.
[10] المصدر السابق، ص 41.
[11] المصدر السابق، ص 42.
[12] المصدر السابق، ص 43.
[13] Gülen, Toward a Global Civilization of Love and Tolerance, 112 (كولن، نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح).
[14] المصدر السابق.
[15] المصدر السابق، ص 113.
[16] المصدر السابق، ص 116.
[17] المصدر السابق، ص 169.
[18] المصدر السابق، ص 114.
[19] المصدر السابق، ص 8.
[20] المصدر السابق، ص 8-9.
[21] المصدر السابق، ص 221.
[22] المصدر السابق، ص 224.
الفصل الثاني: الحرية لدى كولن وميل
يَعتبر الفكر المتأثر بالفلسفة الإنسانية حريةَ الفكر والتعبير عن الرأي ركنًا أساسيًا من أركانه، سواء من الناحية الفلسفية أو الناحية الاجتماعية السياسية. فحرية الصحافة وحرية الاحتجاج السلمي وحرية الدين وحق التجمع وغير ذلك من الأعراف الراسخة في الغرب كلها تنبع من الحرية كأحد المثل العليا التي تُشدد عليها جميع الحركات الإنسانية الحديثة، بينما تنبع تلك الحريات في مناطق أخرى من العالم -بما فيها الدول الإسلامية- من مصادر أخرى. وتَعُود قيمة الحرية في مجال الفلسفة إلى العالم القديم، حين كان الفلاسفة يتحدون بعضهم أو يتحدون الآخرين ممن يتبنون مختلف الأفكار والتوجهات، ويجلسون في الأسواق يتجادلون في تلك الأفكار مع أي شخص يستمع إليهم. وقد ولدت مجموعة من أعظم الأفكار المتعلقة بالتعلم التقليدي على يد أولئك الفلاسفة الذين -حتى وإن تعرضوا في النهاية للإعدام أو النفي بسبب أفكارهم- سمحوا لأنفسهم بالتفكير والكلام بحرية، رافضين تكبيل عقولهم وإخراس أصواتهم بناءً على أوامر الحاكم.
وقد عبر العديد من الفلاسفة والكتَّاب في الغرب الحديث بقوة عن قيمة الحرية، لكن أحدًا منهم -في رأيي- لم يعبر عن هذه القيمة بشكل شامل وجذري مثلما فعل "جون ستيوارت مِيل"، وهو منظِّر اجتماعي وسياسي بريطاني ظهر في القرن التاسع عشر. وفي هذا الفصل سنُجري محاورة بين ميل وكولن حول فكرة "حرية الرأي". وهناك خلاف واسع بين ميل وكولن في مجموعة من النقاط المهمة والواضحة، ولكن رغم اختلاف السياق العام والنظرة إلى العالم بالنسبة لكلٍّ من الرجلين، فقد أكد كلاهما على رؤى معينة للمجتمع تتسم بالتسامح -على الأقل من الناحية النظرية- في أمور الاعتقاد والممارسة الدينية، وتسمح بوجود بحث وجدل شديدين في قضايا تتعلق بالحقيقة في معظم المجالات، إن لم يكن في جميعها. وقد جاءت هذه التشابهات بين النموذج "المجتمعي" لكلٍّ منهما بسبب التزامهما المشترك تجاه قيمة الحرية، وخاصةً في موضوعات الفكر والرأي.
وربما كان أكثر ما يشتهر به ميل هو كتابه "الفلسفة النفعية" (Utilitarianism) الذي تحدث فيه عن الفلسفة الأخلاقية. وسوف أشير إلى هذا العمل لاحقًا في هذا الفصل، لكنني أود التركيز أولاً على عمل آخر من أعماله المهمة وهو كتابه "عن الحرية" (On Liberty) الذي نشر عام 1859، وفيه يقدم ميل مشروعه كتأكيد على الحرية الاجتماعية أو المدنية، أي "طبيعة وحدود السلطة التي يمكن أن يمارسها المجتمع بشكل شرعي على الفرد".([1]) ويوضح مِيل أن جيلاً سابقًا في الغرب كان مشغولاً باستبداد الحكام ومن ثم طور أشكالاً تمثيلية أو نيابية من الحكم تخلصت من السلطات الاستبدادية للملوك الذين كانوا يدعون الحكم بالحق الإلهي وما إلى ذلك. وقد كان هو وجيله هم المستفيدين من ذلك الكفاح، ولم يعودوا -في المعظم- بحاجة للكفاح ضد ذلك النوع من الطغيان.
لكن ميل يؤكد أن الجيل الحالي -أي الجيل الذي عاش فيه ميل في بريطانيا خلال القرن التاسع عشر- ينبغي أن يحارب نوعًا آخر من الاستبداد وهو استبداد الأغلبية، فيقول ميل:
"وعليه فإن الحماية من استبداد الحاكم غير كافية، فالحماية مطلوبة أيضًا من استبداد الرأي والشعور السائد، أي ضد ميل المجتمع إلى فرض أفكاره وممارساته الخاصة -بغير طريق العقوبات المدنية- كقواعد سلوكية على من يخرجون على تلك الأفكار والممارسات، من أجل تقييد أو -إن أمكن- منع تنمية وإيجاد أي نوع من الفردية لا تتوافق مع أساليبه، وإرغام جميع الشخصيات على تشكيل نفسها تبعًا لنموذجه هو. فهناك حد معين من التدخل الشرعي للرأي الجمعي في الاستقلالية الفردية، ويعتبر إيجاد ذلك الحد ومنع تعديه أو تجاوزه أمرًا أساسيا ولا يقل أهمية لسلامة وسلاسة الشؤون الحياتية للناس عن الحماية من الاستبداد السياسي".([2])
وبتعبير آخر، فإن مِيل يلمس استبدادًا خفيًا موجودًا في المجتمع حتى مع وجود حكومة تمثيلية، وهو الاستبداد الاجتماعي أو المدني، أي الضغط الذي يمارسه المجتمع على أفراده كي يرضخوا للمعتقدات والممارسات "الطبيعية" في مختلف نواحي الحياة، فقط لأن تلك المعتقدات والممارسات هي "المعيار السائد" الذي يمارسه غالبية الناس في المجتمع، وبالتالي -طبقًا لمنطق الأغلبية- يكون على كل شخص أن "يسير على نفس الخط" وإلا فسوف يتم إجباره على ذلك. ويرفض ميل هذا الاستبداد، ويشرع في توصيف المبدأ الذي به يمكن تحديد التدخل الشرعي للدولة أو الممثلين المجتمعيين في حرية الفرد، في الغالب لأن هذه التوصيفات تقوم تمامًا على التفضيل أو العرف. ويقرر ميل مبدأه في الحرية المدنية في بدء مقالته، فيقول:
"إن الغاية الوحيدة التي تبرر للبشرية -سواء بشكل فردي أو جماعي- التدخلَ في حرية تصرف أي مجموعة منها هي حماية النفس. والغرض الوحيد الذي يمكن في سبيله ممارسة السلطة بحق أي فرد في أي مجتمع متحضر دون رغبته، هو منع الضرر عن الآخرين، فمصلحة الفرد الذاتية -سواء كانَت مادية أو معنوية- ليست مبررًا كافيًا... فالفرد له -فقط- السيادة على نفسه وعلى جسمه وعلى عقله".([3])
ويعد هذا مبدأً راديكاليًا في الحرية، وهو مبدأ لا يطبقه في الغالب أيُّ مجتمع معاصر بشكل متسق، إذ إنه يجعل الإضرار المباشر والمعتبر بالآخرين الأساس الشرعي الوحيد تقريبًا الذي تستطيع الدولة أو السلطات المدنية بمقتضاه التدخل في تصرفات الفرد. وهذا المبدأ يعتبر شديد الليبرالية بالنسبة لكولن؛ فالإسلام مثلاً يحرم -بشكل عام- قتلَ النفس؛ وبالتالي فإن مبدأ ميل في قصر الحرية على منع الإضرار بالآخرين -وليس بالنفس- ليس كافيا. وقد يقول كولن -وفقًا لتعاليم الدين الإسلامي-: إن الناس ليسوا أحرارًا في الإضرار بأنفسهم عن طريق الانتحار. ومع ذلك، فهناك بالفعل نوع من الاتفاق بين كولن وميل حول فكرة الحرية، خصوصًا في مجال الفكر والمناقشة، الذي أفرد له ميل فصلاً كاملاً في مقالته.
يؤيد ميل بشكل مطلق حريةَ الفكر والمناقشة، حتى لو انتهى ذلك إلى اكتشاف خطأ الأفكار التي يتم التعبير عنها ومناقشتها في المجتمع. ويقول: إن أي ادعاء يُطرح أمام المجتمع للنظر فيه ودراسته إما أن يكون صحيحًا أو خاطئًا أو في مرحلةٍ ما بينهما -بأن يكون حقًا بشكل جزئي أو باطلاً بشكل جزئي-. وبغض النظر عن ذلك، فإن مصلحة المجتمعات تتحقق عندما تسمح بحرية التعبير وحرية المناقشة للأفكار. فإذا كانت الفكرة صحيحة، فسوف يدرِك الناس صحتها عن طريق مناقشتها وإعادة النظر في الآراء المؤيدة لها والدفاع عنها ضد من يقللون من شأنها. وبهذه الطريقة تبقى الأفكار الصحيحة حية ونابضة بين الناس، بدلاً من أن تصبح مبتذلة وخاملة بسبب قبولها جيلاً بعد جيل. أما إذا كانت الفكرة مخطئة، فسوف يستفيد المجتمع من المناقشة العامة لها من جديد، وذلك بإعادة النظر في دليلِ بطلانها أو توضيحه أمام الجميع، وبالتالي يتقبل الناس الحقيقةَ أكثر من ذي قبل نتيجة لتجدد اقتناعهم بها. ويرى ميل أن الأغلب الأعم هو أن تكون الفكرة موضعُ النقاش مزيجًا بين الحق والباطل، فالمؤكد أنه لا أحد يمتلك الحقيقة الكاملة عن أي شيء، ذلك أن العقول البشرية لا يمكنها استيعاب الحقيقة بكاملها عن أي شيء، وبالأخص فيما يتعلق بالذات الإلهية، لأننا لا نعرف الأشياء في ذاتها، بل نعرف فقط إدراكنا الشخصي لها حسب موقعنا منها. كما أن العقول المحدودة لا يمكنها إدراك اللانهائية؛ وبالتالي يجب التعبير عن كل الأفكار بحرية في المجتمع حتى يمكن تعزيز الحقائق الجزئية لتصبح حقائق أكثر اكتمالاً من خلال آلية المشاركة المدنية والجدل المدني.
وتُعتبر الفوائد الاجتماعية لحرية الفكر والمناقشة واضحة بما فيه الكفاية، لكن ميل ركز بشكل أعمق على الأثر الفعلي الذي تُحْدثه حرية الفكر لدى الأفراد الذين يشكلون المجتمع. فالمجتمعات -خصوصًا فيما يتعلق بالدين- تحرِّم في الغالب حريةَ الفكر والمناقشة لمنع الهرطقة (الزندقة) والابتداع في الدين، لكن هذا التحريم لا يؤثر في الزنادقة والمهرطقين بقدر ما يؤثر في غيرهم من الأفراد. يقول ميل:
"إن الضرر الأكبر يقع على غير المهرطقين ممن يتم تكبيل تطور عقولهم، وإرهاب تفكيرهم، بسبب الخوف من الهرطقة. فمن يتخيل حجم ما سيخسره العالم من وجود شعوب ذات عقول واعدة وشخصيات جبانة لا تتجاسر على اعتناق أي فكر جريء وقوي ومستقل خشية أن يقود ذلك إلى وضعهم في صورة غير متدينة أو غير أخلاقية؟"([4])
الشاهد في كلام ميل هنا هو أن الخوف المفرط من الهرطقة ليس سمة المهرطقين وحدهم بل أيضًا من يطرحون أفكارًا جديدة وجريئة عن أي شيء، بما في ذلك التقاليد الموروثة أو التي تعتبر مقدسة. وعندما يزداد التهديد بالعقاب على الهرطقة في المجتمع، أو عندما يتوعد المجتمعُ بعقوبات مدنية كل من يعبر عن أفكار غيرِ تلك الأفكار التي تسمح بها صراحةً "السلطاتُ" المدنية، فإن المجتمع بأكمله سيعاني؛ فالقوة العقلية تأتي بالممارسة والتحدي، والمجتمع الذي يَقهر الفكرَ والمناقشة يصبح مجتمعًا ضعيفًا وهزيلاً. ويستمر ميل قائلاً:
"لا يستطيع أحد أن يكون مفكرًا عظيمًا إذا لم يكن يعترف بأن واجبه الأول كمفكر هو أن يتبع عقله إلى أي استنتاجات يقوده إليها. فالحقيقة تفيد من أخطاءِ من يفكر لنفسه -مع توافر الدراسة والإعداد الملائمين- أكثر مما تفيد من الآراء الصحيحة لمن يؤمنون بها لمجرد أنهم لا يُتعِبون أنفسهم في التفكير".([5])
وكما ذكرنا، فإن الأفكار الصحيحة تَذبُل وتضعف عندما لا تتعرض بانتظام للجدل والمناقشة، ومن يعتنقون أفكارًا صحيحة لن يقتنعوا بتلك الحقائق إذا لم يسمحوا لأنفسهم بالتفكير فيها بحرية، وهو ما قد يعني التشكك في صحة حقائق راسخة منذ أمد طويل. إلا أن ميل يؤكد أن الهدف ليس مجرد إيجاد أفراد مفكرين، فيقول:
"ليس المسعى الوحيد -أو الأساسي- لإيجاد مفكرين عظماء هو ما يجعل حرية الفكر ضرورية. بل على العكس، فمما لا يقل أهمية، إن لم يكن أكثر أهمية، أن يتم تمكين الأفراد العاديين من الوصول إلى المستوى العقلي الذي يستطيعونه. فقد كان -وربما يكون فيما بعد- هناك أفراد مفكرون عظماء وسط ذلك المناخ العام من الاستعباد العقلي، ولكن لم يحدث مطلقًا -ولن يحدث- أن يوجد في ذلك المناخ أفراد فاعلون ونشطون عقليً".([6])
هنا، نرى ميل يؤكد على قيمة الحرية لأسباب إنسانية بحتة فضلاً عن الأسباب النفعية. والفقرةُ السابقة تنطوي على قناعة بأن البشر كائنات مفكرة تبحث عن حقيقةِ عددٍ لا نهائي من الأشياء -من أكثرها دنيوية إلى أكثرها ارتقاءً- وتنتج المعرفةَ، وأن هذه الأنشطة هي جزء من معنى كون الإنسان إنسانًا. فحرية الفكر والتعبير والتساؤل أمر حيوي، ليس فقط للعباقرة الذين لن يستطيعوا استخدام عبقريتهم لصالح المجتمع بدون حرية العمل، بل هي حيوية أيضًا -وربما بدرجة أكبر- للناس العاديين في حياتهم اليومية، وللأفراد ذوي الذكاء العادي؛ كي يتمكنوا من أن يصبحوا أفرادًا مشاركين وفاعلين فكريًا. وهذا سيحقق فائدة للمجتمع بالطبع؛ ومن ثم فهو مطلب نفعي أو وظيفي، لكنه أيضًا مطلب إنساني؛ لكونه موجهًا إلى الناس العاديين. فالناس بشكل عام ينبغي أن يكونوا أحرارًا في التفكير والتساؤل والتعبير؛ لأن ذلك هو مغزى كون الإنسان إنسانًا، وعندما تُتاح لنا الفرصة لممارسة إنسانيتنا بشكل كامل، عندها فقط، سيمكننا أن نخلق مجتمعًا صالحًا للإنسان، كغاية وكوسيلة أيضًا.
وهنا أيضًا يمكننا إشراك كولن في المناقشة، فهو يتحدث كثيرًا عن قيمة الحرية من الناحيتين الإنسانية والنفعية، ومعظم كتاباته تتحدث عن التحرر من الطغيان والاستبداد. وهو يشير في سياقات كثيرة إلى الطغاة والمستبدين الذين ابتُليت بهم جموع المسلمين في السنوات الأخيرة على يد قوى العلمانية والاستعمار. وفي سياقات أخرى يتحدث كولن بشكل أكثر عمومية عن الحرية التي يمتلكها كل إنسان باعتباره إنسانًا. وتَعكس آراءُ كولن مبدأَ مِيل الذي ذكرناه عن الحرية عندما يقول: "إن الحرية تسمح للناس بفعل ما يريدون، شريطة ألا يضروا الآخرين، وأن يظلوا مخلصين تمامًا للحقيقة".([7]) وربما كانت العبارة الأخيرة "وأن يظلوا مخلصين تمامًا للحقيقة" ستستوقف ميل في بادئ الأمر، ولكنه ربما يقول: إنه حتى من ضلوا أو آمنوا بالأباطيل مخلصون تمامًا للحقيقة، لكنهم فقط أخطأوا في فهم تلك الحقيقة. فالتحدث أو التصرف بشكل "غير مخلص تمامًا للحقيقة" يتضمن -في رأي ميل وكولن- أشياء مثل الافتراء أو التشهير أو أن يهتف شخص قائلاً: "حريق!" داخل مسرح مزدحم، في حين أنه لا يوجد حريق فعلاً.
إن انتصار كولن لفكرة التسامح لا يمكن فهمه دون التزام بحرية الفكر والمناقشة، ذلك أن التسامح لن تكون له جدوى إذا لم يُسمح بحرية الفكر والمناقشة والاختيار الفردي وما إلى ذلك. فما يَجعل التسامحَ فضيلةً هو أن الناس يكونون أحرارًا وأنهم يختارون معتقدات وديانات ومساعي مختلفة. ويؤكد كولن على هذه النقطة في كثير من المناسبات، وغالبًا في مناقشات عن الديمقراطية وحدها أو عن الديمقراطية والإسلام، اللذين لا يرى بينهما أي تعارض. ففي مقال له عن العفو والصفح، يربط كولن بين التسامح والديمقراطية من خلال مفهوم الحرية، فيقول: "الديمقراطية نظام يعطي لكل شخص تحت مظلته الفرصةَ للعيش والتعبير عن مشاعره وأفكاره الخاصة، ويشكِّل التسامحُ بعدًا مهمًا من هذا. وفي الحقيقة، يمكن القول: إن الديمقراطية تصبح غير واردة حيثما لا يوجد تسامح".([8])
إلا أن هذه المقولات لا تحمل السمة الراديكالية التي تميز أفكار ميل عن ضرورة الحرية والحماية التي يحتاج اليها الناس من الاستبداد الاجتماعي، فعندما يطرح كولن تصوراته عن البشر المثاليين -أو "ورثة الأرض" كما يسميهم في أحد أعماله- لا نرى التزامه العميق بالحرية فحسب، بل نرى أيضًا الأساس المنطقي لهذا الالتزام، وهو أساس إنساني بحت. ففي كتابه (The Statue of Our Souls) [ونحن نقيم صرح الروح]، يقدم كولن رؤية واسعة ومفصلة لمجتمع وعالم يقوده أفراد يتمتعون بسمو روحي وأخلاقي وفكري، يسميهم "ورثة الأرض"،([9]) ويتعمق بعض الشيء في وصف شخصياتهم وسماتهم.(*)[10] وقد ذكر الصفة الخامسة ضمن سرده لصفاتهم المحورية وهي "القدرة على التفكير بحرية واحترام حرية الفكر".([11]) ويتابع قائلا:
"إن التمتع بالحرية يمثل عمقًا مهمًا لقوة الإرادة الإنسانية وبابًا سحريًا يطلع منه الإنسان على أسرار ذاته. ومَن ليست لديه القدرة على الدخول في ذلك العمق واجتياز ذلك الباب لا يمكن تسميته إنسانً".([12])
وعليه، تُعدُّ حرية الفكر محورية بالنسبة لكون الإنسان إنسانا، بل وللإنسانية ذاتها، فبدون حرية الفكر -ليس كمبدأ اجتماعي أو سياسي فحسب بل أيضًا كقدرة داخلية- لا يمكن للمرء أن يسمى إنسانًا حقًا. وبتعبير آخر، لا يصل المرء إلى الصفة الإنسانية بدون حرية الفكر. ويتوسع كولن في ذلك قائلاً:
"في ظروف يجري فيها فرض قيود على القراءة والتفكير والمشاعر والحياة، يستحيل على المرء المحافظة على ملكاته، فضلا عن تحقيق التجديد والتقدم. وفي وضعٍ كهذا يكون من الصعب للغاية المحافظةُ حتى على مستوى الإنسان البسيط والعادي، ناهيك عن تربية شخصيات عظيمة وثَّابة مليئة بروح التجديد والإصلاح، وترنو بأَبصارها نحو اللانهائية. وفي هذه الظروف لا تجد سوى شخصيات ضعيفة منحرفة، وأناسًا أرواحهم متبلدة ومشاعرهم مشلولة".([13])
إن التنمية الإنسانية ومن ثم التنمية والنمو الاجتماعيين -بل وحركات الإصلاح والتقدم كلها- تتوقف على حرية الفكر وطريقة الحياة؛ فمجتمع بلا حرية لن يربي أناسًا لديهم الروح والرؤية اللتان تدفعانه قدمًا إلى أبعاد جديدة، وربما الأسوأ من هذا هو أن مجتمعًا كهذا لا يربي أناسًا عاديين يمكنهم بلوغ كل ما لديهم من طاقات إنسانية. وهنا تتفق أفكار كولن مع أفكار ميل في مناصرة الحرية لفائدتها بالنسبة للمجتمع ولقيمته الإنسانية. والحقيقة أن الأول متأصل في الثاني، فالحرية نافعة للمجتمع لما تقوم به من "عمل" في تكوين البشر وتنميتهم كأفراد. وكما رأينا في الجزء السابق، فإن البشر هم أعلى الأشياء قيمة، وبالتالي فإن تنمية الطاقة الإنسانية -أو "الكينونة" الإنسانية- هي أعلى الأشياء قيمة أيضًا.
ويرثي كولن التاريخ الحديث لتركيا وغيرِها من المناطق الإسلامية التي عانت فيها الشعوب -وما زالت في بعض الأحيان- من وجود بنية اجتماعية تمنع حرية الفكر والتعلم، إما من خلال الاستهجان الصريح، أو من خلال الأيديولوجيات المهيمنة التي ترعاها الدولة. وفي مجال التعلم الإسلامي على وجه الخصوص، يتحدث كولن عن ماضٍ مشرق من العلم والتعلم كان منفتحًا على شتى مجالات المعرفة والاستقصاء العلمي. وفي تلك الحضارة، كان تقرير الحدود الملائمة للحرية يقوم على السنة النبوية وبعض المصادر الإسلامية الأخرى، التي كانت هي نفسها تُعلي من قيمة الحرية الإنسانية. إلا أن روح العلم ذهب وأُفسح المجالُ لضيق الأفق والاستظهار الأعمى والتكرار لكتب ومؤلفات تلقتها بعض الناس بالقبول، وفي تلك المرحلة بدأت جميع الإمكانات الإنسانية في التضاؤل شيئًا فشيئًا، وأصبحت فريسة سهلة للطغاة الانتهازيين والمذهبيين والاستعماريين.
ويتوق كولن إلى حركة تجديد بين المسلمين حتى تستعيد الحضارة الإسلامية مكانا لها في ريادة العالم، كما فعلت في القرون الماضية حين كان معظم ما يشكِّل "الحضارة" يأتي من العالم الإسلامي. ولكي يحدث ذلك، يقول كولن:
"علينا أن نكون أكثر حرية في الفكر والإرادة، فنحن بحاجة إلى تلك القلوب الكبيرة التي يُمْكنها استيعاب الفكر الحر المتجرد، والتي تظل منفتحة على العلم والمعرفة والبحث العلمي، والتي تستشعر التوافق بين القرآن وسنة الله في ذلك المدى الواسع الممتد من الكون إلى الحياة".([14])
فبدون تجديد القدرة على حرية الفكر -سواء على المستوى الفردي أو الجمعي- تضيع الحضارة الإسلامية بل الحضارة بمجملها، إذ لا وجود لإنسانية أصيلة وقوية بغير حرية الفكر، ولا إمكانية للسمو في الحضارة بغير إنسانية أصيلة.
وبهذا يتفق كلٌّ من كولن وميل كل منهما مع الآخر في نواحٍ عديدة بخصوص الدور الحيوي الذي تلعبه الحرية في المجتمع، سواء من ناحية عملها الوظيفي أو من ناحية الالتزام الإنساني العام. فالمجتمع الذي يقمع حرية الفكر لا يكون مجتمعًا عاملاً ومزدهرًا، ولا يكون مجتمعًا يقدِّر قيمة الإنسان مهما حاول الدفاعَ عن هذا القمع متذرعا بالمصلحة الإنسانية.
غير أنني أود الآن الحديث عن الحرية في أعمال ميل وكولن من زاوية مختلفة قليلاً، وهي نوعية الحرية المسموح بها في أعمال كلٍّ منهما، إذ سنرى أن نوعية الحرية التي يطالب بها كلٌّ منهما للبشر هي حرية يتمتع بها البشر وحدهم، ومن ثم تؤكد "الكرامةَ الخاصة للبشر" في الحياة، والتي تنعكس في "الخطاب الإنساني".
وأكثر ما اشتهر عن ميل في موضوع الحرية مؤلَّفه "عن الحرية"، ولهذا فقد ركزتُ عليه في هذا الفصل. ويأتي بعده مؤلفه المهم "الفلسفة النفعية"، وهو مؤلف في الفلسفة الأخلاقية يعارض فيه المبادئ الأخلاقية لدى كانط، ويحاول أن يقدم فلسفة أخلاقية تقوم على السعادة أو المتعة. والنفعية كفلسفة موجودةٌ قبل ميل -بالطبع- وقد أخذتْ عدة أسماء على مر التاريخ مثل الأبيقورية (Epicureanism)، إلا أن الاسم الأكثر شيوعًا لها في عصر ميل كان "مبدأ السعادة القصوى" (the Greatest Happiness Principle). ويعرِّف ميل النفعيةَ في كتابه كالتالي:
"إن العقيدة التي تجعل "المنفعة" أو "مبدأ السعادة القصوى" أساس الأخلاق تَعتبر أن الأفعال تكون صحيحة بقدر ما تسهم في تحقيق السعادة، أو مخطئة بقدر ما تؤدي إلى عكس السعادة. والمقصود بالسعادة هنا المتعة وانعدام الألم، أما عكس السعادة فيعني الألم وفقدان المتعة. فالسعادة وعدم الألم هما الشيئان الوحيدان المرغوبان كغاية. وكل المرغوبات (وهي كثيرة بالنسبة للفكر النفعي كما هي في أي مقصد آخر) تكون مرغوبة، إما لما تنطوي عليه من متعة أو كوسيلة لزيادة المتعة وتجنب الألم".([15])
وفي النفعية كما في الأبيقورية القديمة، تصبح المتعة والألم هما المعيارين للحكم على ما هو جيد ومرغوب؛ ومن ثم الحكم على الصواب والخطأ. ويعرِّف ميل النفعيةَ هنا بطريقة متسقةً تمامًا مع الفلسفة الإغريقية القديمة، فيذهب إلى القول إنه هو وغيره من مفكري المذهب النفعي -تمامًا كأتباع إبيقور (Epicurus) القدماء- يواجهون اتهامات من معارضيهم بأنهم يضمرون فلسفة جديرة بالخنازير وحدها؛ لأنه ليس لها مسعى أفضل أو أرقى من المتعة، وهذا يبدو "مذهبًا حقيرًا ووضيعًا لا يليق إلا بالخنازير".([16]) ويرد ميل على هذا الاتهام بالطريقة نفسها التي اتبعها الإبيقوريون القدماء، بالقول إنه ليس النفعيون بل منتقدوهم هم من يسوون فئة من البشر بالخنازير، لأنهم يفترضون أن البشر لا يحصلون على المتعة إلا كالخنازير. وبتعبير آخر، يرفض الناس الأبيقورية -والتي تسمى غالبًا مذهب المتعة الأخلاقية (Ethical Hedonism) -أو مبدأ السعادة القصوى-؛ لأن كلمات مثل "المتعة" و"السعادة" تستدعي -في أذهانهم- معاني التهتك والفجور والغواية، وإذا كان هذا هو ما تعنيه "المتعة"، فسوف يرفضها الناس بالطبع كمبدأ أخلاقي. إلا أن ميل -تمامًا كما فعل الإبيقوريون- يرفض هذا النقد تمامًا، لأنه ينظر إلى البشر باعتبارهم كائنات أرقى من الحيوانات؛ وبالتالي فهم أقدر و"أكثر ملاءمة" للوصول إلى أشكال أرقى من المتعة. يقول ميل:
"إن تشبيه الحياة الأبيقورية بحياة البهائم يعد شيئًا مهينًا؛ لأن متع البهيمة لا تلبي تصورات الإنسان عن السعادة؛ فالبشر لديهم ملكات أرقى من الشهوات الحيوانية، وبمجرد أن يصبحوا على وعي بها، فإنهم لا يرون سعادة إلا فيما يحقق لهم الرضا والإشباع. وليست هناك نظرية إبيقورية معروفة عن الحياة لا تعطي لمتع العقل والمشاعر والخيال والعاطفة الأخلاقية قيمة أعلى بكثير من مجرد المتع الحسية".([17])
نرى هنا تفريقًا تامًا بين المتع الإنسانية والحيوانية وإقرارًا بالملكات والطاقات الإنسانية العليا التي هي بطبيعتها تجد المتعة في الأشياء الأكثر نبلاً ورقيًا، والتي توجد في عالم العقل والوجدان والضمير، وليس في عالم الجسد أو الشهوة الحسية. ولا يعني هذا أن ميل ينكر على البشر حقهم في الحصول على المتع الحسية أو الجسدية، لكنه فقط يدافع عن نفسه ضد تهمة نشر روح عامة ترتكز على المتع الحسية. فالبشر -باعتبارهم المخلوقات الوحيدة التي لديها إدراك أخلاقي ويمكنها وضع فلسفات أخلاقية- لديهم أشكال من المتعة أرقى من الحيوانات؛ وبالتالي فإن المتع التي تمثل أركان هذه الفلسفة تكون لها طبيعة أكثر سموًا.
ويواصل ميل بالقول: إن من لديهم تجربة واسعة في كلٍّ من المتع العليا والدنيا يعطون الأفضلية للصنف الأول، ويؤثرون اتّباع أسلوب حياة تكون الأولوية فيه للمتع العليا. فلا يوجد شخص عاقل -في رأيه- يرضى بتبادل مكانه مع حيوانٍ ما في مقابل الحصول على أقصى درجات المتع الحيوانية، فأكبر المتع الحيوانية -والتي لا تعدو أن تكون غريزية وجسدية- لا تقارَن بالمتع الإنسانية العليا الموجودة في العقل والمشاعر والضمير، حتى لو كانت تلك المتع العليا تتسم ببعض الألم. يقول ميل:
"إن كائنًا ذا ملكات عليا يتطلب للحصول على السعادة ما هو أكثر مما يتطلبه كائن أدنى رتبة كما يمكنه في الغالب تحمل معاناة أكبر من الكائن الأدنى، وبالتأكيد يتعرض لها بشكل أكثر تكرارًا، لكنه رغم كل هذه الأعباء لا يتمنى أبدًا أن يغرق فيما قد يراه مستوى أدنى من الوجود".([18])
فالكائنات الأرقى في النهاية لن تسعد حقًا بالمتع الدنيا، إذ إن السعادة التي تليق بالبشر هي تلك السعادة التي تتحقق ليس في الميادين الحسية أو الجسدية أساسًا، بل في الجوانب الفكرية والوجدانية والأخلاقية الروحية. ولا يؤثر على هذه الحقيقة -بحسب ميل- ما يبدو من أن الناس غالبًا يختارون المتع الدنيا على حساب المتع العليا، وهو يعترف أن الناس يختارون في الغالب ما هو ضد مصلحتهم طمعًا في متعة قليلة وزائلة؛ فالبعض مثلاً يفرطون في الطعام أو الشراب على حساب صحتهم التي تعتبر المصلحة الأكبر، والتي تعطي متعة أكثر ديمومة، والبعض الآخر قد يمتنعون عن القيام بأعمال نبيلة مستبدلين بها أعمالا أدنى تعبر عن الأنانية والتكاسل. ويبين ميل هذا بالإشارة إلى الشخصية الإنسانية، قائلاً: إن الناس لأي سبب من الأسباب تأتي عليهم لحظة معينة يفقدون فيها صلتهم بأهليتهم المتأصلة للبحث عن المتع العليا، فيوضح قائلا:
"إن القدرة على امتلاك المشاعر الأكثر نبلا تشبه في معظم الطبائع نبتة هشة للغاية يسهل سحقها ليس بالمؤثرات المضرة فحسب بل بمجرد نقص التغذية، وهي تموت سريعًا لدى غالبية الشباب إذا كانت الوظائف التي أوصلهم إليها وَضْعُهم في الحياة والمجتمعُ الذي ألقاهم فيه غيرَ مواتية لتوظيف تلك القدرة. وحينها يفقد الأفراد طموحاتهم العريضة مع فقدهم للقدرة على التذوق العقلي؛ لأنه لا يكون لديهم وقت أو فرصة للاستغراق فيه، ويدمنون الانغماس في المتع الدنيا؛ ليس لأنهم يفضلون ذلك عن عمد، بل إما لأنها المتع الوحيدة التي يستطيعون الحصول عليها، أو لأنها المتع الوحيدة التي بقيت لديهم القدرة على الاستمتاع به".([19])
وفي هذه الفقرة يظهر المنظِّر الاجتماعي في شخصية ميل، حيث قضى شطرًا كبيرًا من حياته في الكتابة عن الإصلاح الاجتماعي، والمشاركة في النشاط السياسي، لإحداث تغييرات إيجابية في التعليم، والمؤسسات المدنية، وحقوق المرأة، ونُظُم العقوبات، والتي كان سيحظى الكثيرُ منها بموافقة تامة من كولن اليوم. كما أن النشاطات التربوية والثقافية والاجتماعية الواسعة لحركة كولن كانت ستحظى بتأييدِ ميل الكامل أيضًا، حيث كان إسهام ميل في كل هذه المجالات منطلِقًا من إيمانه -الذي يشاركه فيه كولن- بالكرامة المتأصلة للبشر، والتي تتبدى هنا في القدرة على الوصول إلى المتع العليا في المجالات الفكرية والوجدانية والأخلاقية. وقد آمن تمامًا أن كل مكونات المجتمع يجب أن تعكس هذه الحقيقة، وأنه يجب تنظيمها بطريقة تحافظ على صفة الكرامة المتأصلة وتغذيها لدى كل الناس منذ نعومة أظفارهم. أما عدم العمل على تنظيم المجتمع بهذا الشكل فيعد ظلمًا إنسانيًا واجتماعيًا، أو حتى إثمًا كبيرًا من وجهة نظر كولن.
ويعرف ميل المتعة في الفقرات السابقة بطريقة معينة تميزها عن المتعة الزائفة للحرية المطلقة التي تتوافر في عالم الشهوة والجسد. صحيح أن المبدأ الاجتماعي للحرية الذي يتناوله في كتابه "عن الحرية" يفسح المجال أمام الناس لكي يهدروا حياتهم في إدمان المتع الدنيا على حساب ذاتهم العليا الأكثر عمقًا، فإن مبدأه هذا أو حتى مذهبه النفعي لم يقل: إن هذه "الحرية" هي الهدف الأسمى للحياة الإنسانية، بل يستطيع المرء أن يجزم بأن هذه ليست "حرية" على الإطلاق، ولكن مجرد شكل معين من أشكال العبودية أو الإدمان. ويستطيع كولن أن ينضم إلى المناقشة الآن، حيث يفرق في مختلف كتاباته بين الحياة التي يقضيها الإنسان بحثًا عما هو خيِّر وحق وجميل وراقٍ، والحياة التي يهدرها في ما هو زائل وشهواني وجسدي فقط. وسوف نناقش هذا التفريق بتفصيل أكبر في الفصل القادم، ولكن يكفي هنا أن نقول: إن كولن يعرّف الحرية بطريقة موازية لتعريف ميل فيما يتعلق بالكرامة الإنسانية والقدرة. يقول كولن:
"من يعتبرون أن الحرية مطلقة يخلطون بين الحرية الإنسانية والحرية الحيوانية، فالحيوانات ليست لديها أي قضايا أخلاقية تُسأل عنها ولذلك فهي غير مقيدة بالقيود الأخلاقية. وبعض الناس يرغبون في هذا النوع من الحرية ويستعملونه -إذا أمكنهم- للانغماس في أحط الشهوات الجسدية، وهذه الحرية تكون أسوأ من الحرية البهيمية ذاتها. أما الحرية الحقيقية -حرية المسؤولية الأخلاقية- فهي تُظهر المرء كإنسان؛ لأنها توقظ الضمير وتحفزه وتزيل العوائق الموجودة أمام الروح".([20])
إذن، فإن ميل وكولن ينظِّران للحرية الإنسانية بطريقة تضعها في إطار فلسفة أكبر للازدهار الإنساني، ولا يَعتبِر أيٌّ منهما أن الحرية الإباحية (Libertinism) هي أعلى مراتب الحرية، بل على العكس؛ حيث يفسر كلاهما الحرية على أنها ما يوفر الأساس لأقصى درجات التنمية والتعبير عما هو أسمى وأرقى في الصفات الإنسانية، والتي يصل الناسُ، من خلال تلبيتها، إلى المتع الأبقى أثرًا والأكثر ديمومة. وتكمن هذه المتع في المجالات الفكرية والروحية والوجدانية والأخلاقية.
وكما ذكرت سابقًا، فإن كلاً من ميل وكولن ينتميان إلى خلفيات دينية وسياسية واجتماعية مختلفة للغاية، ولا شك أنه لو كان بإمكانهما التحاور معًا وجها لوجه لكانا سيختلفان حول بعض قناعاتهما عن حدود الحرية والتسامح في المجتمع، إلا أنهما يتفقان في نقطة أكثر حيوية -في رأيي- للحياة والازدهار الإنسانيين، ألا وهي حرية الفكر والتعبير في سياقِ التزامٍ أكبرَ بالمبدأ العام للحرية. فرغم ضرورة أن ينتبه الناس إلى العواقب المحتملة لما يقولون، ينبغي أيضًا أن يظلوا قادرين على التفكير بحرية والتعبير عن تلك الأفكار للعالم دون خوف من العقاب، إذ لا يوجد في رأيي أي ضرر مباشر أو محسوس يقع على أي أحد من مجرد التعبير عن الأفكار بالقول أو بالكتابة. بل على العكس، حيث يستفيد الأفراد والمجتمع ككل استفادة كبرى عندما يوطن المجتمع نفسه على حرية الفكر والتساؤل والتعبير، ومن خلال تلك الحرية يعطي البشر لأنفسهم أكبر مساحة ممكنة لتنمية طاقاتهم المتأصلة من ضمير وخيال ووجدان وروحانيات وفكر. وعندما تنمَّى تلك الطاقاتُ وتتاح لها المساحة للنمو في ظل نُظم اجتماعية وسياسية سليمة، عندها فقط سيزدهر الوجود البشري ويصل إلى أبعد مدى ممكن من الإنجاز.
إن ميل وكولن ملتزمان على حد سواء بقيمة الحرية ضمن السياق الخاص بكلٍّ منهما على حدة؛ ذلك أن الاثنين ينتميان إلى الفلسفة الإنسانية بالمعنى الواسع للكلمة، ومبدأُ الحرية يحتل مكانة مركزية في الفكر الإنساني. كما أنهما -مع مناداتهما بالحرية الإنسانية- يناصران فكرة العظمة الإنسانية، ليس كمبدأ مجرد فحسب بل كجزء ضروري من الحياة الإنسانية الجمعية في عالم الواقع. وتوجد لدى كولن -مثل كثيرين غيره- رؤية واضحة عن العظمة الإنسانية وعن الصفات التي تميز البشر العظام، أولئك الذين يبلغون أقصى الإمكانات البشرية وأفضلها. وسوف ننتقل الآن إلى مناقشة هذه الرؤية عن العظمة الإنسانية، وهي المثالية الإنسانية التي ينبغي تجسيدها في كل زمان ومكان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] Mill, On Liberty, s.41. (عن ميل، الحرية).
([2]) المصدر السابق، ص 44.
([3]) المصدر السابق، ص 48.
([4]) المصدر السابق، ص 67.
([5]) المصدر السابق.
([6]) المصدر السابق.
[7] Gülen, Pearls of Wisdom, 55.. (كولن، الموازين أو أضواء على الطريق).
[8] Gülen, Toward a Global Civilization of Love and Tolerance, 44. (كولن، نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح).
[9] Gülen, The Statue of Our Souls, 5–10, 31–42. ( كولن، ونحن نقيم صرح الروح)
[10](*) سوف أتناول مفهوم "ورثة الأرض" وكذلك رؤية كولن الاجتماعية بمزيد من التفصيل في الفصل الثالث
([11]) المصدر السابق، ص 38.
([12]) المصدر السابق، ص 38-93.
([13]) المصدر السابق، ص 39.
([14]) المصدر السابق، ص 40.
[15] Mill, Utilitarianism, 7.( ميل، النظرية النفعية)
([16]) المصدر السابق.
([17]) المصدر السابق، ص 8.
([18]) المصدر السابق، ص 9.
([19]) المصدر السابق، ص 10.
[20] Gülen, Pearls of Wisdom, 55.( كولن، الموازين أو أضواء على الطريق).
الفصل الثالث: الإنسان المثالي لدى كولن وكونفوشيوس وأفلاطون
تطرح الفلسفات الإنسانية الأكثرُ انتشارًا ومنهجية رؤى مختلفة للمثالية الإنسانية (İdeal Human)، ففي بعض الحالات تكون المثالية اجتماعية أو جمعية في طبيعتها وتشمل السياسة والتعليم والحكم والنظم الاجتماعية وما إلى ذلك، وفي حالات أخرى تركز الرؤية على الفرد وعلى كيفية تحقيق كل شخص لما هو أعلى وأفضل في الحياة. ومن أمثلة الحالة الأولى أشهر ثلاثة فلاسفة من الإغريقيين الكلاسيكيين وهم سقراط وأفلاطون وأرسطو، ومن أمثلة الحالة الثانية الكاتب الرواقي إبيكتيتوس والإبيقوريون وبوذا. إلا أن ما يجمع كل هؤلاء تقريبًا هو رؤية مثل أعلى إنساني باعتباره الهدف المنشود من التطور والإنجاز الإنسانيين. وتبرز الفلسفة الإنسانية -التي تناصر الإنسان في تلك الأمثلة- شكلاً مثاليًّا منه كمعيار للقياس أو كهدف يطمح إليه أي مسعى أو جهد بشري، إما لذاته فقط أو لما يقول به من وجود حقيقة غيبية مطلقة مثل الذات الإلهية.
وفي هذا الفصل والفصل الذي يليه، سأجري محاورة ثلاثية بين الأستاذ كُولَن واثنين من أقوى شارحي المثالية الإنسانية الذين عرفهم العالم، وهما كونفوشيوس وأفلاطون. ومما يثير الاهتمام أن كونفوشيوس (551-479 ق.م) وأفلاطون (427-347 ق.م) كان يفصل بينهما جيل واحد تقريبًا، لكن أحدهما عاش في الصين بينما عاش الآخر في أثينا. وقد تحدثا عن رؤى ثورية متشابهة عن المجتمع والفرد بناءً على ما يعتقدانه من الإمكانيات المتأصلة للطبيعة البشرية من ناحية، وترتيب أو "كيفية وجود" الأشياء في الواقع الأوسع من ناحية أخرى. أما الأستاذ كُولن فيصوغ رؤية لمجتمع متجدد روحيًّا يستمد قوته وتماسكه أساسًا من وجودِ وجهودِ أناس اجتهدوا في تحصيل الكمال البشري -لأقصى مدى ممكن- طبقًا للمعتقدات الإسلامية. ونرى في أعمال الثلاثة، كونفوشيوس وأفلاطون وكُولن، فكرة مشتركة تحرك الرؤى الخاصة بكلٍّ منهم، وهي أن المجتمع يسير على أفضل ما يكون عندما يحكمه ويشكِّله أناس ذوو قوة أخلاقية وعقلية. وبالطبع تختلف تسمية هؤلاء الناس ذوي القوة الأخلاقية والعقلية في أعمال كلٍّ من المفكرين الثلاثة، كما أنهم يوجدون في أطر ثقافية وفلسفية ودينية متباينة، إلا أنهم يتفقون في جوهرهم، وهذا الجوهر المتمركز حول القيمة الإنسانية هو ما سنتناوله الآن.
رغم انتماء كونفشيوس وأفلاطون وكولن إلى خلفيات ورؤى حياتية مختلفة تمامًا، فإنهم يشتركون جميعا في رؤية أساسية واحدة حول بنية الواقع؛ فالثلاثة يتحدثون عن رؤاهم للمجتمع الإنساني من منطلق مثالية غيبية تمثل الأساس والمصدر والحقيقة والأصل لكل الواقع الدنيوي. وهذه المثالية الغيبية تسمى لدى كونفوشيوس "الداو" (Dao) أو "كيفية وجود جميع الأشياء"، والداو ليس إلهاً أو معبودًا شخصيًّا، وإنما هو القوة أو المبدأ أو الطاقة الطبيعية للواقع؛ فكل الأشياء توجد في الداو ومنه تتكون جميع الأشياء. ويعتبر الداو في كلٍّ من الفلسفات الصينية القديمة والكونفوشية والطاوية (Daoism أو Taoism) الأرضيةَ العميقة لكل الوجود والجوهر والواقع، وعن طريق الانسياب أو التكامل مع الداو أو الاتصال به أو تقليده يمكن فقط أن يَحدث التناغمُ في الحياة الإنسانية بأبعادها الاجتماعية والسياسية والكونية.
ويصف أفلاطون هذه الحقيقة الغيبية "بالمثالية" (ideal) في مقابل العالم "الحقيقي" (real). وفي المحاورات التي أجراها عن معلمه سقراط وتلامذته، كان سقراط يركز على هذين البعدين الأساسيين للوجود -المثالي والحقيقي- أو يعبّر عنهما أحيانًا بألفاظ مختلفة مثل الحقيقة والظل. والمثالي أو الحقيقي هو أزلي وغير مادي -أي إنه فكرة أو روح صرفة- لا يفنى أو يتغير، وهو مصدر الخير والحق والعدل وغير ذلك. ويشبِّه أفلاطون تلك الذات بالنور أو السطوع في مقابل الظلام الدامس للواقع الإمبيريقي الذي غالبًا ما يخلط البشرُ بينه وبين الواقع الحقيقي المطلق. أما العالَم الفعلي أو عالم الظل فهو مادي ومتغير وفانٍ، تتعدد فيه تصورات الخير، وتتصارع أشكال الحق، وتكون مفاهيم العدالة نسبية. وباختصار، فالعالم المثالي أو الحقيقي هو عالم العقل أو الروح الصافية ورغباتها، بينما العالم الفعلي أو عالم الظل فهو عالم الجسد ورغباته، ولا تستقيم الحياة الإنسانية على المستويين الفردي والجمعي إلا عندما يكون الأولُ هو الحاكم على الثاني.
وأخيرًا، يؤكد كُولن على تصوره للحياة الإنسانية في إطار الإسلام، الذي يطرح رؤية حياتية تجمع بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. ولا تكتسب الحياةُ الدنيا كمالَها ومعناها وأصالتها إلا عندما نعيش فيها ونحن نؤمن بوجود الرب -أو الله- باعتباره المصدر والأساس للحقيقة. وجميع الكائنات هي في جوهرها مسلمة -بمعنى أنها تسلم وجهها لله- لأنه لا وجود مطلقًا لأي شيء بعيدًا عن إرادة الله وقدرته. وعندما تسير الأشياء في حياتها وأهدافها بالطريقة التي فطَرها الله عليها، فإنها تفعل ذلك "في خضوع واستسلام" لله -باعتبارها مسلِمة. وبتحديد أكثر، فإن الحياة في أكمل صورها لا تكون إلا عندما نعيشها ونحن نؤمن -بعقولنا وليس فقط بالفطرة- بتلك الجنّة الأبدية للحياة في خضوع واستسلام لله، سبحانه وتعالى.
إذن، فنحن نرى في الأمثلة الثلاثة السابقة شكلاً من أشكال تقسيم الحقيقة، فالحقيقة واحدة بالتأكيد ولكنها تتكون من أبعادٍ وعوالِمَ وأشكالِ وجود مختلفة. ومَن يدركون هذا ويعيشون وفقا له يَجدون السعادة والخير والحق مهما كانت ظروفهم وأحوالهم؛ لأن توجههم دائمًا يكون نحو الحقيقة الأعلى والأسمى. أما من يَغفلون عن ذلك فإنهم يغوصون في مستنقع الحيرة والشهوات الجسدية، ويغرهم الواقع المحدود والأدنى لعالم الظل. باختصار، هناك صنفان أساسيان من الناس: الأعمى والبصير، ولكي تستقيم الحياة على الأرض ينبغي أن يحكمها ويسودها الصنف الثاني.
وفي كتاب "المقتطفات الأدبية" (The Analects)، يميز كونفوشيوس وغيره بين من لديهم شخصيات "سامية" أو "نبيلة"، ومن لديهم أساليبُ "دنيا" أو "وضيعة" أو عقول "متدنّية". وغالبا ما تكون هاتان الصورتان على النقيض من أحدهما الآخر. يقول كونفوشيوس:
"الشخص النبيل يختلف عن الآخرين، ولكنه يكون في سلام معهم. أما الشخص الوضيع فهو مثل الآخرين تمامًا، ولكنه لا يكون في سلام معهم على الإطلاق".([1])
"الشخصيات النبيلة تشجع ما هو جميل في الناس، وتحارب ما هو قبيح فيهم، أما الشخصيات الوضيعة فتفعل العكس تمامًا".([2])
"الشخصيات النبيلة تبحث عن الحقيقة دائمًا في داخلها، أما الشخصيات الوضيعة فتبحث دائمًا عنها في الخارج".([3])
في هذه الفقرات نرى أن الشخصيات النبيلة لديها توجه مختلف كليًّا عن الآخرين، فالشخصيات النبيلة هي شخصيات لديها قدرة أكبر في كل أبعادها الداخلية، مما يسمح لها بأن تكون وأن تتصرف في الحياة بطريقة مختلفة جذريًّا عن غيرها. ويستمر النص:
"الشخصيات النبيلة تقدر ثلاثة أشياء: التكاليف السماوية، والشخصيات العظيمة، وكلام أهل الحكمة. أما الشخصيات الوضيعة فهي لا تفهم التكاليف السماوية وبالتالي لا تعظمها، وتستخف بالشخصيات العظيمة، وتسخر من كلام أهل الحكمة".([4])
"الشخصيات النبيلة لها تسْع سمات: بريق العينين، ورهافة السمع، وبشاشة الوجه، والتواضع في السلوك، والصدق في الكلام، والأدب عند عرض الخدمات، والتحقق عند الشك، والتـروي عند الغضب، والالتزام بالأخلاق عند وجود مصلحة".([5])
وتسلك الشخصيات السامية في الحياة طريقًا مختلفًا عن ذلك الذي تختاره الشخصيات الوضيعة، فآذانهم تبحث عن الحكمة والأدب والكرامة والمساعدة، بينما الناس العاديون أو "الوضيعون" لا يلْقون بالاً أصلاً لكل هذه الأمور.
أما أفلاطون فيتحدث عن نوع مماثل من الناس في كتابه "الجمهورية" (The Republic)، وهو أطول المحاورات التي أجراها على الإطلاق، وقد أُفردت أعمال كثيرة لتفسير تلك المحاورة وحدها. وأنا لا أنوى -إطلاقًا- عمل تحليل مفصل لأي جزء من تلك المحاورة، بل سأركز فقط على الفقرات التي تهمّنا هنا. وكما ذكرت سابقًا، يقسِّم أفلاطون الواقع إلى عالمين: العالَم الأزلي للفكر أو الروح الصافيين، والعالم المحدود للجسد. ويتعلق جزء كبير من المحاورة بين سقراط وطلابه بالفيلسوف -أو "محب الحكمة"- الذي يفهم بعمقٍ هذا الجانبَ من الوجود، وينتمي إلى العالم المطلق المثالي ويعيش من أجله. وفي آخر المحاورة، يصف سقراط من ليس لديهم حب الحكمة ولا يفهمون الحقيقة وبالتالي لا يتمتّعون بفوائد الحياة المتناغمة مع الحكمة، فيقول:
"وهذا هو حال من ليس لديهم أيّة دراية بالحكمة والفضيلة، لكنهم يشغلون أنفسهم عنها دائمًا بالبحث عن المتع والملذات وما إلى ذلك. فهم أولاً يبدون كما لو كانوا قد انجرفوا إلى القاع ثم صعدوا من جديد حتى وصلوا إلى المنتصف ثم بدأوا يتحركون ويتنقلون ما بين هاتين النقطتين طوال حياتهم، فهم دائمًا محصورون داخل تلك الحدود، ولا يتطلعون أبدًا إلى ما هو موجود فوقهم، ولم يوجد ما يحملهم لأعلى. فهم لم ينعِّشوا أنفسهم أبدًا بجوهر الحقيقة، ولم يتذوقوا المتعة الصافية التي ليس فيها أي خداع. ينظرون دائمًا إلى الأسفل، مُطأطِئي الرؤوس، يعيشون كالأنعام، يأكلون ويسمنون ويتزاوجون، يقودهم الطمع إلى الترافس والتناطح بحوافر وقرون من حديد. ولأنهم نهمون فإنهم يقتتلون، وهم نهمون لأنهم يغفلون البحث عن الانتعاش الحقيقي في ذلك الجانب الحقيقي والصافي من الروح، لذا فهم يضطرّون للعيش بأقنعةِ وأوهام المتعة الحقيقية: فمتعهم لا بدّ أن تمتزج بالألم، وهذا التجاور بين إحساسَي المتعة والألم هو ما يعطي لكلٍّ منهما طعمه وقوته، مما يدفع الحمقى إلى الانغماس في مستنقعات الأنانية وحب الذات، ويظلون يدافعون عن كل هذه الضلالات والأوهام كما روى الشاعر الإغريقي ستيسيكورس قصة المعركة التي دارت في طروادة لمطاردة شبح هيلين من قبل رجال لا يعرفون الحقيقة".([6])
وكما هو الحال مع مذهب كونفوشيوس، يوجد هنا تفريق واضح بين مجموعتين من الناس: من يتسمون بالحكمة ويركزون انتباههم على المتع العليا، ومن يتسمون بالجهل ويركزون انتباههم على المتع الدنيا. وفي أحسن الأحوال، قد يرتفع الجهلة والعامة إلى مستوى متوسط ولكنهم يقضون معظم حياتهم في المسافة ما بين المنتصف والقاع، فيعيشون أشبه بالأنعام يبحثون عن متع أقرب إلى الحيوانات التي لا روح فيها بدلا من أن يُشبهوا البشر الذين لديهم روح خالدة.
ويصور أفلاطون الفرق بين الفلاسفة والعامة في الجزء السابع من كتابه "الجمهورية" من خلال قصة الكهف الشهيرة، حيث يطلب منا سقراط أن نتخيل أناسًا يعيشون في كهف منذ طفولتهم وهُمْ في وَضْعٍ بحيث لا يرون أمامهم سوى جدار الكهف، ولا يعرفون أن وراءهم ممرًّا طويلاً يقود إلى خارج الكهف، ويوجد خلفهم ضوء ساطع يجعل ظلال الأشياء مِن خلفهم تسقط على الجدار أمامهم. ويعيش هؤلاء الأشخاص حياتهم وهم ينظرون إلى الحائط ويتعاملون مع الظلال الساقطة على الجدار كما لو كانت أجسامًا حقيقية، ولا يدركون أنها ليست في حقيقتها سوى ظلال أو صور للأجسام الحقيقية. وعندما يسمعون أصداء الأصوات تتردد داخل الكهف يعتقدون أن الظلال هي التي تصدر تلك الأصوات، وتبدأ عقولهم في نسج قصص حول تلك الظلال، ويصبح لها معنى لديهم، فهذه الظلال هي "الحقيقة" بالنسبة لهم... وذات مرة، تمكن أحد هؤلاء الأشخاص بشكل أو بآخر من التحرر من هذا الوضع الثابت، واستدار ليرى ذلك الضوء الساطع والظلال التي يكوِّنها، والممر الذي يمتد لأعلى إلى خارج الكهف حيث يوجد نور أكثر سطوعًا، فقطع الممر والنورُ يؤلم عينيه حتى خرج من الكهف إلى ضوء النهار، إلى العالم "الحقيقي". ولم يستطع في البداية رؤية السطوع الكامل للحقيقة؛ فلا بدّ أن تعتاد عيناه عليها بالممارسة، إلا أنه في النهاية أصبح يرى كل شيء بوضوح، فعاد إلى الكهف ليخبر الآخرين بالظلام الذي يقبعون فيه والنور الذي يُمْكنهم الحصول عليه إذا تحرروا وتركوا تلك الظلال ومشوا عبر الممر إلى النور، فسخروا منه وتشاجروا معه، حتى قرروا قتله في النهاية بسبب أفكاره التي تبدو سخيفة للغاية ولا تمت بصلة للحقيقة.([7])
والشاهد في القصة واضح، وهو أن عددًا محدودًا من الناس هم الذين سيوجهون شخصياتهم بالكامل صوب نور الحكمة والحقيقة ويهبون أنفسهم للبحث عنه رغم كل المصاعب، أما الأغلبية فسوف يفضلون كهف الظلام ويقضون حياتهم مشغولين بالأعمال اليسيرة والهينة التي تنتمي إلى عالم الظلال، على حساب المتع العليا التي تليق بمخلوقات لديها روح حية. ويواصل سقراط قائلا:
"نؤكد أن هذه القوة كامنة بالفعل في روح الجميع، فالطريقة التي يتعلم بها كلٌّ منا تشبه ما يحدث للعين؛ فهي لا تستطيع الانتقال من الظلام إلى النور من دون نقل الجسم بأكمله، لذا فإن المرء -من خلال قدرته على المعرفة، إضافة إلى روحه بأكملها- ينبغي أن يحول وجهته من عالم الأشياء المؤقتة والزائلة إلى عالم الوجود الأزلي الدائم، إلى أن يتعلم في النهاية تحمُّل رؤية أكثر الأشياء سطوعًا في ذلك العالم. وهذا هو ما نسميه "الخير"، أليس كذلك؟"([8])
إذن، صحيح أن القدرة على الحياة بحب الحكمة موجودة فينا جميعًا، إلا أن القليلين هم من يفعِّلون هذه القدرة الداخلية في حياتهم. وتحقيق ذلك يتضمن توجه الفرد بكل كيانه نحو "الحقيقة المطلقة" ومقاومة إغراء المتع الزائلة التي تكون في أحسن الأحوال مجرد صور لتلك الحقيقة. ويتفق أفلاطون مع كونفوشيوس في وجود نوعين أساسيين من الناس في هذا العالم: الأعمى والبصير.
وبعد أفلاطون وكونفوشيوس، يأتي كولن ليحدد خصائص البشر المثاليين التي تميزهم عن القطاع العريض من الناس العاديين. وقد أعطى كولن في أعماله أسماء عديدة للأفراد الذين يُعتَبَرون مثالاً للكمال الإنساني، منها "ورثة الأرض" (Inheritors of the Earth)([9]) و"الشخص ذو المثل العليا" (Person of Ideals)([10]) و"الأشخاص المثاليون" (Ideal People).([11]) وأيًّا كانت التسمية، فهؤلاء الناس يشتركون في سمات واضحة تميزهم تمامًا عن الناس الدنيويين. ويرى كولن أن التجديد والنهضة سيَحدثان في العالم بشكل عام -وفي تركيا بشكل خاص- عندما يتقدم هؤلاء الناس المثاليون روحيًّا وأخلاقيًّا وفكريًّا لقيادة الإنسانية إلى عصر جديد، من خلال ما يقدّمونه من خدمات وأيضًا ما يمثّلونه من قدوة في حياتهم الخاصة. وبدون هؤلاء الناس، سيستمر المجتمع في التخبّط وسط بحر من الشهوات والأيديولوجيات الانتهازية، ولن يَسْمُوَ الناس في مجتمع كهذا إلى مستوى يجعلهم يستحقون صفة "الإنسانية". يقول كولن:
"بعض الناس يعيشون دون تفكير، بينما البعض الآخر يفكرون ولكنهم لا يستطيعون وضع أفكارهم حيز التنفيذ. (...) ومن يعيشون دون تفكير يكونون مادة لفلسفات الآخرين، وهم يتنقلون دائمًا من نمط إلى نمط ولا يفتأوون يبدلون قوالبهم وصورهم، ويقضون حياتهم في سباق محموم من الانحرافات في الأفكار والمشاعر، والاضطرابات في الشخصية، وهم ممسوخون بصورهم أو أرواحهم، وليس بمقدورهم أن يرجعوا إلى ذواتهم. (...) هؤلاء يُشْبهون دائمًا بِركة ماء راكد آسن منتن، فبدلا من يبعثوا الحياة فيما حولهم يصبحون أشبه بمستعمرة للفيروسات أو مأوى للجراثيم".([12])
هذه هي كلمات كولن، ولكنها يمكن بسهولة أن تكون كلمات أفلاطون أو كونفوشيوس أيضًا؛ فكولن هنا يفعل ما سبقه إليه زميلاه في المحاورة من تحديد نوعين من الناس في هذا العالم، وهم المثاليون -أو من يدركون ما هو مثالي ويسْعون إليه- والدنيويون. وما يشترك فيه الدنيويون هو أنهم -عند مستوى معين- ينسون أنهم أناس لهم قيمة. ويكمل كولن فيقول:
"ويبلغ من ضحالة أفكار هؤلاء الناس وسطحية آرائهم أنهم يقلدون كل ما يرون أو يسمعون -تمامًا كالأطفال- يسيرون كالإمّعات هنا وهناك وراء الجموع، ولا يجدون أية فرصة للإنصات إلى أنفسهم أو محاولة التعرف على قيمتهم، بل إنهم لا يدركون أصلاً أن لديهم قيمة تميزهم عن غيرهم، فيقضون حياتهم كعبيد للجسد، عبيد لا يرضون بالتحرر من أحاسيسهم الجسدية، ويجدون أنفسهم -بوعي أو بدون وعي- عالقين في واحد أو أكثر من تلك الفخاخ القاتلة، ويَذبحون أرواحهم مرة بعد مرة، في أكثر أشكال الموت بؤسا".([13])
وكما هو الحال مع سكان الكهف في قصة أفلاطون، فإن الدنيويين -حسب رأي كولن- يعيشون حياة متمركزة حول المتع الجسدية المحدودة على حساب المتع العليا من النمو الفكري، والارتقاء الروحي، والمساهمة في بناء المجتمع، وهم بذلك يتنكرون لإنسانيتهم ويعيشون كالحيوانات. ويقول كولن فيما يتعلق بالوصول إلى الإنسانية الكاملة:
"إلا أن البشر بعيدون كل البعد عن الوصول إلى ذلك بسبب جسديتهم وشهوانيتهم، بل يمكن القول: إنه عندما يغفل البشر عن أنفسهم أو عن وجودهم وماهيتهم فإنهم قد يصبحون أدنى من المخلوقات الأخرى. غير أن هؤلاء البشر في الوقت نفسه -بعقولهم ومعتقداتهم وضمائرهم وأرواحهم- شهود على الأسرار المقدسة الكامنة بين مسارات الحياة. ولذلك فإنه مهما بدا البشر تافهين، فإنهم يظلون "المثال الأسمى" ويظلون مميَّزين عن غيرهم. والإسلام لا يقدِّر قيمة البشر بطريقة مسك العصا من المنتصف، فهو الدين الوحيد بين كل المعتقدات الذي يَعتبر البشرَ كائناتٍ راقيةً خلقت لرسالة أو لمهمة خاصة، ولذا فقد أمدها الله بإمكانات ومواهب أعلى. فالبشر في الإسلام لهم السيادة لمجرد كونهم بشرًا".([14])
والشاهد واضح في كلام كولن، حتى إذا شكك البعض في قوله عن نظرة الإسلام المتميزة للإنسان؛ فكما ذُكر في الفصل الأول، ينادي كولن بالكرامة الإنسانية والقيمة الأخلاقية المتأصلة في إطار النظام الفلسفي الديني للإسلام، والذين يعيشون غافلين عن تلك القيمة وذلك الوعد -أو مستخِفِّين بهما- يختارون أن يعيشوا حياة أدنى من الحياة الإنسانية، وتلك للأسف هي الحياة التي يختارها أكثر الناس.
ولكن من بين الجموع الغفيرة، يظهر قلة من الأفراد الاستثنائيين يرون ما هو أبعد من المتع الوقتية الزائلة ومشاغل الحياة الدنيا، وهؤلاء -رغم تنوع وصفهم لدى كونفوشيوس وأفلاطون وكولن- يصلون إلى المثالية الإنسانية، وبالتالي يمثلون القدوة الساطعة لما هو ممكن في عالم الحياة الإنسانية. وبالنسبة للمفكرين الثلاثة، ينعقد الأمل على هؤلاء الناس في تحقيق حياة إنسانية طيبة على المستوى الفردي والاجتماعي أو السياسي، لذا يرى كلٌّ من المفكرين الثلاثة -بطريقته الخاصة- أن هؤلاء الأفراد المثاليين ينبغي أن يأخذوا مكانهم كقادة في المجتمع.
وكما ذكرنا سابقًا، يتميز الإنسان المتفوق لدى كونفوشيوس عن عامة الناس بشخصيته الأخلاقية، وقد أكثر كونفوشيوس وغيره في التراث الإنساني من الحديث عن الفضائل الجوهرية التي تُميّز الإنسان المتفوق وتُجسد إنسانيته العميقة، وهذه الفضائل الجوهرية تسمى "الفضائل الثابتة" في الكونفوشية، وهي تتفاوت من حيث الكم وكذلك من حيث "الكبر" أو "الصغر" بحسب الشخص الذي ينظر إليها، ولكنها تعمل كمجموعة شاملة من الصفات الشخصية التي يمثلها البشر المتفوقون. وهذه الفضائل تشمل الـ"رين" (ren) وهي الإنسانية وحب الخير والطيبة، والـ"لي" (li) وهي الطقوس والآداب العامة واللياقة، والـ"يي" (yi) وتعني الاستقامة والصواب، والـ"زي" (zhi) وتعني الحكمة، والـ"زين" (xin) وتعني الوفاء والموثوقية، و"شينج" (cheng) وتعني الإخلاص، و"زياو" (xiao) وتعني بر الوالدين. وتتواتر تأكيدات كونفوشيوس على كل تلك الفضائل وغيرها في التراث، ولكن أبرزها كانت الـ"رين" والـ"لي" وأهمها على الإطلاق هي الـ"رين" التي اعتبرت جوهر كل الفضائل. فالـ"رين" هي أساس كل الفضائل، ويعلق لورانس ج. تومبسون (Laurence G. Thompson) على ذلك قائلاً: "لقد تم تلخيص الكمال الأخلاقي في كلمة الـ"رين"، وهي تعني بالنسبة لكونفوشيوس درجة من المثالية تبلغ من الارتفاع والسمو أنه لم يجد قط شخصًا تنطبق عليه فعلاً تلك الكلمة".([15]) وقد كان التركيز على الـ"رين" هو ما ميز الكونفوشية عن أشكال الدين الأخرى التي تقدم مثالية متجذرة في إنكار الذات الاجتماعي أو السياسي، أو الزهد، أو الممارسات المتعلقة بالغذاء، أو الرياضة الروحية (اليوجا) أو الارتقاء النفسي التي تَشيع في الديانات الصينية الأخرى. ويؤكد اسم "تراث الأدباء" (Literati Tradition) -وهو الاسم الذي أُطلق على مذهب كونفوشيوس الذي ينادي بإنتاج أفراد متفوقين أخلاقيًّا وعقليًّا- على بناء الشخصية دون النظر إلى النسب أو السلالة كي توضع تلك الشخصية بعد ذلك في خدمة الدولة. ويعتبر "الرين" المثالية الأخلاقية الأكمل للصلاح والإنسانية وحب الخير، وهي تُغرَس داخل البشر عن طريق "اللي"، والذي يعني ممارسة الطقوس والشعائر. وهناك قصة في كتاب "المقتطفات الأدبية" توضح ذلك المعنى فتقول:
سأل "يَن هُويْ" عن الإنسانية [أي الـ"رين"]، فأجاب المعلِّم [كونفوشيوس]: "أن تهب نفسك للطقوس [أي الـ"لي"]؛ فهذه هي الإنسانية. فإذا كرس الحاكم نفسه للطقوس ولو لمدة يوم واحد، فسوف يعود كل ما هو تحت السماء إلى الإنسانية. ألا تجد أن ممارسة الإنسانية مصدرها أولاً في النفس ثم بعد ذلك لدى الآخرين؟" فسأله "ين هُويْ": "هل يمكنك أن تفسر كيف يكون تكريس النفس للطقوس؟" أجاب المعلِّم: "لا تنظر إلا بالطقوس، ولا تسمع إلا بالطقوس، ولا تتحدث إلا بالطقوس، ولا تتحرك إلا بالطقوس". قال ين هوي: "إنني لست بمثل هذه البراعة، لكنني سأحاول أن أطبق تلك النصائح".([16])
الشاهد هنا هو أن التمسك الدائم بجميع أشكال اللياقة والآداب والطقوس في كل بعد من أبعاد الحياة يتطلب انضباطًا، وهذا الانضباط بدوره يستخدمه المرء كي يغرس في نفسه شخصيةً مُحبة للخير والصلاح والإنسانية. فالـ"رين" -بقدر ما ينميها الإنسان في نفسه- توفر الأساس لتنمية كل الفضائل الأخرى لديه من خلال الممارسة الدائمة للـ"لي"، وهي هنا تشبه "الإرادة الصالحة" في نظرية كانط عن الشخصية الأخلاقية (سبق تناولها في الفصل الأول). فبغير الإرادة الصالحة لا يمكن تحقيق أي خير آخر، وكذلك بدون الـ"رين" -أي بدون ميل حقيقي للخير والإنسانية- تصبح الفضائل الأخرى بلا أي أساس.
وعندما يجسِّد الإنسانُ المتفوق الفضائلَ الثابتة ويتحمل دوره في الخدمة المدنية، فإنه يكتسب قوة في المجتمع تكون أخلاقية في الأساس، ويطلق على هذا المفهوم الـ"تي" (te) وتترجم غالبًا بالقوة الأخلاقية (moral force) أو الاستقامة (integrity). وهذه الاستقامة لدى الإنسان المتفوق تهذب وتلهم أولئك المحيطين به بحيث تصبح قيادته لهم امتدادًا لشخصيته الخاصة. ونقرأ النص التالي في كتاب "المقتطفات الأدبية":
قال المعلِّم [كونفوشيوس]: "السر في الحُكم هو الاستقامة [أي الـ"تي"]. استعملها؛ وسوف تصبح مثل النجم القطبي الذي يوجد دائمًا في مكانه المناسب، بينما تدور حوله النجوم الأخرى مهابةً وإجلالاً".([17])
وأضاف المعلِّم: "إذا استخدمت الحُكم [الحكومة] لتريهم الحق، والعقاب كي تبقيهم على جادة الطريق، فسوف يتحول الناس إلى مراوغين، ولن يكون لديهم أي إحساس بتأنيب الضمير. ولكن إذا استخدمت الاستقامة لتريهم الحق، والطقوس كي تبقيهم على الجادة، فسوف ينمو فيهم تأنيب الضمير، وسينظرون دائمًا بعمق في كل شيء".([18])
قال الحاكم "تشي كانج" وهو يسأل كونفوشيوس عن الحكم: "ماذا لو قتلتُ كل من يخرج عن الحق لكي أضمن أن كل الناس يتبعون الحق؟! هل يفلح ذلك؟"
فأجاب كونفوشيوس: "كيف يمكن أن تحكم عن طريق القتل؟ عليك فقط أن توجه قلبك صوب ما هو فاضل وخيِّر، وسوف يصبح الناس فاضلين وخيِّرين. فالنبلاء لديهم استقامة الرياح [الـ"تي"]، أما الصغار فلديهم استقامة العشب: فعندما تهب الرياح ينحني العشب".([19])
أراد المعلِّم أن يذهب ليعيش بين القبائل البرية التسع الموجودة في الشرق، فسأله أحدهم: "كيف ستتحمل كل تلك الفظاظة؟" فأجاب المعلِّم: "إذا عاش بينهم شخص نبيل، فكيف تكون الفظاظة مشكلة؟"([20])
الفكرة في هذه الفقرات هي أن الـ"تي" قوة في ذاتها، قوة تكفي للتحكم في سلوك الآخرين عندما تتبدى في حياة إنسان متفوق. فالإنسان المتفوق الذي يظهر الـ"تي" بشكل دائم لا توجد لديه أي مشكلة في حكم الناس في المجتمع، لأنه يلهمهم بالقدوة الحسنة إلى درجة أن الصفات الفاضلة تبدأ في الظهور بداخلهم نتيجة اقتدائهم به، فما يتمتع به من الفضيلة يجعلهم يشعرون بتأنيب الضمير بسبب سلوكياتهم غير الأخلاقية، وسيجدون أنفسهم رغمًا عنهم يتلمسون منه الهداية والفضيلة ويُصلحون من أساليبهم المتدنية دون أن يُضطر لإجبارهم على ذلك. وتنطلق هذه النظرية من قناعة كونفوشيوس بفكرة أن الطبيعة الإنسانية خيِّرة في الأصل، ولم يكن ذلك سذاجة من كونفوشيوس فيما يتعلق بالبشر وإمكانية وجود الشر بداخلهم، فقد كان يدرك ذلك بما يكفي، ولكنه مع ذلك ظل مقتنعًا بأن الطبيعة الخيِّرة للبشر يمكن غرسها بالممارسة الدؤوبة والمتأنية بفضل الصفات المتأصلة فيها والتي تجعلها متقبلة لهذا الغرس. كما أن هذا التقبل يعني أن الطبيعة الإنسانية تستجيب لمظاهر الخير الأخلاقي بإصلاح نفسها -حتى ولو بدرجة بسيطة- في اتجاه ذلك الخير الأخلاقي، تمامًا كما ينحني العشب أمام الرياح وتدور النجوم الصغيرة حول النجم القطبي. فهذه هي قوة الـ"تي".
ويؤكد كونفوشيوس باستمرار في كتاباته أنه بدون إسهام الأشخاص المتفوقين -الذين يجسدون القدوة في الفضيلة الأخلاقية والعقلية- ينحدر المجتمع إلى الفوضى ويسقط ضحية المادية العفنة والتقيد بالطقوس الجوفاء وضحالة التفكير والفساد الأخلاقي. هكذا كانت نظرة كونفوشيوس إلى المجتمع في عصره، وكانت تعاليمه موجهة لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة، فكان يرى أنه لا يمكن أن يوجد في المجتمع نظام عام أو تناغم لا يبدأ بالشخصية الداخلية لأفراد على خُلق يساهمون بفضيلتهم الأخلاقية في تعزيز المجتمع من خلال التقدم للقيادة والسيطرة. وعلى ذلك، تعد الكونفوشية نظرية سياسية بقدر ما تمثل أيضًا نظرية أخلاقية أو دينية، كما أنها تُعتبر نظرية إنسانية أو طبيعية تعطي أولوية للأفراد الذين يُلزمون أنفسهم بأن تُجسِّد شخصياتُهم أعلى درجة ممكنة من الإنجاز الإنساني أو قيمة الكمال الأخلاقي والعقلي.
ويطرح أفلاطون -مثل كونفوشيوس- نظرية في التنمية الأخلاقية والحكم السياسي في كتابه "الجمهورية" تتمركز حول وجود إنسان مثالي محب للحكمة أو "فيلسوف". وتُصوِّر محاورات أفلاطون أستاذَه سقراط كأكبر مثال لذلك الفيلسوف من كل الجوانب، وبالتالي فسقراط -كما يظهر في محاورات أفلاطون- يجسد المثالية الإنسانية، وهو يعلِّم هذه المثالية للشباب الذين يتجمعون حوله. فحياته وأفكاره ترشد تلاميذه، سواء من كانوا يجلسون معه في أثينا القديمة أو من يقرؤون محاورات أفلاطون اليوم.
وتبدو "الذات" (Persona) السقراطية واضحة المعالم في كل محاورات أفلاطون، ولكنها تبدو بشكل أكثر تأثيرًا في محاورات "الاعتذار" (Apology) و"كريتو" (Crito) و"فيدو" (Phaedo)؛ إذ يواجه سقراط المحلَّفين الأثينيين الذين اتهموه بالمروق وإفساد شباب المدينة وانتهوا إلى إدانته، ويستسلم لحكم الإعدام المفروض عليه. وفي السطور الأخيرة الشهيرة من "الفيدو" يشرب سقراط الشراب المسموم الذي قدمه له الحارس ويموت. وفي دفاعه عن نفسه أمام المحلفين ضد الاتهامات الموجهة إليه يُبرز سقراط رؤيته للحياة الإنسانية المثالية، فيبين أفضل أنواع الحياة التي يمكن أن يحياها الإنسان، ويدافع عن نفسه بأنه عاش محاوِلاً فهم تلك الحياة والوصول إليها من أجل نفسه ومن أجل الآخرين أيضًا، ويستمر في "الفيدو" و"الكريتو" في التوضيح وضربِ الأمثلة على هذه الحياة المثلى أثناء زيارات تلامذته له وهو يعيش أواخر أيامه في السجن.
والحكمة من أهم سمات الفيلسوف، كما يشرح سقراط وكما يظهر من الأمثلة التي ضربها؛ فكلمة "فيلسوف" كما هو معلوم تعني "مَن لديه حبَ الحكمة". إلا أن هذا المعنى تم شرحه بشكل متضارب إلى حد كبير في "الاعتذار"، إذ يقول: إن الفيلسوف يكون حكيمًا لأنه يقر بأنه يعرف القليل جدًّا أو لا يعرف شيئًا، فسقراط هو الإنسان الأكثر حكمة؛ لأنه -على عكس المعلمين والسفسطائيين في عصره- كان يدرك أنه ليس حكيمًا. فهذه هي الحكمة بالضبط: إدراك أوجه القصور في المعرفة الإنسانية، خصوصًا عندما تسقط عملية التعلم في براثن التكبر أو تبلد المشاعر، وتكون نتيجةُ هذا النوع الخاص من الحكمة حياة يعيشها المرء فقط لاكتساب المعرفة والبحث عنها أينما كان وكيفما أمكن. وباختصار، فقد عاش سقراط حياته وأراد الآخرين أن يعيشوا حياتهم في البحث عن الحقيقة، وذلك بالتفحص والاستقصاء الدائم لكل شيء مرة بعد مرة. وعلى ذلك، فالصورة التي يرسمها أفلاطون لمعلمه في كل المحاورات هي صورة رجل مستعد لأن يهجر كل شواغل الحياة في مقابل محاورةٍ واستقصاءٍ متعمّقَين عن طبيعة الأمور ذات القيمة، مثل الحب والجمال والخير والعدل، وغير ذلك. ولا يمل سقراط أبدًا من تلك المحاورات، حتى عندما يكون لديه ما يبدو أنه قناعات محسومة أو راسخة في هذه الأمور، فهو يرغب دائمًا في الاستفسار أكثر وإطالةِ الفحص والتحري واختبارِ كل شيء حتى الاستنتاجات الثابتة. ومن هذا النمط من الحياة جاءت إحدى أشهر مقولات سقراط: "الحياة التي ليس فيها استفسار عن كل شيء لا تستحق أن نحياها".([21])
كما يجسد سقراط خصائص أخرى للمثالية الإنسانية -أو للفيلسوف- ومنها الاهتمام بالروح أكثر من الجسد، والخوف من الشر أكثر من الخوف من الموت، والتحصن ضد آراء العوام. وهذه النقطة الأخيرة بالذات لها أهمية بالنسبة لموضوعنا هنا، إذ يخبر سقراط كريتو أنه ينبغي أن يعيش حياته طلبًا لرأي الخيِّرين والمطلعين فقط وليس جموع الناس، فالناس لديهم ما لا يعد ولا يحصى من الآراء حول كل شيء، ويميلون إلى التركيز على المكسب المادي العاجل على حساب الحقائق الأزلية، لذا ينبغي على كريتو أن يطلب الرأي والمشورة فقط من القلة الحكيمة. في كل هذه المقولات تقف قناعة أخلاقية عميقة بأن أفضل وأسمى حياة إنسانية هي حياة الفضيلة أو الرقي، وعلاوة على ذلك -كما يوضح سقراط في كتاب "الجمهورية"- فإن هؤلاء الأفراد الذين يمتلكون تلك الفضيلة ينبغي أن يتقدموا لتحمل مسؤولية الدولة، وإلا فإن الفوضى والطغيان هما النتيجة الحتمية.
وتمثل فكرةُ أن الحياة تستقيم عندما تسود الفضيلة موضوعًا ثابتًا في تعاليم سقراط، كما أنها الفكرة المركزية في كتاب "الجمهورية"، فهو يقول: إن "الجزء" الفاضل في أيِّ كيان يجب أن يحكم كل الأجزاء الأخرى حتى يوجد النظام والتناغم والخير في الكيان بكامله. وهذا صحيح على المستويين الفردي والجماعي؛ فحياة الأفراد تستقيم عندما يُحكَمون من خلال الجزء الأسمى والأفضل في أنفسهم، ألا وهو روحهم التي فُطرت على التوافق مع أسمى فضائل الخير والحق والعدل، وبالـمِثل يتحقق للمجتمع النظام والتناغم والعدل عندما يتولى أفراده الأفضلون والأسمَوْن حُكمَ بقية الأفراد، وهؤلاء الأفضلون والأسمَوْن هم الفلاسفة -الأفراد المهذبون أخلاقيًّا الذين تَحدّثْنا عنهم سابقا- الذين يصفهم سقراط لاحقًا بأنهم "الوصاة" على الدولة. ويعترف سقراط أن البعض قد يجد فكرةَ أن الفلاسفة ينبغي أن يصبحوا ملوكًا غير قابلة للتصديق، لكنه مع ذلك يصرّ عليها، فيقول لأحد الشباب الملازمين له، ويُدعَى جلاكون:
"ما لم يصبح الفلاسفة ملوكًا في بلادنا -أو ما لم يصبح الملوك والحكام الموجودون الآن فلاسفة حقيقيين- بحيث تتقارب السلطة السياسية مع الحنكة والفطنة الفلسفية، وما لم يُستبعد مِن تولي الحكم ذوو الطباع الدنية الذين يسعون وراء أحدهما دون الآخر، فأنا أومِن يا عزيزي جلاكون أنه لا يمكن أن تكون هناك نهاية للمتاعب في بلادنا أو في حياة البشرية كلها. عندئذ فقط، ستدب الحياة في نظريتنا وسترى النور -على الأقل- بقدر ما هو ممكن. الآن ترى لماذا امتنعتُ لفترة طويلة جدًّا عن التحدث علانية في هذا الاقتراح المثير للمتاعب؛ لأنه يعني حقيقة مؤلمة وهي أنه ليس هناك سبيل آخر لتحقيق السعادة، سواء في الحياة الخاصة أو العامة".([22])
وما يهم في هذه الفقرة هو وصف "ذوي الطباع الدنية" الذي أطلقه سقراط على من يطلبون إما السلطة السياسية أو الفطنة الفلسفية وحدها، وليس الجمع بينهما، ورأيه هنا هو أن الأُولى بدون الأخيرة تؤدي إلى الاستبداد والفساد، بينما الأخيرة بدون الأولى تؤدي إلى الضعف وعدم الفائدة. فمن يمتلكون السلطة السياسية ولكن ليست لديهم فطنة فلسفية حقيقية يستعينون بها، سيحكمون الدولة من منطلق السعي للمكسب الشخصي واستغلال السلطة. ومن يتمتعون بالفطنة الفلسفية ولكن ليست لديهم أي تطلعات لتطبيق معارفهم سياسيًّا سيهدرون طاقاتهم في نزوات وتفاهات فكرية ليس لها أي تطبيق مفيد. إذن، يجب أن يتم الجمع بين هذين المجالين، وأن يتولى الحكمَ الفلاسفة الحقيقيون.
والفلاسفة الحقيقيون -بالطبع- هم مَن وصَفناهم منذ قليل: أولئك الذين يهتمّون أكثر بالحقائق الأزلية وليس بالحقائق الزائلة، والذين يسعون نحو النور وليس نحو ظلمة الكهف، والذين يعيشون مثل أرواحهم الخالدة وليس كالحيوانات التي تأكل وتتناسل كما يُفضِّل معظم الناس. هؤلاء الأفراد وحدهم -الرجال والنساء الذين يعيشون معًا بلا أي اكتراث للثروة الشخصية حتى على مستوى الحياة العائلية- يمكنهم أن يوجهوا دفة الدولة بحيث يسود الخير والنظام والحق في كل شؤونها.(*[23]) وهؤلاء الفلاسفة الحقيقيون يبحثون عن الحقيقة قبل أي شيء آخر، ويبحثون عنها كي يعيشوا بها سواء بشكل فردي أو جماعي، ولا توجد إمكانية لوجود تناغم اجتماعي وسياسي خارج نطاق حكمهم.
ويَعترف سقراط بأن جمهوريته المثالية قد لا تتحقق بالكامل على أرض الواقع، لكنه مع ذلك يصرّ على أن من يعنيهم أمر الْمجتمع يجب أن يحاولوا الوصول إليها قدر المستطاع، وإلا فسيبقى الاستبداد والفوضى هما الخيارين الأخيرين للمجتمع. وقد أدرك كلٌّ من كونْفوشْيوس وسقراط بوضوح في حياتهما أنه إلى أي مدى يمكن أن ينحدر المجتمع عندما يسيطر مَن لا يهتمون بالخير أو الحق على مقاليد السلطة. وما تزال احتمالات الفوضى تلك قائمة منذ العصور القديمة حتى يومنا هذا. لذا يأتي كولن اليوم ليطرح رؤية لتوجيه المجتمع وإرشاده تُشابه كثيرًا رؤية نظيريه القديمين، فهو يتفق مع كونفوشيوس وسقراط بأن أمل المجتمع يكمن فقط في تأثير "الأفراد المثاليين".
وتتوازى أفكار كولن عن العالم الإسلامي، وخصوصًا تاريخ الأناضول ومصيره، مع خواطر كونفوشيوس عن الصين القديمة، فكِلا الرجلين يشير إلى فترة ماضية من العظمة الضائعة التي يجب استعادتها الآن. يشير كونفوشيوس بشكل متكرر إلى الحكام والأباطرة القدماء وغيرهم من الأجيال السابقة كأمثلة للنبل والحكمة اللذين كان ينبغي -وقتها- استلهامهما لو كانت الصين ترغب في استعادة مجدها السابق وتجنب التشرذم والطغيان. وكولن أيضًا يتأمل في الماضي المجيد للإمبراطورية العثمانية، يوم كانت الحضارة التركية في أوجها، وكان الإسلام كدين وثقافة يسود العالم سيادة مطلقة. وهو يرى أن عظمة العثمانيين الحقيقية كانت تكمن في التزامهم بالمُثل العليا التي تهدف إلى خير المجتمع في حاضره ومستقبله، وأيضًا في جوهرهم الإسلامي الذي جعلهم يقتدون بالخلفاء الأربعة الراشدين، الذين جاؤوا في أعقاب وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويرى أيضًا أن شخصيات بارزة مثل الفراعنة وقَيصر ونابلْيون، وإن كانت تصرّفاتهم تسيء إلى سمعتهم، فإن أعمالهم لم تكن ذات طبيعة استمرارية؛ لأن الدافع في أعماقهم لم يكن المثل العليا من أجل الإنسانية ومستقبلها، بل الطموح الشخصي والطمع وشهوة القوة. يقول كولن عنهم: "إن الأبهة والحياة الصاخبة لفرعون ونمرود ونابليون وقيصر وأمثالهم والتي فَتنت الكثيرين من الأغرار لم تكن -ولن تكون- واعدة ومبشرة للمستقبل بأي حال من الأحوال؛ لأنهم أناس تعساء وضعوا الحق تحت إمرة القوة، وبحثوا عن الروابط الاجتماعية في محيط المصالح والمنافع الشخصية، وعاشوا حياتهم عبيدًا لا يتوقون إلى التحرر من الأحقاد والأنانية والشهوانية".([24])
فغياب المثُل العليا والقيم المطلقة من أجل الحاضر والمستقبل هو ما منع أعمال تلك الشخصيات التاريخية من إحداث أي تأثير إيجابي متجدد. لكن هذا في رأي كولن لم يكن ينطبق على الخلفاء الراشدين أو على العثمانيين، فيقول: "في المقابل، قدم الخلفاء الراشدون ومِن بعدِهم العثمانيون أعمالاً جليلة تجاوزت آثارُها هذا العالم إلى العالم الآخر، وكانت من العظمة بحيث إنها صمدت أمام السنين والقرون، طبعًا في نظر مَن لا ينخدع بفترات الخسوف المؤقَّتة. ورغم أنهم عاشوا عمرًا زاخرًا وأكملوا رسالتهم في الحياة ثم رحلوا، ولكنهم لن يغادروا الصدور التي يَحيون فيها بذكرى مآثرهم الجميلة. فما زالت أرجاء بلادنا تعبق بروح ومعاني "آلبْ أرْسلاَن" و"ملِك شاه" و"الغَازي عُثمان" و"محمّد الفاتح" وغيرهم كثيرين، كأريج البخور، فيبعث طيفهم الآمالَ والبشرى داخل أرواحنا".([25])
وهناك فارق نوعي بالنسبة إلى كولن بين شخصيات مثل قيصر ونابليون والفراعنة من ناحيةٍ، والفاتح وسُلَيمان القانوني والْخلفاء الراشدين وغيرهم من الناحية الأخرى. هذا الفارق يكمن في تجسيد كلٍّ منهم -أو خضوعه- للمثل العليا من خير وحق وأخلاق وعدل، فهذه المثل العليا هي الأساس الشرعي الوحيد لأي برنامج اجتماعي أو سياسي أو ثقافي يحقق نتائج إيجابية لحاضره ومستقبله. ويرى كولن أن هناك مطالبات بإحياء تلك المثل في تركيا المعاصرة، مع ظهور جيل جديد ملتزم بالمثل العليا، فيقول: "هناك الآن -وفي الطريق أيضًا- أعداد هائلة من حملة العلم والمعرفة والفن والأخلاق والفضيلة هم ورثة القيم التي قام عليها تاريخنا المجيد".([26])
وقد ركّز كولن في مختلف أعماله على وصف البشر المثاليين في تصوره، ولكنه لم يكن أكثر بلاغة في الوصف مما كان في كتابه (ونحن نقيم صرح الروح)، حيث استعمل فيه مصطلح "الإنسان المثالي" أو "ورثة الأرض" للإشارة إلى الأشخاص الفاضلين عقليًّا وأخلاقيًّا الذين يجسّدون الإنسانية الحقة، وبالتالي يجب أن يقودوا المجتمع حتى يكون مجتمعًا صالِحًا. والفكرة هنا -كما يطرحها كولن- تتلخص في مجموعة من الأشخاص يجسدون ثقافة روحية ويكتسبون مكانة بارزة في الحياة الدنيوية بسبب صلاحهم وورَعهم، وهذه المكانة تظل هبة وتكليفًا لهم من الله، حتى إذا فقدوا استحقاقهم لها نزَعها الله منهم. ويستشهد كولن بآية من القرآن الكريم تشير إلى نصّ من التوراة، يقول الله تعالى في هذه الآية: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾(الأنبياء:105).([27]) ويعلّق كولن قائلاً: "ولا ينبغي أن يتردد امرؤ في توقع مجيء هذا اليوم، وهو وعد الله المؤكّد. ولن تنحصر هذه الوراثـة بالأرض وحدها... ذلك، بأن مَن يـرث الأرض ويحكمها، يحكم أعماق الفضاء والسماء أيضًا. إذن هي حاكمية في الكون كذلك. ولما كانت هذه الحاكمية بالنيابة والخلافة، فحيازة خصال التمثيل التي يريدها صاحبُ السموات والأرض الحق، لازمة وضرورية. بل يصحّ القول: إنما تتحقق تلك الرؤيا، وذلك الرجاء، بقدر إدراك هذه الخصال وتمثُّلها".([28])
ويواصل كولن فيوضّح أن الحضارة الإسلامية في العصور الماضية كانت تحمل لقب "وراثة الأرض"، لكنها فقدت تلك المكانة بسبب الإخفاقات الداخلية -في عالم القلب والروح-، والخارجية -في عالم العلم الحديث-، وضلّت المجتمعات الإسلامية طريقها روحيًّا وعقليًّا؛ ومن ثَم فَقدت مكانتها كـ"وارثة للأرض"، لتأخذها منها كيانات أخرى في الغرب. ويكرر كولن المناداة باستمرار في هذا الكتاب إلى إحياء الإسلام بمعانيه الروحية والعقلية لكي يعيد نفسه إلى نفسه، حتى تدخل الإنسانية كلها والأرض نفسها في عصر جديد مجيد من التسامح والسلام. ومن خلال مجموعة من الأفراد المتّسمين بالفضيلة والورع، يمكن أن يعود الإسلام وكذلك تركيا -كما يأمل كولن- إلى موقع عالمي بارز لقيادة العالم إلى ذلك العصر الجديد.
ومن الجدير بالذكر أن كولن في كتابه هذا لم يناد بأي نوع من النشاط السياسي أو الحكومي للوصول إلى هذا العصر الجديد. فكولن ليس رجل سياسة كما أنه ليس منظِّرًا سياسيًا، ولم يناد بجيل جديد من القادة السياسيين على عكس كونفوشيوس وأفلاطون. وهذا فارق جوهري بين كولن وزميلَيه في المحاورة الثلاثية التي نجريها في هذا الفصل وفي الفصل القادم. فأفكار كولن -التي تعتبر تكرارًا لمثل إسلامية أكبر- لا تعتمد على قوة الحكومة من أجل تطبيقها، بل على العكس، يركّز كولن على إعادة تكوين فهم ثقافي وفكري وإنساني ينبع من أناس عاديين ذوي فضل وفضيلة يعيشون حياتهم في سبيل رسالتهم الْمهنيّة والمجتمعية والأسرية. و"السيادة" التي يشير إليها كولن هنا ليست سيادة نخبة من القادة السياسيين على الآخرين، بل هي سيادة وغلبة رؤية حياتية تتّسم بالسلم والعلم والروحانية والتسامح والمحبة، كما أن هذه الرؤية الحياتية تسود نتيجة للأعداد الهائلة من الناس الذين يُثبتون أهليّتهم كورثة للأرض، من خلال ما يتمتعون به من فضيلة وأهلية للخلافة.
ويخصص كولن فصلاً كاملاً من كتاب (ونحن نقيم صرح الروح) لاستعراض صفات ورثة الأرض، وقد تضمن هذا الاستعراض أبلغ تأكيد من كولن على الإنسان المثالي كما يتصورها من منظور إسلامي. فحدد ثماني صفات أساسية لورثة الأرض،([29]) أو كما يسمّيهم في موضع آخر "الإنسان المثالي"، وهذه الصفات هي: الإيمان الكامل، والمحبّة، والتفكير العلمي المستنير بالرؤية الإسلامية، وتقويم الذات، ونقد الرؤى والتصورات الشخصية، والتفكير الحر واحترام حرية الفكر، والضمير الاجتماعي وتفضيل القرار المبني على الشورى، والتفكيرُ المنطقي، والتذوق الفني.
وتبدو هذه القائمة ظاهريًّا مختلفةً تمامًا عن قائمة كونفوشيوس لفضائل الإنسان المتفوق أو عن الفضائل التي وضعها سقْراط، ولكن بإمعان النظر نجد خطوطًا متوازية بين الثلاثة. فالإيمان والمحبّة الكاملان يوجدان في الشخص المثالي عند كولن من منطلق إسلامي نابع من إسلام الوجه لله، أي إن الإيمان والمحبة يأتيان هنا ضمن ذلك الإطار الأوسع للمرجعية الدائمة التي هي الاستسلام والخضوع لله. وذلك الإيمان وتلك المحبة لن ينـزلقا إلى استهداف أشياء مادية أو دنيوية تقود الحضارة إلى طريق المادية والشهوانية، بل يضعان صوب أعينهما دومًا الحقائقَ الأزلية، تمامًا كما يفعل الوصاة الذين تَحدَّث عنهم سقراط.
والتفكير العلمي والمنطقي لورثة الأرض عند كولن يعبر عن وجهة نظر مبنية على القناعة بأن الحقيقة واحدة وأنها لا تتمايز إلى ضروب متباينة من الحقيقة الدينية في مقابل الحقائق العلمية، أو حقائق الإيمان في مقابل حقائق العقل. فالحقيقة بالنسبة لورثة الأرض لا تتجزأ، وهم يسعون لفهم الحقيقة كلها بقوة العلم والرياضيات، ويتحمسون لتعزيز الفهم العلمي للكون كـ"كتاب مقدس" شديد التعقيد من صنع الخالق سبحانه. وهم يشتركون مع أفراد كونفوشيوس المتفوقين في أنهم يبرعون في العديد من مجالات المعرفة وليس في المعرفة "الدينية" فحسب. فورثة الأرض يتصرفون في أمور الحكم وصناعة القرار من منطلق مصلحة المجتمع وليس مجرد المصلحة الشخصية، ويقدرون قيمة الشورى والحوار كأفضل طريق لاتخاذ القرارات الصائبة. وهم يشبهون طبقة الوصاة عند سقراط في أنهم يخضعون أنفسهم للتحليل والاستقصاء فيما بينهم من أجل الخروج بإجماع يصلح للجميع. وهم يجتمعون مع وصاة سقراط وأفراد كونفوشيوس المتفوقين في أنهم يقسون على أنفسهم، ويُلزمون أنفسهم بالتدقيق المستمر والبحث في مدى صحة أفكارهم ورؤاهم الخاصة من أجل تنقية وتنقيح أنفسهم وأفكارهم في سبيل إشباع تعطشهم الدائم للحقيقة والفضيلة. وأخيرًا، فورثة الأرض -مثل الأفراد المتفوقين والوصاة- يتذوقون الجمال أينما وجد، ويدركون أن حرية ممارسة التفكير والابتكار وحدها يمكن أن تجعل الأرواح المتسامية تخلق رؤى جديدة للعالم وللإنسانية، سواء في علم الجمال أم الفلسفة أم الحكم أم أي مجال آخر.
الفارق الجوهري بين ورثة الأرض عند كولن والأفراد المتفوقين عند أفلاطون أو الوصاة عند سقراط، هو أن ورثة الأرض مسلمون يستمدون وجودهم كله ورؤيتهم للعالم من منظور إسلامي، وما يحول دون تحول حكم ورثة الأرض المسلمين إلى استبداد وقمع هو بالضبط ما يحول دون استبداد حكم وصاة سقراط أو أفراد كونفوشيوس المتفوقين، ألا وهو الحرص على صالح المجتمع والاعتراف المطلق بالقيمة المتأصلة لكل البشر نتيجة شبههم بالإله (كما ذكرنا في الفصل الأول). ويصف كولن ورثة الأرض بإسهاب فيقول: "تلك الشخصية تهرول من نصر إلى نصر، ولكن ليس لتخريب البلاد وإقامة العروش على أطلالها، بل لتحريك المشاعر وتنشيط الملكات الإنسانية، وتقويتنا بأحاسيس الحب والرعاية والمروءة التي تجعلنا نحتضن الناس كلهم والأشياء جميعا، ولإعمار الأرجاء المنهدمة، ونفخِ الحياة في الأوصال الميتة، لتتحول إلى حياة ودم يسري في عروق الوجود، وإشعارِنا جميعا بالأذواق الرحيبة لغاية الوجود. هذا الإنسان بطبعه رباني في كل أحواله وبكل ذاته... وهو في مناسبة دائمة مع الوجود باعتباره خليفة الله. وحركاتُه وأفعاله كلها مراقَبة... فلا يقوم بعمل إلاّ بحسِّ مَن يعرضه على التفتيش... حتى يكون الله سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به... ويكون أسلوبه مترشحا من تأثير بيانه تعالى... ويكون تحت إرادته تعالى "كالميّت في يد الغسال". وإن إحساسه بعجزه وفقره أمام الله تعالى هو أعظم مصدر للقوة والغنى... فلا يني ولا يفتر من الاستمداد بأحسن وجه من مَعين هذه الخزينة التي لا تنضب ولا تنفد".([30])
وكما نرى، فورثة الأرض الذين يقدمهم كولن ليسوا غزاة باسم الله أو الإسلام، وليسوا مجاهدين يشنون حربًا ضد الكفار، بل هم أناس بلغوا منتهى الفضيلة والخير والمحبة وهَبوا أنفسهم للمُثل العليا، ويسعون لإيجاد عالم يتمكن فيه جميع الناس من بلوغ أقصى إمكانيتهم البشرية في كل مجالات الحياة، من أكثرها دنيوية إلى أكثرها سموا وعلوًّا، ويقدِّم فيه أفراد المجتمع أنفسهم مثالاً ملهمًا لتلك الإنسانية المتحققة بشكل كامل.
وهؤلاء الأفراد ذوو المثل العليا يمثلون ركنًا أساسيًا في أي مجتمع حي وصالح ومستمر. وبدونهم تضيع المثل، كما يضيع من يمثلونها، وينخرس تراث المجتمع في أحسن الأحوال، ويكون الخير الذي يبدو أنه يحققه هشًّا سريع الذوبان. يقول كولن: "إذا كان المسؤولون الذين يديرون شؤون دولة فاضلة يتم انتخابهم حسب أصالة نفوسهم ومُثلهم العليا وأصالة مشاعرهم، فإن تلك الدولة دولة قوية وعلى أساس متين. أما الحكومة النكدة الحظ فهي الحكومة التي يُحرَم موظفوها من مثل هذه الخصال الحميدة، ولن يكون عمرها طويلاً؛ لأن تصرف هؤلاء الموظفين المفتقرين إلى السجايا الحميدة سينعكس عليها ويكون -عاجلا أو آجلا- لطخة سوداء على جبينها وتفقد مصداقيتها عند جماهير شعبها"([31]).. "إن سيادة القوة مصيرها إلى زوال، أما سيادة الحق والعدل فباقِية أبد الدهر، وحتى لو لم يكونا غالبين اليوم، فسوف ينتصران عن قريب. ولهذا السبب، ينبغي البحث عن السياسة الكبرى في الانحياز إلى جانب الحق والعدل".([32])
إن كولن -كزميليه في المحاورة- يصرّ على أن خير المجتمع يتوقف بشكل مباشر على خير مَن يحكمونه. كما أن هؤلاء الحكام وغيرهم من أفراد المجتمع الذين يجسدون هذه الصفات يضحون بكل طموح شخصي من أجل خير الكل، ويهبون أنفسهم تمامًا لخدمة البشرية، ولا يتوقفون أبدًا عن التفكير في المستقبل. وهم يحيطون أنفسهم بمجموعة من القيم الروحية المطلقة، ويقيسون قيمة كل المكاسب العلمية والتقنية في ضوء تلك القيم. يقول كولن عنهم: "الإنسان الجديد، هو إنسان يتألم ويئن، يموت ويحيا من أجل إحياء الحق وإنهاضه. فهو دائما على أهبة الاستعداد للتخلي عن المال والولد والغالي والنفيس، ولن تكون سعادته الشخصية بُغيتَه أو همه أبدا، بل هَمُّه الوحيد ألا يضيع بذرة واحدة من البذور الصالحة التي منحها له الحق تعالى، بل ينثرها كلها بدقة فائقة على سفوح العناية الربانية من أجل مستقبل الأمة القريب والبعيد... ثم يرتقب مُكابِدا آلامَ مخاض جديد، يتلوى ويتأوه ويئن ويقلق، ويبتهل إلى المولى في أمل، يموت ويحيا في اليوم ألف مرة ومرة. فالسير في سبيل الحق والفناء فيه غايته الوحيدة في الحياة، وانفلات هذه الغاية من بين يديه -في نظره- خسارة لا تعوض أبدا. (...) الإنسان الجديد، هو إنسان عميق من حيث جذوره الروحية، متعدد من حيث ما يملكه من كفاءات صالحة للحياة التي يعيش في أحضانها. إنه صاحب القول الفصل في كل الميادين بدءا من العلم إلى الفن ومن التكنولوجيا إلى الميتافيزيقيا، وصاحب خبرة ومراس في كل ما يخص الإنسان والحياة. أجل، إنه عاشق لا ينطفئ ظمؤه إلى العلوم مهما نهل، مولع بالمعرفة ولعًا لا يفتأ يتجدد كل حين، عميق بأبعاده اللدنية التي تعجز العقول عن تصورها.. وهو بهذه الخصال كلها يسير جنبا إلى جنب مع سعداء عصر السعادة وينافس الروحانيين في سباق معراجي جديد كل يوم".([33])
يصف كولن المثاليين هنا بأنهم أناس يهربون من الإغراءات الدائمة التي ذكرها سقراط في كتاب "الجمهورية"، أي إغراءات التعلق بالمتع الدنيوية والثروة وسبل الراحة الشخصية. فالمثاليون عند كولن -كما الوصاة عند سقراط- لا يستسلمون لتلك الإغراءات؛ لأنهم جُبلوا على السعي الدائم لنيل المتع والحقائق الأبدية على حساب ما هو وقتي وزائل. وهم -كالوصاة أيضًا- لا يرضون أبدًا عن أنفسهم وعن معرفتهم، بل يتحركون دائمًا إلى الأمام، توّاقين إلى آفاق أرحب من المعرفة والفضيلة والخير والحقيقة. ويرى كولن أنه عندما يتشكل المجتمع التركي -والمجتمعات كلها- من أمثال هؤلاء الأفراد أو يتأثر بهم، عندها فقط ستتحول الحضارة الإنسانية إلى الحياة والحيوية والعافية بدلاً من السير نحو الموت والتحلل.
ونكرر هنا أن رؤية كولن للقيادة رؤية واسعة بعيدة كل البعد عن الجانب السياسي؛ فمحاضراته وكتاباته لا تحوي بين طياتها نظام حكم أو نظرية سياسية معينة كما هو الحال مع مذهب كونفوشيوس وأفكار أفلاطون التي ذكرها في "الجمهورية". فكُولَن داعية وعالِم دين إسلامي وليس عالِمًا أو ناشطًا سياسيًّا، وهو لا يدعو مستمعيه إلى الترشح للمناصب أو السيطرة على مقاليد الحكم، ولا يدعو إلى حل نظم الحكم القائمة. صحيح أن رؤيته للمجتمع تتضمن بالتأكيد أناسًا مثاليين يحتلون مواقع سلطة في الحكومة، إلا أنه في الغالب لا يتكلم بتلك النظرة الضيقة أو المحدودة، بل يتكلم عن قيادة مجتمعية منتشرة في أنحاء المجتمع في مختلف المهن والتخصصات؛ إذ إن ذوي المثل العليا سيسهمون في تشكيل المجتمع بأن يهب كلٌّ منهم نفسه لرسالته التي يؤديها كعالم أو كمعلم أو كرجل أعمال أو كموظف في جهة خدمية أو كوالد أو كموظف عام أو كعامل أو غير ذلك. فالصورة بالأساس هي صورة لقاعدة عريضة من الناس تختار -من خلال العملية الديمقراطية- من يجسدون المثل الفاضلة كي يتولوا خدمة الدولة وتوجيهها. غير أن النتيجة النهائية هي نفسها بالنسبة لكلٍّ مِن كونفوشيوس وأفلاطون وكولن، ألا وهي إيجاد مجتمع صالح ومستقر؛ صار كذلك لأنه يُدار بواسطة أناس يجسدون في أنفسهم أسمى المثل الإنسانية العليا للخير والفضيلة.
إذن، فقد بلْور لنا الفلاسفة الثلاثة المشاركون في المحاورة -في ضوء الرؤية الخاصة بكلٍّ منهم وعصره- سمة أساسية لما هو مطلوب من أجل حياة إنسانية صالحة على المستويين الفردي والجمعي، هذه السمة الأساسية هي الفضيلة: العقلية والأخلاقية. فالناس سيبلغون أقصى -ومن ثم أسعد- ما في الحياة الإنسانية عندما يضعون نصب أعينهم أن يقيموا من أنفسهم أناسًا ذوي فضيلة عقلية وأخلاقية. والمجتمع ككل يبلغ أقصى وأفضل تنمية عندما يوجهه أولئك الأفراد ذوو الفضيلة العقلية والأخلاقية العالية، الذين يُعتبرون الأقدر على رؤية ما فيه الخير للجميع، وليس خير القلة المتميزة أو خير أنفسهم فقط. هؤلاء الناس ذوو الفضيلة سيوجهون المجتمع بحيث يمتلك أفراده فرصًا هائلة لتنمية أنفسهم لبلوغ أقصى ما في إمكانهم من الإمكانات البشرية.
والسؤال الآن هو: مِن أين نأتي بهؤلاء الأفراد ذوي الفضيلة؟ أين نجد تلك الشخصيات القيادية البارزة التي سترشد وجودنا الاجتماعي والجمعي نحو الخير والحق والعدل؟ هل ينـزل هؤلاء الناس علينا من السماء ومعهم عصا سحْرية للحكم؟ أهم كائنات ملائكية تمشي بيننا؟ كلا؛ فهؤلاء الناس هم بشر مثلنا لهم أب وأم وليسوا ملائكة، ويجب أن يتربّوا ويتعلموا لكي يصبحوا نماذج الفضيلة التي يحتاجها المجتمع للتقدم والازدهار. وقد اتفق الفلاسفة الثلاثة على أن التعليم هو الوسيلة التي بها ننمي من بيننا كمجتمع هؤلاء الأفراد ذوي الفضيلة، لذا سنستعرض نظريات التربية والتعليم الخاصة بكلٍّ منهم في الفصل القادم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] Confucius, The Analects, 146. (كونفوشيوس، المقتطفات الأدبية)
[2] المصدر السابق، ص 132.
[3] المصدر السابق، ص 176.
[4] المصدر السابق، ص 188-189.
[5] المصدر السابق، ص 189.
[6] Plato, The Republic, 277–8.( أفلاطون، الجمهورية)
[7] المصدر السابق، ص 209-211.
[8] المصدر السابق، ص 212.
[9] Gülen, The Statue of Our Souls, 5ff. (كولن، ونحن نقيم صرح الروح).
[10] المصدر السابق، ص 125-126.
[11] Gülen, Toward a Global Civilization of Love and Tolerance, 128–30. (كولن، نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح)
[12] Gülen, The Statue of Our Souls, 135. (كولن، ونحن نقيم صرح الروح).
[13] المصدر السابق، ص 135-136.
[14] Gülen, Toward a Global Civilization of Love and Tolerance, 113. (كولن، نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح)
[15] Thompson, Chinese Religion, 13. (تومبسون، الدين في الصين).
[16] Confucius, The Analects, 127. (كونفوشيوس، المقتطفات الأدبية).
[17] المصدر السابق، ص 11.
[18] المصدر السابق.
[19] المصدر السابق.
[20] المصدر السابق، ص 95.
[21] Plato, The Republic, 41. (أفلاطون، الجمهورية).
[22] المصدر السابق، ص 165.
[23](*) يؤكد سقراط في موضع آخر من "الجمهورية" أنه بالإضافة إلى كون هؤلاء الأوصياء فلاسفة، فإنه يمكن أن يكونوا ذكورًا أو إناثًا، وأنه لا ينبغي أن تكون لهم ملكية شخصية بل تكون الملكية مشتركة بينهم جميعًا، بما في ذلك الأطفال.
[24] Gülen, The Statue of Our Souls, 124. (كولن، ونحن نقيم صرح الروح)
[25] المصدر السابق.
[26] المصدر السابق، ص 119.
[27] المصدر السابق، ص 5.
[28] المصدر السابق.
[29] المصدر السابق، ص 31-42.
[30] المصدر السابق، ص 89.
[31] كولن، الموازين أو أضواء على الطريق، ص 71-72. Gülen, Pearls of Wisdom.
[32] المصدر السابق، ص 73.
[33] Gülen, Toward a Global Civilization of Love and Tolerance, 82. (كولن، نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح)
الفصل الرابع: التعليم بين كولن وكونفوشيوس وأفلاطون
انتهى الفصل الأخير بسؤال عن أصل "الأفراد المتفوقين" أو "الملوك الفلاسفة" أو "ورثة الأرض"، وهي التسميات التي استخدمها كل من كونفوشيوس وأفلاطون وكولن على الترتيب لوصف تصوراتهم عن الإنسان المثالي الذي ينبغي أن يقود المجتمع أو يؤثر فيه إذا أريد له أن يكون مجتمعًا صالحًا وعادلاً. ولكن أين هم هؤلاء الناس؟ كيف نصل إليهم؟ أين نجدهم؟ بالطبع الجواب واضح إن لم يكن مطمئنًا: إننا هم، أو ينبغي أن نكون هم. إن هدف هذه الفلسفات الثلاث كلها هو أن يجسد الناس جميعًا المثالية الإنسانية في أنفسهم قدر الإمكان، إلا أن عبارة "قدر الإمكان" تعني التسليم بأن الكثير من الناس -بل ربما أغلبهم- لن يصلوا إلى هذا المستوى العالي للإمكانيات الإنسانية. فكما رأينا في بداية الفصل السابق، أشار كل من كونفوشيوس وأفلاطون وكولن بوضوح إلى الفارق بين الأعمى والبصير، بين جموع العامة الذين يتوقفون عند الحقائق الدنيوية والقلة التي تسعى وراء ما هو أكثر سموًا وارتقاءً. وعليه، فرغم أن الجميع لديهم إمكانية أن يصبحوا أفرادًا مثاليين بفضل طبيعتهم البشرية المتأصلة، فإن أكثرهم لن يفعلوا أو على الأكثر سيصبحون كذلك بشكل جزئي أو تدريجي.
وبالنسبة لمن يحققون "الإنسان المثالي"، يبقى السؤال: كيف فعلوا ذلك؟ ما هي السبل أو الآليات التي وضعتهم في موقف مكنهم من تهذيب أنفسهم إلى هذه الدرجة؟ تأتي الإجابة واحدة من الفلاسفة الثلاثة المشاركين في المحاورة: عن طريق التعليم. فالتعليم هو القاعدة العامة التي ترتكز عليها أيّ جهد لتحقيق الإنسانية الكاملة أو المثالية. ويقدِّم كلٌّ من كونفوشيوس وأفلاطون وكولن نظريات محددة في التعليم كجزء من الرؤية الحياتية لكلٍّ منهم، إلى درجة أنهم يقولون: إنه من دون العنصر التعليمي فإن صرح النظام بأكمله سينهار، بل والأكثر من ذلك أن كلاً منهم يحدد نوعًا معينًا من التعليم هو الذي سيحقق أقصى إمكانية للحصول على نوعية التهذيب للشخصية الإنسانية التي يسعى إليها كلٌّ منهم. باختصار، يتفق كونفوشيوس وأفلاطون وكولن على أن التعليم القوي والموجه هو حجر الزاوية في تنمية الإنسان المثالي الأرقى، ومن ثم يجب صياغة الأطر الاجتماعية في الأساس حول آليات ذلك التعليم حتى يتمكن المجتمع من تكوينِ أعلى وأفضل زعمائه من داخله هو.
وكما رأينا في الفصل السابق، تُعتبر الكونفوشية نظرية اجتماعية سياسية بقدر ما هي فلسفة دينية أو أكثر من كونها فلسفة دينية. وفي سياق إبرازه للفارق بين عامة الناس من ناحية و"الإنسان المتفوق" أو "النبيل" من ناحية أخرى، يطرح كونفوشيوس رؤيته بأن ذلك التناغم في الحياة الاجتماعية والسياسية الإنسانية يحصل عندما يتولى الأفراد المتفوقون الحكم. ومنذ ذلك الطرح عاشت الكونفوشية في الصين عبر القرون كنظرية فلسفية للتنمية الاجتماعية والسياسية تُعلم الناس وتؤهلهم لتَولي مختلف مستويات العمل الحكومي وصولاً إلى كبار مستشاري الإمبراطور. إلا أن كونفوشيوس كان مهتمًا بالناس ككل وبالمجتمع ككل، وليس بالحكام المنتظَرين فحسب. ويبين ديفيد هينتون (David Hinton) في مقدمة ترجمته لكتاب "المقتطفات الأدبية" أن الطقوس بالنسبة إلى كونفوشيوس تتضمن ما هو أكثر بكثير من مجرد الحديث بأدب إلى الأكبر سنًا أو ارتداء اللون المناسب أثناء موسم العيد، إذ تشمل أيضًا اتخاذ الوضع الملائم داخل شبكة العلاقات الاجتماعية التي تغطي الحياة الإنسانية كلها، مثل العلاقات مع الوالدين، والأشقاء، والأقارب الأكبر سنًا، والسلطات الإمبراطورية، والنصوص التاريخية القيمة، وغير ذلك. إذن فحياة الـ"لي" (li) -أو مواءمة الطقوس والشعائر- بهذا المعنى تتضمن مجموعة واسعة من مبادئ المساواة التي اهتم بها كونفوشيوس كثيرًا، مبادئ مثل العدالة الاجتماعية والحكم وفقًا لما هو خير للمجتمع (وليس للحاكم فقط)، والدور الذي يلعبه المفكرون في توجيه المجتمع ومحاسبة حكامه. يقول هينتون:
"بالنسبة لكونفوشيوس، يتوقف مجتمع الطقوس على عناصر المساواة هذه، والتي تتوقف في النهاية على تعليم أفراد المجتمع وتهذيبهم. ويعتبر تقليلاً من شأن كونفوشيوس إذا وصفنا إسهاماته في هذا الجانب بالتاريخية، فقد كان أول معلم مهني حقيقي في الصين، حيث أسس لفكرة التعليم الأخلاقي العام، كما وضع النصوص الكلاسيكية التي حددت المحتوى اللازم لذلك التعليم، ولم يكتف بهذا بل وضع المبدأ الخالد للمساواة في التعليم، وأن كل الناس يجب أن يتلقوا شكلاً ما من التعليم؛ لأن هذا ضروري لصحة المجتمع الذي يتمتع بالأخلاق. وقد ركز انتباهه على تعليم المفكرين، فأعطاه أهمية أكبر بكثير من تعليم العامة، ولكنه ظل يؤمن بأنه حتى هذا التعليم يجب أن يتوافر لأي فرد يسعى إليه، مهما تواضع أصله ومنشأه، ذلك أن السيد/ المعلِّم [كونفوشيوس] نفسه لم يكن وحده من خلفية متواضعة نسبيًا، بل إن كل حوارييه كانوا كذلك أيضًا".([1])
فاهتمام كونفوشيوس بالتعليم هو في الحقيقة اهتمام بالإنسان، بالبشر في ذاتهم وفي مجتمعهم، بالروح الإنسانية (Humaneness) التي هي أهم فضيلة أخلاقية تحدد معنى أن يكون الإنسان إنسانًا وترسخ مجتمعًا مستقرًا وصالحًا. وبدون هذا التطور المهم لن يَصلح المجتمع، لأن الناس الذين يتكون منهم ذلك المجتمع لا يتصرفون بالمستوى الذي يُعتبر "إنسانيًا".
ويشير المتابعون من داخل التراث الصيني وخارجه عادةً إلى أفراد كونفوشيوس المتفوقين باعتبارهم "علماء" (Scholars)، وذلك بسبب النظام التعليمي والتربوي الصارم الذي كان يتعين عليهم إتقانه للوصول إلى أي رتبة في وظائف الخدمة المدنية. هذا إلى جانب أن كونفوشيوس كان يَعتبر التعليم شيئًا محوريًا بالنسبة للفضيلة، حيث يقول في كتابه "المقتطفات الأدبية":
سأل المعلِّم [كونفوشيوس]: "هل سمعت بالإدراكات الست وضلالاتها الست؟" أجاب الخبير ليو: "لا". قال المعلِّم: "إذن اجلس وسأخبرك. أن تحب الإنسانية دون أن تحب التعلم، وهذا هو ضلال الحماقة. وأن تحب الحكمة دون أن تحب التعلم، وهذا هو ضلال التسلية. وأن تحب الإخلاص دون أن تحب التعلم، وهذا هو ضلال الذريعة. وأن تحب الحق دون أن تحب التعلم، وهذا هو ضلال التعصب. وأن تحب الشجاعة دون أن تحب التعلم، وهذا هو ضلال الفوضى. وأن تحب قوة العزيمة دون أن تحب التعلم وهذا هو ضلال التهور".([2])
هنا، يوضح كونفوشيوس أن الكفاح لتحقيق أي فضيلة في الحياة وتقديمَ الخدمات بدون تعلم، ليس إلا مجموعة من الضلالات والأوهام، فالفضائل بطريقة ما لا تصبح فضائل دون أن يصحبها -أو تكتسب عن طريق- التعليم أو التعلم. وفي موضع آخر من كتاب "المقتطفات الأدبية"، يقول كونفوشيوس: "قضيت أيامًا دون طعام وليالي دون نوم على أمل الوصول إلى نقاء الفكر وصفاء العقل، لكن ذلك لم ينفع كثيرًا، فهذا كله لا يساوي شيئًا بجانب الدراسة المخلصة".([3]) فالدراسة والتعلم المخلصان ينميان فضيلتَيْ طهارة القلب والعقل، أما ممارسات التنسك التقليدية مثل الصوم أو الحرمان من النوم فهي غير مجدية.
فأفراد كونفوشيوس المتفوقون أو النبلاء كانوا تلامذة وممارسين متميزين لما سمي لاحقًا "الكلاسيكيات الكونفوشية" (Confucian Classics) أو "قانون الأدباء" (Canon of the Literati)، وقد توسعت النصوص التي تضمنها هذا القانون بمرور الوقت، لكن الجزء الأقدم والأكثر قيمةً فيه والذي يحمل غالبًا عنوان "الكتاب المقدس" (Scripture) يتضمن خمسة نصوص: "شو تشينج" (Shu Ching - أي كتاب التاريخ)، و"شيه تشينج" (Shih Ching - أي كتاب الأغاني)، و"يي تشينج" (Yi Ching = أي كتاب التغييرات)، "تشون تشيو" (Chun-Chiu أي فصول الربيع والخريف)، و"لي تشينج" (Li Ching - أي كتاب الطقوس).([4]) وقد كان أفراد كونفوشيوس المتفوقون علماء أهّلهم إتقانهم لمحتوى هذه النصوص وغيرها لأن يكونوا جديرين بالعمل كمسؤولين حكوميين، وحكام أقاليم، ومستشارين للإمبراطور. وتُقدم النصوص المختلفة لقانون كونفوشيوس درسًا شاملاً عن تهذيب الشخصية بالفضائل الكلاسيكية من روح إنسانية ولياقة وتعقل واستقامة وأخلاق قويمة وتدبير في الإنفاق وبر بالوالدين وحب للخير وانضباط وإخلاص، كما كانت هذه النصوص تُكسب البراعة في الموسيقى والشعر وغيرها من المعارف. فنقرأ في كتاب "المقتطفات الأدبية":
قال المعلِّم [كونفوشيوس]: "كيف لم يدرس أيٌّ منكم ’الأغاني‘ يا صغاري؟ بالأغاني يمكنكم أن تُلهموا الناس وتُوجهوا نظرهم إلى دواخلهم، وأن تجمعوا بين الناس وتجعلوا لشكواهم صوتًا. وبالأغاني تخدمون أباكم عندما تكونون بالمنزل، وتخدمون سيدكم عندما تكونون بعيدًا، وبها تتعلمون أسماءَ ما لا يحصى من الطيور والحيوانات والنباتات". ثم قال المعلِّم لابنه بويو: "هل قرأت "التشو نان" (Chou Nan) و"شاو نان" (Shao Nan) [أول فصلين في كتاب الأغاني]؟ إلى أن تنتهي منهما على الأقل، فإنك ستعيش كما لو كنت تقف في مواجهة حائط".([5])
نرى هنا أن إجادة كتاب الأغاني -أي الموسيقى والشعر- تعد أمرًا حيويًا بالنسبة لتنمية الذات والقيادة وخدمة العائلة والإمبراطور، وبدون هذه التربية تصبح الحياة مثل "الوقوف في مواجهة حائط". ويبدو التشابه مع قصة أفلاطون عن الكهف واضحًا هنا، فبدون إجادة الأقسام الأولى على الأقل من كتاب الأغاني يصبح الإنسان المتفوق المنتظر مثل أحد سكان كهف أفلاطون، ثابتا في موضعه يحدق في الحائط الذي تنعكس عليه الظلال كما لو كان منتهى الحقيقة. وبالدراسة فقط يتمكن المرء من الابتعاد عن الحائط والتوجه نحو نور المعرفة. فمن لديهم المعرفة هم وحدهم القادرون على تلبية حاجة المجتمع إلى أسر قوية متماسكة، وحكام صالحين، وإمبراطور مستنير بالنصح والمشورة، وبدون تلك الأمور ينحدر المجتمع إلى الفوضى.
وقد أفرز النهج التربوي المبني على الكلاسيكيات إجادة لما هو أكثر من مجرد علوم الحكم، فالتعليم عند كونفوشيوس لم يكن بهذا التعريف الضيق. فكما يتبين حتى من عناوين الكلاسيكيات نفسها، كان علماء كونفوشيوس مدرَّبين على مجموعة متنوعة من العلوم كالشعر والموسيقى والتاريخ والطقوس -وهو أمر قد يبدو ظاهريًا غير جوهري بالنسبة لتعلم نظم الحكم الصالح- كما كان هؤلاء العلماء موسيقيين بارعين يعزفون على مختلف الآلات الموسيقية، وكانوا بارعين أيضًا في نظم الشعر وإلقائه، وكانوا خطاطين ماهرين جدًا، وهذه مجرد عينة من مجالات خبرتهم واطلاعهم. وتَرى النظريةُ الكونفوشية أن مثل هذا التعليم والتدريب يهذبان الشخصية بشكل مركب ومرغوب، ونحن نرى تلميحًا إلى هذا في إحدى فقرات كتاب "المقتطفات الأدبية":
قال المعلِّم: "عندما أكرر دائمًا: الطقوس الطقوس، هل تعتقد أنني فقط أتشدق بالكلام عن الحرير والأحجار الكريمة؟ وعندما أكرر الموسيقى الموسيقى، هل تعتقد أنني فقط أتحدث عن الطبول والأجراس؟"([6])
الشاهد هنا هو أن هناك ما يتم تعليمه أكثر من مجرد آليات الطقوس أو الموسيقى. صحيح أن الطقوس والموسيقى لهما قيمة أصيلة تشجَّع وحدها على دراستهما وإتقانهما، لكن كونفوشيوس يقول هنا: إن إتقانهما يحقق شيئًا إضافيًا أبعد من مستوى اللياقة في الملبس أو العزف على الآلات. وتتضمن الفقرة السابقة عن كتاب الأغاني طرحًا مماثلاً، وهو أنَّ تعلم الموسيقى يمنح تعليمًا أبعد من مجرد أداء الأغاني أو تاريخ التراث الموسيقي.
هنا، نرى لمحة من أقوال كونفوشيوس عن الطبيعة البشرية وأعماقها، فإتقان الموسيقى والشعر والطقوس يؤدي تلقائيًا إلى إتقان الآلات والكلمات والتصرفات، مما يكون بالتأكيد مفيدًا في حد ذاته. ولكن على مستوى أعمق، يؤدي إتقانُ هذه الأمور إلى تنمية نزعة إنسانية في الشخصية وهذا هو الأهم؛ فالموسيقى تنير جانبًا من الروح الإنسانية لا يستطيع أيُّ شيء آخر إنارته، وامتلاكُ حس مرهف في تذوق الموسيقى وعزفها يتطلب مستوى رفيعًا وراقيًا من التهذيب لذلك الجانب الأعمق في الطبيعة البشرية. والشيء نفسه ينطبق على الشعر أو فن الخط، فكلاهما يتطلب قدرات عالية ورفيعة من الإدراك والتعبير، سواء على مستوى آليات تحريك اليد أو استخدام الصوت أو حتى على مستوى الروح.
هذا هو الشاهد عند كونفوشيوس: أن الأفراد المتفوقين يصبحون أفرادًا متفوقين من خلال تهذيب تلك الملَكَة الغضة والنقية وتنميتها بداخلهم، وهي ملَكَة يشتركون فيها مع كل البشر، ولكنهم وحدهم بتعليمهم وانضباطهم نجحوا في أن يجسِّدوها في أنفسهم. ومع تنميتهم لأنفسهم في تلك الجوانب يزداد تأثيرهم في الآخرين، لأن جميع البشر -سواء مهذبين أم غير مهذبين- لديهم طبيعة تتجاوب مع الموسيقى وغيرِها من أشكال الجمال. وكما تُبين الفقرة السابقة، فإن الموسيقى تحفِّز الناس للنظر بداخلهم والتوحد مع الآخرين والتعبير عن مشاعرهم، وهذا هو ما يبعثه العلماء داخل الناس بإلهامهم ووعيهم الموسيقي، وتشمل هذه القوة الإلهامية جزءًا من الـ"تي" التي تناولناها في الفصل السابق.
وقد مَثَّل رجالُ كونفوشيوس المتفوّقون الإنسانَ المثقّف والإنسان المثالي الأخلاقي للفكرِ الصينيِ على مدى قرونِ، إلى عصر الرئيسِ "ماو" والشيوعية. ، وقد قام هؤلاء المثاليون بتعريف الإنسانية الحقة في أسمى وأجل صورها، أدبيًا وأخلاقيًا، وكانت صورتهم هي صورة الرقي العقلي والفني وكمال الشخصية وأناقة المظهر والسلوك والجمال الأخلاقي اللامتناهي، وقد وصلوا إلى هذه الدرجة بالدراسة المخلصة والممارسة الدؤوبة، أي بجهودهم الفردية. فالعديد من المذاهب الإنسانية -مثل هذا المذهب- تعطي أولوية لما يستطيع البشر تحقيقه بجهودهم الفردية، في مقابل ما يحققونه بتوفيق من الله أو بالقضاء والقدر. ويخبرنا كونفوشيوس أن الفطرة البشرية واحدة لدى الجميع، وما يميز الناس عن بعضهم في النهاية هو ما يقومون به من دراسة وممارسات بمفردهم وبقوة عزيمتهم. فهؤلاء الناس هم الأحق بلقب "الأفراد المتفوقون"، أما غيرهم ممن لا يبلغون هذه الدرجة فينبغي أن يشعروا بالامتنان لأن هؤلاء الأفراد المتفوقين يحكمونهم ويقدمون لهم القدوة في الحياة والسلوك الإنساني السليم. ويرى كونفشيوس أن شخصية الإنسان المتفوق يكون لها نوع من التأثير الأخلاقي على المحيطين به فيجعلهم يشعرون برغبة في القيام بأعمال نبيلة أو على الأقل الامتناع عن الأعمال السيئة، فهم أناس لا يرتقون بحياتهم الشخصية فحسب بل يرتقون بالحياة نفسها لكل من حولهم عن طريق القدوة وسلطة الحكم، ومع التجسيد العملي للإنسان المثالي في الحياة الاجتماعية والسياسية فإن هذا يكون إثباتًا لقوة التعليم والتهذيب وأثرهما في الحياة الإنسانية.
ولو أن رجال كونفوشيوس المتفوقين انتقلوا عبر الزمان والمكان إلى جمهورية أفلاطون الفاضلة، لوجدوا ترحيبًا وتشجيعًا على أن يأخذوا أماكنهم بين الوصاة الذين تحدث عنهم سقراط، فكلا هاتين الصورتين للإنسان المثالي -كما رأينا في الفصل السابق- تتضمن تنمية أخلاقية عالية وحرصًا على إفادة المجتمع عن طريق تولي الحكم، كما يجمع بينهما أيضًا الاعتقاد بأن من تثبت صلاحيتهم للحكم هم وحدهم من ينبغي أن يحكموا. لذا فإن النموذج السياسي الذي تُقدمه هاتان الفلسفتان يقوم على أساس الكفاءة والجدارة، في مقابل الأرستقراطية القائمة على الحسب والنسب. فمن لديهم الجدارة ينبغي أن يكونوا حكامًا، ومن لا يتمتعون بها ينبغي أن يكونوا محكومين، أو مساعدتهم على حكم أنفسهم. وتتحدد الجدارة من خلال النظام التعليمي، لذا نجد أن السبيل إلى الوصاية في جمهورية أفلاطون الفاضلة -كما هو السبيل إلى العمل الحكومي في الكونفوشية- يتطلب مستوى كبيرًا من التعليم والتثقيف الرسمي والمنهجي.
وتتوزع أفكار سقراط عن التعليم الخاص بالوصاة -وكذلك كل الأدوار الأخرى في المجتمع المنظم- عبر صفحات كتاب "الجمهورية" (The Republic)، فيَعرض الجزءان الثاني والثالث محاوراتٍ مطولة عن عناصر معينة في المناهج التعليمية، وتتناول الأجزاء التالية المنافع الأخلاقية لتعليم الرياضيات، ثم تُوضح مفهوم سقراط عن حكم أهل الخبرة والجدارة مقارنةً بأربعة أشكال أخرى سيئة من الحكم، وهي التيموقراطية (Timocracy-أي حكم الأثرياء) والأوليجاركية (Oligarchy-أي حكم القلة) والديمقراطية الراديكالية، والاستبداد. ولسنا هنا في معرض طرح كل هذه التقسيمات وتفسيرها بالتفصيل، لكننا سنوجز فكرة سقراط الأساسية عن الدولة المنظَّمة والوصاة الذين يحكمونها وكيف أنه ينبغي اكتشاف هؤلاء الوصاة وتأهيلهم كوصاة من أجل خير المجتمع ككل. وربما تكون أفضل نقطة للبدء منها هي "أسطورة المعادن" (Myth of the Metals) في الجزء الثالث.
يشير علماء الدين إلى "أسطورة المعادن" على أنها تعكس نظرية أفلاطون: "الوظيفية في الدين"، والتي تعني أن الأسطورة والقصة الدينية تُقدم وظيفة مفيدة في المجتمع سواء كانت صحيحة واقعيًا أو تاريخيًا أم لا، "فالحقائق" التي تحملها الأسطورة أو القصة هي حقائق ميتافيزيقية أو فلسفية تسود وتنتشر رغم افتقارها للواقعية في القصة نفسها. وقصة المعادن لسقراط هي أسطورة خيالية رائعة تعبر عن حقيقة فلسفية عن الواقع، وهي في حالتنا هذه الفروق في المواهب والقدرات الإنسانية، أو ما يشير إليه سقراط بـ"قدرات الناس الطبيعية". تقول الأسطورة: جميع البشر يأتون من مصدر واحد وهو أمنا الأرض، غير أن الآلهة وَضعت معادن الذهب والفضة والحديد في باطن الأرض بحيث يكون البشر رغم مجيئهم من نفس المصدر متفاوتين عن بعضهم البعض بحسب ما يحتويه كلٌّ منهم بداخله من الذهب أو الفضة أو الحديد، فبعض الناس "يحتوون على" أو "يتكونون من" الذهب، في حين يكون معدن غيرهم فضة أو حديدًا. وهكذا، فإن الأسطورة تعبر بأسلوب قصصي عن حقيقةٍ تحدث في الواقع الإنساني. فذلك المزيج من المعادن في نسيج الإنسانية المشترك يعني أنه من المرجح أن ينجب الوالدان ذرية من "ذهب" إذا كانا هما من "ذهب"، لكنهما أيضا ربما ينجبان نسلاً من "الفضة أو "الحديد". فلا يوجد ضمان بأن الذهب يلد ذهبًا، أو أن الفضة تلد فضة، بل قد يلد الذهب فضة والحديد ذهبًا. وفي تقسيم سقراط، يوجد الذهب في طبقة الوصاة، والفضة في طبقة الجنود، والحديد في طبقة الحرفيين والفلاحين، وكل طبقة من هذه الطبقات لها دور ضروري وتُشكِّل جزءًا من كيان المجتمع بأكمله، لكنَّ هناك تسلسلاً هرميًا داخل ذلك التكوين الأساسي القائم على المساواة، وهو أن الذهب يجب أن يحكم بقية المعادن بما فيها الذهب نفسه، فالذين يُظهرون خصائص الذهب فقط هم الذين يجب أن يحكموا، والذين يظهرون خصائص الفضة أو الحديد يجب أن يؤدوا المهام الاجتماعية التي تناسب هذين المعدنين، وبالتالي يجب تنظيم المجتمع على أساس المعادن الموجودة في كل شخص، بحيث لا يوضع من يظهرون خصائص الذهب في مهن الحديد أو من لديهم خصائص الحديد في مهن الذهب، وتأتي الفوضى من وضع الناس في مناصب أو أعمال أو مسؤوليات لا تلائم شخصياتهم أو طبائعهم المتأصلة. فينبغي تمييز معادن الناس الطبيعية -أي مواهبهم وقدراتهم الطبيعية- وتهذيبُها بالشكل الملائم من أجل تنظيم المجتمع تنظيمًا سليمًا،([7]) وهذا يتم عن طريق التعليم.
وفي مختلف صفحات كتاب "الجمهورية"، يتحدث سقراط عن التدقيق والاختبار الذي يجب أن يتم للناس حتى يستطيع الـمُشْرفون تحديد "معدنهم" أو -بعد تحديده- تنميةَ ذلك "المعدن" وصقلَه إلى أقصى درجة. ويتلخص هذا في أن يتلقى كل شخص تعليمًا أساسيًا، ثم ينتقل في النهاية إلى الدراسات المتخصصة بعد أن تكون شخصيته وقدراته الطبيعية قد اتضحت وتبلورت. وفي كل مستوى يتلقى الناس التعليمَ المخصَّص لإظهار الإنسانية المثلى وتنميته فيهم والتعبير الأكمل عن معدنهم. وأفضلُ تعليم هو أيضًا ذلك الذي يحقق التوازن بين الروح والجسد، إذ يوضح سقراط في الجزء الثالث أن من يتلقون تدريبًا مفرطًا في الموسيقى والشعر على حساب التدريب البدني أو الرياضي يصبحون مائعين وضعفاء وواهني العزيمة، وبالعكس من يتلقون التربية الرياضية وحدها دون تهذيب أرواحهم لتذوق الجمال يصبحون عدوانيين ويتعاملون مع أي موضوع بالعنف والهمجية.([8]) فالبشر لهم جوانب متعددة ويجب تربيتهم حتى يبلغوا أقصى إمكاناتهم كبشر وككائنات ذات مواهب أو "معادن" معينة تتفرد بها.
وبالطبع، فمن يمتلكون مواهب الوصاة يتلقون أعلى وأصعب مستوى من التعليم، لأن مسؤولية حكم الدولة بأكملها تقع على عاتقهم. وقد خَصص سقراط معظم الجزأين الثاني والثالث لمناقشة نوعية التعليم الذي يجب أن يتلقاه الوصاة، وهما من أكثر الأقسام إثارة للجدل في كتاب "الجمهورية"، حيث ينادي سقراط بمنهج تربوي صارم ومحكم للوصاة يبدو دكتاتوريًا ومقيِّدًا للحرية بالنسبة للكثيرين ممن يعيشون في الغرب الآن. ويقول سقراط في هذه الأقسام: إن الوصاة يجب ألا يتعرضوا لبعض أنواع الأدب والموسيقى والكتابة المسرحية لأنه من شأن هذه المجالات أن تخلق بعض الخصائص في الروح تؤدي في النهاية لإضعاف قدرة الوصاة على إدراك الخير والحكم بشكل سليم. والكثيرُ من الأعمال الكلاسيكية الإغريقية -مثل أعمال هوميروس وهسيود- لم يكن مسموحًا بتدريسها للوصاة؛ لأنها تمتدح أبطالاً مثل أخيل أو حتى الآلهة في تصرفات غير إيجابية. وبعض الأدوار في الأعمال الدرامية كانت تُعد تجاوزًا بالنسبة للوصاة المستقبَليين؛ لأن أداء مثل هذه الأدوار في عمل مسرحي يتضمن تقليدَ أو محاكاةَ سلوكيات غير أخلاقية أو مثيرة للجدل مما قد ينمي في أرواحهم استعدادًا لمثل هذه السلوكيات. فأرواح الوصاة يجب حمايتها وتهذيبها بعناية منذ الطفولة المبكرة حتى تُغرس في أعماقهم قيم الخير والجمال والنظام والعدل، لأن دورهم كوصاة يتطلب تلك النوعية من الروح. وينبغي توجيه كل الاهتمام لخلق تلك الملكة فيهم منذ البداية والحفاظ على استمرارها بعد غرسها فيهم. وفي الجزء الثاني، يقول سقراط عن الأوصياء الشباب: "في هذه السن الغضة يكونون أكثر حساسية ويمكن التأثير عليهم بشكل أكبر، وبالتالي يكونون أكثر احتمالية لتبني أي نماذج توضع أمامهم".([9]) وفي موضع لاحق، يدافع سقراط عن منع بعض أنواع الشعر وأشكال التعبير الفني الأخرى، فيقول:
"بهذه الطريقة يمكننا حماية الوصاة من الترعرع وسط الشرور في مرعى من الأعشاب السامة يؤدي التغذي منه رويدًا رويدًا ويومًا بعد يوم إلى أن تتجمع في أرواحهم دون وعي كتلة ضخمة من الفساد".([10])
وقد كان التربويون دائمًا على وعي بأن الروح -خصوصًا لدى الوصاة- هي ما يتم تربيته وتهذيبه. ويرى سقراط أنه بما أن التعليم يَحدث على مستوى الروح، فإن تعليم الموسيقى والآداب يعتبر من المكونات الأكثر أهمية في بناء المنهج، فيوضح في حديث لتلميذه جلاكون:
"لهذا يأتي تعليم الشعر والموسيقى أولاً من حيث الأهمية يا جلاكون؛ فالإيقاعات والنغمات لها أعظم تأثير في الروح؛ حيث تَنفذ إلى أعمق أعماقها ثم تستقر هناك. فإذا كانت الروح مدرَّبة تدريبًا سليمًا فإنها تجلب الخير والفضيلة، وإلا فإنها تجلب العكس. ومن لديه تعليم رفيع في هذه الأمور سيستشعر ويستنكر على الفور أي غياب أو تشويه للجمال في الفن أو الطبيعة، وبحسه المرهف سيسعد بالأشياء الجميلة ويمدحها ويجد لها صدى في روحه، وسوف يغذيها ويصبح هو نفسه جميلاً وخيِّرًا، وسيجد نفسه -رغم صغر سنه وعدم إدراكه السبب- يرفض ويكره ما هو قبيح، ثم لاحقًا عندما يجمع بين رجاحة العقل والتعليم سيقوده انجذابه لما هو خيِّر وجميل إلى التعرف عليه والاحتفاء به".([11])
إن الروح هي المحور هنا، أو هي الذات الداخلية -ما قد يسميه بعضهم في عصرنا هذا "الشخصية"- فينبغي تنمية هذا التكوين بكل جوانبه وبكل السبل وبكل عناصر المنهج. وكما هو الحال مع علماء كونفوشيوس، يتلقى وصاة سقراط تعليمًا مكثفًا في كثير من المجالات، منها الموسيقى والشعر والرياضة البدنية والرياضيات وغيرها، وكل ذلك بهدف تربية أفراد موطَّنين في ذواتهم الداخلية على قيم العدل والخير والتناغم. فأفراد كهؤلاء -فقط- يمكن ائتمانهم على الوصاية على الدولة بأكملها، وبوجودهم على قمتها يمكن لسفينة الدولة أن تبحر بأمان وسط مياه العالم العنيفة والقاسية.
ويشكِّل هذا الفهم بأن التعليم حق للجميع وخصوصًا الوصاة، تعريفًا أساسيًا للعدل -كما يراه سقراط- والذي يمثل محورًا رئيسيًا لجميع المحاورات في كتاب "الجمهورية". فمِن أول جزء ظلت المناقشة تتطرق مرارًا وتكرارًا إلى مفهوم العدل وكيفية تعريفه، وفي نهاية الجزء الرابع -بعد إفراد جزأين كاملين للحديث عن تعليم الوصاة- يؤكد سقراط على تعريف للعدل يتشابك تمامًا مع النموذج التعليمي الذي يطرحه، فيقول:
"إن العدل -إذن- ما هو إلا تلك القوة التي تَخلق أناسًا وشعوبًا محكومين بشكل جيد. والواقع أن العدل ليس مسألة سلوك خارجي، لكنه الطريقة التي يحكم بها الإنسان نفسه بنفسه وبصدق. فالإنسان العادل لا يسمح للجوانب المختلفة من روحه بأن تتداخل مع بعضها البعض أو أن تغتصب وظائف بعضها البعض، فقد رتب حياته الخاصة وتصادق مع نفسه وأصبح هو السيد وهو القانون لنفسه، وبلغ درجة التناغم والانسجام في روحه بمستوياتها الثلاث: المرتفع والمتوسط والمنخفض، تمامًا كما تتجانس المقامات الموسيقية وتسير معًا بشكل إيقاعي وموزون. وعندما يُحقق هذا التناغمَ والانسجام فإنه يكون قد جَعل من نفسه إنسانًا واحدًا وليس أكثر من إنسان، وعندها فقط سيكون مستعدًا للقيام بما يقوم به في المجتمع، مثل: كسب المال، وتدريب الجسم، والانخراط في السياسة أو الصفقات التجارية، وغير ذلك. وفي كل النشاطات العامة التي يمارسها سيكون السلوك العادل والجميل هو فقط ذلك السلوك الذي يتناغم مع نظامه الداخلي الخاص الذي ذكرناه توًا ويحافظ عليه، وستكون الحكمة بالنسبة له هي المعرفة التي تعي معنى مثل هذا السلوك وأهميته".([12])
إذن، يعتمد العدل نفسه على الناس الموجودين في مختلف المهن والأدوار داخل المجتمع الذين تربوا منذ الطفولة على مظاهر الجمال والخير، كما أن المجتمع الذي يستعين بهؤلاء الناس ليحكموه يجب أن يكون هو نفسه منظَّمًا بحيث يُنتج نفسَ تلك النوعيات من الناس للحفاظ على استمراريته، وهذا هو الدور المحوري الذي يلعبه التعليم في المجتمع. فالتعليم هو الآلية التي تتم بها تنمية أعلى وأفضلِ الملكات الإنسانية، وأفضلُ أشكال التعليم هي التي تجعل هدفها الرئيسي -مهما كانت المادة العلمية المباشرة التي تقدمها- هو تهذيب الروح الإنسانية وتوطينها على العدل والجمال والخير، وبدون وجود هؤلاء الأفراد على كافة مستويات المجتمع فهو هالك لا محالة.
ويأتي كولن -في إطار إسلامي تَفصله قرون عديدة عن كونفوشيوس وسقراط- ليقدم نظرية مشابِهة كثيرًا في التعليم والروح والتنمية الإنسانية، حيث ينظر إلى النفس الإنسانية -مثل زميليه القديمين- باعتبارها كيانا يشتمل على مكونات جسدية وعقلية وروحية. وكلُّ مكون من هذه المكونات يجب تنميته بشكل سليم لبلوغ أقصى الإمكانات البشرية. وهذه التنمية تحدث من خلال التعليم. ويوضح كولن ذلك فيقول:
"إن الإنسان ليس مخلوقا يتكون من جسم فقط أو عقل فقط أو مشاعر فقط أو روح فقط، بل هو عبارة عن مزيج منسجم من كل هذه العناصر. فكلٌّ منا له جسم ينطوي على مجموعة متشابكة من الحاجات، وكذا عقلٌ له حاجات أكثر دقة وحيوية من الجسم، وتسيطر على هذا العقل مخاوف بشأن الماضي والمستقبل. (...) كما أن كل إنسان هو مخلوق مكون من مشاعر لا تكتفي بالعقل وروحٍ نكتسب من خلالها هويتنا الإنسانية الفعلية. فكل فرد هو هذا كله معًا، وعندما يُنظر إلى الإنسان، رجلاً كان أو امرأة -وهو الذي يدور حوله كل شيء من جهود وأنظمة- باعتباره مخلوقًا يحمل كل هذه الجوانب، وعندما يتم تلبىة كل حاجاته، فإنه سيصل إلى السعادة الحقيقية. وفي اللحظة الراهنة، لا يمكن تحقيق التقدم والتطور الإنساني الحقيقي فيما يتعلق بكيانه الأساسي إلا بالتعليم".([13])
هنا، نرى تشابهًا مع تعريف سقراط للنفس الإنسانية بتقسيمها إلى ثلاثة جوانب متمايزة: العقل أو الروح، والدوافع، والجسد. وكل هذه الأجزاء يجب أن يتم تنميتها بشكل سليم ويجب أن تعمل في نظامها الصحيح داخل الإنسان لبلوغ كمال الإنسانية. ويُبدي كولن رأيًا مماثلاً في هذه الفقرة، وهو أن كل رجل أو امرأة عبارة عن تركيبة معقدة من المكونات التي يجب تنميتها في نفسها، والتي يجب تنظيمها بشكل متآلف ومنسجم داخل النفس لتحقيق التقدم الإنساني.
هذه الفقرة وغيرها من الفقرات المشابهة تشكل جزءًا من مناقشة أوسع للتاريخ يتتبع فيها كولن مراحل تطور الحضارات سواء في الشرق أو الغرب، فيقول: إنه رغم هيمنة الحضارة الغربية على العالم في القرون الماضية وصدارتها في مجالات العلم والتكنولوجيا، فإن نظرة الغرب الحديث إلى العالم هي نظرة مادية وبالتالي فهي قاصرة، ذلك أن الفكر الغربي يتعامل مع البشر بمنظور شديد المادية ويسعى لتحقيق الإنجاز الإنساني من ذلك المنظور الضيق، في حين أنه يضحِّي بالأبعاد الأخرى للإنسان، وهي الأبعاد الروحية، وهذه التضحية أدت إلى العديد من الأزمات الاجتماعية. ويتلخص جزء من رؤية كولن للمستقبل في الجمع بين أفضل ما في الثقافة الغربية -وهو التطور العلمي والتكنولوجي- وأفضل ما في الثقافة الشرقية -وهو القيم الروحية والأخلاقية- لإيجاد ثقافة إنسانية أكثر تطورًا وشمولية تنقل هذا الواقع بأكمله إلى عصر جديد.([14])
ويرى كولن -مثل سقراط وكونفوشيوس- أن أي فرد أو مجتمع لا يمكنه بلوغ أقصى إمكاناته بدون التعليم، فهو يعتبر التعليم الوسيلة التي يصبح بها الناس كما أرادهم الله حين خلقهم، ومن ثم فإن التعلم هو أهم الواجبات في الحياة. يقول كولن:
"الواجب أو الغرض الرئيسي للحياة الإنسانية هو السعي من أجل المعرفة الإلهية، وما يُبذل من جهد في سبيل ذلك -وهو ما نطلق عليه التعليم- هو عبارة عن عملية سعي نحو الكمال نكتسب من خلالها -في كل الأبعاد الروحية والفكرية والجسدية لذواتنا- المكانةَ التي حُددت لنا كأكمل نموذج للخَلْق. وواجبُنا الرئيسي في الحياة هو اكتساب الكمال والنقاء في تفكيرنا وتصوراتنا وإيماننا. وبأداء واجبنا في العبودية للخالق الرازق الحفيظ، وبمحاولة إدراك سر الخلق من خلال ما لدينا من قدرات وإمكانات، فإننا نسعى لبلوغ مكانة الإنسانية الحقة والفوز بالنعيم والخلود في عالم آخر أكثر سموا".([15])
هنا، يضع كولن التعليم والتعلم في صلب الغرض الأساسي من الوجود الإنساني، وبتعبير آخر أن الهدف من حياة الإنسان هو أن يصبح إنسانًا كاملاً، وهذا تم بطلب العلم والمعرفة. وكولن، كمسلم، يضع هذا الأمر ضمن السياق الأكبر للعبودية لله، ولكن يمكن بنفس البساطة أن نصوغه في سياق أكثر اتفاقًا مع فكر أرسطو، وهو أن غرض كل شيء ووظيفته هي أن يكون هو نفسه بكل كماله واكتماله، وكل شيء بطبيعته مزودا بالقدرات والعناصر الداخلية التي تجعله هو نفسه بشكل كامل، إذا توافر الإطار الملائم. فالبشر يولدون ولديهم القدرة على أن يصبحوا بشرًا بكل معنى الكلمة، ويعتقد كولن (مثل أرسطو وسقراط وكونفوشيوس وكثيرين غيرهم) أن الآلية الفطرية لتحقيق الإنسانية بشكل كامل تكمن في قدرتنا على التعلم. يقول كولن:
وبما أن الحياة "الحقيقية" لا تأتي إلا بالمعرفة، فإن من يهملون التعليم والتعلم يُعتبَرون "ميتين"، حتى وإن كانوا أحياء من الناحية البيولوجية، فقد خُلقنا لنتعلم ونَنقلَ ما تعلمناه إلى غيرنا.([16])
يتحدث كولن في مختلف أجزاء مؤلفه عن حاجة كل الناس إلى التعليم العام حتى يمكن لأي حضارة من الحضارات أن تؤدي مهامها، فيقول: "إن الناس لا يكونون "متحضرين" إلا بقدر ما يحصلون عليه من تعليم، وخاصةً القيم التقليدية الخاصة بثقافة معينة، فالتماسك في الحياة على كافة المستويات يأتي عن طريق تعليم كل المواطنين في أي أمة أو دولة رؤيةً واحدة مشتركة ومنظومةً أساسية من القيم". إلا أن هذه الحركة العالمية للتعليم عند كولن تتعدى التركيز على مجموعة محددة من القيم أو المعايير الثقافية، فالمدارس الألف تقريبًا (في وقت تأليف هذا الكتاب) التي استلهمت فكر كولن، والتي تنتشر في جميع أنحاء العالم، تدرس للأطفال والشباب جميع المجالات والتخصصات الدراسية، من العلوم والرياضيات والتاريخ واللغة والأدب والدراسات الاجتماعية أو الثقافية والفنون والموسيقى وغيرها. وقد قام الكثيرون ممن ألهمتهم تعاليم كولن بإنشاء مدارس في تركيا بعد سماح الحكومة بإنشاء المدارس الخاصة بشرط أن تظل ملتزمة بالمناهج التي تفرضها الدولة وتخضع لإشراف الدولة. وتتبنى المدارس التي تتأثر بأفكار كولن في البلدان الأخرى نفس الاتجاه التربوي الأساسي الذي تتبناه المدارس في تركيا، ولكن بدرجة أكبر من التفاعل مع الثقافة والقيم الوطنية لتلك البلدان. حتى إن كولن نفسه لديه اتصال بسيط للغاية -إن وجد- مع هذه المدارس، بل ولا يَعرف بدقة عددَ هذه المدارس أو حتى أسماءها، فقد حفَّز مثالُه الرائد كتربوي -وكذلك أفكاره عن التعليم والمجتمع العالمي والتقدم الإنساني وغير ذلك- جيلاً كاملاً لإنشاء المدارس في جميع أنحاء تركيا ووسط آسيا وأوروبا وإفريقيا وغيرها من المناطق لمحاربة المشاكل الناجمة عن الجهل والفقر والشقاق.
وتتلخص البنية والشخصية الأساسية لتلك المدارس في أن تمويلها يأتي من المؤسسات الخيرية والجماعات الأهلية ومصاريف الدراسة، وتساهم الإدارات المحلية بتوفير البنية التحتية، ويعمل المدرسون فيها بدافع خدمة الغير وبأجور منخفضة غالبًا. وكما ذكرتُ سابقًا في مقدمة هذا الكتاب، فقد زرت الكثير من هذه المدارس في مختلف أنحاء تركيا والتقيت بداعميها من رجال الأعمال المحليين وقيادات المجتمع المحلي الذين تلاقت جهودهم لإنشاء تلك المدارس في مجتمعاتهم المحلية. وفي حالات كثيرة تكون أبنية تلك المدارس هي الأحدث في المنطقة، وتمتلئ الجدران بصور الطلاب الذين تسلموا أوسمة في مختلف المسابقات الدراسية محليًا ودوليًا وزيارات لعدد كبير من الوزراء ونواب البرلمان في تركيا، وتحتوي على حجرات دراسة ومعامل وتجهيزات على أعلى مستوى حتى بعد أن يستخدمها مئات الطلاب الشغوفين، وطلابها أذكياء ومنفتحون ومتحمسون لاستعمال لغتهم الإنجليزية مع الزوار الأمريكيين، أما مسؤولو هذه المدارس والإداريون والمعلمون فلديهم التفاني والتركيز ويفتخرون بمدارسهم وطلابهم، والكثيرون منهم يقيمون مع الطلاب في مقار المدارس التي توفر الإقامة. وقد جلست على مائدة الطعام مع الكثير من الأسر التركية التي ترسل أطفالها إلى تلك المدارس، وسألتهم نفس السؤال الذي أطرحه في كل مدينة وكل منطقة: لماذا ترسل أطفالك إلى هذه المدرسة؟ وكانت الإجابة واحدة في كل مرة، وهي تفاني المعلمين، وجودة المناهج، والرؤية العامة التي تنشرها المدرسة -عن طريق المعلمين- فيما يتعلق بالإنسانية العالمية والتعليم والتسامح والحوار.
ولا تشمل رؤية كولن التربويةُ المدارسَ وحدها، بل تشمل أيضًا الأسر والمجتمعات والإعلام، فكل المكونات الرئيسية للمجتمع يجب حشدها من أجل تعليم الشباب وإكسابهم جميع المعارف والمعلومات المفيدة، وهو شيء في غاية الأهمية؛ لأن مستقبل أي أمة أو حضارة يتوقف على شبابها. يقول كولن:
"إن من يريدون ضمان مستقبلهم لا يمكن أن يهملوا كيفية تعليم أطفالهم وتربيتهم، فينبغي أن تتعاون الأسرة والمدرسة والبيئة المحيطة ووسائل الإعلام بكل أشكالها لضمان تحقيق النتيجة المنشودة... [وإذا لم يؤد واحد أو اثنان من هذه دوره فهذا يعني أن الشباب قد ترك ليتضارب في هذا الجو من المتناقضات. فإذا لم تكن المدرسة متعاونا مع الأسرة، وإذا لم يتعاون الإعلام مع الأسرة والمدرسة، وإذا لم تكن البيئة في خط هؤلاء... فستكون العملية التربوية منحصرة في الإطار الذي تُجرى فيه. ومن البدهي أن هذا التأطير لن يأتي بالفائدة المرجوة] وبتحديد أكبر، ينبغي على الإعلام المساهمة في تعليم النشء عن طريق اتباع السياسة التربوية التي يرضاها المجتمع. والمدرسة يجب أن تكون على أفضل ما يمكن من حيث المناهج، والمعايير العلمية والأخلاقية للمعلمين، والحالة المادية للمكان. أما الأسرة فيجب أن توفر الدفء والجو المناسب لتنشئة الأطفال".([17])
هنا، نرى كولن يبدي مخاوف شديدة الشبه بما ذكره سقراط في كتاب "الجمهورية"، حيث يذهب سقراط -كما رأينا سابقًا- إلى المطالبة بفرض الرقابة على الشعراء والموسيقيين، وهي وسائل الإعلام التي كانت موجودة آنذاك، حتى لا يتعرض الأوصياء إلا لمظاهر التعبير الفني التي تغذي أرواحهم. ورغم أن كولن لم يناد في أيٍّ من مؤلفاته بفرض الرقابة بالطريقة التي يقول بها سقراط، إلا أنه يشارك الأخير قلقه العام حول التعليم الملائم لبلوغ أقصى تجسيد للإنسانية، وما يتضمنه ذلك من دعم الآباء والمجتمع والبيئة المدرسية والموضوعات التي يتم تدريسها والمعايير الأخلاقية للمعلمين.
ويمكننا أيضًا أن نرى أهمية التعليم لكل أفراد المجتمع عندما يتحدث كولن عن دور الشورى في الإسلام بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، حيث خصص لمناقشة ذلك الموضوع فصلاً كاملاً في كتاب (The Statue of Our Souls) [ونحن نقيم صرح الروح]، وبيّن في هذا الفصل الدور الحيوي الذي يلعبه المثقفون في استمرارية وتقدم المجتمع ونوعيات التعليم المطلوبة في عصر العولمة الذي نعيش فيه. ويبدأ كولن بذكر آية من القرآن توضح أن إدارة الشؤون الحياتية بالشورى يقع في نفس منزلة إقامة الصلاة على وقتها، ثم يستشهد بما للشورى من أهمية كبرى في الإسلام لدرجة أن المجتمع الذي لا يطبق الشورى لا يكون مجتمعًا إسلاميًا بالمعنى التام للكلمة، ويستطرد بعد ذلك فيوضح دور الشورى في المجتمع الإسلامي، فيقول:
"تعتبر الشورى من الديناميكيات الأساسية التي تحافظ على استمرارية التركيبة الإسلامية كمنظومة؛ فإليها تعود مهمة تسيير شؤون الفرد والمجتمع، والشعب والدولة، والعلم والمعرفة، والاقتصاد والاجتماع، بالطبع ما لم يكن هناك نص شرعي واضح الدلالة يحكم هذه الأمور".([18])
حتى الحكام يجب أن يديروا شؤون الدولة بالشورى، فالشورى هي الطريقة التي يتخذ بها الحاكم أو الحكام القراراتِ التي تؤثر فعليًا في كل جوانب الحياة سواء للفرد أو للمجتمع. ويفرد كولن عدة صفحات في توضيح الآيات القرآنية التي تؤيد الشورى، واستعراضِ تاريخ تطبيقها في الإسلام، وحصرِ القواعد الثابتة لممارستها. ثم يصل كولن إلى السؤال المحوري عمن يصلح للشورى، ومع من ينبغي أن يتشاور الحكام؟ ومن هو المؤهل للعمل كمستشار؟ يقدم كولن نفسه الإجابة قائلاً:
"بما أن الأمور التي تطرح للنظر والمشورة تتطلب في غالب الأحوال المعرفة والخبرة والدراية، يجب أن تكون هناك لجنةُ أو هيئةُ الشورى تضم أناسًا تتوافر فيهم تلك الصفات، ولا يتأتي ذلك إلا بمن اصطلح العلماء على تسميتهم بـ"أهل الحل والعقد"، وهم الكبار المقدمون المقتدرون على حل كل المعضلات. واليوم بالذات -مع زيادة الحياة صعوبة وتعقيدًا ومع تيار العولمة الذي يجعل من كل مشكلة شأنًا عالميًا يمس جميع البشر- أصبح من الضروري مشاركة أهل الاختصاص في العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا التي هي من مصالح المسلمين، إلى جانب أولئك من ذوي المنزلة الرفيعة الذين يدركون جوهر الإسلام وروحه ويفهمون الواقع الإسلامي والعلوم الإسلامية. فتجوز استشارة أهل الخبرة في العلوم ومجالات المعرفة الدنيوية المختلفة وغيرها من المجالات المطلوبة طالما أن إصدار القرارات يتم في النهاية تحت إشراف السلطات الدينية للتحقق من أن ما يرونه يتفق أو يتماشى مع الإسلام".([19])
نرى في هذه الفقرة المعايير الراقية التي يجب توافرها في الأشخاص كي يكونوا مستشارين. ومن المهم أن نذكِّر هنا بأن كولن يطرح رؤية لمجتمع إسلامي، وهو يرى أنه أفضل أنواع المجتمعات. وسواء اتفقنا معه أم لم نتفق ليس هذا هو الموضوع، فالمهم هنا أن التعليم في تصوره للمجتمع له أهمية مطلقة حتى يحصل كل الناس على أساسيات الوجود الإنساني. كما ينبغي توفير مستويات عالية من التعليم لنخبة من الكوادر الذين ستتم الاستعانة بهم كمستشارين للحكام في بعض القضايا أو الذين قد يصبحون هم أنفسهم حكامًا. يوضح كولن ذلك قائلا:
"وقد يتغير تكوينُ وطريقةُ عملٍ هيئة الشورى حسب الظروف والعصور، إلا أن مؤهلات تلك النخبة وسماتها -كأن يكونوا من أهل العلم والعدل والحكمة والنظر والدراية بالمجتمع- يجب ألا تتغير أبدًا".([20])
وهؤلاء المستشارون في الغالب يصبحون "الأفراد المثاليين" أو "أصحاب القلوب" الذين يصفهم كولن في موضع آخر من كتابه، وقد تناولنا ذلك في الفصل السابق. فالمستشارون هم من تهدف المدارسُ التي استلهمت أفكار كولن إلى تعليمهم، وهم الشباب الذين سيدخلون معترك الحياة بشخصية تتسم بالفضيلة وأيضًا بمستوى مرتفع من التدريب الأكاديمي كلٌّ في مهنته. وبعض هؤلاء الشباب سيبلغون مستويات استثنائية من النجاح والحكمة وسيُطلَب منهم العمل كمستشارين، وبذلك يكونون هم جيل "الأفراد المثاليين" الذين يبشرون بواقع اجتماعي جديد يُصلِح حالة الخصام المصطَنَع بين العلم والدين، ويجمع ما بين الشرق والغرب ويقدِّم منهجَ حياةٍ جديدًا للعالم.
ولا توجد في نظر كولن طريقة أخرى لتنظيم المجتمع تستحق أن تسمى "إنسانية" وبالتأكيد لا توجد طريقة أخرى يمكن أن تسمى "إسلامية"، فالبشر يمتلكون بداخلهم الملكات اللازمة لتحقيق الكمال كبشر، ومن يستوعبون هذا الكمال ويحققونه في أنفسهم يجب أن يؤثروا في المجتمع، كحكام أو كمستشارين أو كزعماء للمجتمع على مستوى القاعدة، ولكي يحدث أيٌّ من هذا يجب تعليم الناس وتربيتهم بطريقة سليمة وهادفة. وتُعتبر مدارسُ حركة كولن العابرة للحدود مبادراتٍ معاصرةً في هذا الاتجاه، وهي تسعى لتعليم الشباب من جميع قطاعات المجتمع ليصبحوا أناسًا على مستوى عالٍ من التأهيل والفضيلة يؤثّرون -كرجالِ كونفوشيوس المتفوقين- في كل ما حولهم ومن حولهم بقوة ما لديهم من المعرفة والخير والجمال (أي الـ"تي").
إن كل واحد من أطراف المحاورة الثلاثية التي أجريناها يطرح رؤية قوية لما هو ممكن على المستوى الاجتماعي الإنساني وكذلك السياسي، وتعود قوة هذه الرؤية في جزء كبير منها إلى الطبيعة الروحية أو اللامادية التي يقر بها كلٌّ منهم -بطريقته الخاصة وفي إطار القواعد الثقافية واللغوية التي تحكمه- كجزء محوري من الكينونة الإنسانية. هذه الطبيعة "الروحية" هي -من وجهة نظر كلٍّ منهم- ما يميز البشر عن بقية الكائنات، حيث يُؤْمن ثلاثتهم كثيرًا بقدراتنا المتأصلة على تنمية ملكاتنا الفطرية لتحقيق الكمال الإنساني، وإن كانوا جميعًا يعترفون أن الكثير من الناس لن يستعملوا هذه القدرات. وإيمانُ كونفوشيوس وسقراط وكولن بتلك القدرات -سواء استعملت أم لا- هو ما يجعلهم فلاسفة إنسانيين (humanists) بالمعنى الواسع للكلمة، فهم يؤمنون بقدرة الإنسان على أن يكون إنسانًا في أكمل صوره وأمثلها.
ولأن الناس يستطيعون تحقيق ذلك، فإن عليهم تحقيقه. وهؤلاء الفلاسفة ليسوا من القائلين بالجبرية أو الحتمية، فهم لا ينظرون إلى الناس -فرديًا أو جمعيًا- كقِطَع شطرنج في يد التاريخ. وكولن بالتحديد -حتى مع الأخذ في الاعتبار رؤيته بوجود إله قدير وعليم- يحث قراءه على تحمل مسؤولية أنفسهم ومسؤولية العالم، وهذه المسؤولية تعتبر تحديًا كبيرًا في أي عصر، إلا أن عصرنا الحالي بما فيه من تغيرات سريعة وانتشار للعنف ربما يدعونا للوقوف والمواجهة أكثر من أي شيء آخر. والآن ننتقل إلى الفصل التالي للحديث عن موضوع المسؤولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] Confucius, The Analects, xxiv–xxv. (كونفوشيوس، المقتطفات الأدبية)
[2] المصدر السابق، ص 198.
[3] المصدر السابق، ص 178.
[4] Thompson, Chinese Religion, 145–6. (تومبسون، الدين في الصين)
[5] Confucius, The Analects, 198. (كونفوشيوس، المقتطفات الأدبية)
[6] المصدر السابق، ص 199.
[7] Plato, The Republic, 113–114. (أفلاطون، الجمهورية)
[8] المصدر السابق، ص 109.
[9] المصدر السابق، ص 73.
[10] المصدر السابق، ص 99.
[11] المصدر السابق.
[12] المصدر السابق، ص 137.
[13] Gülen, Essays, Perspectives, Opinions, 80. (كولن، مقالات ورؤى وآراء)
[14] Gülen, Pearls of Wisdom, 231–232. (كولن، الموازين أو أضواء على الطريق)
[15] Gülen, Toward a Global Civilization of Love and Tolerance, 202. (كولن، نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح)
[16] المصدر السابق، ص 217.
[17] المصدر السابق، ص 206-207.
[18] Gülen, The Statue of Our Souls, 45. (كولن، ونحن نقيم صرح الروح)
[19] المصدر السابق، ص 54-55.
[20] المصدر السابق، ص 55.
الفصل الخامس: المسؤولية عند كولن وسارتر
ركزنا في الفصلين الأخيرين على الإنسان المثالي كما يراه كونفوشيوس وسقراط وكولن، والدورِ الذي يلعبه البشر المثاليون في الدولة، أو الحكم الوطني، وكذلك في قيادة المجتمع. وخلصنا إلى التأكيد على أن المفكرين الثلاثة كانوا فلاسفة "إنسانيين" بالمعنى الواسع للكلمة؛ فهم بالأساس يؤيدون بشدةٍ فكرةَ أن البشر قادرون على تحقيق مثالية أخلاقية وعقلية في أنفسهم، وأن أي مجتمع إنساني يمكن أن يتقدم ككل بشكل جمعي نحو تلك المثالية، وأن التعليم هو الآلية الرئيسية التي يتحقق بها ذلك. وقد قامت المناقشة في الفصلين السابقين بالكامل على قناعة أساسية تناولها كولن في مختلف أعماله وهو مؤمن بها تمامًا، وهي أن البشر مسؤولون عن هذا العالم.
وقد كانت مسؤولية الإنسان عن العالم وعن حياته الخاصة وحياة الآخرين كذلك وعن المجتمع وعن المستقبل موضوعًا ثابتًا عبر القرون في الفلسفة الإنسانية وفي جزء كبير من الخطاب الديني. فالمبادئ الأساسية للفلسفة الإنسانية الخاصة بما في البشر من قوة وقدرة وجمال فردي وجمعي لا يكون لها أي معنى -أو على الأقل تكون عرضة للاتهام بالفراغ الأخلاقي- ما لم يصحبها إيمان قوي بالمسؤولية الإنسانية في هذا العالم وعن هذا العالم. والتأكيدُ على القوة والقدرة الإنسانية في هذا العالم من دون المسؤولية الإنسانية عن توظيف تلك القوة في صناعة الجوانب المسخرة للإنسان في هذا العالم سيبدو في أفضل الأحوال أمرا غير منطقي، أو مدعاة للسخرية في أسوئها. إذن فقد كانت الفلسفة الإنسانية -أي الإيمان بقدرة البشر ومسؤوليتهم عن أن يكونوا صناعًا للعالم بطريقة ذات معنى- هي الخلفية التي في ضوئها حَقق الأفراد والمجتمعات بعض أعظم الإنجازات الإنسانية. فكم وُجدت عجائب العالم في الفن والأدب والعمارة والسياسة والاجتماع فلسفةً وتطبيقًا والطب وغيرها من المجالات لأن الناس آمنوا بقدرتهم على صنع أشياء جديدة، والنظر من زوايا جديدة، وتحقيق طفرات جديدة. والبعض نظروا إلى قوتهم باعتبارها منحة من الله أو من الآلهة، واعتبروا ما يقدمونه من خدمات وإنجازات نوعًا من العبادة لله، في حين نَظَرَ البعضُ الآخر إلى قوتهم من منظور غير ديني. ولكن في الحالتين كان الناس يعترفون بقوتهم -أيًا كان مصدرها- وكذلك بمسؤوليتهم عن استعمال تلك القوة لخير المجتمع.
وقد كان يمكنني اختيار أي عدد من الفلاسفة الإنسانيين من القائمة الطويلة التي تتضمنها الثقافات الشرقية والغربية ليكون الطرفَ الآخر أمام كولن في المحاورة الأخيرة في هذا الكتاب عن موضوع المسؤولية. فقد اهتم الكثير من الفلاسفة والكتاب ورجال الدولة والمنظرين والمفكرين من مختلف القرون والثقافات بموضوع المسؤولية بدرجات متفاوتة في أعمالهم، وحتى من لديهم إيمان عقدي قوي بوجود إله قدير وعليم بيده القضاء والقدر يمكنهم عمل قائمة كهذه بمن يؤكدون بقوة على المسؤولية الإنسانية عن العالم (وكولن نفسه ينتمي إلى هذه الفئة). لكنني اخترت لهذه المحاورة الأخيرة الاسمَ الأبرز في واحدة من أكثر المدارس الفلسفية تأثيرًا في القرن العشرين، وأكثرَ مَنْ دَافَع عن فكرة المسؤولية الإنسانية عن كل شيء، وهو الفيلسوف جان بول سارتر، صاحب المدرسة الوجودية.
وتثور على الفور أسئلة حول هذا الاختيار، وهي أسئلة مشروعة يجب علينا بحثها أولاً قبل المضي في الموضوع. بدايةً، قد يبدو مثيرًا للجدل الجمع بين كولن وملحد مثل سارتر، فكيف يمكن أن يوجد أي اتفاق أو محاورة بين ملحد من ناحية وعالم مسلم من الناحية الأخرى؟ ولماذا نريد أن تكون هناك أي محاورة بينهما؟ فكلٌّ من الملحدين والمؤمنين -وخصوصًا الموحدين- لا يتقبل الآخر، وبالتالي فليس لديهم استعداد للحوار. لكن هذا هو السبب في أن حوارًا كهذا ينبغي أن يحدث، حتى وإن كان ذلك في حالتنا هذه على صفحات كتاب. فالطبيعة الحرة للضمير الإنساني تضمن أن الملحدين والموحدين -وكل درجات الإيمان أو الكفر فيما بينهما- سيظلون موجودين في هذا العالم كما هو حاصل الآن، وكما كان يحصل دائمًا، وكل ما يفعله الرفض المتبادل بين الملحدين والمؤمنين هو أنه يقلل من فُرص التعايش السلمي في عالمنا اليوم بكل ما فيه من عولمة وتنوع مذهل. وليس بإمكاننا أن نسمح للرفض المتبادل بأن يصبح -أو أن يظل- هو الأصل والقاعدة بين من يختلفون في أمور الإيمان، بل علينا أن نشجع الحوار حتى بين من ليس لديهم -أو يبدو أنه ليس لديهم- شيء يقولونه لبعضهم البعض.
ثانيًا، أن كولن نفسه ينتقد سارتر والوجودية صراحةً، ففي كتاب (The Statue of Our Souls) [ونحن نقيم صرح الروح] يضع كولن الوجودية ضمن قائمة طويلة من المدارس والفلسفات الضالة التي اكتسحت تركيا والغرب في القرنين التاسع عشر والعشرين، ومن ضمنها الماركسية والدوركايمية واللينينية والماوية. يقول كولن عن حال الشباب التركي في تلك الفترة:
"فمنهم من واسى نفسه بأحلام الشيوعية ودكتاتورية البروليتاريا، ومنهم من غاص مع فرويد وعُقَدِه، ومنهم من ضيع عقله في الوجودية ووقع في شراك سارتر، ومنهم من سال لعابه متأثرًا بأفكار ماركوس، ومنهم من أهدر عمره لاهثًا خلف هذيان كامو..."([1])
وكما هو واضح، فإن كولن ليس من المعجبين بالوجودية أو باثنين من أكبر مؤيديها وهما سارتر وكامو. إذن، كيف، ولماذا نضع سارتر في أي نوع من الحوار العقلاني مع أفكار كولن، في حين أن كولن لديه مثل هذه النظرة السلبية نحو أفكار سارتر؟ يعد هذا تكرارًا للسؤال الأول ولكن بصيغة مختلفة، فكولن يرفض الوجودية في كثير من الجوانب، ولو أن سارتر مازال حيًا كان سيرفض الكثير من أفكار كولن. ولكن هذا لا يمنع من إجراء محاورة بينهما، إذ لو كان الأمر كذلك لكان هذا ضربة قوية في صميم مشروع الحوار بأكمله، والذي يمثل محورًا أساسيًا في حركة كولن؛ لأنه عندئذ لن يوافق على الحوار إلا مع من يوجد بينهم اتفاق كبير. فالعلاقة الصادقة والاحترام المتبادل يمكن أن يوجدا بين أناس يختلفون بشدة في وجهات النظر مع بعضهم البعض، كما هو الحال بين كولن وسارتر أو أي مؤمن مع أي ملحد. علاوة على ذلك، فإن كولن يمكن أن يؤدي واجبه كعالم مسلم يُلزمه القرآن باستنكار الإلحاد ورفض الأفكار الإلحادية ولكن مع احترام الشخص نفسه، ببساطة لأنه إنسان له قيمة وكرامة متأصلة. والحوار هو الوسيلة التي تجعلنا نستمر في الإحساس بإنسانية الآخرين، حتى عندما -أو ربما خصوصا عندما- نختلف بشدة مع أفكارهم. فاكتشاف جوانب مشتركة من بين نقاط الاختلاف الجذرية يُعد إستراتيجية مجربة للتعايش السلمي بين من توجد بينهم خلافات حادة، بل ربما تكون مثل هذه الحوارات الصعبة أَولى الحوارات بإجرائها. ومن هذا المنطلق، هيا بنا ننتقل إلى كولن وسارتر لنرى أي روابط -إن وجدت- يمكن أن تجمع بين أفكارهما.
لقد عانت أفكار سارتر -والأفكار الوجودية بشكل عام- من الشعبية التي اكتسبتها الحركة الوجودية في منتصف القرن العشرين، حيث زادت شعبيتها كفلسفة -سواء في فرنسا نفسها أو في جميع أنحاء الغرب- إلى درجة أنها تحولت إلى موضة قصيرة العمر. وكانت الوجودية، ومازالت، تنتشر بين العامة بسبب شخصيات تعكس تفسيراتُهم فهمًا شعبيًا "جماهيريًا" لأفكارها أكثر مما تعكس قراءة قوية وشاملة لموضوعاتها الأساسية كما تعبر عنها أعمال الكثيرين من ممثلي هذه المدرسة. ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن معظم الوجوديين ليسوا متفقين حول الكثير من النقاط، أو جميعِها في بعض الحالات. ويَعتبر معظم الناس سارتر -أحد أغزر الكتاب إنتاجًا في الوجودية- هو المعبر الأول عن المفهوم الوجودي بأكمله، وهي مكانة يعترف بها هو نفسه بدرجة معينة في بعض اللحظات في مؤلفاته.
لقد كان سارتر على وعي بالتفسيرات الضيقة والخاطئة غالبًا للوجودية والادعاءات التي تثار في الثقافة الشعبية حول تلك المدرسة الفكرية ككل، وقد رد على هذه الإدعاءات في مقالة معروفة بعنوان "الوجودية كفلسفة إنسانية" (Existentialism as a Humanism) أو باختصار "الوجودية" (Existentialism) ضمنها في كتاب نشر عام 1957 بعنوان "الوجودية والمشاعر الإنسانية" (Existentialism and Human Emotions). وفي هذه المقالة يحدد سارتر الأخطاء الرئيسية التي يقع فيها الناس عند تفسير الوجودية أو عند تحديد مواقفها الأساسية من الواقع الإنساني. وفي دفاعه عن الوجودية ضد تلك الإدعاءات المثيرة للجدل، نلمح رؤية للوجود الإنساني في العالم تختلف تمامًا عن التفسيرات الأكثر شيوعًا للوجودية، حيث يتحدث سارتر عن موضوع المسؤولية الإنسانية التي تحفز على العمل المتحمس والتأكيد الشديد على القدرة الإنسانية على تشكيل هذا العالم، لدرجة أنه يكاد يستعمل مصطلح "الواجب" (duty) لوصف علاقة البشر تجاه العالم الذي يُـمْكنهم تشكيلُه وتغييره. وتلوح ظلال هذه الكلمة من بين السطور حتى وإن لم يذكرها صراحةً، فهو يقول: إن من يختارون الحياة في هذا العالم ولا يتحملون المسؤولية عنه يعيشون حياة إنسانية ناقصة ويعيشون جبناء. وهذا المبدأ -وغيره كثير- تتفرع عنه مجموعة من الأفكار التي تتوافق بدرجة كبيرة -كما يتضح لنا- مع موضوعات معينة في فكر كولن.
ويلخص سارتر في بداية المقالة التهمَ الموجَّهة ضد الوجودية ثم يشرح تصوره لها. ومن خلال شرحه للعناصر الأساسية للوجودية يرد على التهم الأكثر شيوعًا التي تُلصَق بها، وهي تُهَمٌ بسيطة ومعروفة تنبع من الفهم الشعبي للوجودية: أنها تشجع على السلبية والعزلة الصوفية (Quietism)، وأنها تتلقف كل ما هو قبيح في الحياة وتركز عليه، وأنها تنكر جدية الأعمال الإنسانية. وباختصار، ينتقد الناسُ الوجودية الإلحادية الفرنسية لأنهم يفسرونها باعتبارها نوعا من العدمية (Nihilism) أو الاحتفاء بالعدم، فلا وجود فيها لشيء ثابت؛ فلا إله، ولا قيم مطلقة، ولا معنى حقيقيا للحياة أو للناس؛ وبالتالي فليست هناك فائدة من أن يصبح المرء فاعلاً سياسيًا، أو اجتماعيًا، أو أن يبذل جهودًا جادة لتحسين العالم أو لتحقيق قفزات في مجالات المعرفة.
ويرفض سارتر هذا الفهم للوجودية بل ويتهكم به، ويخصص الجزء الأول كاملاً من رده على تلك التهم لتعريف الوجودية بدقة، فيشير إلى أن كل أشكال الوجودية -سواء المسيحية أو الملحدة- تتبنى رأيًا واحدًا مشتركًا وهو أن الوجود يسبق الجوهر (Essence). ويقول سارتر دفاعًا عن الأشكال المتعددة للوجودية الإلحادية؛ إن هذا الرأي ينطبق بشكل خاص على هذا النوع من الوجودية، ذلك أن "الجوهر" هنا يشير إلى هدف أو مقصد أو طبيعة معينة، فمعظم الجمادات خُلقت لتحقق هدفًا أو غاية قصدها خالقها وصانعها.. فقاطعة الورق مثلاً جاءت إلى الوجود بعد أن صممها مخترعها وصنعها استجابة لغرض أو هدف أو مقصد يريده منها، فقد احتاج إلى شيء يقطع به الورق ولكنه لم يجد شيئًا يؤدي تلك الوظيفة، لذا قام باختراع قاطعةِ ورق يكون غرضُ ومعنى وجودِها هو قطيع الورق، وهكذا فإن جوهر قاطعة الورق قد سبق وجودها. ويقول سارتر: إن معظم الناس يفكرون في الله بنفس القياس مع البشر: أن الله خلق البشر لغاية أرادها وأن معنى وجودهم يرتبط بتلك الغاية، أي أن جوهرهم يسبق وجودهم تمامًا كقاطعة الورق. وهذا المعنى أو الغاية أو الطبيعة يحددها سلفًا مَن قام بالصنع في كلتا الحالتين، والأشياء تأتي إلى الوجود وتسعى -كما في حالة البشر- إلى التعرف على تلك الغاية حتى يمكنهم العثور على السعادة.
إلا أن سارتر ملحد، وهذا يعني أنه لا يؤمن بإله كانت توجد في ذهنه غايةٌ أو معنى أو طبيعة إنسانية -أي "الجوهر" الإنساني- قبل حتى أن يقوم بخلق البشر أنفسهم. وبما أنه لا إله فإن البشر يأتون إلى هذا الوجود أولاً ثم يأتي جوهرهم بعد ذلك، أي أن الوجود بالنسبة للبشر يسبق الجوهر، وهذا هو المبدأ الأول في الوجودية. يوضح سارتر ذلك فيقول:
ماذا يعني هنا القول: إن الوجود يسبق الجوهر؟ هذا يعني أولاً أن الإنسان يوجد ويأتي إلى هذه الحياة، ثم يبدأ بعد ذلك في تحديد ماهيته. فإذا كان الإنسان -كما يراه الوجوديون- لا يمكن تحديد ماهيته، فذلك لأنه في الأساس لم يكن شيئًا، ولكنه بعد ذلك أصبح شيئًا، وهو نفسه من يصنع ماهيته. وعلى ذلك فليست هناك طبيعة بشرية؛ لأنه لا يوجد إله لكي يدركها، والإنسان ليس هو ما يعتقد أنه هو فحسب، بل هو أيضًا ما يريد أن يكون عليه بعد مجيئه إلى الوجود. فالإنسان ما هو إلا ما يصنعه من نفسه، وهذا هو المبدأ الأول في الوجودية.([2])
إذن، فليس هناك مقصد أو غاية محددة سلفًا للحياة الإنسانية؛ لأنه لا يوجد إله لكي يحدد هذا المقصد أو الغاية. والبشر يوجَدون في هذه الدنيا هكذا دون مسبب ويجب عليهم أن يوجِدوا لأنفسهم معنى وغاية وطبيعة لوجودهم في الحياة. ونحن نرى في هذا المبدأ بذور المسؤولية التي ينثرها سارتر في فلسفته عن البشر، خاصةً وأن البشر يأتون إلى الوجود ككائنات مفكرة ثم -مع نموهم المعرفي- يصبح لديهم الوعي الذاتي. ويستطرد سارتر قائلاً:
الإنسان في الأصل هو عبارة عن خطة تدرك نفسها بنفسها، وليس قطعة خشب أو قمامة أو ريشة في مهب الريح، وليس هناك شيء موجود قبل هذه الغاية، لا يوجد شيء في السماء، والإنسان يكون ما يخطط لأن يكونه... ولكن إذا كان الوجود يسبق الجوهر حقًا، فإن الإنسان يكون مسؤولاً عما هو عليه. إذن، فإن أول هدف للوجودية هو أن تجعل كل إنسان يعي من هو، وأن تجعل المسؤولية الكاملة عن وجوده الإنساني تقع على عاتقه هو. وعندما نقول: إن الإنسان مسؤول عن نفسه فنحن لا نعني أنه مسؤول عن فرديته الخاصة فحسب، بل هو مسؤول عن البشر جميعًا.([3])
وتظهر في هذه الفقرة مسألتان جديرتان بالمناقشة؛
أولاهما: أن المسؤولية التي يتحدث عنها سارتر تتعدى الإنسان الفرد إلى جميع البشر. وهذا الرأي يرتبط بفهم سارتر للذاتية (Subjectivity) والذي يتلخص في أن البشر دائمًا مرتبطون بهذا العالم، العالم الإنساني، عالم البشر. فنحن لا يمكن أبدًا أن نخرج من هذا العالم، من ذاتنا الإنسانية، وأن ننظر من منظور "موضوعي" أو غير ذاتي (objective) بمعزل عن العالم وعن الآخرين. فنحن بطبيعتنا نوجَد جميعًا في هذا العالم مع الآخرين، نوجد كجزء من هذا العالم، نشترك فيه جميعًا بإنسانيتنا. وبالتالي، عندما نختار لأنفسنا ونتحمل مسؤولية بناء حياتنا، فإننا لا نفعل ذلك من أجل أنفسنا وحدنا، بل نفعل ذلك من أجل الجميع لأننا نرتبط بالجميع. فنحن متجذرون في الذاتية، وعندما نقرر أو نختار فإننا نقدم القرار أو الاختيار، ليس فقط لأنفسنا كأفراد بل نقدمه للجميع. يقول سارتر: "ونحن إذ نخلق الإنسان الذي نريد أن نَكُونَه، فإنه لا يكون هناك تصرف واحد من تصرفاتنا لإلا ويعكس في نفس الوقت صورة للإنسان الذي نعتقد أنه ينبغي أن نكونه".([4])
النقطة الثانية التي تستحق المناقشة في الفقرة السابقة هي تعريف سارتر للإنسان؛ حيث يميز فيها بين البشر و"قطعة الخشب أو القمامة أو الريشة في مهب الريح"، فالبشر -حسب رأيه- ليسوا مجرد أشياء ضمن غيرها من الأشياء تعبث بها يد التاريخ أو الغريزة الجسدية العمياء أو ظروف الطبيعة. وقد أبرز سارتر هذه النقطة بشكل أكبر في موضع لاحق من مقالته، فيقول عن نظرية الوجودية:
هذه النظرية هي النظرية الوحيدة التي تمنح للإنسان الكرامة، وهي الوحيدة التي لا تهبط بقدره إلى أن يكون مجرد "شيء". وما تفعله المادية هو أنها تعامل البشر جميعًا -بمن فيهم الفلاسفة الماديون أنفسهم- كأشياء، أي كمجموعة من ردود الفعل الثابتة التي لا تختلف إطلاقًا عن مجموعة الخصائص والظواهر التي تكوِّن الطاولة أو الكرسي أو الحجر. ونحن بالتأكيد نريد أن نعتبر العالم الإنساني كمجموعة من القيم التي تتمايز عن العالم المادي.([5])
هنا، يميز سارتر الوجودية عن المادية، التي يرفضها كولن وكثيرون غيره ممن لديهم منظور ديني، إما باعتبارها مظهرًا للاختلال الروحي أو جانبا من جوانب الإلحاد، وإما باعتبارها رؤية اختزالية (Reductionist) للحياة الإنسانية. وسارتر أيضًا يرفضها ولكن لاعتبارات مختلفة؛ فوجودية سارتر لا تسمح أبدًا بوضع الناس في مستوى الأحجار أو الكراسي أو قِطَع الخشب، وإنما تصر على أن البشر أكبر من ذلك، ليس لأن الله خلقهم لهدف أو لغاية معينة، ولكن لأننا نُظهر بوضوح منذ ميلادنا ملكة الوعي والوعي الذاتي والوعي الذاتي بالذات (Self-Self-consciousness)، وهو ما نختلف فيه مع أي كائن حي آخر. فخلافًا للكائنات الأخرى، نحن نفكر -بكل المعنى الديكارتي للكلمة- وهذا يتضمن التفكير الذاتي أو التفكير في الذات، وهو ما يمثل فارقًا كبيرًا بين البشر وجميع الكائنات الحية الأخرى. علاوة على ذلك، فإن هذا الجانب من الكينونة الإنسانية هو ما يدفع إلى إيجاد القيم والمثل العليا والغاية، فلكوننا بشرًا بهذا الشكل ومتجذرين في الذاتية الإنسانية، علينا أن نقول لأنفسنا في بداية أي فعل إذا كنا صادقين ومتحملين للمسؤولية في هذا العالم: "هل أنا حقًا الإنسان الذي يحق له أن يتصرف بحيث تسترشد الإنسانية بتصرفاته؟"([6]) يقول سارتر: إن الإنسان الذي لا يسأل نفسه هذا السؤال يعيش في ما يسميه "سوء نية" (bad faith) مع نفسه ومع العالم.
ومما هو واضح أن أي شخص محبطٍ ومرهق وسلبي ومنعزل ليس هو من يجول بخاطر سارتر هنا عندما يتحدث عن شخص يتحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية العالم، فشخص كهذا سيتهرب من مسؤوليته عن حياته الخاصة -وكذلك عن حياة الآخرين- كمن ينفض يديه من الأمر: "ماذا يمكن عمله؟ لا شيء". على العكس تمامًا، هناك الكثير مما يمكن عمله كما يقول سارتر، ونحن الوحيدون الذين ينبغي أن يقوموا به، ونحن "نقوم به" فعلاً حتى عندما نجلس ونقول: "إننا لا نفعل"، وننكر مسؤوليتنا عنه قائلين: "إننا ولدنا هكذا" أو "إنه لا يمكننا فعل شيء حياله" أو "إن القدر شاء هذا". إن الاستسلام والسلبية هما نتاج فلسفة تتخلى عن الحياة الإنسانية وتتركها لتصرف القدر والحتمية المادية، أما الوجودية فهي ترفض فكرة الجبرية والحتمية المادية وتعتبر الحياة الإنسانية ميدانًا للحركة والمسؤولية، انطلاقًا من الاقتناع بأنه لا يوجد غيرنا وأننا سنكون ما نريد أن نكونه وأن العالم سيكون كما نصنعه، لا أكثر ولا أقل. ويفرد سارتر معظم مقالته لوصف "مظاهر" الحياة بهذا الوعي بالمسؤولية والفعل، وهو يلخصها في ثلاث كلمات: الألم (anguish) والحرمان (forlornness) واليأس (despair). وهذه الكلمات عندما يساء تفسيرها تجعلنا محبطين وسلبيين، ولكن عند فهمها فهمًا سليمًا فإنها تجعلنا نتحرك في هذه الحياة ونحن نحاول تحقيق أفضل الخطط التي نضعها لأنفسنا وللعالم من حولنا.
ويعني سارتر بالألم الخبرة التي يمر بها المرء عندما يعيش ولديه وعي كامل بالمسؤولية، فيقول:
ومعنى هذا [الألم] هو أن الإنسان الذي يشغل نفسه والذي يدرك أنه ليس الشخص الذي يختار أن يكونه فحسب، بل هو أيضًا مشرِّع يقوم في ذات الوقت باختيار البشرية كلها علاوة على نفسه، لا يمكنه التوقف عن الهروب من شعوره الكامل والعميق بالمسؤولية. صحيح أن هناك كثيرين لا يشعرون بالقلق، ولكننا ندعي أنهم يُخفون قلقهم وأنهم يهربون منه.([7])
وكلا هذين النوعين -اللذين يهربان من الألم نفسه أو من فكرة تحمل المسؤولية ككل- يمثلان سوء نية في نظر سارتر، وهو يرى أن كل من يشغل موقع قيادة يعرف هذا الألم، مثل القائد العسكري الذي يقرر ما إذا كان سيقود جنوده إلى خوض معركة، مدركًا أن حياة رجاله تتوقف على هذا القرار، وهو بالطبع يمكنه تفادي المسؤولية وإحالتها إلى رؤسائه قائلاً: إن قيادته للرجال إلى المعركة كانت مجرد تنفيذ للأوامر. غير أن سارتر يقول: إن القائد قد فسر تلك الأوامر وقرر تنفيذها من عدمه، وبالتالي فهو مسؤول عن اختياره. وعدمُ الشعور بالألم في هذا الموقع لا يكون تحملاً للمسؤولية، كما أن الشعور بالألم لا يسمح بالتراخي من جانب القائد، فمازال عليه اتخاذ قرارِ إرسال جنوده إلى المعركة من عدمه، وهذا الألم -الذي لا يمكن اعتباره مبررًا للتراخي- هو الشرط الأساسي للتحرك والعمل. وهذا الألم كما يقول سارتر "ليس حاجزًا يفصلنا عن العمل، بل هو جزء من العمل ذاته".([8])
الحرمان أيضًا بسيط للغاية، من وجهة نظر سارتر الذي يقول: "لا نعني بالحرمان سوى أنه لا يوجد إله، وأنه علينا مواجهة عواقب ذلك".([9])
ويرفض سارتر ميل أنصار الحداثة في الغرب إلى ادعاء الإلحاد مع الاستمرار في التصرف وكأنه يوجد عالم سامٍ من المبادئ الأخلاقية والغاية أو المعنى للأشياء. ففي هذه المنظومة الفكرية يعتبر الإله مفهومًا عتيقًا ينبغي التخلي عنه، إلا أن القيم والمعاني المبنية على وجود الإله مازال من الممكن بطريقة ما إعطاؤها نفس المكانة والأهمية القصوى كما لو كان الإله موجودًا، حتى يمكن للمجتمع أن يتقدم للأمام بشكل مطمئن. وسارتر لا يجد هذا غير منطقي فحسب بل وغير مسؤول أيضًا، فيقول:
والإنسان الوجودي على العكس يعتقد أنه من المحزن للغاية ألا يوجد إله؛ لأن كل إمكانية للعثور على القيم في سماء الأفكار تختفي معه، إذ لا يعود هناك خير بدهي لأنه لا يوجد وعي مطلق وكامل لكي يفكر فيه. يقول دوستويفسكي: "إذا انتفى وجود الله، فإن كل شيء سيكون ممكنًا". وهذا هو المنطلق الرئيسي للوجودية، أن كل شيء يكون مباحًا إذا لم يكن هناك إله، ونتيجة لهذا يكون الإنسان بائسًا لأنه لا يجد أي شيء سواء في نفسه أو خارجها لكي يتشبث به، فلا يمكنه أن يبدأ في اختلاق الأعذار لنفسه.([10])
والجملة الأخيرة هي الشاهد هنا، ومن السهل أن تغيب عنا. فسارتر لا يقول: إننا ينبغي أن نفعل ما يحلو لنا لأنه مع عدم وجود إله لا يوجد شيء له قيمة محددة إلهيًا ولا وجود لفكرة الخير أصلاً. بالعكس، فهو يقول: إننا عندما نحيا بوعي كامل بهذه الحقائق، فإننا نرى بوضوح أننا نحن المسؤولون عن كل شيء وليس الله، إذ لا يوجد لدينا أي أساس يجعلنا نُرجع ما يحدث في حياتنا إلى "إرادة الله" أو مشيئته أو أي شيء من هذا القبيل، فنحن نقرر ما هو جيد وقيم وليس الله، ونحن نشعر بالألم الذي يصاحب هذا الموقع بما يتضمنه من المسؤولية المطلقة عن كل شيء، والحرمانُ أو الوحدة التي نعيش فيها في هذا العالم، وعدم الشعور بهذا -أو محاولة تجاهله- يعد اختلاقًا للأعذار لأنفسنا.
ويذهب سارتر إلى حد القول: إنه حتى لو كان هناك إله فإن هذا لن يغير موقفنا الإنساني، ويَضرب عدة أمثلة في مقالته على المؤمنين الذين يعيشون كما لو أن الله قد اختار لهم طريقهم: امرأة تسمع أصواتًا روحانية تأمرها بعمل أشياء، وطالِبٌ يحصل على التوجيه الإلهي في حياته عن طريق قس، وشخص كاثوليكي يتصرف تبعًا لعلامات من الله، وشخص يسوعي يرى يد الله تسيِّر مجريات حياته. يقول سارتر: إن الناس في كل هذه الأمثلة يحاولون تجنب المسؤولية، ليس لأنهم يجرؤون على الإيمان بالله، ولكن لأنهم يرفضون رؤية مسؤوليتهم الخاصة فيما يؤمنون به، فهم لا يرون أنهم هم أنفسهم يحددون ما يُعتبر علاماتٍ من الله وما لا يعتبر، وما إذا كانت الأصوات المسموعة صادرة من الله أم من الشيطان، وما إذا كان القس صادقًا أم لا، وكيفية تفسير النص المقدس، وغير ذلك. فحتى لو كان الإله موجودًا وكان يرسل الملائكة للحديث إلينا وإملائنا الوحي الذي نكتبه كلمة كلمة، فنحن من يقرر ما إذا كانت الملائكة تستحق الاستماع إليها أم لا، وكيفيةَ تفسير الكلام الذي ينزلون به علينا. فنحن في النهاية مازلنا مسؤولين، ولا نستطيع اختلاق الأعذار لأنفسنا أو التنصلَ من الأمر. ويوضح سارتر في نهاية مقالته أن الوجودية لا تضيع وقتًا في الدفاع عن الإلحاد لأن هذا في النهاية لا يُحدث فرقًا فيما يتعلق بالمسؤولية الإنسانية. يقول سارتر:
الوجودية ليست من الإلحاد بحيث تستميت في سبيل إثبات أن الله غير موجود، بل هي تؤكد أنه حتى لو كان هناك إله فإن ذلك لن يغير شيئًا. هذه هي وجهة نظرنا، فليس الأمر أننا نؤمن بوجود الله، ولكننا نعتقد أن مشكلة وجوده ليست هي القضية.([11])
وفي كلتا الحالتين فنحن مسؤولون عن هذا العالم وعن قيمنا وعن معنى وغاية وجودنا فيه. هذا أمر لا يمكن الهروب منه، ومن يحاول أن يفعل ذلك سيعيش بسوء نية مع هذا العالم.
وأخيرًا، يقصد سارتر باليأس أنه يجب علينا أن نعمل في هذا العالم -كوكلاء مسؤولين مسؤولية كاملة- دون أن نعرف مطلقًا ما إذا كانت أعمالنا ستحقق النتائج المنشودة أم لا. فنحن لا نستطيع أن نعتمد -كما فعل هيجل- على روح غيبية (geist) توجه حركة التاريخ نحو الأهداف الأسمى لأعمالنا، ولا نستطيع أن نعتمد على الخير الفطري داخل الإنسان أو الوجود المطلق للحق أو أيٍّ من هذه المفاهيم كي نضمن أن أعمالنا ستُحقق لنا المستقبل المنشود، فليس هناك شيء مضمون. يقول سارتر:
"إنني -بالأخذ في الاعتبار أن البشر أحرار وأنهم غدًا سيقررون بحرية ما سيكون عليه الإنسان- لا يمكن أن أكون متأكدًا من أن زملائي المناضلين سيواصلون ما أقوم به من عمل بعد موتي لكي يصلوا به إلى أقصى درجات الكمال. فغدًا بعد أن أموت، قد يقرر البعض أن يصفنا بالفاشية، وقد يكون الآخرون جبناء وفارغي العقول بما يكفي لتركهم يفعلون ذلك، وستكون الفاشية عندها هي الواقع الإنساني، وهو أسوأ شيء بالنسبة لنا. في النهاية، ستسير الأشياء على ما يرى البشر أنها ينبغي أن تسير عليه".([12])
إذن نحن ليست لدينا أية ضمانات على أن أعمالنا ستثمر بعد أن نموت ونصبح خارج دائرة الفعل، مما قد يجعل البعض يقولون: إن هذه الحقيقة وحدها تبرر التراخي والسلبية ويسألون لماذا ينبغي على المرء أن يزعج نفسه بإصدار الأفعال إذا كان من الممكن ألا تثمر أفعاله شيئًا. ويكرر سارتر: إننا مسؤولون، ونحن نبقى مسؤولين عن العالم بأكمله حتى مع أننا مقيدون بأعمارنا المحدودة، وهو ما يجعلنا نشعر باليأس. يقول سارتر:
هل يعني ذلك أنني يجب أن أهجر حياتي وأتجه للعزلة الصوفية؟ لا، عليَّ أولاً أن أشعر نفسي بالاهتمام ثم أعمل بالمثل القديم: "لا مكسب من دون مخاطرة". ولا يعني ذلك أيضًا أنه ينبغي ألا أنتمي إلى جماعة، بل يعني أنه لن تكون لديَّ أي أوهام وأنني سأفعل ما بوسعي. على سبيل المثال، لنفترض أنني أسأل نفسي: "هل المشاركة الاجتماعية بهذا الشكل ستحدث؟" لا أعرف. كل ما أعرفه هو أنني سأفعل كل ما بوسعي لإيجادها. وبخلاف هذا لا يمكنني الاتكال على أي شيء. فالعزلة الصوفية هي موقف من يقول: "دع الآخرين يفعلوا ما لا يمكنني فعله"، وما أطرحه هنا هو العكس تمامًا من العزلة، إذ يقول: "لا توجد حقيقة سوى في الفعل"، بل يذهب إلى ما وراء ذلك ويضيف: "ليس الإنسان سوى ما يخططه لنفسه، فهو يوجَد فقط بقدر ما يحقق نفسه، وبالتالي فهو ليس سوى مجموع أفعاله، ليس سوى حياته."([13])
إذن، فاليأس، مثل الألم، هو الشرط للتحرك والفعل، ولا يمكن أن يكون عذرًا للتراخي إذا ظل لدينا إحساس بالمسؤولية عن هذا العالم. إن الصورة التي تقدمها هذه الفقرة هي صورة أناس يهبون أنفسهم تمامًا للمهام الواجبة عليهم والمشاريع والخطط التي يشعرون بأكبر التزام تجاهها، ويجدون فيها أعلى درجات الإنجاز، مع إدراكهم طوال الوقت أنه لا توجد ضمانات بأن العمل سيكتمل، ولكنهم يدركون أيضًا أنهم مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذا العالم، مهما كان الألم والحرمان واليأس.
وجدير بالذكر هنا أن تحمل المسؤولية وما يصاحبها من الألم والحرمان واليأس لا يعني بالضرورة الحياة في تعاسة، فسارتر يذهب إلى حد القول: إن الوجودية هي نوع من أنواع التفاؤل، وإن كان تفاؤلاً قاسيًا. فالحياة في إطار من المسؤولية تتضمن بالتأكيد التضحية والمعاناة، لكن هذا لا يعني التعاسة أو الإحباط طوال العمر، فالحياة في إطار من المسؤولية هي حياة العمل والإنجاز وتحقيق المشاريع، حياة الخلق والابتكار، فهذه الحياة وهذا العالم مصنوع ونحن من صنعناه، نحن البشر الذين يتميزون عن كل ما عداهم بما لديهم من الوعي الذاتي وما يكمن بداخلهم من إدراك القيم والضمير. ومعظمُ الناس -بالطبع- يشعرون بالرعب من فكرةِ إمكانية العيش في مثل هذه الحياة المصنوعة، فهم لا يريدون تحمل المسؤولية كاملة عن حياتهم أو عن العالم، ويفضلون بدلاً من ذلك تحميل القدر أو الله أو الظروف أو الطبيعة أو البيولوجيا المسؤوليةَ عن حياتهم. وعندما يواجهون هذه الهالة من الرعب التي تحيط بفكرة تحمل المسؤولية، نجدهم يهربون ويلجأون إلى سوء النية ومهاجمة المدرسة الفكرية التي تؤكد على تحملهم للمسؤولية.
وقد عاش سارتر حياته كناشط اجتماعي وسياسي وأيضًا كفيلسوف ومعلم وجندي ومواطن مهموم منفذًا لفكرة المسؤولية هذه ومتسقًا معها. يقول سارتر في نهاية مقالته:
وهكذا، أعتقد أننا قد رددنا على عدد من التهم الموجهة إلى الوجودية، فأنتم ترون أنه لا يمكن فهمها باعتبارها فلسفة تنادي بالعزلة والتصوف لأنها تعرف الإنسان من خلال ما يقوم به من أفعال وتصرفات، ولا باعتبارها وصفا متشائما للإنسان؛ فليس هناك مذهب متفائل أكثر منها؛ لأنها ترى أن قدر الإنسان موجود بداخله، ولا باعتبارها محاولة لتثبيط الإنسان عن العمل والحركة؛ لأنها تخبره أن الأمل الوحيد هو فيما يقوم به من فعل وأن هذا الفعل هو الشيء الوحيد الذي يمكِّن الإنسان من الحياة. إذن فنحن نتعامل هنا مع فلسفة تنادي بأخلاقيات العمل والمشاركة.([14])
ولا يرفض كولن سارتر بسبب أفكاره عن المسؤولية، فهما في الحقيقة متفقان إلى حد بعيد في هذا الموضوع، حتى وإن اختلفا في كل ما عداه تقريبًا. فكولن -كمسلم تنطلق أفكاره كلها من سياق إسلامي- يتحدث عن قضايا الخلافة والمسؤولية الإنسانية في هذا العالم بطريقة مشابهة لكل أقوال علماء الدين تقريبًا في الديانات الكبرى التي تنادي بالتوحيد عند التعاطي مع تلك الموضوعات. فهذه الموضوعات في الحقيقة ظلت تغذي وتثري النقاش والتحليل والجدل عبر القرون داخل كافة الديانات الكبرى التي تؤمن بوجود إله قوي وعليم. والمشكل في هذه القضية هو التوفيق بين الإرادة والعناية الإلهية من ناحية وبين الإرادة والفعل الإنساني من الناحية الأخرى. فمعظم علماء الدين الموحدين -خصوصًا من يؤمنون بالثواب والعقاب- لا ينفون حرية الإرادة الإنسانية؛ لأن في ذلك نفيا لمسؤولية البشر عن أفعالهم، مما يشكك في عدالة دخول الجنة أو النار كجزاء لأفعال الإنسان، وهو اعتقاد أساسي في كلٍّ من المسيحية والإسلام. فإذا لم تكن للبشر إرادة حرة، فكيف يمكن معاقبتهم أو إثابتهم على أعمالهم؟ ومن الناحية الأخرى، فإن القول بوجود تفويض إنساني حر ومطلق يتعارض مع فكرة السلطة الإلهية، فالله ليس المدبر الأسمى للعالم لو اختار البشر بإرادتهم الحرة طريقًا آخر لهذا العالم. ولهذا فقد حظي ذلك الصراع بين التدبير الإلهي والإرادة الإنسانية الحرة بقدر كبير من الاهتمام في أوساط علماء الدين، وهناك محاولات كثيرة ومتعددة لتسوية هذا الصراع أو تخفيفه في مختلف الثقافات. ولسنا بحاجة هنا للإفاضة في الحديث عن تلك المحاولات، سنذكر فقط أن هذه المعضلة أو القضية تظهر في الخلفية عندما يطرح كولن أفكاره عن المسؤولية الإنسانية في هذا العالم. فهو لن يقول أبدًا -كما فعل سارتر- إن البشر مسؤولون مسؤولية كاملة عن هذا العالم كما هو عبر التاريخ؛ لأن ذلك يتعارض مع فكرة التدبير والتقدير الإلهي التي يؤمن بها تمامًا. وينادي كولن بمفهوم الله في الإسلام، الله القوي المطلع خالقِ السماء والأرض، الذي وسع علمه كل شيء. وكلُّ ما هو كائن في الواقع والوجود ما هو إلا تقدير أو قضاء إلهي، وليس له أي كينونة أو وجود خارج هذا القضاء. وهذا الإيمان يغلف كل رأي يقوله كولن عن المسؤولية الإنسانية، وهو فارق أساسي بين رؤية كلٍّ من سارتر وكولن لا يقبل التقريب بأي حال من الأحوال.
إلا أن كولن يتحدث عن هذه القضية بشكل يفتح لنا بضعة قنوات للنفاذ عبرها إلى تفسير حديثه عن "الوعي بالمسؤولية" بالطريقة التي تحدث بها عنه في كتابه (The Statue of Our Souls) [ونحن نقيم صرح الروح] ومواضع أخرى. ويستعمل كولن في حديثه عن هذه القضية كلمة محورية وهي "الخليفة" (Vicegerent) أو "الخلافة" (Vicegerency)، وهذا الاستعمال يدل بالفعل على أن كولن يحاول أن يحقق التوازن الدقيق بين التدبير الإلهي والإرادة الإنسانية الحرة. فالخلافة تعني بالتأكيد الإدارة والحكم والمسؤولية، إلا أنها توحي بوجود تفويض من سلطة عليا ربما حتى عن طريق حكم أو أمر بذلك. وهذا يلخص رؤية كولن ورؤية كثيرين غيره من علماء الدين الذين ينادون بالوحدانية أمام ذلك التحدي الصعب بالتوفيق بين التدبير الإلهي والإرادة الإنسانية الحرة. فالله القوي المطلع قضى بخلق الوجود بحيث يكون العالم الإنساني داخل هذا الوجود متأثرًا بالخلافة أو الولاية الإنسانية، والناس إما يؤدون هذه المهمة أو لا يؤدونها فيعانون من العواقب في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكن مهما يكن من أمر يظل قضاء الله أو حكمته المطلقة وبالتالي الغيبية (لأن عقولنا المحدودة لا تستطيع استيعاب ما هو مطلق ولكنها تستطيع فقط التلقي عنه) من هذا العالم وكل ما يوجد فيه نافذة وجارية. هنا أيضًا نرى توازنًا دقيقًا قد لا يحسم الصراع تمامًا بين القضاء الإلهي والإرادة الإنسانية الحرة، ولكنه ربما يقوم بأفضل ما يمكن القيام به في هذا الشأن حيث يدع مجالاً حقيقيًا للخلافة والمسؤولية الإنسانية في هذا العالم، وهو ما يهمنا هنا.
ويبني كولن أفكاره عن خلافة الإنسان على الآية التي تقول: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾(البقرة:30).([15]) فالبشر هم خلفاء الله في هذا الكون. يقول كولن:
"إذا كان البشر هم خلفاء الله في الأرض ومن اصطفاهم الله على سائر المخلوقات ومحور كل الوجود وعصارته وأجلى مرآة تعكس تجليات الخالق -وهذا شيء لا يرقى إليه أدنى شك- فإن الذات الإلهية التي أَرسلت البشر إلى هذا العالم قد منحتهم الصلاحية القدرة على أن يكتشف الأسرار الكامنة في روح هذا الكون، ويبرز القوى والإمكانات المكنونة بداخله، ويستعملَ كل شيء في الغاية التي خَلق من أجلها، فيكون ممثلا شعوريا لصفات الله من علم وإرادة وقدرة... حتى لا يتعرض لعقبات لا يمكن تخطيها وهو في طريقه نحو التدخل في الوجود وأداء دوره كخليفة الله في أرضه".([16])
هنا، نرى كولن يقوم بذلك التوازن الدقيق الذي ذكرناه من قبل، فهو يؤكد بقوة على طبيعة البشر كخلق من خلق الله وآية أو مرآة لوجوده، وهم عباد لله وممثلون له في الوقت نفسه. فهذا هو دور الخليفة: التسليم الدائم لأوامر الله وأداء المهمة المنوطة به في تلك الأوامر بتنفيذ ما يريده الله في هذا العالم من خلال ما أودعه الله فيه من طاقات وصفات تعكس الصفات الإلهية. ويستطرد كولن في شرح الخلافة الإنسانية قائلاً:
"وتتسع خلافة الإنسان للخالق في مجال واسع جدا لتشمل أفعالاً تتدرج من الإيمان بالله وعبادته إلى فهم الأسرار الكامنة في الأشياء والحوادث، ومن ثم امتلاك القدرة على التدخل في مجريات الطبيعة... فالإنسان الحقيقي ينظم مشاعره وأفكاره طوال حياته كلها في إطار إيمانه، ويبرمج حياته الفردية والاجتماعية في ظل أنواع مختلفة من العبادات، ويوازن بين معاملاته العامة وعلاقاته الأسرية والاجتماعية، ويجعل رايات أبناء جنسه ترفرف في كل مكان بدءا من تخوم الأرض إلى أعماق الفضاء، فيقوم بمقتضى الخلافة الحقة، ويعطي "الإرادة حقها، وبذلك يقوم بإعمار الأرض، والحفاظ على التناغم الموجود بين البشر وباقي عناصر الوجود وجني خيرات الأرض والسماوات لنعيم البشرية وسعادتها، ومحاولة تحسين مستوى المعيشة وشكلها ومضمونها، لتصبح أكثر إنسانية في حدود ما أنزله الخالق من شرائع وقوانين. هذه هي الطبيعة الحقة للخليفة، وهذا في الوقت نفسه هو معنى أن يكون الإنسان عبدًا ومحبًا لله".([17])
إن الخلافة الإنسانية للخالق تحدث في مجال كبير يتسع لأفعال تتدرج من الإيمان بالله وعبوديته إلى فهم الألغاز ضمن الأشياء ومعرفة أسباب الظواهر الطبيعية، وبذلك يستطيع التدخّل في مجريات الطبيعة... هذه الكائنات تحاول ممارسة إرادتها الحرة بطريقةٍ بنّاءة من العمل على تطوير العالم والحفاظ على التوازن بين الإنسانية والوجود وحصد ثمرات الأرض والسماء لإفادة الإنسانية بشكل عام، فهم يحاولون رفع مستوى المعيشة ليكون مستوى أكثر إنسانية ضمن إطار تشريعات وقوانين الخالق. هذه هي الطبيعة الحقيقية للخليفة وفي نفس الوقت هذا هو معنى أن يكون الإنسان عبد وحبيب الله في آن واحد
لاحظ ذلك المدى الواسع للفعل الإنساني في دوره كخليفة، حيث يتضمن الإيمان والعبادة وفقًا للتعاليم الدينية والمعرفة العلمية بالعالم الطبيعي، وأساليب "التدخل" في مكونات ذلك العالم الطبيعي، أو استغلالها للحصول على نتائج إيجابية، وتحسين الحياة الإنسانية بأساليب أكثر ثراءً وإنسانية. فالبشر، كخلفاء، مسؤولون أمام الله عن القيام بكل هذا، حتى يحققوا ما هو منوط بهم من واجبات في هذه المجالات.
ويناقش كولن الخلافة الإنسانية بالتفصيل في كتاب (The Statue of Our Souls) [ونحن نقيم صرح الروح] بطريقة تبدو أكثر قوة وراديكالية مما في كتاباته الأخرى، حيث ينطلق مع مطلع الكتاب في مناقشة التدبير الإلهي والإرادة الإنسانية الحرة، مؤكدًا في النهاية على التوازن الدقيق الذي ذكرناه سابقًا، وهو يقدم تأملاً مثيرًا للاهتمام في موضوع الإرادة الإنسانية قائلاً:
"إن الله تعالى قد أمر بقبول شيءٍ يرجع إلينا، شبيهٍ بأمرٍ اعتباري، كداعية إلى إرادته ومشيئته، وجعل لها أهمية، ووعد بتحقيق أعظم الأعمال بنـاء على هذا المخطط، وحققها... وقـد خلق هـذا الشيء الاعتباري وسيلة للإثم والثواب، وجعله أساساً للجزاء عقاباً ومكافأة، وقَبِله فاعلاً في إسناد الخير والشر... ومع أن هذا الأمر الاعتباري ليس مُعَبّراً عن أي قيمة في ذاته، لكنه سبحانه وتعالى أرجع إليه -باعتبار النتائج المترتبة عليه- قيَما فوق قيَم. ولو لم يكن كذلك، لتوقفت الحياة تماماً، وسقط الإنسان إلى درك الجماد، وبطل التكليف وذهب كل شيء انجراراً إلى العبث. فلا بد من إيلاء الاهتمام به، ومراعاة متطلباته. فإن الله تعالى يُظهر بُعدا خفيا من أسرار قدرته بجعل ذلك شرطاً عاديا في إعمار الدنيا والعقبى، ووسيلة مرعية وشبيهة بزر سحري لعملية كهربية تضيء العوالم.. فيوجِد بحراً في قطرة، وشمساً في ذرة وعالما من عدم".([18])
إن حكم الأسباب أو أي شيء آخر لا يجري على الله تعالى، ولا يقيِّد إرادته ومشيئته الإلهية. الله يحكم كل شيء. الله هو الحاكم الأحد المطلق. ومراعاة الأسباب وعدّ العلل وسائل صغيرة ليس إلاّ بأمر الله تعالى. فنؤمن بهذا الاعتبار بأن الإنسان سيعاقب إن خالف الشريعة الفطرية المعروفة بسنّة الله عقابا معظمه في الدنيا وقسم منه في الآخرة.
إذن، يؤكد كولن هنا أن آلية الإرادة الإنسانية -التي أنشأها الله- هي الآلية التي تحدد واقع الحياة في الدنيا والآخرة، والتأكيدُ على الأهمية الكبرى للإرادة والفعل الإنسانيين في هذا العالم لا ينتقص بأي حال من الأحوال من مشيئة الله، بل إن الإرادة الإنسانية هي التأكيد والتنفيذ لمشيئة الله في العالم، ولهذا يكون الانحراف عن الحس الإنساني والإيمان والعلم والحق مشكلة كبرى؛ ذلك أن الابتعاد عن تلك الأشياء يعني التنازل عن مكانة الخلافة المسؤولة واستعمال السلطات التي تعطيها هذه المكانة في الشر، مما يؤثر على الحياة إلى أبعد مدى لأن مجال المساءلة عن تلك المكانة يشمل هذا العالم والعالم الذي يلحقه، وباختصار يشمل الواقع بأكمله.
نبدأ هنا في ملاحظة نبرة يتبناها كولن في بقية كتاب (The Statue of Our Souls) [ونحن نقيم صرح الروح]، وهي نبرة العاطفة والإلحاح التي تحفز أناسًا يتمثلون تمامًا مكانة الخلافة هذه ويحملون على عاتقهم عبء المسؤولية المتأصلة في هذه المكانة. ويستفيض كولن في بقية الكتاب في الحديث عن السمات التي تتصف بها شخصية هؤلاء الخلفاء، وقد تناولنا العديد منها بالفعل في الفصلين السابقين؛ لأن أفضل الخلفاء هم "ورثة الأرض" أو "ذوو القلوب الحية" أو "الأفراد المثاليون". غير أننا سنركز هنا على تلك السمات التي ترتبط مباشرةً بالمسؤولية تجاه العالم، ومن هذه السمات الحركة والفعل، أي أن يكون الإنسان إنسان أفعال. يوضح كولن ذلك قائلاً:
"وإن أهم شيء وأشـده ضرورة في حياتنا هو الحركية. فمن الضروري أن نتحمل بعض المسؤوليات بحركية مستمرة وفكر مستمر ونواجه بعض مشاكلنا ونأخذ على أنفسنا القيام بالحركة الدؤوبة حتى ولو أدى ذلك بنا إلى التضحية بأمور كثيرة في سبيل تحقيق ذلك. فإن لم نتحرك وفقا لهويتنا الذاتية الأصيلة، فسندخل في تأثير الدوامات الفكرية والبرنامجية لأمواج هجمات الآخرين وأعمالهم الحركية، ونضطر إلى تمثل فصول حركاتهم... إن السكون الدائم يعني إهمال التدخل فيما يحدث حولنا، وترك المشاركة في التكوينات المحيطة بنا، والاسـتسلام للذوبان الذاتي رغماً عن أنفسنا كقطعة جليد سقطت في الماء".([19])
إن القراء الفطنين سيستشعرون خطوط التشابه بين كولن وسارتر في هذه النقطة تحديدًا، فكولن هنا يعرِّف العمل بأنه المكون الرئيسي للحياة الإنسانية، وبالعمل وحده نصبح ورثة الأرض بالطريقة التي شرحناها في الفصلين السابقين، وبالعمل وحده نصنع أنفسنا والعالم من حولنا. وبدون العمل -أي بدون أن نشغل أنفسنا وأن نتحمل مسؤولية الأشياء وأن نواجه المعاناة التي تتضمنها تلك المسؤولية عادةً- فإننا نترك أنفسنا أسرى لأعمال الآخرين وتصرفاتهم، ونهجر دورنا كبشر وكخلفاء ونختار بدلاً من ذلك حياة محددة سلفًا أو يحددها لنا الآخرون تشبه ما يحدث للجمادات أو الحيوانات التي تعيش بالغريزة وليس بالاختيار والضمير. إن كينونتنا الإنسانية تتلاشى من داخلنا عندما نرفض العمل وتحمُّلَ مسؤوليات العمل. ويَعتبر كولن في فقرة أخرى إن اختيار عدم الفعل (وهو فعل في حد ذاته، وإن كان فعلاً غير مسؤول) يعني أننا نختار الموت، فيقول: "إن أهم جانب في الوجود هو العمل وبذل الجهد، أما الجمود فمعناه التفسخ والتحلل وهو صورة من صور الموت".([20])
ويقول كولن: إن من يتحركون ويعملون يأخذون أدوارًا كثيرة في المجتمع؛ "فأحيانًا يكون أحدهم وطنيًا متحمسًا، أو بطلاً قام بعمل مفيد للآخرين، أو طالب علم مجتهدا، أو فنانًا عبقريًا، أو رجل دولة، وأحيانا يكون كل هذه الأمور مجتمعة".([21]) ويخصص كولن فصلاً كاملاً لتلخيص حياةِ وعملِ رموز معاصرة في التاريخ التركي. وما يميزهم ويجمع بينهم في نظر كولن هو تلك العباءة المدهشة من المسؤولية التي يرتدونها عند القيام بكل شيء، ونداءُ الخلود الذي يسمعونه يتردد داخل ضمائرهم بأنهم مسؤولون عن هذا العالم، وأن كل ذرة في كيانهم وطاقتهم يجب أن توضع في خدمة هذه المهمة. يوضح كولن ذلك قائلاً:
"ويبلغ من مسؤوليتهم أن كل ما يدخل في نطاق فهم الفرد وإرادته الواعية لا يظل أبدًا خارج نطاق شؤونهم: مسؤولية عن الخلق والأحداث، عن الطبيعة والمجتمع، عن الماضي والمستقبل، عن الموتى والأحياء، عن الصغار والكبار، عن المتعلمين وغير المتعلمين، عن الإدارة والأمن... مسؤولية عن كل أحد وكل شيء. وهم بالطبع يشعرون بكل هذه المسؤوليات وآلامها في قلوبهم فتجعل فيها غصة قوية وتبعث شعورًا بالضيق في أرواحهم محاوِلةً استثارة انتباههم... هذا الألم والضيق الذي ينبع من الوعي بالمسؤولية -إذا لم يكن مؤقتًا- هو صلاة ودعاء لا يُردُّ، ومعين ثريٌّ للمزيد من الأعمال البديلة، وهو النغمة الأكثر جاذبية للضمائر التي ما تزال صافية وغير فاسدة".([22])
هذه فقرة في غاية الروعة، نلاحظ فيها أولاً مجال المسؤولية الذي يشمل "كل أحد وكل شيء"، بما في ذلك الماضي والموتى، فلا شيء يمكن أن يقع ضمن نطاق الفهم أو الوعي يخرج عن مجال هذه المسؤولية، فإذا كان يمكننا التفكير فيه وكان حقيقيًا (لا خياليًا) فإننا نكون مسؤولين عنه. ثانيًا، نلاحظ المعاناة التي تصاحب المسؤولية و"الألم والضيق" الذي يرافق هذا الوعي. ويتحدث كولن في هذه الفقرة وغيرها في نفس الكتاب عن المعاناة الداخلية التي تأتي مع الاضطلاع الجاد بدور الخليفة أو وارث الأرض، وكثيرًا ما يردد في حديثه عن جلال الدين الرومي الشاعر الكبير الذي عاش في القرن الثالث عشر وتَحدَّث في قصائده الرائعة عن الألم والمعاناة اللذين يرافقان الحب والهيام وعن الشوق المبرح للمحبوب الذي يسبب معاناة كبيرة، ومع ذلك لا ينساه المحب تجنبًا لتلك المعاناة؛ لأن حب المحبوب هو السبب في الوجود وهو الحياة نفسها. فالخلفاء الذين يتحدث عنهم كولن هنا هم المحبون للمحبوب، والمحبوب في هذه الحالة هو الله وخلقُ الله وكل الواقع الذي يأتي من الله، هو كل شيء وكل أحد، وحب المحبوب يعني تحمل مسؤوليته. إنه حنين ومعاناة وخفقان قوي في القلب ووعي يزلزل الكيان لا يمكن الهروب منه طالما ظل المرء "غارقًا في الحب". فالمحب قد حُكم عليه بأن يكون محبًا، وهذا الألم ليس عَقَبة أمام الحب بل هو الشرط الأساسي له. وأخيرًا، تُبين الفقرة السابقة أن هذه المسؤولية بمثابة جرس الوصول إلى بر الأمان لكل البشر الصادقين، وأنهم كلما سمعوا هذا الجرس يدوي من خلال المعاناة أقدموا على المزيد من المشاريع والأعمال. ويقول كولن: "إن من يتحملون المسؤولية يحبون تلك المسؤولية بشدة لدرجة أنهم قد يخرجون من الجنة لأجلها".([23])
ويبدو التشابه مع أفكار سارتر واضحًا حتى ونحن نقر بأن كولن وسارتر يستقيان أفكارهما وأعمالهما من أطر فلسفية مختلفة كليًا، لدرجة أنه تبدو لأول وهلة استحالة وجود أي اتفاق بينهما. غير أن الواضح هو أن كلاً منهما -من منظوره الخاص ومنطلقاته شديدة التباين عن الآخر- يطرح رؤى متوازية عن الحياة الإنسانية فيما يتعلق بالمسؤولية الإنسانية عن هذا العالم. ويوجه كلٌّ من كولن وسارتر كل طاقته الفكرية لإبراز الحاجة الملحة في هذه الحياة إلى أن يتحمل الناس مسؤولية العالم، والتأكيد على أن العالم سيظل دائمًا وأبدًا هو ما نصنعه بأيدينا. إذن فقد كان يمكن لأيٍّ من الفيلسوفين -كولن وسارتر- أن يكتب هذا الكلام الذي جاء في كتاب (The Statue of Our Souls) [ونحن نقيم صرح الروح]:
وينبغي على كل واحد أن يقول لنفسه بمسؤولية فردية جادة: "اليوم يوم الفعال. فإن لم أنهض للعمل، فمن المحتمل بقوةٍ أنه لن ينهض غيري أيضا" ثم يَهْمِز فرسه ليندفع إلى مقدمة الصفوف لرفع الراية.
فنحن يجب أن نعتمد على أنفسنا وعلى قدراتنا نحن بغض النظر عما إذا كنا نعتقد أن تلك القدرات قد جاءتنا من الله -كما يؤمن كولن- أو لا -مثل سارتر- وأن نرفض أن ننتظر من أي شيء أو أي أحد غيرنا أن يقوم بعملنا بدلاً منا. فإلقاء مسؤوليتنا على عاتق الآخرين يعني الحياة "بسوء نية" على حد تعبير سارتر، الذي يتشابه -بشكل مثير للدهشة- مع تقويم كولن لمن لديهم إيمان ولكنهم يرفضون المسؤولية، بأنهم يعيشون "بسوء نية".
ونختم بفقرة أخيرة لكولن تلخص رؤيته للحياة والازدهار الإنساني الحقيقي وتُلقي الضوء على ما ينبغي أن يتم بالضبط إذا أردنا أن نحيا في عالم يمتلئ بالخير والحق والحرية لكل شخص والدورِ الذي يلعبه الناس في إيجاد مثل هذا العالم. مرة ثانية، نجد أن روح النص تتشابه مع أحاسيس سارتر وإن اختلف التعبير. يقول كولن:
"والصحيح هو أننا في هذه الجغرافية الكبيرة -بدلا من الأرواح اليتيمة والأفكار الضئيلة التي لا تقيم وزنا للشعور بالمسؤولية والقيم الإنسانية والعلم والأخلاق والفضيلة، ولا تعير اهتماما إلى الفن- بحاجة إلى إرادات فولاذية وأدمغة أصيلة تحتضن الوجود بكل أعماقه، والإنسانَ برحابه الدنيوية والأخروية، وتفسرهما، بل وتتدخل في الأشياء بعنوان خلافة الله في الأرض".([24])
إن الروح العميقة هنا هي الشجاعة، شجاعة المسؤولية. فنحن بالجبن وسوء النية نهرب من تحمل المسؤولية عن حياتنا الخاصة وعن العالم، ونحن بهذه الروح الجبانة الهزيلة نختلق الأعذار لأنفسنا، ونلقي باللائمة لما يحدث في العالم على الآخرين أو على القدر أو على الظروف. كل هذا في حين أن مسؤولية هذا العالم تقع على أكتافنا، سواء اعترفنا بذلك أم لم نعترف، وسواء تحملنا تلك المسؤولية أم لم نتحملها. فالعالم مازال يقع على عاتقنا، حتى عندما نختار الموت والجمود والحياة مثل قطعة طحلب أو كرسي أو حصاة، حياةً أقل بكثير مما أراده لنا الله أو الطبيعة أو الوجود. فالحياة الحقيقية عند الله -أو عند الحياة نفسها- هي حياة المسؤولية، ومن يعيشون تلك الحياة يعانون مما فيها من اليأس والألم ولكنهم أيضًا الكائنات التي تستحق فعلاً أن يطلق عليها وصف "البشر"، لأن لديهم إرادة حديدية وقلوبًا شجاعة تدفعهم إلى الأمام وسط الألم والضيق إلى آفاق أوسع وأكثر رحابة من المسؤولية عن كل أحد وعن كل شيء. وهؤلاء الأفراد هم الأبطال الحقيقيون للإنسانية وعلى عاتقهم يبنى العالم، وكما يؤكد سارتر وكولن فإن المجتمع الإنساني كان وسيظل دائمًا هو ما نصنعه نحن البشر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] Gülen, The Statue of Our Souls, 35. (كولن، ونحن نقيم صرح الروح)
[2] Sartre, "Existentialism" in Basic Writings of Existentialism, 345. (سارتر، الوجودية في "كتابات أساسية عن الوجودية")
[3] المصدر السابق، ص 346-347.
[4] المصدر السابق.
[5] المصدر السابق، ص 358.
[6] المصدر السابق، ص 348.
[7] المصدر السابق، ص 347.
[8] المصدر السابق، ص 348.
[9] المصدر السابق، ص 349.
[10] المصدر السابق.
[11] المصدر السابق، ص 367.
[12] المصدر السابق، ص 354.
[13] المصدر السابق، ص 355.
[14] المصدر السابق، ص 357.
[15] Gülen, Toward a Global Civilization of Love and Tolerance, 122. (كولن، نحو حضارة عالمية من المحبة والتسامح)
[16] المصدر السابق.
[17] المصدر السابق، ص 124-125.
[18] Gülen, The Statue of Our Souls, 15. (كولن، ونحن نقيم صرح الروح)
[19] المصدر السابق، ص 59.
[20] المصدر السابق، ص 99.
[21] المصدر السابق، ص 68.
[22] المصدر السابق، ص 95.
[23] المصدر السابق، ص 97.
[24] المصدر السابق، ص 105.
الخاتمة
أثناء تأليفي لهذا الكتاب، سنحت لي الفرصة الاستثنائية بأن أقابل الأستاذ فتح الله كولن وأن أتناول معه الطعام مرتين في مقر إقامته، وقد كان كريمًا للغاية وقضى معنا وقتًا طويلاً رغم مرضه الشديد، كما أجاب على بعض أسئلتي وتَناقش مع من كانوا حاضرين حول قضايا الساعة واستمعوا بإعجاب إلى أفكاره وتصوراته. وبالطبع فقد "عشت" مع كولن من خلال كتاباته أثناء إعداد هذا الكتاب ومازالت أفكاره تلهمني، ولقد عرفت بعد لقائه لماذا أَلهم هذا الرجل ما يقرب من ثلاثة أجيال في تركيا ومَنَحَهم الدافع رجالاً ونساءً لخلق عالم جديد. إنه رجل بداخله قدر هائل من الروحانية والإخلاص والتعاطف، وهو شيء واضح للغاية في كتاباته وفي شخصيته.
لقد قارنتُ أفكار كولن مع أفكار كلٍّ من كانط وأفلاطون وكونفوشيوس وميل وسارتر لأنني أؤمن بأنهم أهل لأن يتناقشوا مع كولن، وأنه أهل لأن يتناقش معهم. فأنا أعتبرهم جميعًا أفرادًا على قدر عظيم من المعرفة اهتموا بالأسئلة الأكثر إلحاحًا واستمرارية عن الوجود الإنساني، وتعاطوا مع التحديات الصعبة بكل كيانهم وبأمانة من دون أي نوايا متشككة أو خبيثة أو تشاؤمية، وهم نماذج رائعة لأفضل شكل من أشكال المعرفة في العلوم الإنسانية، وهو الشكل الذي يعطي تحليلاً متعمقًا لكي نطبقه على هذا العالم وعلى حياتنا فيه حتى نتعلم ما يكوِّن الحياة الصالحة ونحققه لأنفسنا وللأجيال القادمة. فالمعرفة التي لا تجعل هذا هدفها الأسمى لا تكون معرفة حقيقية.
وقد ألهمني حقًا ما قمت به هنا من مقابلة الأفكار ببعضها، وهذا الإلهام لم يأت لأنني أتفق تمامًا مع أي رؤية من الرؤى التي عرضنا لها، ولكن ما ألهمني هو المحاورة نفسها وما تتيحه تلك المحاورات من إمكانيات عند إجرائها، ليس فقط على صفحات الكتب بل وفي الواقع أيضًا مع أناس حقيقيين. وأنا أعرف أنني قد توسعت في مفاهيمَ وموضوعاتٍ ونصوص بسيطة في الأصل في محاولةٍ لكشف أوجه التشابه بين أفكار المشاركين في المحاورة، كما أعرف أن هذا التشابه في كثير من الحالات لن يصمد طويلاً -إذا صمد أصلاً- قبل أن تبدأ خيوط العلاقة في التفكك نتيجة لضعفها ولكبر حجم الاختلافات التي تشدها من الجانبين. ولكن إذا كانت العلاقة كافية لكي تصمد ولو لفترة بسيطة، فإن الارتباط يكون قد تحقق على الأقل لتلك الثواني المعدودة. فعلى صفحات الكتب ومع أشخاص ماتوا منذ زمن بعيد، لا يكون الارتباط ممكنًا إلا من الناحية النظرية المجردة. أما عندما يكون هناك أشخاص أحياء، من لديهم استعداد منا للمشاركة والتفاعل ومن هم في الحقيقة مسؤولون عن العالم وعن كل أحد وكل شيء، فإن الارتباط الذي نقيمه في لحظات التوسع هذه لا يكون نظريًا أو مجردًا بل يكون ارتباطًا حقيقيًا. وربما يمنعنا هذا الارتباط ساعتها من القدح في بعضنا البعض وقتل بعضنا البعض -سواء مجازًا أو فعليًا- بعد أن ينقطع الخيط الرفيع ونعود إلى مواجهة الاختلافات الجذرية القائمة بيننا.
إن تنمية استراتيجياتِ وإمكانيات التعايش السلمي في ظل الاختلافات الجذرية وتضاؤل الموارد الطبيعية يعتبر التحدي الأكبر في عصرنا هذا، فيجب علينا أن نهب كل ما لدينا للتغلب على هذا التحدي وإلا فإن كل إنجازاتنا الأخرى ستضيع، لأننا بذلك سنكون قد دمرنا العالم بالكراهية والعنف. ربما نجد بداخلنا -كبشر يحملون تكليفًا من الذات المطلقة أيًا كان شكلها- شخصية تجعلنا نسمو بأنفسنا ونخلق عالمًا يملؤه التسامح والاحترام والتراحم.
المراجع
Confucius, The Analekts, Trans. David Hinton, Washington D. C., Counterpoint, 1998
Davidson, Herbert A., Alfarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect, Oxford, Oxford University Pres, 1992
Fakhry, Majid, A History of Islamic Philosophy, New York, Columbiam Un›-versity Pres, 1983 (First edition 1970)
Goodman, Lenn E., Islamic Humanism, Oxford, Oxford Universty Pres, 2003
Gülen, M. Fethullah, Pearls of Wisdom, Fairfax, The Fountain, 2000
—— Toward a Global Civilization of Love and Tolerance, New Jersey, The Light Inc. 2004
—— The Statue of Our Souls: Revival in Islamic Thought and Activism, New Jersey, The Light Inc. 2005
—— Essays, Perspectives, Opinions, New Jersey, The Light Inc. 2005
Guthric, W.K.C., A History of Greek Philosophy, Cambrige, Cambridge University Pres, 1969
Kant, Immenuel, Grounding fort he metaphysics of Morals, Trans. James W. Ellington, Indianapolis, Hackett Publishing Company, 1993
Kraye, Jill, ed. The Cambridge Companian to Renaissance Humanism. Cambridge, Cambridge University Pres, 1996
Mill, John Stuart, On Liberty, A Norton Critical Edition. Ed. Alan Ryan, New York, W. W. Norton, 1997
—— Utilitaraianism, Indianapolis, Hackett Publishing Company, 1979
Plato, The Republic, Trans. Richard W. Sterling and William C. Scott, New York, W. W. Norton, 1985
Rabil Jr., Albert, ed. Renaissance Humanism: Foundation, Forms adn Legacy, 3 vols. Philadelphia: Pennsylvania University Pres, 1988
Sartre, jean Paul, "Existentalism" in Basic Writings of Existentialism, Ed. Gordon Marino , New York, The Modern Library, 2004
Thompson, Laurence G., Chinese Relegion: An Introduction, Fifth edition, Belmont, CA, Wadsworth Publishing Company, 1996
المصدر: http://fgulen.com/ar/dirasat/dialogue-of-civilizations
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
