الإسلام والديمقراطية.. تداخل أم تصادم؟
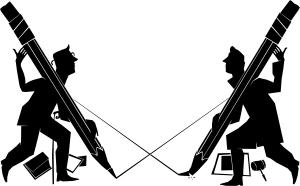
إبراهيم العلبي
يتساءل البعض مستشكلاً: إذا كان “الحكم” في الإسلام لله وفي الديمقراطية للشعب، فكيف نطالب -كإسلاميين- بدولة ديمقراطية ونحن لا نرضى بالإسلام بديلاً؟ أليس في ذلك هدماً لمبدأ الحاكمية؟
للإجابة على هذه السؤال لا بد من تبيان حقيقة أن الديمقراطية تتداخل مع الإسلام في ضرورة الشورى، وكذلك في استناد شرعية الحكام إلى إرادة الأمة. وتفترق الديمقراطية عن الإسلام بأنها تتألف من وسائل وإجراءات محددة، وتتشكل بأشكال عديدة بما ينسجم مع ثقافة البلاد التي تطبقها، إن في الشرق أو الغرب، أما الإسلام فهو لا يلزم الأمة بطريقة معينة للتحقق من شرعية الحاكم وقيام مبدأ الشورى، مع أنه مقصد شرعي ثابت لا يتغير، فهل هذا مجرد افتراق أم تصادم؟
تعد مسألة الإمامة العظمى من أخطر المسائل التي بحثها الفقهاء وناقشوها في كتبهم، وإن لم يوفّوها حقها لعدم تطلب الأوضاع والظروف المرافقة للعصور الأولى كثير بحث أحياناً، ولعدم تشجيع الدول المتعاقبة على بحث هذه القضية بحثاُ مستفيضاً، وربما دخلت كتبهم إجراءات معينة لم تأت عليها النصوص الشرعية، ولم تكن من مقاصدها وإنما استوحاها الفقهاء من عرف ذلك الزمان.
وفي المحصلة، فقد اتفقت مقولاتهم فيما أثر عنهم على مبدأ مهم، وهو الشورى المفضية إلى اختيار المسلمين ورضاهم بإمامهم. و من الأدلة على أصل فرضية الشورى –كما بات معلوماً للجميع– قوله تعالى: “وأمرهم شورى بينهم” [الشورى: 38]، وقوله في موضع آخر “وشاورهم في الأمر” [آل عمران: 159]، و هو أمر يشمل شؤون الحياة كافة فيما يتطلب عادة تخيراً للأصلح؛ وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ما رواه عنه البخاري في سياق خطبته الشهيرة في آخر أعوام خلافته: (أيما رجل بايع رجلاً على غير شورى المسلمين فلا يبايع له تغرة أن يقتلا)، أي حتى لا يقتلا لشقهم صف المسلمين ومخالفتهم مبدأ الشورى، وبالتالي تسببهم في الفتنة الواجب اتقاؤها.
ومن الأدلة على انعقاد الإمامة باختيار غالبية المسلمين ممن تمتعوا بأهلية الاختيار والذين سماهم أهل العلم “أهل الحل و العقد” أو “أهل الاختيار”؛ انعقادُ إمامة علي رضي الله عنه باختيار معظم صحابة رسول الله –صلى الله عليه وسلم– له خليفةً مع عدم رضا عدد قليل من الصحابة وعدم مبايعتهم له، إلا أن اختيار الغالبية ألزم الجميع الاتباع و الطاعة، ولذلك كان علي ومن معه –بعيداً عن قتلة عثمان– فئة الحق الواجب اتباعها، أي أنه كان إماماً شرعياً؛ وكان معاوية ومن معه الفئة الباغية، فقد أخطؤوا بقتال علي بشهادة أحاديث النبوة العديدة، وأبرزها مقتل عمار بن ياسر وهو بين صفوف جيش علي رضي الله عنهم أجمعين.
إن إجراءات تنصيب الخلفاء وعقد الإمامة -أعني التي اتبعها الصحابة في عصر الراشدين- كانت تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقق الرضا والاختيار وتسلم الخليفة زمام السلطة بناء على تعاقد ذي طرفين، بل إن الخلافات التي رافقت بعض تلك الإجراءات أو حدثت بعدها كان مردها إلى عدم التسليم بشرعية الإمام المنصوب في رأي من خرج عليهم، أو بغي من خرج على الإمام الشرعي ونازعه سلطته أو صلاحيته؛ فمعاوية كان يطالب بالقصاص من قتلة عثمان إذ خرجوا عليه بغياً ثم قتلوه ظلماً، وكان لا يقر بشرعية إمامة علي، وذلك لأنه لم يبايعه، ومن ثم لم يمتثل لأمره بعزله عن ولاية الشام، وكذلك كان طلحة والزبير، حيث أكرههما الخوارج على بيعة علي، واستعجلا القصاص لعثمان من قتلته ولم يمهلا علياً حتى يتمكن من القتلة وتستقر له الأمور، مستبيحين استعجالهم القصاص ومباشرتهم له باعتبارهم في حل من بيعة أكرها عليها.
أما عليٌّ فقد استند في قتاله للخوارج في الحروراء على كونهم بغاة عليه بغير حق مع اتصاف إمامته بالشرعية، وقتاله معاوية في صفين على عصيانه لأمره بعزله وامتناعه عن تسليم ولاية الشام لسهل بن حنيف، وقتاله طلحة والزبير في موقعة الجمل لخروجهما على ولاته في البصرة والكوفة ومباشرتهما أخذ القصاص من قتلة عثمان بأنفسهما وخارج إطار الدولة، مع أن لموقعة الجمل أسباباً أخرى إلا أن مسوغات هذه المعركة استمدت من الاعتبارات المذكورة.
أما عن مسير الحسين إلى العراق فقد كان بهدف الإصلاح في الأرض كما صرح بذلك مراراً بعد أن تم تنصيب يزيد بن معاوية خليفة بالتوريث، وبعد موقعة الحرة التي قتل فيها ثلة من فضلاء أبناء الأنصار.
إذن، فمستند من ذكرتهم و منطلقهم الأساسي في استباحة القتال عندما خاضوه هو احتجاجهم على خرم مبدأ الشورى أو الإخلال بالتزام ما يترتب عليه من نتائج.
من خلال ما سبق، يتبين للمتأمل أن وصول الحاكم إلى السلطة مرده –في الأصل– إلى الأمة، ومهما تخلّف هذا المبدأ تقع الفتن وتندلع الحروب. وإذا كانت الأمم في العصور السالفة بشكل عام قد ذاقت مرارة الاقتتال والنزاع الداخلي بسبب غياب آلية واضحة تضبط عملية استلام السلطة وتسليمها بشكل يضمن تحقق المبدأ الجوهري المتفق عليه وهو “الشورى المفضية إلى اختيار المسلمين ورضاهم بإمامهم”، فإن تراكم التجارب الأممية وتنوع الدروس المستفادة منها ليدفع بنا –ضرورة– إلى الأخذ بإجراءات ووسائل ترسم أسلوباً واضحاً محدداً في كيفية التعاطي مع مسألة السلطة بما يقي الأمة شرّ النزاع لاحقاً.
فإذا كان هذا هو الحكم المراد بقولهم في تعريف الديمقراطية: “هي حكم الشعب نفسه بنفسه”، أي مباشرته اختيارَ حكامه ليجعل منهم نواباً عنه، فهذا لا يتعارض مع التشريع الإسلامي الحنيف، بل ينطلق منه كما بينا في الأدلة والأمثلة.
وإن كان المراد بالحكم في تعريف الديمقراطية هو مستند الحكام العقدي والديني (مبدأ الحاكمية) فهذا أيضاً مما لا يتعارض مع التشريع الإسلامي، بل يؤسس لعلاقة صحيحة بين المجتمع وهويته، وهذا ما يستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحديداً عندما جاءه أهل يثرب يبايعونه نبياً (مصدر التشريع) وحاكماً (صاحب السلطة) قبِل منهم بيعتهم.
وسبق هذه المبايعة قيام مصعب بن عمير على دعوتهم وتربيتهم وتهيئتهم، وقد تقدم وفد مسلمي يثرب إلى الحج عام 13 للبعثة المؤلف من نحو سبعين رجلاً وثلاث نساء، تقدموا ليلة 12من ذي الحجة لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتخب هؤلاء الوفد 12 نقيباً يمثلونهم في البيعة استجابة لطلب النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على بيعة هذا الوفد هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة ليبدأ فيها عهد الدولة والتشريع.
إذن فاختيار المجتمع للعقيدة التي ينطلق منها في قوانين دولته وأعراف مجتمعه ليس منقصة من الإسلام ولا تردداً في الاستجابة لتعاليمه البتة، بل هو تعبير وتأكيد على إرادة الأمة الحرة في اختيار ديانتها واختيار نمط حكمها حتى تنصاع لما تسنه دولتها من قوانين وتصدره من تشريعات، وليس من نافلة القول أن نبين أنه لا شأن للديمقراطية في تحديد مصدر القوانين ومرجعية الحكام، بعد استقرار نظام الحكم، وإن أي تحول في هذه المرجعية لن ينبع إلا من إرادة الشعب، فإن كانت هذه الإرادة عرضة للتزوير أو التوجيه فليكن دعاة الإسلام و علماؤه حماة الأمة والأمناء على سلامة معتنقها والمسؤولين عن توجهاتها، فمصعب يؤسس الأمة تأسيساً إيمانياً وتربوياً وثقافياً، وصاحب الرسالة يقيم على هذا الأساس المتماسك دولة العدل والبناء على مستوى الأمة جمعاء لتتوجه لاحقاً في حال التمكين إلى إقامة العدل وإيصال رسالة الإسلام إلى شتى أنحاء الأرض.
وإذا كنا قد أكدنا على ضرورة تعبير الأمة عن إرادتها الحرة تجاه حكامها وما يستندون إليه، فما ذلك إلا لما بيناه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار ومبايعته لهم على اعتناق الإسلام والتزام ما يترتب على ذلك من واجبات، وذلك باختيارهم الحر، إذ ليست المبايعة إلا عقد تراض بين طرفين، أضف إلى ذلك أنه لم يُقم عليه الصلاة والسلام دولة على الأقلية المسلمة في مكة، والأهم من ذلك أنه عندما عرض عليه زعماء قريش كل المغريات الدنيوية لكي يتخلى عن دعوته، وكان على رأس تلك المغريات أن ينصب ملكاً على مكة، رفض ذلك، وقد كان بإمكانه أن يقبله مؤقتاً فيصبح ملكاً وعندما يتمكن من الملك يفرض حكم الشرع الإسلامي على المجتمع المكي الجاهلي، إلا أن ذلك لم يكن وارداً لديه البتة.
بل كان –صلى الله عليه وسلم– يريد أن يكون التزام الإسلام وتحكيمه نابعاً من إرادتهم وصادراً عن قناعتهم، وأن يكون التوحيد مالئًا قلوبهم ومهيمناً على نفوسهم ومتمثلاً في سلوكهم، ولم يكن ذلك ليتأتى دون دعوة وتربية ومحبة تهون دونها كل التضحيات، فكان لأجل ذلك يقول في مكة: “قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتنجحوا.. قولوا لا إله إلا الله تملكوا كنوز كسرى وقيصر”.
وهكذا يتبين أنه لا يضر الأسلوب الديمقراطي في إدارة شؤون الحكم ولا يقلل من شأنه أنه لم يتم النص عليه في الكتاب أو السنة، فقد رسم الشرع الخطوط العامة وترك الوسائل والتفاصيل لعرف ومصالح الناس المتبدلة باستمرار في مختلف الأزمنة والأمكنة، ليس في المجال السياسي فحسب، بل أيضاً في مجالات عامة أخرى تتسم عادة بسمة العصر وتتأثر إلى درجة كبيرة بثقافته وأعرافه ووسائله، كالعلاقات الدولية على سبيل المثال، بخلاف المجال الأسري والاجتماعي حيث نص التشريع الإسلامي على كثير من الجزئيات التي لا يؤثر في طبيعتها تبدل الظرف غالباً.
ولا يضره أيضاً –أي الأسلوب الديمقراطي– أنه لم يلتزم الخلفاء الراشدون به على وجه التحديد، بل قد آل الأمر إلى أن يصبح ملكاً في معظم الدول التي تلت عصر الراشدين، فإن تركهم لذلك في عصرهم وغياب الضوابط الشرعية لاحقاً لانعقاد الإمامة شرعاً ليس حجة في عصرنا في تركنا له أو لأي قانون يضبط شؤون السلطة واستلامها وتسلمها، وإنما يُعدّ سَنّ قانون ينظم شؤون الحكم بآليات تفصيلية محددة تراعي أنواع المصالح الشرعية المتفق عليها وتراعي كذلك المصالح المرسلة المعاصرة واجباً معاصراً، شرعاً وعرفاً، تماماً كما تستلزم الحياة في عالم تعد فيه “السيارة” وسيلة النقل الرئيسية قانوناً ينظم المرور في شوارع المدن والطرقات العامة، حتى لا تتصادم السيارات فتهدر الأموال وتزهق الأرواح وتضيع الحقوق فيقع من جراء ذلك مفسدة عظيمة، وينقلب استعمال السيارة إلى سبب الفوضى والاضطراب بعد أن كان الهدف منها راحة الإنسان المعاصر وقضاء حوائجه الدنيوية.
ولا يفوتنا في هذا المقام أن نبين أن الوسائل الديمقراطية المعاصرة كصناديق الاقتراع وتحديد مدة الرئاسة وتحديد صلاحيات الرئيس من خلال إلزامه بشورى نواب الأمة فيما يخص المصالح الكبرى للدولة وفرض آليات محددة للمراقبة والمحاسبة وربما العزل في حال إخلال الرئيس بالعقد الذي أبرمه مع الأمة والسماح بحياة حزبية تعددية؛ ليست هذه الوسائل سوى اجتهاد بشري محض، نشأ بالمجمل في الغرب نتيجة ظروف وسياقات معقدة، إلا أن الهدف منها تحقيق مقصد مهم جداً؛ وهو أن يحكم الشعب نفسه ويختار حكامه ويمنع استبداد فرد أو مجموعة بالسلطة استبداداً يحيلها إلى ملك فردي أو فئوي، وهو –كما ترى– مقصد شرعي أصيل.
وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الوسائل من النوع الذي تتفاوت الأفهام في تقديرها وانتقاء الأمثل منها. كما تختلف تفاصيلها من بلد لآخر ومن ثقافة لأخرى. وما نحتاجه في هذا الصدد هو تخير ما يناسبنا ويراعي خصوصيات مجتمعاتنا المصبوغة بالصبغة الإسلامية ويفي بالمقصد العام الذي كان سبب الأخذ بمثل هذه الوسائل والأدوات. وتبقى هذه الوسائل الإجرائية خاضعة للنظر والتأمل والتطوير كلما دعت الحاجة أو استجدت وسيلة تؤدي أكثر من سابقتها إلى تحقيق ذلك المقصد الشرعي والسياسي العتيد.
المصدر: https://alfajrmg.net/2013/03/20/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%...
