الشرق والإسلام والغرب والاستشراق
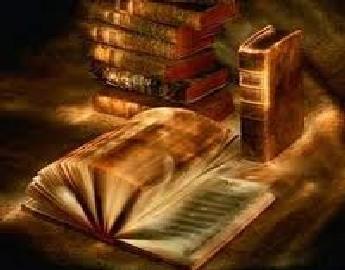
ضياء الدين سردار
يبدأ تاريخ الاستشراق مع الإسلام بالأزمة التي أحدثها الوافد الجديد، وفي سياق هذه الأزمة فحسب يمكن لأوروبا أن تحشد كل ما تعدّه خاصاً بها، بما في ذلك ميراث الإغريق والرومان؛ لتنشئ مقولةً هي نوعٌ من التعريف البديل للذات، وهو تعريفٌ اصطلاحيٌّ ووصفٌ لموقف الغرب مما هو ليس غربياً، أي ما هو شرقي.
لقد كان الإسلام منذ ظهوره مشكلةً للعالم المسيحي، فما السبب الذي جعل من الوحي الجديد للنبي العربي -صلَّى الله عليه وسلَّم- عدواً للغرب لمدةٍ بالغة الطول؟ لقد تضمن الإسلام في تعاليمه اعترافاً بالمسيحية وصحتها؛ ذلك أنّ الإسلام وصف نفسه بأنه مجموع الرسالات التي دعا إليها إبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء الآخَرين. لقد تقبل ولادة مريم العذراء لعيسى، وبوَّأه مكانةً رفيعةً بين الأنبياء، كما تقبلَّ الإنجيل بين كتب الله المقدَّسة، ولم يعتبر الإسلام نفسه "مشكلةً" للمسيحيين، ومنذ ظهوره أبقى على الكنائس مفتوحة، ووفّر الضمانات الضرورية لاستمرار المسيحية ومؤسساتها في دار الإسلام؛ بيد أنّ الكنيسة ما ردَّت الجميل على هذا الكرم الكبير؛ فقد كانت أوروبا في مرحلة نشر الدين المسيحي ضمن حدودها، وصار الإسلام مشكلةً سياسيةً وعسكرية عندما وجدته أوروبا على حدودها بعد مائة عامٍ على ظهوره. وبالإضافة لذلك فإنّ ما حقّقته حضارة المسلمين جعلت من الإسلام مشكلةً اجتماعيةً ثقافية، وقد ظهر الاستشراق بوصفه الخطاب المنطقيَّ لأوروبا في مواجهة تحدّي الإسلام.
تأسَّس الاستشراق على يد يوحنا الدمشقي-748م)، وهو عالمٌ مسيحيٌّ كان مقرباً من يزيد بن معاوية. ادّعى يوحنا الدمشقي أنّ الإسلام عبادةٌ وثنية، وأنّ الكعبة في مكة مجرد وثن، وأنّ النبيّ محمداً -صلَّى الله عليه وسلَّم- قام بترقيع ديانته من العهدين القديم والجديد بمساعدة راهبٍ أريوسي، وقد صارت كتابات يوحنا الدمشقي واتهاماته المصدر الكلاسيكي لكل الكتابات المسيحية عن الإسلام. وبذلك برهن الاستشراق أنه من أكثر البنى قوة ذاكرة، فكثير من العناصر التي استخدمها اختفت تماماً، ومع هذا يمكن القول: إنّ يوحنا الدمشقي -الممثل القديم للاستشراق- ظلَّ المصدر المُلْهِم والروح الحارس لإحدى أكثر الدراسات المعاصرة تشدداً: الهاجريون Hagarism لباتريشيا كرون ومايكل كوك(1977)، والتي انبنت حججها وتقييمها لمصادر الإسلام -بل ومعاداته- على كتابات يوحنا الدمشقي. وقد وجدت كتابات الدمشقي (= منصور بن سرجون) صدى قوياً في العالم المسيحي، ليس لأنها رأت في الإسلام ديناً مختلفاً تماماً عن المسيحية؛ بل لأنّ المجتمع المسلم مثّل أسلوبَ حياةٍ مختلفاً تماماً عن ذلك السائد في أوروبا. وكما يشرح ر. دبليو. سوذرن Southern فإنه "طوال العصور الوسطى تقريباً، وفي معظم المنطقة التي سادت فيها المسيحية، كان الغرب يتشكل من مجتمعاتٍ زراعيةٍ في الأساس، وإقطاعيات تابعة للأديرة والنبلاء، في الوقت الذي كانت فيه قوة الإسلام نابعةً من مُدُنه العظيمة، وبلاطات حكامه الأثرياء، وخطوط الاتصال الطويلة الممتدة لعالمه. واستناداً إلى المُثُل الغربية -التي تقوم على الرهبانية، والكهنوت، والتراتبية الهرمية- مثَّل الإسلام رؤيةً مختلفةً للعالم، ومجتمعات من الناس العاديين المتسامحين ذوي المحبة للحياة، والمساواة. كما أنّ المسلمين تمتعوا بحريةٍ مشهودٍ لها في البحث من دون كهنةٍ وأبرشيات تحتلُّ مركز المجتمع، كما هو الشأن في الغرب(1).
ما الذي كان بوسع قادة العالم المسيحي أن يفعلوه في وجه هذا التقدم السريع للدين الجديد، والذي بدا أنه قد صار يُهدّد الوعد الإلهي للمؤمن المسيحي؟ لقد انكبُّوا على الأناجيل، وفي سِفْر دانيال وجد بول ألفاروس (المتوفي عام 859م) أنّ الإسلام سيزدهر لثلاث حِقبٍ زمنيةٍ ونصف كلٌّ منها تُساوي سبعين عاماً، فيكون مجموعها 245 عاماً. وبما أنه كان يكتب عام 854م، وتاريخ الإسلام يبدأ عام 622م، فقد كان سهلاً عليه القول: إنّ نهاية المجـد الإسلامي صارت قريبة، وفي مصادفةٍ غريبة؛ فإنّ أمير قرطبة الأُموي عبد الرحمن الثالث توفّي عام 852م،وخلفه ابنه محمد الأول الذي كان العالم المسيحي متفقاً على وصفه بأنه" لعنة الزمان". لقد كان في حوزة ألفاروس وزملائه سيرةٌ للنبي محمد-صلَّى الله عليه وسلَّم-، وهي محاكاةٌ ساخرةٌ لحياة المسيح كتبها الرهبان الأسبان، والتي جعلت وفاته تُطابق سنة 666 من التاريخ الأسباني، و666 هو بالطبع عدد وحوش النبوءة التي تقترن بظهور المسيح الدجّال. وهكذا اكتملت الصورة، ووُلدت صورة محمد-صلَّى الله عليه وسلَّم- بوصفه المسيح الدجّال، والإسلام باعتباره مؤامرةً شريرةً على المسيحية. وكانت هذه -كما يلاحظ سوذرن- " الرؤية المتماسكة الأُولى للإسلام التي يطوِّرُها الغرب"، وكانت نتاجاً للجهل المُطبق، وهو جهلٌ من نوعٍ خاص: "كان الرجال الذين طوَّروا هذه الرؤية يكتبون عمّا خبروهُ بقوة، وقد نسبوا هذه الخبرة للأساس المتين المتوافر لديهم- الكتاب المقدَّس. كانوا جاهلين بالإسلام، لا لكونهم بعيدين عنه مثلهم مثل الكارولنجيين، بل لكونهم يقعون في قلبه؛ لأنهم رأوا وفهموا القليل مما يدورُ حولهم، ولم يعرفوا شيئاً عن الإسلام الدين؛ فإنهم هم الذين لم يكونوا راغبين في معرفة شيء. وقد ظلَّ سوءُ الفهم العنيد والجهل المظلم الروحَ التي تقود الاستشراق، واستطاعت هذه الروح مواصلة الحضور متحديةً، وبقيت مهيمنةً حتَّى بعد توافُر معرفةٍ بديلةٍ بيُسْرٍ وسهولة. يتكون الاستشراق إذن مما رغب الغرب في معرفته، لا فيما كان بالإمكان معرفته. وفي الوقت الذي كانت الصورة الاستشراقية فيه تنمو وتتحصّن كان الإسلام ينمو ويتقدم.
ومع وصول الصليبيين، أُضيف عددٌ آخَرُ من الرحلات الخيالية في عالم النزوة والرغبات لنشر الصوَر الدعوية حول الإسلام وسيلةً للحفاظ على الروح الصليبية. ألقى البابا أوربان(الثاني) أول موعظةٍ له حول الحملات الصليبية في كليرمونت بفرنسا عام 1096، وربط الفكرة الجديدة حول تلك الحملات مع بعضٍ من الأفكار الراسخة التي كانت شائعةً في أوروبا: الأعمال الخيِّرة العظيمة والحج. كما أرسى البينات الأساسية التي تشكّل البذورَ الأُولى للوعي الأوروبي للذات، من خلال التشديد على حق المسيحيين في السيادة على الأراضي التي وُلدت فيها المسيحية، وكانت من قبلُ جزءًا من الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وكان معياره المرجعي العالم المسيحي المرصوص في مواجهة الإسلام الموحَّد الذي يمثّل العدوّ. وولَّدت الموعظة حول الحملات الصليبية ردَّ فعلٍ أوروبياً أَصيلاً، وحرّكت قطاعاتٍ واسعةً من الفرسان للتوجه إلى الأراضي المقدَّسة. وقد قال غوين وليامز: إنّ "فكرة الحملات الصليبية هيمنت على الخيال الأُوروبي، وقد مثّلت مزيجاً من الحماسة والطمع اللذين يطبعان الكولونيالية، والتوق إلى القداسة..". وكانت قبضة الصليبيين على الخيال الشعبي محكمةً حتَّى إنّ الروح الصليبية أصبحت موتيڤاً أساسياً في الفكر والأدب الأوروبيين، وعاشت لقرونٍ بعد توقُّف الحملات الصليبية في الشرق الأوسط. فقد كان المكان الذي سعى الصليبيون للوصول إليه مكاناً حميماً وعزيزاً على قلوب الأوروبيين جميعاً؛ فالشرق هو الأرض التي وصفها الكتاب المقدس، كما كانت أدبيات الحج قد صارت نصوصاً ثابتةً ودليلاً إلى تلك الديار، وجنساً شعائرياً مركزياً في الكتابات الأوروبية. وقد كان هناك تركيز على المواطن المتعلقة بالمعجزات، ثم حدثت انعطافةٌ إبان الحروب الصليبية تُعطي الحقَّ في السيطرة على تلك الأماكن التي تتضمن قبر المسيح. وما كان بالإمكان تخيل الحملات الصليبية العسكرية الطابع لولا وجود الإسلام، الذي رأوه مغتصبا للمقدسات، ومانعاً من الحج والرحلات إلى الأرض المقدسة. لقد كان الشعور المحسوس بوجود العدوّ ضرورياً، وتغلغل في عمليات تشكيل المثال الصليبي. وكان الركن الآخر الحكايات الخرافية التي وضعت لنشر الكراهية ضدّ أولئك الذين يسيطرون على الأرض التي عاش فيها المسيح. وفي هذا الشأن ظهرت تفاصيل كثيرةٌ لإثارة الخيال والكراهية معاً بشأن النبيّ محمد-صلَّى الله عليه وسلَّم-، وعمله على تدمير الكنيسة في إفريقية والشرق.
سقطت القدس في أيدي جنود الحملة الصليبية الأُولى (1099م)، وأدّى ذلك إلى تأسيس ممالك صليبية في الشرق، وبقيت تلك الممالك في المنطقة أكثر من قرنين. فالقدس نفسُها ما عادت إلى سيطرة المسلمين قبل عام 1244م، وعكا حتَّى عام 1291م. وهكذا ما كانت الحملات الصليبية رحلة حجٍ عادية، بل عملية متصلة من التورط المستمر الممتد على مدار قرونٍ. وقد جرى تبديل المحاربين الصليبيين ودعم المستقرين منهم بموجاتٍ جديدةٍ متواصلة من البلدان الأوروبية المختلفة. وكانت السِمة الجوهرية لهذا التورط الطويل تتمثل في محتواه للشحن الديني الذي كان يتجدد ويُعادُ التشديدُ عليه بصورةٍ دائمةٍ لتأمين الدعم بالمال والأَنفُس للحملات الصليبية والمشاركين فيها. وكذلك لمنع أولئك المقيمين من أن يصبحوا سكّاناً عاديين في المشرق. ومن ثمَّ فإنّ الحملات الصليبية أورثت الاستشراق (استشراق التقارير والرحلات والانطباعات) خيالاً مشوَّهاً وسوءَ تمثيل، حالا دون أن يصبح الاتصال الحميم وسيلةً ناجعةً لفهمٍ أفضل ومتبادَل. فالتواصُلُ نفسُهُ أصبح المشكلة؛ أي أنه جعل الإسلام شيئاً "يمكن ألا يكون"، كما يشير لذلك نورمان دانييل. فمن بين عناصر الجهل التي يشير إليها دانييل ملاحم الأدب التمثيلي الشعبي؛ حيث اتخذ النبيّ محمدٌ ملامح شيطانية. ومن بين أقدم هذه الملاحم المعروفة أغنيات رولان التي كتبها كريتيان دي تروي حوالي عام 1130م، وهي تعتنق المثال الصليبي من خلال استدعاء التاريخ القديم العائد لفترة حكم شارلمان وعام 778م، وهي حقبة ولادة فكرة أوروبا نفسها. فوصف المسلمين بأنهم وثنيون، وأنهم يعبدون ثلاثة آلهة، تختلط -كما يشير غوين وليامز- بالكفاح ضد بقايا الوثنية في أوروبا، وضد الهراطقة. وبذلك يصبح عالم المسلمين (=السرازانيين) مرآةً عن العالم المسيحي بصورةٍ مقلوبة.
بيد أنّ هذه الصُوَر الخيالية -التي لم يُفد القُربُ والتجاوُز الطويل في ضربها للوهلة الأولى- كانت تُضربُ من جهاتٍ أُخرى وإن ببطء؛ فقد مرت قرونٌ على التفاعُل بين الحضارة الإسلامية في أسبانيا والممالك الصليبية، مما وضع أوروبا في موقع المقترض من عدوّها التاريخي. كان الشرق غنياً بالذهب والفضة والمنتجات التي تُجلَبُ إلى أوروبا بكثرةٍ فتصبح من الضروريات. وما تعلق الأمر بالتبادل التجاري أو الاستيراد من الشرق وحسب؛ بل تمَّ أيضاً أَخْذُ فكرة الجامعة بكاملها شكلاً واصطلاحاً وبرامج تعليمية من المدرسة التي تطورت بدءًا من القرن الثامن الميلادي في العالم الإسلامي. فقد استعاد المسلمون تعليم العالم الكلاسيكي الذي افتقدته أوروبا، وبنوا عليه. كانت الرغبة عظيمةً في العلوم العربية التي شكّلت أساس النهضة الأُوروبية في القرن الثاني عشر، عصر توما الأكويني وبيتر أبيلار وروجر بيكون. وقد جعل ذلك السلطات الكنسية في أوروبا تتخوف كثيراً من أثر هذه الأفكار غير المقبولة والمهرطقة التي بدأت تتخلل نسيج العالم المسيحي المتعلّم. وكان على رجال الدعاية المضادّة أن يطوّروا أعمالهم ويقووها؛ ففي مقابل عِشق الشعر العربي، ظهرت شعريات دانتي أليغييري (1265-1321م). ففي النشيد الثامن والعشرين من جحيم دانتي نصادف النبيّ محمداً -صلَّى الله عليه وسلَّم-، بل وعليَّ بين أبي طالب. وبالإمكان التعرف على أثر الفلاسفة المسلمين كذلك. فقد بدأت الفلسفة الإسلامية -التي عبَّر عنها ابن سينا بقوة- تحرز حضوراً في الدوائر الأكاديمية في العالم المسيحي. ومن خلال تأثيرها وجَّه توما الأكويني طعنةً كاثوليكيةً غاضبة على شكل جدالية مطولة كتبها عام 1250م. ولكي يدافع عن موقفه القائل: إنّ أرواح المؤمنين تسعد برؤية وجه العلي الأعلى، اعتمد الأكويني على فيلسوفٍ مسلمٍ آخَر هو ابن رشد. ومع أنه كان مخطئاً في هذا الاستنتاج (فابن رشد مثل ابن سينا لا يقول بجواز رؤية الله بالأبصار يوم القيامة)؛ فإنّ المشكلة ومنهجيات حلّها مأخوذة عن هذين الفيلسوفين المسلمين. وقد رأى الأكويني أنّ اليهود والمسلمين يمثلون حالة جهلٍ وعنادٍ معاً؛ لأنهم عرفوا المسيحية ورفضوها، بخلاف تلك الشعوب التي لم تسمع بالمسيحية من قبل وتسهُلُ هدايتُها. وقد رأى روجر بيكون (ت. 1292م) أنّ رسالته تتمثل في استخدام الفلسفة الإسلامية للردّ على الإسلام: "فالفلسفة هي المملكة الخاصة بغير المؤمنين". ولا يرى جون ويكليف في كتاباته (1378-1384م) في الإسلام مجرد هرطقة في مجال العقائد فقط؛ بل هو طريقةٌ أيضاً على صعيد النظام الأخلاقي والممارسة العملية. لقد أصبحت المسيحية معياراً للحياة الطبيعية، والقانون الطبيعي. وقد تقدم بجون السيغوفي (ت. 1458م) البحث إلى حدّ إرادته الاقتصار على قراءة القرآن وفهمه ونقده؛ فإذا كانت فيه تناقُضاتٌ وإشكالياتٌ فمعنى ذلك أنه ليس موحىً من الله. وفي عام 1312م كان مجمع فيينا قد جادل بأنه لا يمكن ردُّ المسلمين عن دينهم بالإقناع أو بالسيف، ولذا لا بد من إنشاء كراسٍ لدراسة الإسلام والقرآن، من أجل مكافحته على أمدية أطول في جامعات باريس وأوكسفورد وبولونيا وسلمنكا. وتكرر هذا المطلب في مجمع بازل عام 1343م. لكنّ كراسي العربية تأخر إنشاؤها حتَّى منتصف القرن السابع عشر وبدايات الثامن عشر، ووقتها كانت الأفكار وبالتالي الوظائف قد داخَلَها تغييرٌ كبير.
كانت هناك إذن أدبيات تتصل بالحج، وهناك أدبيات تتصل باللاهوت والعقائد والفلسفة، وأدبيات شعبية مثيرة للخيال، وقد صبّت كلُّها في غير صالح الإسلام حتَّى لدى أولئك الذين تعلموا كثيراً من ثقافته ومن تقدمه. وبالتوازي ظهر أدبُ الرحلة ليس من أجل التجارة أو الحج، بل على سبيل الفضول وحُبّ الاستطلاع. وأَشهرُ هؤلاء غيبرت من نوغنز، والقديس برنار. وما أخطأَ هذان الرحّالتان كثيراً في الملامح الجغرافية للشرق؛ لكنهم دخلوا -مثلهم مثل غيرهم- في أمرين: تقاليد ومشاهد المعجزات والعجائب، وتشويه صورة النبيّ محمد-صلَّى الله عليه وسلَّم- والمسلمين. وكما تشير ماري كامبل فإنّ الشرق مفهومٌ منفصلٌ عن أي منطقةٍ جغرافيةٍ محدَّدة، إنه بالضرورة " في مكانٍ آخر" بالنسبة لكُتّاب العصر الوسيط، وكذلك بالنسبة للمستشرقين الذين كتبوا في المراحل التالية، كما هو بالنسبة لأسلافهم الكلاسيكيين. فالمواقع التي تسكنها الأعراق المتوحشة تتحرك من مكانٍ إلى آخر، من شرق إلى شرقٍ بالقياس إلى الغرب الذي تتصل به أو تقع في دائرة اهتمامه. فالأعراق المتوحشة، وأكلة لحوم البشر، وساكنو الكهوف، والبشر الذين لهم رؤوس كلاب، هي الأمور الجوهرية والثوابت الباقية، وهو مجازٌ يرمُزُ إلى البعد المفهومي الذي وضع الشرق خارج الغرب، وجعله ذا معنى يتطابق وأغراضَ الغرب. أما كتابات الرحّالة فهي نوعٌ من الأدب "الدنيوي"؛ لكنه عبّر عن الانشغالات لمجتمعٍ معين، ومن ثَمَّ فقد انبثقت من وعي مجتمعها المعاصر وخياله، ونشرت قيم ذلك المجتمع ووجوه تَوقه والمدركات الحسية الخاصة به. لقد رأى الرحّالة ما رغب أن يراه، وكتب ما كان جمهوره في أرض الوطن قد نشأ على توقّعه وكان مهتماً به ومسروراً لسماعه. وقد ذهب الفلورنسي ريكولدو دي مونتيكروتشي إلى بغداد عام 1291م وكان جاهلاً تماماً بعلوم العرب ومنجزاتهم الثقافية التي مثّلت يومَها ذروة الحضارة. كان همه الأساس مهاجمة الإسلام الذي قال عنه: إنه منحلّ، كما وصف المسلمين بكل الأَوصاف السلبية. أما الإيرلندي الفرنسيسكاني سايمون سيميونس فقد ذهب إلى فلسطين عام 1323م حاملاً معه نسخةً من القرآن كان كثيراً ما يقتبس منها؛ لكنه لم يستطع أن يذكر اسم النبيّ محمد-صلَّى الله عليه وسلَّم- مرةً واحدةً دون أن يُلحقه بنعوتٍ غير لائقة. وأخيراً هناك السير جون ماندفيل سيد كُتّاب الرحلة وعميدهم، وراعي المستشرقين والمثال التقليدي لهم، ويقول ماندفيل: إنه غادر موطنه عام 1356م، والواقع أنه ما كان هناك شخصٌ بهذا الاسم، وكاتب الرحلات هذا لا يبدو أنه غادر مكتبته إلى أيّ مكان، ومن المحيِّر أن تقاوم كتابات ذاك الرحّالة الموهوم هذه المقاومة المفزعة حتَّى أواخر القرن الثامن عشر. ففي عام 1785م كان عصر التنوير قد حلّ، وتمَّ التعرف على معالم الكرة الأرضية، ومع ذلك ظلّت تلك الرحلات مجالاً للاقتباس، وكأنه لم يمض عليها أربعمائة عام! ولهذا السبب يصف توماس بينانت في عمله الموسوعي: حدود الكرة الأرضية (1798-1800م) ماندفيل بأنه "أعظم الرحّالة في عصره وفي كل العصور"! وقد بلغ من تأثير خريطة جون ماندفيل لسيره أن استدلّ منها ماركو بولو على كروية الأرض. وعندما اتّبع كريستوف كولومبوس خَطَّ السير الذي حدَّده ماندفيل كانت أوروبا تُواجهُ "رُعْب العالم" الجديد، كما سمّاه فرنسيس بيكون. والرُعْبُ الذي يذكره بيكون هو زحف العثمانيين باتجاه أوروبا. لقد كان الإسلام هو القوةَ الأساس التي تُسيِّر عملية استكشاف الأوروبيين للكرة الأرضية. كان الأوروبيون يسعون لكسْر العُزْلة عنهم والتي فرضتها قوة الإسلام، وكانوا يسعَون للحصول على الذهب الذي يستطيعون به دفع ثمن السِلَع التي يستوردونها من عالم الإسلام، وكانوا يبحثون أيضاً عن الملك الخيالي الطيّب بريستر جون، وهو ملكٌ مسيحيٌّ موجودٌ في مكانٍ ما بالشرق، أو عن الخيال العظيم الذي تحدث عنه ماركو بولو. وفي زمنٍ واحدٍ تقريباً وقعت عدة أحداثٍ غيَّرت كلَّ شيء، ومن ضمن ذلك موقع الشرق في خيال الأوروبيين وواقعهم: اكتشفوا العالم الجديد بخيراته، ووصل البرتغاليون إلى الهند بإرشاد بحّارٍ مُسْلم، وتوقّف التقدم الرئيس من جانب العثمانيين إلى أوروبا وفيها، وحصل الإصلاح الديني الذي شق الكنيسة. وهكذا تغير موقع الشرق في الاهتمام؛ لكنّ تغيرات الوعي استغرقت عشرات العقود لتُساير وقائع المعرفة والقوة والسلطة الجديدة.
في منظور الإصلاح الديني الجديد الذي جرى في القرنين السادس عشر والسابع عشر، أصبح الدين أكثر مركزيةً في تعريف الذات وفهمها، وهكذا يرى همفري بريدو عميد نورويتش في نصٍ كتبه عام 1697م أنّ المسلمين -بوصفهم جزءًا من غايات الله لا ندركها- هم عقابٌ للمسيحيين على خطاياهم. ولهذا السبب ظلت الإمبراطوريات الإسلامية الكبرى في تركيا وفارس والهند المُغُلية قائمة: "عقاباً لنا نحن المسيحيين الذين أنعم الربُّ علينا بأقدس الأديان وأفضلها، دون أن نبرهن أننا نستحقُّ هذا الدين". لقد كان الإحساس المسيحي بالتفوق، والفكرة القائلة: إنّ المسيحيين اختارهم الله، سمات ومعالم ثابتة، أمّا الإحساس بالتقدم الاجتماعي والعلمي فهو أمرٌ جديد. لقد كانت الإمبراطورية العثمانية نفسها من بين الخيوط التي ساعدت هذا النسيج الجديد على التكوُّن، كما أدركت أوروبا تماماً خلال العصر الوسيط تفوُّقَ العلوم في الحضارة الإسلامية. على أنّ التعلُّم من علوم المسلمين ما غيَّر من النظرة إلى المسلمين أنفُسهم؛ إذ المُهمُّ أنّ الشمس تحركت من الشرق إلى الغرب، وهذه هي الفكرة المتكررة على الدوام منذ فيكو وإلى هردر وهيغل. فحتى الصعود الأوروبي صار معركةً تُشَنُّ على حساب الشرق، الذي ما عادوا يرون فيه غير الأتراك المتخلِّفين. وكان المجتمع التركي أيضاً هو النموذج الذي تمَّ بناءُ الاستبداد الشرقي استناداً إليه، وقد ظنَّ السير وليم تمبل أنّ الإمبراطورية العثمانية هي الأشرس في العالم، والوزراء والجند هم عبيدٌ للسلطان صاحب السلطة المطلقة، ومن ثمَّ فإنّ الشرق الأكثر قُرباً من أوروبا والأكثر إثارةً للرعب فيها، أُضيفت إليه في آخر الأمر شخصيةٌ طبعت تاريخه وإنسانه.
لقد كان الاستشراق وسيلةً للاختيار والانتقاء، ولا يستطيع المرء اختيار ما يبدو تعليقاتٍ ومواقف مفضَّلة والتعامُل معها بوصفها بصماتٍ لنوعٍ من "تاريخ حزب الأحرار"؛ أي آلام ولادة ما يسمَّى بلغة اليوم: الاستقامة السياسية. إنّ الشيء المفضَّل منغرسٌ بثباتٍ في سياقه التام. ومن فكروا بالشرق بصورةٍ إيجابيةٍ كانوا دائماً مهمَّشين، وما بدا إعجاباً تمت معادلته برأْي يفهمُ منها الرفض. لذا كان في إمكان تيفينوت التعليق قائلاً: "هناك أُناسٌ كثيرون في العالم المسيحي يعتقدون أنّ الأتراك أشرارٌ وهمجيون، ورجالٌ بلا معتقدٍ أو أمانة. لكنّ من عرفوهم وخالطوهم لهم رأْيٌ آخَر... فهم يقولون: إنهم ورِعون ومحسنون متمسكون بدينهم"؛ لكنّ التعلُّق المهووس بدينٍ باطلٍ نُظر إليه بوصفه فشل الشرق الأساسي، وهذا عنصر أساس من عناصر الصورة النمطية، كما أنّ النُدرة هي مجرد حالةٍ فردية تتخذ من مثال العدوّ منطلقاً للرغبة في إصلاح المجتمع (الغربي) وتعديل مواقفه. ولنأخذ على سبيل المثال محادثة السير توماس باينز مع المعلّم التركي فان أفندي؛ فالسير توماس يقول: "إنّ كلَّ مسلمٍ ملتزم بأصول دينه قد يحصل على الخلاص دون شكّ.. لكنّ المسلم المتمسك بتلك الأُصول يعدّ الآخرين -أياً كانوا وبسبب اختلافهم بالذات- منحرفين وعبدة أوثان أو مشركين..". فحتى العثمانيون الفضلاء -في نظر قلةٍ من الأوروبيين- كان "فضلُهُمُ" هذا بالذات مانعاً لهم من النظر إلى غيرهم نظرةً فيها شيء من السَعَة والإنصاف! وهذا كلُّه في عصر العقل والتعقُّل، القرن التاسع عشر الميلادي. ويكون علينا أن نتنبه إلى أنّ الاستشراق الذي صنع هذه المقاييس المنطبقة على المسلمين هو نفسُهُ الاستشراق الذي نظر إلى الصينيين والهنود باعتبارهم تكراراً من نوعٍ ما للمسلمين والإسلام، في مواجهة أوروبا والأوروبيين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) نصُّ سردار مأخوذٌ من كتاب سوذرن: صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى (1963، 1978). وقد ترجمتُه إلى العربية عام 1983، وصدر مرةً ثانيةً عام 2006. والاقتباس موجودٌ في الترجمة (ص42-43). والفقرات اللاحقة أيضاً تأخذ كثيراً عن سوذرن (ر. السيد).
