شعبُ حوار.. وخبرة تعايش.. على مر التاريخ
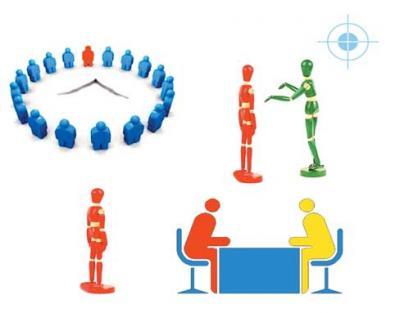
قراءة لمحطات الحوار في حياة اليمنيين
توفيق الحرازي
أخيراً، قرر اليمنيون الالتئام، وتنادوا للحوار.. وولّوا وجوههم شطر الفرصة الأخيرة.. بدأ كلٌّ باتخاذ موقعه في الطاولة، وانطلقت السفينة، فبسم الله مجراها ومرساها، تلاقت الجموع بعد صراع إراداتٍ أعمى، وحوار مَوتٍ، زج بالبلد في نفق مظلم كاد يفقدهم البصر والبصيرة، وكبّدهم خسائر مروعة فاقت قدرة الناس على الاحتمال، نحو ثلاثة أعوام..
وما كان لمثلهم- وقد أعياهم التعب- أن يتأخروا عن حوار حياة- كل هذا الوقت، إلا لأنه كان وراء الأكمة ما وراءها.. ودفع الله ماكان أعظم!
هي المبادرة إذن، أدركت الخطر مبكراً.. فصراعٌ كهذا كان بإمكانه أن يُفضي لمآلات كارثية، مفتوحة على أسوأ الاحتمالات، في بلدٍ مفخخ، مخزونه الاستراتيجي من سلاح ونار، أوفر من الخبز والغذاء... وقطرات الماء!!.. مقارنة صادمة جعلت العالم يتوقع سيناريوهات مخيفة، خلاصتها: إذا وقعت الواقعة في هذا اليمن ليس لوقعتها كاذبة!!.. لهذا تحاماه الجميع، سرعان ما أحاطوه بالعناية الفائقة، وأدخلوه غرفة الإنعاش- تحت الوصاية المركزة!!
لا غرابة في اهتمام العالم.. فبلدٌ كهذا، وفي ظروفٍ كتلك، ليس من العقل أن يُترَك لنفسه - بل هو الجنون ذاته.. ثمة أيدٍ على الزناد، ورغبة انتقام، وأعصاب مشدودة يمكن أن تتفلت في غمضة عين، وأمامك منطقة تغلي برمتها، ثمة زلزال عربي متنقل يجر بعضه بعضا- لا قدرة لأحدٍ على كبحه، وثمة خارطة تتشكل من جديد، ومتغيرات يجب أن تمر في بلدانها، فيما وضع اليمن مختلف عن كل مايجري، تحدياته أكثر تعقيداً، وموازين القوى أحدثت تعادلاً صعباً؛ تعرقلت إزاءه كل سيناريوهات الحل والحسم، وتوشك إطالة أمد الصراع أن تقضي على ماتبقى من يمنٍ راعف؛ لو تُرِك أبناؤه لقَدَرهم سيدفع الجميع فاتورة باهظة؛ لا قُدرة "للجوار" على احتوائها!!.. إذن، لا مجال هنا للمغامرة بمصير بلد يتاخم أهم منطقة في العالم.. فأي حل حاسم لهذه المعادلة المعقدة يمكنه أن ينتشل اليمن بهدوء؟؟
كان على العالم أن يخترق الضجيج بقوة ليقدم حلا عاجلا ينقذ اليمنيين من بعضهم، ويتفادى الكارثة بأقل الخسائر.. ليس بمقدوره أن يأتي بعصا سحرية تنهي الورطة في لمح البصر.. لكنه بحاجة لحل يمني صميم من رحم التجارب.. فكان لابد من التفتيش في الذاكرة الوطنية بحثاً عن مخرج ملائم.. وبقراءة سريعة للتاريخ القريب التقط الرعاة خصوصية تاريخية فريدة، وميزة يمنية خالصة يمكنها وحدها أن تنتشل البلد من المأزق، وتمرر التغيير بأقل ثمن.. فكان ما أرادوا.. إذ تم الرهان على "الحكمة اليمانية" وإرث الحوار!
سرعان ما تذكّر العالم، والجيران على وجه الخصوص، أن لليمن تاريخا حافلاً بالمصالحات، وسجلاً ثرياً من التفاوض، وجنوحاً معهوداً للسلم.. ففي كل حقبة تغيير؛ أياً كان ثمنه، ومع كل دوامة صراع؛ أياً كانت دمويته، اعتاد اليمنيون على التصالح وتقديم التنازلات.. فهم على عنادهم وجسارتهم، وشراستهم في المعارك، لا يركبون رؤوسهم حتى النهاية، بل سرعان مايعودون من تناحرهم مكلومين، يجرون أذيال الحسرة وتأنيب الضمير وحالهم كحال القائل:
إذا احتَرَبتْ يوماً وسالتْ دماؤها
تذكرتْ القـُربىَ فسالت دموعُها
هي الحكمة إذن ولو بعد حين، خصوصية يمانية حاسمة.. فالصراعات في العالم عادة ما تكتب نهاياتها برسم التناحر.. إلا في اليمن، تَكتب الصراعات نهايتها بالتحاور!!.. هنا فقط تنتصر الحكمة.. وهنا ثقافة حوار متوارثة، اكتسبوها من كثرة خلافهم، وخبرة صراعهم، وتوازن ضعفهم.. حتى وإن انتصر طرف، لا يعني ذلك نهاية المعركة معه، بل هي أشبه بشهر عسل وفترة نقاهة مؤقتة لا تلبث أن تدور بعدها الدوائر، ويتجدد الصراع، ليتطاير مَثارُ النقع فوق الرؤوس، كَلَيلٍ تهاوىَ كواكبُه، ولا يهدأ عرشٌ بحاكميه، إلا عندما يجلس الجميع إلى طاولة حوار تنتج صلحا، أو صيغة احتواءٍ مُرضية!
في مشكلة اليمن، ثمة حقيقتان تاريخيتان لا تقبلان الجدل، الحقيقة الأولى أن اليمانين كلما ابتعدوا عن الحوار أصابتهم اللعنة، وأدخلتهم في ظلماتهم يعمهون، إلى أن يحتكموا لمصالحة.. كانوا كلما تصارعوا ضعفت دولتهم وانكسرت شوكتهم وتشتت شملهم، وتفرغوا لاستنزاف قدراتهم في مواجهة بعضهم دون حسم.. لكنهم ما إن يلتقطوا أنفاسهم ويعودوا لجادة الصواب حتى يلتقوا على طاولة حوار، وإذا تحاوروا تآلفوا، وحين يتآلف اليمانون يشرق عهد ذهبي من التعايش والقبول بالآخر..
الحقيقة الثانية أن اليمانيين كلما تحاوروا وتعايشوا أضافوا للعالم حضارة جديدة وسبقاً تاريخياً، وليس صيتُ سبأ ومعين وحمير ببعيد، وحتى الحقب الإسلامية الوسطى، فمنذ ثلاثة آلاف عام ظل اليمن سباقاً لإنتاج حضارة تلو حضارة، إلا في الحقب التي يتفرغ فيها للصراع.
يقال ان الأرض الطيبة لا تنتج إلا طيبا.. واليمن بلدة طيبة- شهادة معمدة بختم القرآن.. لهذا أهلها طيبون، أرق قلوبا وألين أفئدة، وأكثر الناس حكمة وجنوحا للسلم والتعايش، إذا تحاوروا وحُفِظت كرامتهم!
على مر تاريخه؛ لم يُحكم اليمن بالفردية ولم يشهد استقراراً حين تحكمه قبضة حديدية تستضعف أهله.. تلك مُسَلّمة تاريخية، أكدها حتى القرآن الكريم في قصة قوم سبأ.. كانت بلقيس لا تتخذ قرارا سيادياً حتى تستشير حكماءها، حتى وهي الملكة العظيمة، وصاحبة القوة والبأس الشديد، لم يكن بمقدورها أن تدير بلد الحضارات؛ بكل مافيه من الأقيال وأقحاح الرجال، دون هندسة جماعية للقرار.. بدليل قصتها مع الملك سليمان حين دعاها لعبادة الله (قالت ياأيها الملأ أفتوني في أمري، ماكنتُ قاطعة أمراً حتى تشهدون).. وفي قولها (ماكنت قاطعة أمراً) تأكيد على أن نظامها لم يكن فردياً، بل تشاركياً.. ومشاورة القوم دليل حوار.
حتى عندما استشعرت خطر المَلِك الجديد، القادم من أورشليم، كانت تتوقع غزواً لا محالة، بدليل قولها لقومها: (إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلِها أذلة).. كان بمقدور كبريائها أن يدفعها لاتخاذ قرار المواجهة بفرديّة، مادامت تملك العزة والهيلمان.. لكنها لم تكن من الطيش حتى تواجه خصمها بالقوة قبل أن تقرأه أولاً.. والقراءة الجيدة تبدأ بالحوار مع الخصم.. كان عليها أن تتمهل، تأملت في رسالة الهدهد: (إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أن لا تعلو عليَّ وأتوني مسلمين).. خطاب روحاني مسالم، مثله لا يصدر من غُزاة، بل من هُداة.. وهذا لا يواجَه بحملة حرب، بل بحكمة حوار.. لهذا كان موكبها الضخم إلى بلاط سليمان محملاً بالهدايا والكنوز والبخور، لا بالويل والطبول.. لقد جنحت للسلم قبل أن تواجه خصمها، ولم ترسل إليه وفداً ينوب عنها كعادة الحكام، بل ترأست وفدها دون غيرها، لتتولى حواره بنفسها، تأكيداً لحسن النوايا، ولرؤية حقيقة مُلكِه رأي العين، فكانت حكمة صائبة قادتها إلى الهداية!!.. مثل هذه الحكمة هي التي حكمت سبأ، فأمكنها ان تنتج أعظم الحضارات.. وهكذا كانت في الحقب التالية والحضارات المتوالية.
لن نوغل في القِدم، يكفي أن نلتقط شاهدا آخر من قصص سيف بن ذي يزن، آخر ملوك حِمْيَر، على مقربة من فجر الإسلام، وتحديدا في حواره مع وفود مكة بزعامة عبدالمطلب حين جاؤوه مهنئين بالنصر.. فرغم ان الملك الشهير قهر الأحباش وطردهم من الجزيرة العربية برمتها، وعاد ملكا متوجا على اليمن إلى حدود مكة، إلا انه لم يستأسد على أهل منطقته، أو يتمدد كعادة المنتشين، بل استضافهم، سالمهم، حاورهم، أكرم وفادتهم، وترك البلدة لأهلها، ليتعايش معهم، دون أن يفرض دينه أو فكره على أحد!
حدثت هذه الرؤية التقدمية قبل الإسلام.. وحتى مع بزوغ الفجر المحمدي؛ معروف أن أهل اليمن جنحوا للسلم منذ لحظاته الأولى، سمعوا عن الدين الجديد الذي يتهدد معتقدهم فلم يواجهوا صاحبه (ص) كما فعل غيرهم.. كان بإمكانهم- وهم أهل القوة والبأس- أن يتحالفوا مع زعماء مكة لوأد الثورة الجديدة، لكنهم سالموه وفضلوا محاورته أولاً، أرسلوا وفودهم لملاقاته.. ولأنهم كانوا أول المسالمين، اختارتهم السماء ليكونوا أول المسلمين وباكورة المدد، بل خصّهم صاحب الرسالة (ص) بأشهر وصف دون سائر الأمم: "أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان، والحكمة يمانية".. كان لهذه الشهادة المقدسة أعظم الأثر في نفوسهم، فقد جعلتهم أحرص الناس على المسالَمة والتعايش وصلح الشأن، جيلاً بعد جيل.. حتى إبان الخلافات الثلاث (راشدية، أموية، عباسية)، ظل اليمنيون على تعايشهم وجنوحهم للسلم والتصالح مع الجميع، وإن تكرر الصراع.
وثمة دول استثنائية في تاريخ اليمن لم تشتهر وتزدهر إلا لأنها أسست مجدها على قاعدةٍ من حوار واحتواء، فملأت الأسماع وتوهجت بذكرها سجلات التاريخ.. أما الدول التي استأثرت ودخلت في معمعان الصراع والأحادية فلا يكاد يذكرها المؤرخون إلا على سبيل الإشارة.
هنا يمكن الاستشهاد بالدولة الصليحية التي شكلت علامة فارقة في تاريخ اليمن، ففي هذه الامبراطورية العظيمة لا تدري كيف أمكن اليمانيين المأخوذين بفحولتهم ورجولتهم أن يولوا أمرهم امرأة، ولم يجدوا غضاضة في أن تحكمهم "أنثى" للمرة الثانية في تاريخهم ويتآلفوا تحت ظلها!! فبعد بلقيس القديمة تعايشوا في كنف أروى لنحو أربعين عاما، رغم الفارق الفكري والمذهبي، فصنعوا في عهدها مالم يصنعوه في غيره، وأنتجوا دولة لم تتكرر.
كذلك في عهد الدولة الرسولية الشهيرة، والطاهرية، وصولا للعهد العثماني، ثم الإمامي، وحتى الجمهوري، لم يكن يستقر اليمن بالفردية، لكنهم لم يكونوا يركبون رؤوسهم حتى النهاية، بل كان الحوار في كل مراحل الحكم وسيلتهم للتعايش، والتعايش فقط طريقهم للمجد.
إذن هي قضية جذور تاريخية، تؤكد أن الأمر ليس جديدا على أهل اليمن، فقد توارثوا ثقافة الحوار والسلام كابراً عن كابر.. وحسب الدكتور الإرياني في محاضرة ألقاها مؤخرا عن تاريخ الحوار الوطني: "كان الناس في الماضي يرجعون الى إرث الحوار في ما بينهم عندما تكون الدولة اليمنية ضعيفة، وكلما أصابها الضعف عادوا الى العادات والتقاليد والأعراف التي يبنون على أساسها حوارهم، وهو ما رجع إليه اليمنيون اليوم لصياغة الدولة الحديثة".
ربما لا يجدر بنا الإغراق أكثر في التفاصيل والذهاب بعيداً في مجاهل الماضي.. وحتى لا نشرد عن الحاضر، يكفي أن نكون قريبين من تاريخ اليمن المعاصر- وتحديدا إبان الثورتين السبتمبرية والاكتوبرية مطلع الستينات.. فرغم ما مرت به الحقبة الثورية من صراعات طاحنة وحصاد مر، بين الطرفين الجمهوري والملكي من جهة، والسلاطيني والاكتوبري من أخرى، أمكن لهم الجلوس إلى بعضهم حتى حققوا مصالحات وطنية شهيرة أوقفت نزيف الدم واستنزاف القدرات المروع في الوطن المشطر- شماله وجنوبه.
الشمال نموذجاً
لنأخذ الشمال مثلاً، فالنظام الجمهوري في صنعاء اعترضته تحديات كبيرة تمثلت في ثورة مضادة لقيت من يدعمها من الخارج بهدف تقليم أظافر الثورة، وتأثرت الأحزاب والحركات ذات الامتداد الخارجي بالصراعات الإقليمية والدولية، فطال أمد النزيف، وتأجل مشروع بناء الدولة الحديثة.. تصارعت الإرادات وتصادمت المصالح الداخلية بالخارجية، بل تصادم المدد الخارجي ببعضه، فمن شرقي إلى غربي، ومن قومي ناصري إلى إسلاموي، إلى بعثي إلى ماركسي، صِدام لا يتوقف، وفي كل تصادم كان الضحية هم اليمنيون فقط، لكنهم في منتصف كل صراع لم يكونوا يركبون رؤوسهم حتى النهاية، بل إثر كل إنهاك تستيقظ فيهم ثقافة الحوار المتوارثة، ويجدون في التحاور فرصة للتقارب وكسر الحواجز النفسية، فمن مؤتمر عمران1964م إلى مؤتمر خمر1965م، إلى مؤتمر الجند 1966، إلى مؤتمر حرض، إلى مؤتمر جدة، إلى مؤتمر الخرطوم، وغيرها.. تعددت المؤتمرات والهم واحد.. كانت كلها مآلات طبيعية لكتابة نهاية حاسمة للصراعات، صحيح أنها ظلت أشبه باستراحة محارب، يضطرون إليها حين ينهكهم الصراع ثم يعاودونه، لكن المهم انهم ظلوا يحتكمون للحورارت، حاولوا بها إثبات حكمتهم، فشلوا في بعضها ونجحوا في أخرى، إلى أن توصلوا في نهاية المطاف لحلول مرضية استقرت معها سفينة الثورة المنهكة، رغم أنها لم تسلم في ما بعد- من خَضّات مؤسفة.
تلك المؤتمرات، كانت كلها تتمحور حول وضع صيغة مُرضية لطبيعة النظام الجديد للبلد الثائر، ولتحديد العلاقة مع الوجود العسكري المصري المناصر للثورة.. وجود حاسم جعل هجمات الملكيين تشتد على النظام الجمهوري الوريث، وألب القوى الخارجية المتحالفة مع الغرب، ليمتد صراع الجمهوريين والملكيين ثماني سنوات لم يتمكن المتصارعون خلالها، وحتى بعدها، من أن يصنعوا دولة مؤسسات وحركة تنمية تجسد قوة حركة التغيير.
صحيح أن الثورة انتصرت في ما بعد على الملكية وكسرت حصار صنعاء، لكن الاستقرار السياسي لم يتحقق، وجرت محاولات ومؤتمرات لتصحيح مسار الثورة، منها مؤتمر القوات المسلحة عام 1969م الذي عُقد بهدف صياغة مشروع للإصلاح، ثم مؤتمر المصالحة مع الملكيين، وصياغة دستور دائم عام 1970م.. وهو الدستور الذي شهد الإعلان عن مشروعه في ليلة 26سبتمبر70 ليشهد معه شمال الوطن حوارات مفتوحة بغرض الإعداد والتحضير لوضع الدستور الدائم.. شملت تلك الحوارات والاجتماعات مختلف الفئات ودامت ثلاثة أشهر في كل من صنعاء والمدن والقرى، تحاور فيها المواطنون وتبادلوا وجهات النظر، غير أن هذا الدستور لم يطبق، كغيره من الدساتير المؤقتة والدائمة والإعلانات الدستورية التي سبقته، والتي كان كل واحد منها انعكاسا للقوى المهيمنة في وقت إعداده- حسب رؤية البعض.. ذلك أن اليمنيين حين يتحاورون ينجحون في صياغة دساتير وقوانين ومواثيق تعايش، لكنهم يفشلون في تنفيذها والالتزام بها.. وسرعان ما يدفعون الثمن!
حتى بحدوث انقلاب 5نوفمبر 1967م، وانقلاب74، رغم انها كانت حقبة حافلة بالحوارات، إلا أن الصراع لم يتوقف أو يلتقي الفرقاء على مقومات مشتركة لمشروع حضاري يؤسسون به دولتهم.. ليس لأن الحوار لا يجدي في اليمن، بل لأن اليمنيين خرجوا عن جادة الحوار.. صحيح أن ثقافة التحاور لم تمت في ذاكرتهم، لكنهم أصبحوا لا يتحاورون بِنيّة التعايش البنّاء وشراكة البِناء، بل بِنيّة الاستئثار والانقضاض على الآخر. والنتيجة ما حدث في 77 و78 و79 من قطف رؤوس- شمالا، وصولا الى ماحدث إبانها وبعدها حتى 86 و94- جنوبا!
حوارات الجنوب
حتى على صعيد الشطرين، ففي البدء، لولا التقاء نضال الثورتين على قاعدة من حوار ومصير مشترك ورغبة تعايش لما انتصر الشمال، فالدم الجنوبي كان حاضراً بقوة.. ثم بعدها لولا هذا الشعور بالمصير المشترك لما أمكن أن تتدحرج كرة النار من صنعاء إلى عدن لتفجر ثورة ثانية.. وما كان لألسنة اللهب في عيبان أن تشعل جبال ردفان بعد عام واحد لولا التقاء الثورتين على قاعدة من حوار ومصير مشترك أمكن لليمنيين بفضله أن يتفرغوا لإنقاذ بلدهم، فصنعوا معجزتين بكل المقاييس قلبت موازين القوى وغيرت وجه المنطقة برمتها.. أما عندما اختلفت الثورتان؛ وتفرغ رجالها للاستحواذ وتصفية الحسابات؛ صنعوا لبلدهم إرثاً كبيرا من الخراب ماتزال الأجيال تدفع ثمنه حتى اللحظة.. والشواهد كثيرة على الحالتين- البناء والهدم.
فعلى صعيد الجنوب، كان مفككاُ في 22 سلطنة ومشيخة منذ عام59، ولم تنتصر الثورة الاكتوبرية كلية عام63، فقد دخل رفاق النضال في دوامة صراع، امتدت لأربع سنوات بين قوى الثورة، إلى أن قام حوار طويل بين الجبهة القومية وجبهة التحرير نتج عنه دمج الجبهتين عام 1965م لتجسيد الوحدة الوطنية، ثم لم تلبث القومية بعد عام واحد أن انسلخت عن رفيقتها ليتجسد صراع صامت.. لكن المصير المشترك أبقى الجميع على واحدية نضال حتى تحققت معجزة الاستقلال67.. حينها حُسمت الثورة الاكتوبرية، بالتزامن مع انتصار الثورة بصنعاء في ملحمة السبعين يوماً ضد التكالب الملكي والإقليمي والدولي الذي أدخل ثورتها الوليدة في دوامة صراع مريرة، وسطر ثوار الشطرين حينها أروع ملاحم التوحد في خندق المصير المشترك، ليُصنع الاستقلال والسبعين واحداً بعد الآخر، حينها تنفست الثورتان الصعداء، ومضت الدولتان الجديدتان في تلمس خطاهما، فقامت جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الواحدة، على أنقاض شطر متناثر متعدد الرؤوس والإمارات.
خدعة مسمى الجنوب "العربي"
مع قيام الثورة السبتمبرية في الشمال تعاظمت المخاوف البريطانية من أي تقارب بين الشطرين، فمضت في إثارة هلع المشائخ والسلاطين والقبائل من الخطر الشمالي القادم.. وشجعت على توحيدها في مسمى مستقل عن الهوية التاريخية والجغرافية للجنوب اليمني.. فتم تأسيس ماسمي باتحاد إمارات الجنوب (العربي)، كتكريس لاستقلاليته عن الهوية اليمانية، وهو تجمع لمشيخات وسلطنات تأسست تحت رعاية الإمبراطورية البريطانية في محمية عدن بتاريخ 11 فبراير 1959 من 6 أعضاء، ثم توسع في ما بعد ليشمل كلاً من:
(مستعمرة عدن- مشيخة العلوي- مشيخة العقربي- سلطنة العوذلي- إمارة بيحان- مشيخة دثينة- إمارة الضالع- سلطنة الفضلي- سلطنة الحواشب- سلطنة لحج- سلطنة العوالق العليا- سلطنة العوالق السفلى- مشيخة العوالق العليا- سلطنة يافع السفلى- سلطنة يافع العليا- مشيخة المفلحي- سلطنة الصبيحي- مشيخة الشعيب- سلطنة الواحدي- السلطنة الكثيرية- سلطنة المهرة- السلطنة القعيطية).
كان هذا التفكك إبان فترة ما سمي بالحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي.. لكنه لم يعمّر طويلا فقد قض انتصار الاستقلال مضجعه في30 نوفمبر67.. حينها تمكنت الجمهورية الأكتوبرية من تذويب كافة السلطنات والمشيخات في إطارها.. وكان من سوء حظ الثورتين شمالا وجنوباً أن دخلتا في دوامة صراع داخلية من ناحية، واحتكاكات مؤسفة في ما بينهما من ناحية ثانية، فبعد الاستقلال برز الصراع على السطح بين الجبهتين القومية والتحرير، ولجأ الجميع للحوار، لكنه انتهى بانقضاض طرف على الآخر، بعد أن طال أمد الحوار بلا نتيجة مثمرة، حتى قيل إن الرئيس الراحل سالم رُبَيِّع وصفه بقوله: كان أطول حوار في أصغر بلد".
حروب الشطرين
وبعد انتصار الثورتين ظلت تشتعل حروب ضارية بين الشطرين، "ووقع شمال اليمن وجنوبه ضحية أيديولوجيات متصارعة ومصالح إقليمية ودولية متباينة زجت بهما في طاحونة صراعات وحروب، تارة شطرية، وتارة حروباً بالوكالة كما حدث في المناطق الوسطى" "وفُرضت خلالها توسطات وتدخلات من أطراف عربية وخارجية، ومنها مصر والجامعة العربية.. وعقدت حوارات عديدة، ووقعت اتفاقات على طريق استعادة الوحدة اليمنية، كخيار استراتيجي لإنهاء الصراعات الشطرية، تلاها بيان طرابلس في نفس العام، فضلا عن لقاءات هنا وهناك لفض الاشتباك بين قوى الثورتين من ناحية، وبين قوى الثورة الاكتوبرية وبعضها، ومنها حرب عام 1972م والتي آلت في البداية إلى فتح باب الحوار بين قيادات ومسئولي الشطرين من أجل إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.
الوحدة اليمنية.. نتاج حوار
لم تأت الوحدة من فراغ او تحصيل حاصل، بل ثمرة جهود مضنية عرقلتها الصراعات.
فقد توالت لقاءات القمة بين الشطرين، وتوسعت اللجان والهيئات وتعددت العواصم والمدن التي احتضنتها، فمن اتفاقية القاهرة عام 1972م، إلى بيان طرابلس الغرب في نفس العام، مرورا بالجزائر، وتعز، وعدن، وصنعاء، والكويت، محطات متوالية لإعادة اليمنيين إلى ثقافة الحوار لحل مشاكلهم وأزماتهم..، لكنها لم تسلم من الانكسارات وعودة الأوجاع، ومنها ماحدث في المناطق (الوسطى) التي نشأ فيها نشاط عسكري ضد نظام صنعاء، مدعوماً من نظام عدن، تسبب في حرب أهلية- حسب مراقبين- صعّبت على القوات النظامية قمع الجبهة الوطنية، وتنامت الأحقاد والكراهية بوجود جيش شعبي في مناطق تلك الجبهة، لتتفجر حرب 1979م، لكنها في النهاية أفضت إلى حوار، تَمثّل في لقاء قمة الكويت بين الرئيسين السابقين علي عبدالله صالح- وعبدالفتاح اسماعيل والذي ضم إليه ممثل الجبهة الوطنية، بعد تفاهمات لإنهاء العمل المسلح ضد حكومة صنعاء، وتم الاتفاق في قمة الكويت على تكليف لجنة لصياغة مشروع دستور لدولة الوحدة..
بالتوازي مع هذه الخطوة "دارت عجلة حوار وطني في صنعاء لصياغة نظرية سياسية تؤطر العمل السياسي، وهو ما كان قد تقرر سابقا في قمة عام 1972م بين قيادتي الشطرين لإنشاء تنظيم سياسي في صنعاء، أسوةً بالجنوب الذي يعمل في إطار حزب له نظريته، فجاء تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24أغسطس 1982م كمعادل سياسي للحزب الاشتراكي في عدن.. وكان "الميثاق الوطني" خلاصة ما توصل إليه الشمال لتأطير العمل السياسي.
أما عام 86 فشكل أخطر المنعطفات الدامية التي مرت بها الصراعات، وأكبر الأخطاء التي وقعت في الجنوب، كان لابد من تجاوزه بأسرع ما يمكن، فتم التعجيل بقيام الوحدة اليمنية قبل فوات الأوان.. وجاء30 نوفمبر1989م ليتوج مراحل الحوار السابقة بين الشطرين بخصوص الوحدة، وتم فيه الاتفاق على مشروع دستور دولة الوحدة بين قيادتي الشطرين والحزبين الحاكمين وذلك إيذاناً بقرب تحقيق الوحدة التي أعلنت في 22مايو 1990م بعدن.
"لقد تحققت الوحدة الاندماجية بين الشطرين وتقاسم الحاكمان السلطة ولكن لم يتحقق الاندماج الفكري والعسكري. وهو مايعتبره الخبراء والفرقاء في الأزمة الراهنة وأحداثها السابقة نتيجة لخلل في جوهره، لأن الحوار الذي أفضى لتحقيق هذا الإنجاز العظيم لم يستند لأرضية واسعة وشراكة وطنية كاملة بإمكان مختلف القوى والفعاليات والشخصيات الوطنية من خارج شركاء الوحدة إبداء الرأي حوله وبذل الجهد لترسيخ الوحدة وصياغة رؤية متكاملة للدولة الناشئة تضمن تجذير الديمقراطية ومؤسسات الدولة ومبدأ التداول السلمي وبناء نظام سياسي اجتماعي واقتصادي متوازن يسمح بإحداث تغيير جذري في حياة اليمن.
لذلك- حسب مراقبين- طُبعت الفترة الانتقالية لدولة الوحدة بطابع التأزيم وكان لابد من حوار جاد تشترك فيه قوى جديدة وشخصيات اجتماعية وأكاديمية ذات وزن.. فكان الحوار في الداخل ببعده الاجتماعي إما محدوداً أو لم يخضع للقياس.. ثم التقى شركاء العمل السياسي على طاولة الحوار في العاصمة الأردنية عمان وسط متغيرات اقليمية ودولية وتزايد الأعباء على الاقتصاد الوطني، وحظي الحوار بين اليمنيين كالعادة باهتمام عالمي واسع وتم الاتفاق على بنود مهمة في وثيقة العهد والاتفاق كان من المؤمل أن تؤدي لاستعادة التماسك.
ولكن كان لعدم دمج القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية أثر في استمرار الأزمة التي أدت إلى حرب صيف 1994م بما أدت إليه من هزيمة نفسية لدى المواطن الذي أصيب بخيبة أمل كبيرة، وما نتج عنها من ملفات معقدة استعصت على الحوار، وأدت لتفجر الأوضاع ودخول البلد في نفق مظلم لم تخرج منه حتى اللحظة، ولن تخرج مطلقا مالم يرجع اليمنيون لجادة الحوار التعايشي، الخالي من شوائب الماضي وحساباته البغيضة.. وهو ما يبدو أنه توفر اليوم بانعقاد هذا المؤتمر الأشمل، والذي يمثل حوار الفرصة الأخيرة، ويعول عليه الخروج بصيغة مثلى تعين الجميع على بناء يمن جديد، يتسع للجميع، لا خيار أمام اليمنيين غيره.
القومية والاشتراكي.. ثمرة حوار
يعد الحزب الاشتراكي اليمني أحد أقدم الأحزاب في اليمن الموحد.. وثالث أقوى تياراتها.. والقوة الوحيدة التي حكمت الجزء الجنوبي من اليمن قبل الوحدة.. تعود جذوره إلى حركة القوميين العرب التي تشكلت في بيروت عام 1948م عقب قيام الدولة اليهودية في فلسطين، حينها فتحت لها فرعاً في عدن عام1959م. ومن رحمها تشكلت جبهةٌ قومية يمنية في مايو1963م تقود كفاحاً مسلحاً ضد الاستعمار البريطاني في جنوب اليمن، حتى تحقق استقلاله عام67.. وعقب الاستقلال انفردت الجبهة القــومية بالحكم هناك. إلى أن توحدت عام 1975م مع فصائل يسارية، يمثلها (اتحاد الشعب الديمقراطي, وحزب الطليعة الشعبية), تحت إطار الجبهة القومية الموحدة، والتي جاء توحيدها نتاج حوارات مضنية.
هذه الوحدة المصغرة مكنت الجبهة القومية من توحيد 12سلطنة كانت قائمة في الجنوب اليمني إبان الاستعمار.. ثم ما لبثت أن انبثقت عنها نواة لوحدةٍ أوسع، عندما تأسس على أنقاضها الحزب الاشتراكي عام 78, كحزب طليعي جنوبي، ضم فصائل يسارية من شمال الوطن، جمعته بها وحدة نضالٍ مشترك ضد الاستعمار والإمامة، وحلم الخلاص من التشطر.
منذ تأسيسه، فتح الاشتراكي أبواب التواصل مع النظام في شمال الوطن، للتفاوض والحوار حول مشروع وحدة الشطرين، غير أنه تعرض لموجة صراعات وتشظيات حزبية متوالية واغتيالات قيادية قبل الوحدة، كان أشدها فتكاً مذبحة 13يناير الشهيرة عام 86، فضلاً عن صراعات مع الشمال.. دوامة مريرة عطلت تقدمه وأضعفت بُنيته الفكرية والتنظيمية والجماهيرية وهزت موقعه القيادي في الجنوب، وزاد من ضعفه جملة متغيرات إقليمية وعالمية إبان انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومته الاشتراكية.. الأمر الذي عجّل بقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو90- عقب مفاوضات وحوارات شاقة مع المؤتمر الشعبي- الحاكم في شمال الوطن سابقاً، نجم عنها توقيع اتفاقيات متعددة مهدت للوحدة وأفضت إلى توقيع اتفاقية تاريخية شهيرة في عدن، ذاب معها الشطران في كيان دولة جديدة، فكانت خاتمة صراعات الرفاق، قبل أن تصبح نهاية وجوده في قمة السلطة وشراكة الوحدة، إثر صراعات سياسية ودعوات انفصالية مشئومة وأخطاء نظام، عرقلت كل أبواب الحوار بينهما، فأفضت إلى حربٍ ضروس عام 94م أزاحت حزباً سلطويا عريقاً إلى هرم المعارضة، ومزقته بين الداخل والخارج، ليبدأ معها مشواراً جديداً من معاناة إزاحةٍ لم تهدأ ثائرتها، ظلت آثارها تتصاعد إلى أن شكلت نواة احتقان جنوبي يطالب برد الاعتبار والممتلكات والسلطة، واستعادة كيان شمولي لم تكن تنافسه قبل الوحدة قوة.. في جنوبٍ لا صوت فيه يعلو فوق صوت الحزب!
الميثاق والمؤتمر.. خلاصة حوار
مثلما ولد الحزب الاشتراكي من رحم الحوار، ومر بمراحل تفاوض شاقة، لم يكن طريق الميثاق الوطني سهلا، بل مر الحوار الوطني الذي انبثق عنه بأطول عملية حوارية في تاريخ اليمن، بدأت بتشكيل لجنة حوار ضمت مختلف القدرات والكفاءات الوطنية من مجلس الشعب التأسيسي ومن خارجه، تفرع عنها عدد من اللجان، ضمت بدورها ذوي الاختصاص، وأقيمت الندوات واللقاءات والنقاشات التي تمخض عنها مشروع الميثاق الوطني، وقُدم إلى المجلس الاستشاري لمناقشته، وقد أثري بنقاشات وملاحظات جعلته مشروعاً أشمل، ولهدف الوصول إلى مشروع أكثر شمولاً طرح للنقاش في اجتماع لمجلس الوزراء ومجلس الشورى وضم الاجتماع الموسع محافظي المحافظات والمسئولين العسكريين والمدنيين وقيادات شعبية، وتم التصويت على المشروع من قبل الجميع بأن يعرض على الشعب.
ثم جاءت المرحلة الثانية، والتي تمثلت في تشكيل لجنة الحوار الوطني وعرض مشروع الميثاق على الشعب.. حيث تشكلت لجنة الحوار من خمسين عضواً من كافة الفئات والقوى والتيارات بما فيها الجبهة الوطنية التي مدت يدها للسلطة.. ثم تم النزول بمشروع الميثاق الوطني إلى المواطنين لشرحه وتبادل الرأي معهم والاستفادة من آرائهم، واستغرقت مهمة اللجنة نحو عامين، وعلى ضوئها أعادت صياغة مشروع الميثاق، ثم جاءت مرحلة اقراره من قبل المؤتمر الشعبي العام الذي تشكل بالقرار رقم "19" لسنة 1980م وحدد القرار الرئاسي عدد أعضائه ألف عضو، 700منتخبون من أبناء الشعب و30 ٪ بالتعيين من قبل الدولة ومهمتهم مراجعة مشروع الميثاق في ضوء نتائج الاستبيان واقراره في صيغته النهائية وتحديد أسلوب العمل لتطبيقه. ثم انعقد المؤتمر الشعبي العام الأول في العاصمة صنعاء في الفترة من 24ـ29 أغسطس عام 1982م واتخذ قرارات هامة بمقاييس تلك الفترة حسب مراقبين، حيث أقر الميثاق بالإجماع باعتباره المنهج الفكري للعمل الوطني في شتى المجالات، وفي إطاره تتحدد برامج العمل السياسي ومعالم الطريق للمستقبل في ظل النظام السائد "الذي وصفه الدارسون بعد هذا الإنجاز بأنه تأسيس للممارسة الديمقراطية".
