هل توصل محاولات علمنة الإسلام إلى نتيجة؟..
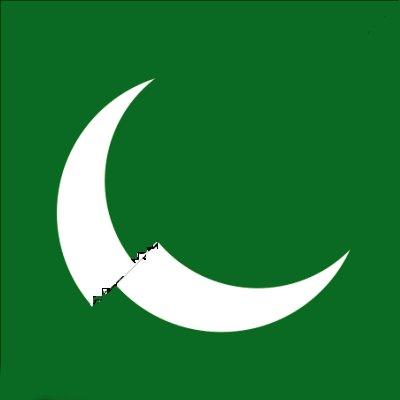
دعوة التعايش مع الآخر تتناقض مع العمل لتطويعه
نبيل شبيب
مع الحديث عن احتمال ترشيح إردوجان لمنصب الرئاسة التركية، ثمّ ترشيح جول بدلا منه، أثيرت ضجّة متوقّعةمن جانب الأصوليين العلمانيين، جمعت بين التصريحات الرسمية والتهديدات المبطنة، والمظاهرات والحملات الإعلامية. وجدّدت الضجّة الحديث عن قابلية تعايش الإسلاميين –رغم أنّ حزب العدالة والتنمية يعلن علمانيته- والعلمانيين في بلد إسلامي، إنّما بقس السؤال المطروح مقلوبا، أو يقلب المعطيات القائمة في تركيا رأسا على عقب، فهو مطروح عن مدى تطبيق الرؤى الإسلامية السياسية عبر السلطة، من جانب من حازوا في الانتخابات على الغالبية الشعبية الكبرى، بدلا من طرح السؤال عن تلك الديمقراطية العلمانية التي تحتكر لنفسها "حقّ" تطبيق ما تراه ومنع الآخر عنه.. أمّا الإرادة الشعبية فلا قيمة لها في تلك التصوّرات الأصولية!. ولا ينفصل الموقف ممّا يجري في تركيا عن الموقف الأوروبي أو الغربي عموما من الإسلام نفسه، كما يظهر لمن يتابع هذا الموقف من كثب.
الحرب على الأفكار - تسلّل علماني - تصدير "إسلام أوروبي" – نموذج المثال التركي
الإسلام كما أنزله الله واحد لا يتعدّد، واسع لا يضيق بالتعدّد، واضح بيّن على محجّة بيضاء وصراط مستقيم لم يتبدّل ولم يتغيّر، حيويّ نابض يحتضن كلّ تطوّر قويم وتغيير هادف، هو دين توحيد الله تعالى الذي ارتضاه لمن خلق، وقد خلق البشر -كما أرادهم- شعوبا وقبائل وألسنة وألوانا وعقولا وأفهاما، وأنعم على الإنسان بالحياة الدنيا امتحانا، وبالإرادة ليختار ما يشاء بين طريقين، فاتحاً بوابةَ الإيمان لتضمّ أمّةُ الإسلام الواحدة الموحِّدة من يختارون طريق الإيمان، ومن يعيش فيها دون أن يعتنق الإسلام دينا، فتستوعبهم جميعا، دون جَوْرٍ ولا إكراه ولا تمييز ولا تعصّب، ولتكون أمّة وسطا بين الأمم، تدافع عن إنسانيّة الإنسان، المسلم وغير المسلم، وكرامته، على أرضيّة المساواة والعدالة والحقّ والإحسان بين البشر.
الإسلام بمواصفاته الذاتية هذه كما أرادها الله عزّ وجلّ، والتي ليس لبشر أن يبدلّها ليخرج بالإسلام عن وسطيته، هو بذلك المنهج الذي يتلاءم مع أوضاع خَلْقِ الله على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وتباين عقولهم وأفهامهم وتعدّد ثقافاتهم وتوجّهاتهم، وقد كان هذا بالذات من مرتكزات انتشاره الجغرافي السريع، دون أن يؤدّي اعتناقه وتطبيقه أو القبول بحكمه، إلى تذويب الانتماء الذاتي للإندونيسي أو التركي أو الصيني أو العربي، فالإسلام الذي ينكر التعصّب لا يلغي الانتماء، وهذا ما يسري على انتشار الإسلام الآن أيضا بين ذوي الأصول الغربية داخل الدول الغربية نفسها.
ويمكن أن نقول تبعا لذلك: الإسلام في أوروبا، أو في الشمال الإفريقي، أو في الشرق الأقصى، ولا يصحّ أن نقول بوجود إسلام أوروبي وآخر إفريقي وثالث آسيوي. كما يمكن القول بشمول الإسلام لميادين السياسة والثقافة والجهاد والعبادات، ولا يصحّ القول بإسلام سياسي وآخر ثقافي وثالث جهادي ورابع تعبّدي. ويمكن العمل في ميدان من ميادين الإسلام فلا يوصف الإسلام بذلك بل يوصف به العمل كالخيري والنسائي والإعلامي وغيره.
يجب تأكيد الفارق الكبير بين هذين الأسلوبين في صياغة تعابيرنا ومصطلحاتنا وكتاباتنا، لاسيّما مع ازدياد خطورة فوضى المصطلحات، وهي فوضى مصنوعة ولم تعد عشوائية على افتراض أنّها كانت كذلك، وأصبحت توظّف مباشرة في الحملة الواسعة النطاق التي تستهدف الإسلام نفسه وليس أرضه وحضارته فقط، وتستهدف المسلمين عموما وليس العاملين للإسلام أو فريقا منهم أو بعض من ينسب إليهم نفسَه بحقّ أو دون حق.
يكفي تأكيدا لذلك استعراضُ مسلسل ما طُرح خلال العقود القليلة الماضية، فبعد انحسار موجة من الألفاظ -ولا يمكن وصفها بالمصطلحات منهجيا- مثل الرجعيّين والمتزمّتين والمتعصّبين، لثظهر موجة تالية من ألفاظ أخرى هلاميّة المضمون، فكان من عناوينها الأصولية، والتطرّف، والإرهاب الإسلامي، وعلى الطريق نفسها بدأت في الآونة الأخيرة موجة ثالثة من الألفاظ المشبوهة، الأخطر من سابقاتها، لأنّ كثيرا منها مُستمدّ لفظيا من ثروة المصطلحات الإسلامية، وهذا ما يرجّح قابليّة انتشار استخدامها بين المسلمين وفي كتابات أصحابِ المنطلق الإسلامي أنفسهم، بينما تتحرّك الآلة الإعلامية والفكرية الغربية بقوّة، وتتحرّك معها قنوات التغريب داخل البلدان الإسلامية، لنشر المضمون المشوّه والمزيّف لا المضمون الإسلامي الأصلي لتلك الكلمات، وهي ألفاظ مبتكرة حديثا أو بدأ استخدامها على نطاق أوسع من ذي قبل، مثل الإسلام السياسي والإسلام الجهادي والإسلام الأوروبي، ناهيك عن قول من يقول بإسلام علماني.
ليست الجولة الجديدة من حرب المصطلحات سوى جزء من الحملة الراهنة على الإسلام والمسلمين، وهدفها تعزيز الجهود المكثّفة من أجل تكييف الإسلام على مقاس ما يجري التخطيط له وتنفيذه لترسيخ الهيمنة الأجنبية على صناعة مستقبل المسلمين في أرضهم وفي عالمهم وعصرهم، وإنّ رأس الحربة في تلك الجهود موجّه في الوقت الحاضر إلى ثلاثة عناصر رئيسية في الإسلام الشامل المتكامل المتوازن، هي السياسة والجهاد والعلاقة باليهود.
خلال ثلاثة أجيال مضت، كانت الحملات المضادّة للإسلام والمسلمين تتركّز على إقصاء التطبيقات العملية المرتبطة بهذه العناصر الثلاثة وسواها عن مختلف ميادين الحياة والحكم، وكان من المفروض أن يقتنع القائمون على تلك الحملات بإخفاقها كما أثبت انتشارُ الصحوة الإسلامية شعبيّا على نطاق واسع، وبدلا من ذلك يأتي التركيز الآن -إلى جانب الميدان التطبيقي- على الميدان العقدي والفكري والتربيوي، فالحملات الجديدة، بما فيها حملة تعديل المناهج، والحملة على بعض المنتجات الفنية والإعلامية، هذه الحملات تستهدف واقعيا فرضَ القيود على الفكرة والكلمة، أي على مضمون الدعوة نفسه، لا سيّما في مجالات السياسة والجهاد والعلاقة مع اليهود. ويجري ذلك على محورين، أوّلهما تكرار المقولات العلمانية التي تعتمد التأويل المنحرف عمّا يقرّره الإسلام وتثبّته نصوصه الشرعية والاجتهادات المعتبرة، والثاني العمل على تسويغ ملاحقة "المخالفة الفكرية" لتلك التأويلات، التي تساهم حرب المصطلحات عن طريق وسائل الإعلام والفكر في العمل على نشرها وتعميمها، كما لو كانت بدهيات لا تحتاج إلى نقاش!.
في هذا الإطار يمكن النظر مثلا فيما طرحه (خريف 2004م) الكاتب الفرنسي جيل كيبل في كتاب بعنوان "الحرب من أجل عقول المسلمين- الإسلام والغرب"، وقد تناول فيه النظرة الغربية التقليدية إلى موضوع "الإرهاب والإرهابيين" ولكنّ النتيجة الأهمّ التي أراد الوصول إليها -وفق ما ورد بقلم شيرين حامد فهمي في موقع إسلام أون لاين"-هي أنّ (أهم جولات حرب العقول المسلمة، في ظل العقد القادم، سوف تتركز في داخل المجتمعات المسلمة التي تعيش في الغرب، في لندن وباريس حيث عاش الإسلام واستقر. ومن ثَمّ فإن مسلمي الغرب الأوربي سيكونون رأس الحربة في تغيير عقول المسلمين نحو الديمقراطية والتعدّدية، وصرفهم عن التطرف والأصولية).
ونجد مثلا آخر جريدة "شيكاجو تريبيون" الأمريكية تنشر في كانون الثاني/ يناير 2005م تحقيقا مفصّلا عن المسلمين في أوروبا، ولا سيّما في فرنسا، فتطرح وجهة النظر نفسها، إلاّ أنّها لا تجزم بالنتيجة مثل كيبل، وتعتبر السؤال مفتوحا في الاتّجاه المعاكس أيضا، أي احتمال تأثير الوجود الإسلامي البشري المتنامي في القارة الأوروبية على تصوّراتها العلمانية وتطبيقاتها لها في الميادين التشريعية والسياسية وغيرها.
قد تبدو الأطروحات الواردة في هذين المثالين مجرّد آراء، إلاّ أنّ أهميتها تظهر عند ربطها بسواها وبما يجري على أرض الواقع، وهنا تتلاقى أفكار كيبل مع صانع القرار الغربي عندما يضع في وعاء واحد كافّة مَن يستخدمون القوّة تحت أيّ عنوان إسلامي، بما في ذلك من يمارس المقاومة المشروعة بمختلف المقاييس ضدّ احتلال أجنبي، ثمّ يستخدم للتعبير عن هذا الخليط كلمة الإرهاب تارة والجهاد أخرى، وتنظيمات إرهابية حينا وتنظيمات جهادية أخرى، كما لو كانت كلمات "مترادفة"، ومن هذا المنطلق يكون الإسلام "الأوروبي" المأمول هو الإسلام الذي يتخلّى عن الجهاد من حيث الأساس، وليس عن عنف غير مشروع بالمعيار الإسلامي نفسه، وأن يتخلّى عن الجهاد كفريضة إسلامية، وليس من باب الحديث مثلا عن شروطه الشرعية والانضباط بها ليكون استخدام المصطلح الإسلامي قويما، وهو الطرح الذي يريد أيضا أن يتخلّى من يدعو إلى الإسلام عن منهج "إعداد القوّة" ابتداء، حتّى وإن اعتبرته قوى الأرض جميعا حقّا لنفسها لا يتخلّى أيّ منها عنه.
يوجد تيّار يتنبّى هذه التصوّرات في مختلف البلدان الأوروبية، مثل ألمانيا، كما تشهد مواقف ومقولات عديدة، لرئيس المجلس النيابي السابق من الاشتراكيين الديمقراطيين فولفجانج تيرزي، أو الأسقف فولفجانج هوبر من قادة الكنيسة البروتستانتية، أو فريق من العلمانيين من ذوي أصول عربية، كبسام طيبي السوري الأصل، المتخصّص في كتاباته العدائية للعمل الإسلامي في الغرب عموما. وقد أصبحت مطالب هذه الجهات تخلط باستمرار ما بين كلمتي الإرهاب والجهاد عند مطالبة المنظمات الإسلامية بنبذ العنف غير المشروع -وهو ما تصنعه على كلّ حال- فأصبح المطلوب من المسلمين في أوروبا، ليس التخلّي عن المنظمات المصنّفة غربيا بممارسة الإرهاب تحت عنوان الجهاد، بل التخلّي عن ارتباط فكرة الجهاد نفسها بالإسلام.
تعتمد هذه الدعوات وأمثالها في الدرجة الأولى على محورين، أحدهما تأويلاتُ مَن ينكرون وجوب الجهاد إسلاميا، وثانيهما اعتبار الانطلاق من المرجعية العلمانية الغربية بدهيا للحكم على أي مرجعية أخرى. وفي الاتجاه نفسه يمكن تصنيف الإصرار الفرنسي الرسمي الشديد على حظر الحجاب على فتيات المدارس التابعة للدولة، فهذا ما لا يمكن تصنيفه قطعا في خانة رمز سياسي رغم الحملة السياسية والإعلامية الفرنسية والأوروبية عموما لتسييس الحجاب وجعله "قضية سياسية عامة" وليس مسألة شخصية خاصّة بالمسلمة وتطبيقها لأحكام دينها، فيتّخذ الحظر في حصيلته على أرض الواقع صورة تطبيقية لتخيير المسلمين في أوروبا ما بين مرجعية الإسلام ومرجعية علمانية، حتى في الميادين الشخصية المحضة كاللباس وشكله، وليس في ميادين العلاقة مع الآخر فقط، أي وفق ما يمكن طرحه عبر مفاهيم الجهاد أوالتعدّدية أوالديمقراطية أو التعايش، وما شابه ذلك.
إنّ الصيغة التي يراد إيجادها ويتنبّأ كيبل بأن المسلمين في أوروبا سيوجدونها، هي صيغة إسلام بمرجعية علمانية، وليست صيغة تعايش المسلمين في أوروبا مع المعطيات العلمانية القائمة للمجتمع والدولة، وهي صيغة لا تقف عند الحدود الأوروبية، وما تركيا إلا مثالا عليها.
كلمة "إسلام أوروبي" كانت تُستخدم قديما من باب تمنيّات أو توقّعات أن يظهر مسلمون أوروبيون لا يطبّقون هذا الجانب أو ذاك من الإسلام جهلا أو تقصيرا أو نتيجة الذوبان في المجتمع حولهم، وبدأ استخدامها تدريجيا باتجاه أبعد من ذلك بوضوح، فالمطلوب هو تبنّي تصوّرات علمانية الجذور، بديلة عن بعض التصوّرات الإسلامية، ثمّ طرح الحصيلة التي تُعطى عنوان "الإسلام الأوروبي" كنموذج للمسلمين داخل البلدان الإسلامية. وهو ما يمكن وصفه بفكرة "تصدير الإسلام الأوروبي"، فهذا هو الجديد في كتاب كيبل المذكور، إذ يرى أنّ صورة الإسلام التي يحدّدها –حسب تصوّره- مسلمو أوروبا عبر استفادتهم من المعطيات العلمانية والديمقراطية والتعدّدية في المجتمعات الأوروبية، سوف تنتشر مستقبلا في بلاد المسلمين، أمّا فكرة الوصول إلى "إسلام مزيّف بمرجعية علمانية" فليست جديدة بحدّ ذاتها، بل هي محور ما بُذل في الماضي وما زال يُبذل من جهود ويُنفّذ من حملات تجاه الإسلام والمسلمين، بعيدا عن الصيغة المعتدلة التي يطرحها حديثا فريق من العلمانيين غير الأصوليين، بحثا عن سبيل لتعايش الإسلام مع تياراتهم وأفكارهم العلمانية.
ويمكن أن تتلاقى الأفكار الخارجية المطروحة المشار إليها، مع صور مشابهة يطرحها بعض الباحثين من داخل المنطقة العربية، مثل الباحث السوري محمد جمال باروت الذي يوصف باعتدال دراساته من منطلق علماني للحركة الإسلامية، وقد اعتبر في أحد الحوارات الشبكية أنّ نموذج حزب العدالة والتنمية في تركيا هو النموذج المستقبلي للعمل الإسلامي، والذي سيحلّ كما يرى محلّ النموذج التقليدي الحالي للتنظيمات الحركية الإسلامية المعروفة. والعنصر الحاسم في هذه المقولة هو أنّ حزب التنمية والعدالة يتحرّك على أرضية علمانية، ومعروف أنّه وصل في هذا الطريق وعبر مساعي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلى إقرار تشريعات قانونية تستثني بوضوح بعض الجوانب القانونية الثابتة إسلاميا، مثل عقوبة الإعدام أو تحريم الزنى تحت طائلة العقوبة.
يمكن تحت عنوان الإسلام في أوروبا تصوّر أنّ المسلمين انطلاقا من تعاليم الإسلام وأحكامه، يركّزون على تطبيق الإسلام بقدر المستطاع، وعلى التعريف بالإسلام -كما أنزل- والدعوة إليه، فهذا ما يطلبه الإسلام، وما يمكن للمسلم صنعه، عندما يعيش في بلد غالبيته من غير المسلمين، فهنا لا تتوافر أصلا الشروط الشرعية الإسلامية لكثير من الجوانب ذات العلاقة بعنصري السياسة والجهاد مثلا، فلا مجال للدعوة إليهما في بلد غالبية أهله من غير المسلمين، وهو ما يسري على جوانب أخرى من قطاع المعاملات عموما، ولكن لا يمكن تحويل هذا السلوك الإسلامي المنضبط بالأحكام والاجتهادات الإسلامية، إلى ما يدخل في باب إنكار "عُقدي" لوجود هذا العنصر أو ذاك، كالسياسة والجهاد، في الإسلام نفسه، وفي محور أحكامه وأطروحاته الثابتة والاجتهادية.
ولا يمكن بالتالي تصوّر طرح إسلامي على أساس انتقاص هذه الثوابت من أجل أن "يُصدّر" إلى البلدان الإسلامية، وهي المستهدفة في نهاية المطاف، كما يتبيّن بوضوح عند النظر في العنصر الثالث من الحملة الراهنة، أي العلاقة مع اليهود، وهم من أهل الكتاب، وأحكام الإسلام في ذلك واضحة لا تحتاج إلى شرح وتفصيل، ولكنّ ما يحتاج إلى التاكيد الآن، هو أنّها هي الأحكام المرجعية في التعامل مع اليهود، وليست مرجعيّةُ المسلمين في ذلك ما يُعرف بالعداء للسامية، أي الظاهرة الناشئة مضمونا وتاريخا وتطوّرا واستغلالا أيضا، في نطاق الغرب وتاريخه وسياساته، ولا علاقة للإسلام والمسلمين بها.
ونعايش في الوقت الحاضر جهودا واسعة النطاق -ليس في نطاق حملات تعديل المناهج فحسب- تستهدف تحقيق غرضين في وقت واحد:
(أوّلهما) نقل هذه الإشكالية الغربية إلى المنطقة الإسلامية، وهذا ما يظهر للعيان من الحملات الصهيونية الدولية المتتابعة، تقليدا لما يجري في الدول الغربية منذ فترة، على مختارات من الإنتاج الفني أو الثقافي أو الإعلامي، داخل البلدان العربية والإسلامية، ووضع عنوان "العداء للسامية" فوق ما يرد فيها وله علاقة باليهود بصورة ما، بغضّ النظر عن صوابه أو خطئه، فالمهمّ في هذا المجال هو تسويغ استخدام تعبير العداء للسامية على وجه التحديد، بحيث يصبح الأمر "بدهيا معتادا" مع مرور الوقت، سواء من باب الدفاع عن النفس ضدّ تهمة مفتعلة، أو من باب التراجع تحت ضغوط ما، محلية أو دولية.
و(الغرض الثاني) هو الخلط المتكرّر ما بين العداء للسامية بمفهومها الغربي الأصلي أي معاداة اليهود من حيث أنّهم يهود، وبين معاداة الصهيونية كفكرة سياسية انبثقت عنها الممارسات الصهيونية العالمية والإقليمية في فلسطين وما حولها، وهذا الخلط هو ممّا وصل إلى مستوى التشريعات القانونية الأمريكية كما هو معروف.
إنّ الجهود المبذولة بهدف اصطناع إسلام آخر، أوروبي أو علماني، أو سيّان ما يُطلق عليه من صفات، ما دام القصد هو تجريده من السياسة والجهاد والحجاب ومرجعية القيم في العلاقات بين الجنسين، هذه الجهود قطعت مراحل عديدة، وتشعّبت طرقها ووسائلها جغرافيا ومضمونا، والهدف هو تطويع الإسلام نفسه لا المسلمين فقط، والعمل لتحويله غلى ديانة من الديانات المنتشرة عالميا، خارج نطاق مفاصل صناعة الإنسان وصناعة الحدث، محاصرا في المعابد، بشروط مفروضة عليه من خارج جدرانها، بما يجدّد مقولة دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بصيغة جديدة وأساليب مبتكرة.
ويمكن التأكيد أنّه رغم النواقص الكبيرة التي تعاني منها غالبية المسلمين في الغرب ورغم الضغوط المتصاعدة التي يتعرّضون لها، فوضعهم لا يختلف عن وضع المسلمين داخل البلدان الإسلامية، من حيث وضوح الإسلام للمسلم بكليّاته الكبرى، وبشموله وتكامله وتوازنه ومرجعيّته الربّانية، وهذا ما أصبح اليوم أشدّ رسوخا ممّا كان عليه في أي وقت مضى، ولا يُستبعد أن تنقلب المعادلة المراد نشرها رأسا على عقب، ككثير ممّا سبقها، وتتحوّل الحملة الجارية بنتائجها إلى دفع المزيد ممّن لا يعرفون الإسلام على حقيقته إلى التعرّف عليه، وتدفع المسلمين إلى بذل المزيد من الجهود للتمسّك بثوابته، والتعريف به، والدعوة إليه، والله بالغ أمره من حيث لا يحتسبون.
الحديث عن تركيا وأوضاعها لا يمكن فصله عن ظروفها الذاتية، فنشأة العلمانية فيها مرتبطة بحصيلة الحرب العالمية الأولى وما سبقها، وسيطرتها على البلاد عسكريا وليس ديمقراطيا، لا يحتاج إلى ذكر دليل، ومن هنا لا يمكن تعميم مثال حزب العدالة والتنمية في تركيا على سواه، وليس المقصود هنا تقويمه، فهذا ما يحتاج إلى حديث آخر، إنّما أصبح هذا التعميم بالذات هو ما يراد التركيز عليه منذ فترة لا بأس بها، والأسباب جديرة بالتأمّل، منها:
1- ظهور خواء الدعوات الأمريكية تخصيصا، والغربية عموما، إلى الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان في البلدان الإسلامية، التي انتشر فيها الاستبداد بدعم غربي، فقد ربطت تلك الدعوات بالحرب الإرهابية الجنونية ضدّ الإرهاب، وباحتلال العراق، ولم توصل إلى أيّ نتيجة.
2- وصول الصحوة الإسلامية مع الدعوة الوسطية المميزة لسوادها الأعظم، إلى درجة من الانتشار والقوّة والوضوح النسبي، تجعل نتائج أيّ عملية اقتراع، في أي بلد، على غير ما كان يرجوه أو يتوهّمه الغربيون، وهو ما يفسّر نكوصهم عن الإلحاح على تحكيم الإرادة الشعبية واحترام حقوق الإنسان، وهذا ما يكشف عن أنّ موقف العداء للإسلام، أو الخوف على هيمنتهم منه، يغلب عندهم حتى على ما يزعمونه لأنفسهم من تصوّرات ومناهج ويزعمون عالميتها.
المطلوب بدلا عن ذلك أن يبقى الاحتكام للإرادة الشعبية مشروطا بسيادة المرجعية العلمانية، ولو بالإكراه العسكري والحزبي كما كان إبان وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا.
ولكنّ التطوّرات في تركيا فاجأت المتشبّثين بالمرجعيات العلمانية على اختلاف توجّهاتهم ودرجات تشدّددهم، ففترة حكم حزب العدالة والتنمية ذي التوجّهات الإسلامية ولو جزئيا، كانت أوّل فترة تشهد في تركيا استقرارا سياسيا، وازدهارا اقتصاديا، وفتح أبواب ترسيخ حقوق الإنسان التي انتهكت طويلا، طوال فترات حكم الأحزاب العلمانية من قبل.
وقد ظهر على سبيل المثال أنّ الميل مجدّدا إلى رفض تلبية طلب انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ومحاولة جعل المفاوضات وجعل قضية قبرص مدخلا إلى سدّ الأبواب أمام تركيا من جديد، لا يرجع إلى عدم التزام الحزب بالعلمانية في تركيا، التي لا تزال مثبّتة دستوريا، بل يرجع إلى النجاح الذي حقّقه في السلطة، مع كلّ ما يقال عن توجّهاته الإسلامية.
ليس المطلوب التعايش مع مرجعية إسلامية من الأصل، ويزيد عليه الآن رفض التعايش مع اتجاه إسلامي وإن كان يلتزم بمرجعية علمانية، وهذا ما يعيد الإشكالية إلى جذورها التي سبق الحديث عنها، أي إلى ثبات هدف الأصوليين العلمانيين على تطويع الآخر لا التعايش معه، وتغيير تصوّراته ومناهجه -لو استطاعوا- للقبول بتحديد هامش ما لوجوده، وهذا ما لا يتناقض مع حقوق الإنسان وحرياته، ومع مبادئ الديمقراطية و قواعدها ومعاييرها فحسب، بل يتناقض أيضا مع مجرى التاريخ الحديث، فالإخفاق الذي كان من نصيب المرجعية العلمانية حيثما فُرضت في بلاد المسلمين، بلغ مداه في صنع الكوارث في مختلف الميادين، والغالبية الكبرى من الشعوب تريد المرجعية الإسلامية بما لم يعد يمكن التشكيك فيه.
ولا يزال العلمانيون الأصوليون يتحكّمون تسلّطا في صناعة القرار والحدث، وجدير بالمعتدلين من العقلاء فيهم أن يوقفوا عجلة الانحدار إلى مزيد من الكوارث، وأن يفتحوا أبواب تعايش قويم، يقبل الآخر كما هو، ويعود إلى الإرادة الشعبية في اختيار المرجعية التي تريدها الشعوب، وسيجدون في المرجعية الإسلامية آنذاك، من الحريات والحقوق، ما لم يجده عامّة سكان بلادنا على امتداد عشرات السنين الماضية.
المصدر: http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.midadulqalam.info/midad/u...
