ما هو الإرهاب؟
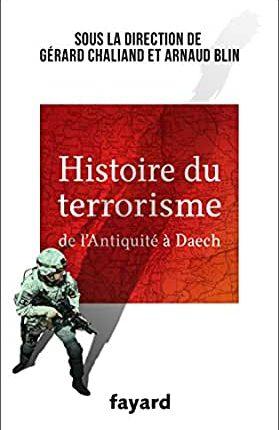
جيرار شاليان وآرنو بلان
ترجمة وتقديم وتعليق: خليد كدري
تقديم:
هذه ترجمة لمقدمة كتاب تاريخ الإرهاب من العصر القديم إلى داعش الذي شارك في تأليفه لفيف من الخبراء تحت إشراف الأستاذين جيرار شاليان وآرنو بلان[1]. وننبه إلى أن العنوان «ما هو الإرهاب؟» من وضعنا، لأن موضوع المقدمة التي كتبها المشرفان على الكتاب، الأستاذ جيرار شاليان – الخبير الدولي في قضايا الإرهاب وحرب العصابات – والأستاذ آرنو بلان – الباحث في المعهد الفرنسي للتحليل الاستراتيجي –، هو مسألة تحديد مفهوم «الإرهاب».
وقد علقنا على ترجمة النص في بضعة هوامش توضيحية خفيفة، وميزنا تعاليقنا عن تعاليق المؤلفين بحرف الميم بين قوسين، هكذا: (م)، الذي يعني «المترجم». وتفادينا في تعاليقنا مناقشة بعض الأحكام المجحفة، ولا سيما تلك التي تهم كفاح الشعب العربي الفلسطيني، لأن مساحة الهامش لا تتسع لذلك، مع الأسف، ولإيماننا بأن ذكاء القارئ العربي للباطل بالمرصاد.
ترجمة:
«إن أشد الأهواء منافاة للعقل والحرية التعصبُ الديني»
ماكسميليان روبسبيير[2]
حدث ذلك في واشنطن، خلال أشغال ندوة نظمتها وكالة استخبارات الدفاع (DIA) في موضوع الإرهاب، أو، بصورة أدق، مكافحة الإرهاب. وكان معظم المشاركين في هذه الندوة يعملون لحساب مختلف (وعديد) الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية التي انخرطت جميعا، بهذا القدر أو ذاك، في مكافحة الإرهاب. ومعظم جنود الخفاء هؤلاء قلبوا وجهتهم، بعد انتهاء الحرب الباردة، نحو هذا المجال الخاص الذي صار، مذذ الآن، ينتمي إلى حقل النشاط الأوسع المسمى «الأخطار الجديدة»؛ وهي الأخطار التي تضم، من جملة ما تضمه، انتشار الأسلحة النووية، أسلحة الدمار الشامل (AMD)، والجريمة المنظمة. وبجد واهتمام، يصغي هذا الجمع الغريب من الناس، المرتدين زيا موحدا، إلى أحاديث المتدخلين الذين يتناوبون على الكلام في ماهية مكافحة الإرهاب. ولما كان المساء، وبينما كان الجمع المتعب يتأهب للاستماع إلى آخر المتدخلين، إذا بشخص غريب يتقدم نحو المنصة، بخطى كبيرة، حاملا حقيبة وجرابا. كان طويل الشعر، ويعتمر قبعة سوداء؛ وكان كث اللحية، ويضع على عينيه نظارتين قاتمتين، ويرتدي سروالا ممزقا وسترة جلدية؛ ومظهره، على كل حال، لا يمت بصلة إلى موظفي مكاتب الاستخبارات. وفجأة، وبسرعة البرق، فتح حقيبته وجرابه، وأخرج قنبلتين يدويتين قذف بهما الجمع، ثم صوّب بندقية من طراز إم 16 نحو الحضور الذي استولى عليه الذهول.
لم تنفجر القنبلتان اليدويتان، كما أن بندقية إم 16 ظلت صامتة. وبكل هدوء، تناول ذلك الشخص الميكروفون وطفق يتحدث. ولأول وهلة، تعرفت القاعة، أو جزء منها على الأقل، على صوت مألوف. وفي الواقع، لقد كان الأمر يتعلق بمدير وكالة استخبارات الدفاع، وبالتالي جنرال، وقد تخفى في هيئة «إرهابي» حتى يبين لمرؤوسيه وتابعيه مدى سهولة تسلل أي إرهابي إلى قلب البناية التي تحتضن الندوة (في جامعة جورج واشنطن التي خلت رحابها من أية مراقبة أمنية) والقضاء على صفوة خبراء أجهزة مكافحة الإرهاب الأمريكية. وبعد أن ارتدى زيه الرسمي من جديد، تحدث الجنرال بكلام ينطوي على نبوءة، فقال: «سيأتي يوم يهاجم فيه إرهابيون بناية مثل هذه، في واشنطن أو في نيويورك. وسيقتلون المئات من الناس، وسيتسببون في حدوث صدمة سيكولوجية لا مثيل لها في التاريخ. ولا تكمن المسألة في معرفة ما إذا كان عمل من هذا القبيل سيقع فوق التراب الأمريكية أم لا، بل تكمن بالأحرى في معرفة متى وأين سيقع. ويتعين عليكم أنتم، أيها السادة، أن تستعدوا له. إن أمن بلادنا بين أيديكم.» وكانت هذه الندوة قد انعقدت في عام 1998. وبعدها بثلاث سنوات، أقدم 19 رجلا على قتل 3000 شخص في العملية الإرهابية الأكثر إذهالا في التاريخ، وهي تلك التي جرت أطوارها في نيويورك وواشنطن. وكان البنتاغون نفسه، الذي يحتضن مقر وكالة استخبارات الدفاع، قد تعرض للإصابة. فبسبب تقصيرها لم تنجح أجهزة الاستخبارات الأمريكية في منع حدوث هذه العملية.
وبعد انصرام زمن على ما حدث، تكاد هذه التمثيلية تبدو سُرياليّة؛ أولا بسبب كلام رئيس استخبارات البنتاغون؛ وثانيا بسبب تنكب عناصره عن اتباع نصائحه على الرغم من سدادها. ويضاف إلى ذلك الفارقُ الموجود بين الصورة المتقادمة التي لدينا عن شخص متعصب مهمش مستعد لتفجير كل ما يصادفه في طريقه – والتي تماثل عمليا تلك الرسوم الهزلية التي تصور شخصا فوضويا يرتدي عباءة سوداء، ويمسك بقنبلة – وبين الأحاديث الجارية عن وشك وقوع أعمال إرهابية باستعمال وسائل تكنولوجية متقدمة، وهو ما اشتهر تحت اسم «الإرهاب الفائق» الذي تتهيأ له السياسات، وتعد له العدة.
وتتسم الظاهرة الإرهابية بدرجة عالية من التعقيد تجعلها أشد اعتياصا على الصياغة المفهومية مما نعتقده لأول وهلة. إن التأويلات الإيديولوجية، والرغبة في تضمين المصطلح، عند استخدامه، ولا سيما من قبل الدول، دلالة مشيطِنة، كلها أمور تساهم في ألوان التشويش والتلبيس. ولربما توجب علينا أن نبدأ بالتذكير بأن استخدام الإرهاب يهدف إلى الترعيب – ومن الناحية التاريخية، كان هذا هو الدور الذي اضطلعت به القوة المنظمة: الدولة أو الجيش، على الأقل حين يتعلق الأمر بأنظمة استبدادية. ولا يزال الأمر على هذه الحال في البلدان غير الديمقراطية. أما في البلدان الأخرى، في زمن الحرب، فيمكن القول إن الإرهاب اكتسب مشروعية، بما في ذلك الإرهاب الممارس على المدنيين. وفي الفترة المعاصرة، يمكن أن نذكر قصف مدن كوفنتري ودرسدن وطوكيو[3]، علاوة على إلقاء قنابل نووية على مدينتي هيروشيما وناكازاكي.
إن الإرهاب باسم الدين، أو الإرهاب المقدس، ظاهرة تاريخية متواترة. وأشهر مثال على ذلك نلفيه، في الديانة اليهودية، عند فرقة[4] الزيلوت، الذين يطلق عليهم أيضا اسم السِّكاري، في القرن الأول. وقد ساهمت هذه الفرقة القَتّالة في اندلاع حركة التمرد على الاحتلال الروماني التي كان من نتائجها دمار الهيكل الثاني (70). وفي حظيرة الإسلام، تشتهر، في هذا الصدد، فرقة الحشاشين[5] الإسماعيلية. فطوال قرنين (1090-1272)، لجأت هذه الفرقة إلى أسلوب الاغتيال السياسي مستخدمة في ذلك السلاح الأبيض في حق طائفة من الوجهاء المسلمين. ولم تلجأ أية فرقة مسيحية إلى استخدام الإرهاب على هذا النحو المدمر. لكننا نستطيع أن نشير إلى فرقة التابوريين في بوهيميا (القرن الرابع عشر) أو فرقة تجديدية العماد (القرن السادس عشر) أو أن نذكر نزعة كراهية اليهود الناشطة خلال الحملة الصليبية الأولى (1095)، من غير أن نخوض في تجاوزات محاكم التفتيش. ومهما يكن الأمر، فالحركات المسيانية تبث الإرهاب وتتغذى عليه[6].
وتسلم المسيانية بأنه سيأتي يوم – ما هو بالبعيد جدا – يتحول فيه العالم تحولا كليا بعد مجيء المخلص الذي سيضع نهاية للتاريخ. وفي مسيحية القرون الأولى، كان الاعتقاد بنهاية وشيكة للعالم يطبعها المجيء الثاني للمسيح (باروسيا) اعتقادا شائعا. وترتبط فكرة الأبوكالوبسيس أو رؤيا النهاية ارتباطا وثيقا بمختلف المسيانيات؛ وهو أمر لا تنفرد به الأديان المنزلة وحدها. لقد كان شعب الأزتك يعتقد بأن أربع شموس (أربعة عوالم) هلكت. وكان مسكونا بالخوف من إمكان حدوث نهاية وشيكة، اللهم إلا إذا تم التقرب إلى الشمس بدماء الأضاحي البشرية.
وقد ظل الحس المسياني حيا نشيطا في حظيرة الديانة اليهودية (حركة شباطاي تزيفي في القرن الثاني عشر، على سبيل المثال). وأسفر الرجوع إلى «أرض الميعاد»، في عقب الانتصار في حرب 1967، عن انبعاث مسياني، كما يشهد على ذلك ميلاد فرقة غوش إيمونيم أو كتلة المؤمنين؛ ولم يكن هذا الرجوع غريبا عن دينامية حركة الاستيطان في يهودا وسامراء (الضفة الغربية). وفي المسيحية، تظهر المسيانية، اليوم، في صفوف بعض الجماعات البروتستانتية الأصولية التي يعود منشؤها إلى القرن التاسع عشر. وفي عداد هذه الأخيرة، نلفي التيار الإنجيلي القوي المتحمس، على وجه الخصوص، لانتصارات إسرائيل التي يشكل تحققها واطرادها، في نظر أصحاب هذا التيار، شرطا مسبقا لحصول الباروسيا. ويشهد الإسلام، أيضا، حركات من هذا النوع، كما تظهرنا على ذلك، على وجه الخصوص، عقيدة قدوم المهدي المنتظر (الذي يعادل المسيا أو المخلص في الديانة المسيحية). وفي مذهب الشيعة الاثني عشرية (إيران)، تحتل المسيانية مكانة مركزية كما يشهد على ذلك انتظار رجعة الإمام الثاني عشر. ومع أن الأحداث والنزاعات التي تغذي، اليوم، المواجهات العنيفة بين الإسلاميين المتطرفين والولايات المتحدة، مثل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، هي عبارة عن صراع سياسي، إلا أنها تنطوي على بعد مسياني. وبخلاف الفكرة الشائعة جدا، لا يتعلق الأمر بشيء اسمه «صدام الحضارات». إن النزاعات تحتد، أيضا، داخل المجتمعات نفسها كما يظهرنا على ذلك هجوم المتطرفين السنيين – ومعظمهم من المملكة العربية السعودية – على الحرم المكي، عام 1979 م، خلال موسم الحج السنوي؛ أو اغتيال إسحق رابين، عام 1995، على يد أحد أعضاء فرقة غوش إيمونيم[7]، بعد أن اتهم بالتخلي عن يهودا وسامراء (الضفة الغربية).
ويتصور الإرهاب الديني بوصفه فعلا ذا صبغة متعالية. فحين تبرره المرجعيات الدينية وتضفي عليه المشروعية، يعطي كل الرخص للفاعلين الذين يتحولون عند ذلك إلى أدوات أو خدام للمقدس. ولا تكتسي أعداد الضحايا، ولا هوياتهم، أية أهمية. فلا حكم يعلو على القضية التي من أجلها يضحي الإرهابي بنفسه. لقد تمكن مرتكبو الاعتداء الأول على مركز التجارة العالمي – الذي لم يفلح في إصابه أهدافه إلا بصورة جزئية (1993) – من الحصول مسبقا على فتوى من الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل حاليا في سجون الولايات المتحدة[8].
لقد انعطف بنا الحديث إلى ما هو ديني، أو على الأقل إلى جانب من جوانبه، لكن ذلك لا ينأى بنا، إلا في الظاهر، عن بيت القصيد الذي هو الإرهاب، والذي غالبا ما يختزل عند القاريء المعاصر في الإرهاب الإسلامي. وينبغي التذكير في هذا الصدد بأن الإسلام يربط ربطا وثيقا بين المشكلات اللاهوتية والمشكلات السياسية. والعلة في هذه الخصوصية التي تطبع الإسلام تكمن في تكوينه أو نشأته. فالقائد الأعلى، إن شئنا استخدام مفردات قريبة من مفرداتنا، كان، في الآن نفسه، زعيما دينيا وسياسيا. ولم يتم اتباع هذا النموذج المثالي في الأزمنة اللاحقة. لقد تشكل، إلى حد ما، جهاز ديني وجهاز شرعي أو قضائي، لكن المثال ظل في ذهن المسلمين عبارة عن بنية أو تركيبة فريدة، بما أن الإسلام، كما يقدمه القرآن، دين ودولة[9]. وأما ظروف ميلاد الكنيسة، فقد كانت مختلفة. فحتى مع تحول المسيحية، في القرن الرابع، إلى دين رسمي للإمبراطورية، ظل الجهازان، الديني والسياسي، متمايزين، وذلك على الرغم من طمع الكنيسة، لفترة وجيزة من العصر الوسيط، في السيطرة على الرؤساء الزمنيين.
إن من ثوابت الحركات الدينية أن تنشطر إلى جماعات. وتعلن الحركات المنشقة دائما أنها هي التي تمتلك ناصية التأويل الصحيح لقواعد الدين.
وفي أيامنا هذه، تلجأ التيارات الإسلامية المتطرفة، بعد أن أبلت حرب العصابات، إلى اجتراح أعمال ذات طابع إرهابي باستلهام الدين الذي يؤول بطريقة من شأنها حشد الحشود وتجنيد الأتباع لخدمة أغراض سياسية.
ولن نسهب الكلام، ههنا، لا عن كوكبة الأنظمة الاستبدادية الغفيرة التي وسمت التاريخ، من عهد تأسيس الدولة الصينية، في القرن الثالث قبل الميلاد، إلى عهد ماو تسي تونغ – ولا عن مجتمعات الشرق القديم أو مجتمعات الهند، إلا من باب استغراب إمكان وجود حاكم حريص على الالتزام بتعاليم البوذية، مثل الملك أشوكا – ولا عن الإمبراطوريات الإسلامية التي آثرت، على غرار كل سلطة حاكمة، الظلم على الفوضى، وبرعت آخرها، ونعني بها الإمبراطورية العثمانية، حتى لحظة سقوطها، في استخدام الإرهاب من دون وازع من ضمير. ولم يكن الغرب أحسن حالا من هؤلاء، إلى أن نبتت البذور الأولى للديمقراطية في كل من سويسرا وهولندا وإنجلترا والولايات المتحدة، ثم في فرنسا حيث انقلبت إلى إرهاب باسم الفضيلة. وقد بلغ هذا الإرهاب ذروته مع صدور قانون 22 بريريال السنة الثانية (1794) الذي يحرم المتهم من الاستعانة بالشهود والمحامين ويخول المحكمة حق الإدانة بناء على اقتناع.
وتحتفظ لنا المصادر التاريخية، أو، بعبارة أدق، سجلات أخبار المهزومين، التي رَسَّخَت في أذهاننا صورة تاريخية معينة، بذكرى المغول في القرن الثالث عشر الميلادي، وما زرعوه من رعب عارم، يكفينا منه مثال تيمورلنك وهرم الرؤوس التي قطعها بعد استيلائه على بغداد. أما قرننا العشرون الذي أنجب النازية والإرهاب الستاليني، فهو قرن الإبادات الجماعية بامتياز، من إبادة شعب الأرمن، عامي 1915-1916، في الإمبراطورية العثمانية، إلى الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا، عام 1994، في ظل الصمت المطبق الذي لزمته الدول، علاوة على المذابح التي تعرض لها اليهود والغجر خلال أعوام 1942-1945، وعمليات القتل الجماعي المرتكبة في حق فئات اجتماعية معينة: الكولاك، أعداء الثورة الحقيقيون أو المفترضون، السلالات المسماة وضيعة.
وكذلك الحال بالنسبة إلى الفرق الدينية، أو غيرها من الجماعات الموكلة بأداء مهمة – مقدسة بهذه الدرجة أو تلك – التي أمعنت في استخدام الإرهاب، فإنها عديدة. ونستطيع أن نذكر، في هذا الصدد، فرقة الثاغي أو الخَنّاقين التي دأبت، منذ القرن السابع، على ترويع المسافرين في بلاد الهند، إلى أن تم القضاء عليها في منتصف القرن التاسع عشر. ويتعلق الأمر بفرقة تمارس الخنق الذي يتم التمرن عليه منذ سن مبكرة، وبصورة عائلية في أكثر الأحيان. وتضم الفرقة في صفوفها، أحيانا، أطفالا صغارا هم في الأصل سبايا. ويستطيع هؤلاء، عند بلوغ نحو العشر سنوات أو الإحدى عشرة سنة، أن يرافقوا القتلة، وأن يشاهدوا من بعيد، تحت إشراف وصي، ما يقوم به الثاغي من أفعال، حتى يتعودوا على أنشطة الفرقة، وحتى يتعلموا، على وجه الخصوص، كيف يلزمون الصمت. وعند بلوغ الحلم، يشاركون في العمليات. ويعظم الثاغي إلهة الموت الهندوسية كالي. فقد رامت هذه الإلهة، بحسب معتقدهم، أن تقاتل الشياطين، ومن أجل ذلك خلقت، من عرق إبطيها، رجلين آزراها في إحدى المعارك؛ ولمكافأتهما على صنيعهما، سمحت لهما بأن يقتلا البشر من غير أن يبكتهم ضمير، أو ينتابهم ندم، شريطة ألا يسيلوا الدم. ويزعم تقليدهم الديني أن الإلهة كالي كانت، في سالف الأزمان، تحرص على محو أثر الجثث بالافتراس. غير أنه حدث، في يوم من الأيام، أن استدار أحد الأغرار من قليلي الخبرة نحوها، فرآها منهمكة في أكل الجثث. ولمعاقبة مثل هذا الفعل، امتنعت كالي، منذ ذلك الزمان، عن محو أثر جثث الضحايا. فأمرت أتباعها بتقطيعها ودفنها ثم إقامة احتفال طقسي.
وحتى أوائل القرن التاسع عشر، كان آلاف المسافرين يختفون كل سنة. وكانت السلطات المغولية، حين يقع أحد الثاغيين في الأسر، تبني عليه جدارا وهو حي، أو تقطع يديه وتجدع أنفه. وابتداء من 1830، حرصت السلطات البريطانية على قطع دابر هذه الفرقة التي اضمحل أثرها واختفت في نهاية المطاف.
إن الإرهاب هو، قبل كل شيء، عبارة عن أداة، أو، إن شئنا، تقنية. وهذه التقنية قديمة قدم ممارسة الحرب، وذلك بخلاف الفكرة الشائعة التي ترى أن الإرهاب ولد مع الحركات القومية الحديثة في القرن التاسع عشر. ومن المؤكد أنه وقع ثمة التباس بسبب الظهور المتأخر لهذا المصطلح مع الثورة الفرنسية وعهد الإرهاب.
وعلى غرار جميع الظواهر السياسية، يتحدد الإرهاب من خلال الثنائية التي تتقابل فيها المثل المعلنة وتطبيقاتها العملية. ومثل جميع الظواهر السياسية، لا يوجد الإرهاب إلا في سياق ثقافي وتاريخي. وطوال عشر سنوات، عانق تأثير الإيديولوجيا الماركسية في الحركات الإرهابية مآلات هذه الأخيرة؛ وفي أيامنا هذه، تعد الجماعات الإرهابية المنتسبة إلى الماركسية جماعات أقلية، بينما كانت هي صاحبة الصولة خلال السبيعينات والثمانينيات. وكذلك الحال بالنسبة إلى مجموع تاريخ الحركات الإرهابية التي تتحدد أشكالها تبعا للسياقات السياسية والثقافية التي تولد فيها وتعيش ثم تموت. ذلك لأنه إذا كان الإرهاب ظاهرة لا تنفك تتجدد، فإن تمرير عصا التناوب[10]، من جيل إرهابي إلى آخر، يؤشر، في أكثر الأحيان، على حصول قطيعة عميقة.
وفي أيامنا هذه، تتجلى أهمية المكون الثقافي في الحركات الإرهابية ذات المرجعية الدينية أكثر من تجليه في الحركات القومية أو المؤسسة على إيديولوجيا سياسية بحصر المعنى. فهذه الحركات هي التي تستأثر بالنصيب الأوفر من حديث الناس. إن تنظيمي حماس والقاعدة، على وجه الخصوص، يمزجان التطلعات السياسية أو شبه الدينية (تدمير إسرائيل أو الولايات المتحدة) بأساس ديني يتم توظيفه، على وجه الخصوص، في تجنيد الأتباع، وينطوي على العنصر الإيديولوجي المشترك مع باقي الحركات. وعلينا أن نلاحظ أن الإرهاب الذي مارسه الفلسطينيون، في بداية الأمر، كان في جوهره إرهابا سياسيا وعلمانيا، ثم حصل الانزلاق الديني، بعد قيام الثورة الإيرانية، خلال الثمانينيات.
في كل الأحوال، أو في معظمها، نلفي تنظيما إرهابيا في مواجهة جهاز الدولة. إن طبيعة هذه المواجهة هي التي تحدد سمة الحركة الإرهابية في أكثر الأحيان. فحيث تهيمن العقلانية على سيرة الدولة، تكتسي الحركة الإرهابية صبغة عاطفية للغاية. وحيث يشتغل جهاز الدولة الحديثة وفقا لمبادئ سياسية «واقعية»، وبناء على الفهم الصحيح لعلاقات القوة، تعمد الحركة الإرهابية إلى تحلية سياستها بنزعة أخلاقية محكمة (تختلف شرعتها تبعا للإديولوجيا المستخدمة)، وباستراتيجية ينتهجها الضعيف في مواجهة القوي بغية النيل منه سيكولوجيا بالدرجة الأولى. وقد عبر ريمون آرون عن ذلك تعبيرا صائبا ينفذ إلى صلب الظاهرة بقوله: «يسمى عمل العنف عملا إرهابيا حين يغيب التناسب بين آثاره السيكولوجية ونتائجه المادية المحض.»
إن ما نفهمه، اليوم، من كلمة «إرهاب» يشكل ما يسميه المتخصصون بالإرهاب «التحتاني»[11]. والحال أن الإرهاب «الفوقاني»[12]، أي ذلك الإرهاب الذي يمارسه جهاز الدولة، هو الذي انتصر عبر التاريخ. وسينعم هذا الإرهاب بأيام مجيدة في القرن العشرين مع مجيء الأنظمة الكليانية. ومن حيث عدد الضحايا، تسبب الإرهاب «الفوقاني» في خسائر تفوق تلك التي خلفها الإرهاب «التحتاني» بما لا يحصى.
وفي سياق هذا الكتاب، سينصرف اهتمامنا، بصورة رئيسية، إلى الإرهاب «التحتاني»، ولكن من غير أن نقتصر عليه. فمن حيث هو أداة، يتبنى الإرهاب، سواء أكان مصدره من «تحت» أم من «فوق»، المبادئ الاستراتيجية نفسها: لي ذراع الخصم بإضعاف قدرته على المقاومة. وحتى عهد قريب، لم يكن أحد يتحدث عن «إرهاب الدولة». إن إرهاب الدولة، كما نفهمه اليوم، ينطبق، قبل كل شيء، على الدعم الذي تقدمه بعض الأنظمة (ليبيا وإيران على سبيل المثال) إلى الجماعات الإرهابية. غير أن إرهاب الدولة يتخذ، بالتأكيد، أشكالا أخرى مغايرة. فهو أداة تستخدمها الأنظمة الكليانية، أيضا، بطريقة منهجية. ويتجلى إرهاب الدولة، أيضا، في العقيدة العسكرية التي تتبناها جيوشها. إن عقيدة «القصف الاستراتيجي»، التي تبلورت في الغرب خلال الثلاثينيات، على سبيل المثال، كانت تراهن، حصرا، على الرعب الذي يمكن أن يصيب السكان المدنيين من جراء القصف المكثف، ابتغاء تركيع الحكومات. وكانت هذه العقيدة هي الباعث على قصف درسدن، علاوة على إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما وناكازاكي.
ونلفي الحد الذي يفصل بين الإرهاب «التحتاني» والإرهاب «الفوقاني»، في أكثر الأحيان، غير محدد بشكل واضح: لنقارن بين لينين كما كان، قبل 1917، ولينين الذي تسلم مقاليد السلطة. فقد يصبح إرهابي اليوم – وهذا أمر معروف – هو رئيس الدولة غدا، أي ذلك الذي يتعين على هذه الحكومة أو تلك أن تحاوره وتباحثه دبلوماسيا. ويمكن أن نعد مناحيم بيغن وياسر عرفات (أو أي فلسطيني آخر غيره) مثالين ساطعين على هذا التحول الفارق.
إن التقليد الغربي لا يمنح المشروعية لغير العنف الذي تمارسه الدولة. وهذا التصور الضيق لاستخدام الإرهاب لا يكترث لأولئك الذين لا يملكون أية وسائل أخرى تمكنهم من قلب أوضاع يرون أنها تقوم على القهر والطغيان. ذلك أن مشروعية عمل إرهابي معين إنما تتجلى من خلال الأهداف التي ينشدها فاعلوه[13]. وحسبنا أن ندقق النظر في الحوارات التي أجريت مع بعض قدماء الإرهابيين لكي ندرك أن فكرة «الغايات تبرر الوسائل» هي الأساس الذي تقوم عليه معظم الأعمال الإرهابية. إن قضية الإرهاب، وليس نمط اشتغاله، هي التي يمكن أن تعد أخلاقية. وفي دائرة حروب التحرر الوطني، التي جرت في الخمسينيات والستينيات، كانت الأعمال الإرهابية تثمن، في أكثر الأحيان، بصورة إيجابية، وذلك لأنها عجلت بتحرر الشعوب المقهورة. إن فاعلي الإرهاب هؤلاء – في بلاد الجزائر، كما في إندونيسيا – يعدون من الأبطال. ولا يشعر معظمهم بأي ندم أو حسرة. وهكذا نعود، في آخر المطاف، إلى الاعتبارات المؤسسة لدعوى «الحرب العادلة» التي تضفي مشروعية على أعمال العنف.
والحال أنه في الغرب، وفي غيره، يميل المرء إلى وسم عمل ما بالإرهاب حين يحكم بأنه غير مشروع. وهذا الالتباس، الخطير على الدوام، الذي يخلط بين التأويل الأخلاقي لعمل سياسي ما وبين هذا العمل ذاته، هو الذي يشوش علينا رؤيتنا للظاهرة الإرهابية. لقد اعتدنا أن نحكم بأن عملا ما «إرهابي» إذا كان موسوما بالتعصب، أو إذا لم تكن أهداف فاعليه لا أهدافا مشروعة ولا أهدافا متماسكة. إن الملاحظ ليجد نفسه في حيص بيص، عاجزا عن الفهم، في متاهة الحركات الإرهابية التي تختلف صورها عبر القرون، خصوصا وأن السياقات التاريخية والثقافية متباينة. وثمة التباس آخر: ويتعلق الأمر بالفكرة التي مفادها أن العمل الإرهابي هو، بالتحديد، عمل يستهدف السكان المدنيين[14]. والحال أن السكان المدنيين يشكلون هدفا للاستراتيجية غير المباشرة، من منطلق أن القلق على مصيرهم، بوصفهم ضحايا محتملين، قد يحمل القادة على تغيير قراراتهم. إن الإقرار بأن مصير السكان المدنيين يؤثر بالضرورة على عمل القادة السياسيين ينطوي على رؤية حديثة للسياسة. ذلك لأنه من المعروف جدا أن مفهوم السيادة الشعبية، التي يتذرع بها إرهاب الدولة، لم يعرف الظهور إلا مع فكر الأنوار. وبعدها بقليل، أخذ الإرهاب السياسي يجاري تطور العقليات: فالشعبويون الروس في القرن التاسع عشر، على سبيل المثال، كانوا متأثرين للغاية بالتقليد الرومانسي.
وإذا كان الإرهاب الحديث، كما هو في الواقع العملي، يستهدف، في المقام الأول، السكان المدنيين، فإن هذه الظاهرة إنما نتجت، في الواقع، عن التطور العام للبنيات السياسية وعن ظهور وسائل الإعلام الجماهيري. فمنذ 1789، في الغرب، تطورت البنيات السياسية نحو الديمقراطية. وفي الفترة نفسها، ظهرت وسائل الإعلام الحديثة التي تشكل مكونا أساسيا من مكونات الديمقراطية الليبرالية. والحال أن المشروعية السياسية التي تتمتع بها ديمقراطية ما، ومنتخَبوها، إنما تستمد من مواطنيها. وهذا يكشف لنا عن السبب الذي يجعل سلاح الإرهاب، عند استخدامه ضد البلدان الديمقراطية، أكثر فعالية بالمقارنة مع نتائج استخدامه ضد الدكتاتوريات. ولا يعني ذلك، كما يميل بنا الاعتقاد، أن الدكتاتوريات أكثر فعالية في ضبط ومعاقبة الإرهابيين – على الرغم من أنها تملك، في هذا الشأن، هامش تصرف أوسع مما تملكه الديمقراطية – بقدر ما يعني أن وقع العمل الإرهاب في بلد حر يختلف عن وقعه في بلد حرم سكانه من الحق في إبداء الرأي والتأثير في القرار، وجعلت وسائل إعلامه في خدمة جهاز الدولة أو أخضعت لرقابته. وعلى ذلك، لن نجافي الصواب إذا ما قلنا إن الإرهاب الحديث يعد، في جزء منه، نتاجا للديمقراطية.
غير أن ذلك لا يعني أن ظاهرة الإرهاب مرتبطة بالديمقراطية بالضرورة، فإن استخدام الإرهاب أقدم زمنا بكثير من ظهور الدولة الديمقراطية الحديثة. لكن الإرهاب «الما-قبل-ديمقراطي»[15]– وهنا يكمن احتمال الالتباس – كان يكتسي أشكالا أخرى مغايرة تبدو، لأول وهلة، في غاية الاختلاف عن الأشكال التي نعرفها اليوم.
ويتعين علينا أن نبحث عن أحد أقدم تجليات التقنية الإرهابية في ما كان يطلق عليه اسم «التيرانيكيديوم» أو قتل الطاغية، وهو المصطلح المهجور منذ زمن بعيد. فقد جرت العادة على أن يتم قتل الطاغية باسم العدالة. ويعد التيرانيكيديوم أكثر أشكال الإرهاب شيوعا قبل العصر الحديث. وأخطر التنظيمات الإرهابية، في هذه الفترة، يتمثل في فرقة الحشاشين التي زاولت نشاطها، خلال القرنين الثامن والتاسع، متذرعة بالنقاء الإيديولوجي؛ وهي تذكرنا ببعض التنظيمات الإرهابية المعاصرة.
إن الإرهاب ليس حكرا على مجتمع بعينه. لقد وسمت أعمال الإرهاب، عبر التاريخ، العديد من المناطق الجغرافية والثقافية. فالزيلوت (أو السِّكاري) والحشاشون، على سبيل المثال، نشطوا في منطقة الشرق الأوسط التي ما زالت، حتى يومنا هذا، تؤوي أكبر التنظيمات الإرهابية. وفي نهاية الحرب العالمية الثانية، فرضت دولة إسرائيل سيطرتها من خلال استراتيجية استخدمت فيها تقنيات الإرهاب. وفي أيامنا هذه، يلجأ الفلسطينيون إلى استخدام التقنيات نفسها ضد إسرائيل. وظلت منطقتا آسيا الوسطى والشرق الأوسط، طوال قرون عديدة، عرضة للإرهاب الذي مارسته مختلف الجيوش الجوالة، ومنها جيوش جنكيز خان وتيمورلنك. وكانت روسيا، منذ القرن التاسع عشر، مسرحا للعديد من أعمال الإرهاب، ومنها إرهاب الدولة الذي قام عليه الصرح السوفياتي برمته لمدة سبعة عقود. وفي أيامنا هذه، أضحى الإرهاب في روسيا، مرة أخرى، إرهابا «تحتانيا» أقرب ما يكون إلى التقليد الشعبوي في القرن التاسع عشر. وفي أوروبا، تظهر لنا حرب الثلاثين عاما (1618-1648) أن تقنيات الإرهاب لم تكن مجهولة من طرف الجيوش التي تحاربت بعنف وشراسة. ومنذ عهد قريب، شهدت أوروبا موجات شتى من الإرهاب: الفوضوية، الإرهاب الإيرلندي، الجماعات الإيديولوجية مثل الألوية الحمراء أو فصيل الجيش الأحمر الألماني، وفي وقتنا هذا: الحركات الاستقلالية الباسكية والكورسيكية.
وشهدت الولايات المتحدة، في نهاية القرن التاسع عشر، عددا من الاغتيالات التي نفذها الفوضويون. ويضاف إلى ذلك أن اغتيال شخصيات سياسية (لينكولن، ماكينلي، جون وروبرت كينيدي) متجذر في تاريخ الولايات المتحدة. وهو قريب من تقليد التيرانيكيديوم؛ فقد صاح قاتل أبراهام لينكولن، قبل أن يقدم على ارتكاب جريمته، قائلا: «الموت للطاغية»[16]. ويعتمد عمل تنظيم كو كلوكس كلان، شبه السري، هو أيضا، على تقنية الإرهاب عبر إعدام الأشخاص من دون محاكمة. وما زالت التنظيمات اليمينية المتطرفة، وريثة كو كلوكس كلان على نحو ما، تواصل في أيامنا هذه استخدام التقنية الإرهابية (تفجير مدينة أوكلاهوما)، ولكن بوسائل حديثة ما فتئت تتطور. ومع أن أراضي الولايات المتحدة ظلت، لمدة طويلة، بمنأى عن الإرهاب الدولي، إلا أنها تعرضت لضرباته، بشكل مأساوي، في 11 أيلول/شتنبر 2001.
أما إفريقيا جنوب الصحراء، التي كنا نعهدها بمنأى عن الإرهاب، فقد وقعت، منذ بضع سنوات، ضحية الإرهاب الذي تمارسه القوات النظامية، وغير النظامية، وبعض العصابات المسلحة. ونلفي ذلك، على وجه الخصوص، في منطقة البحيرات العظمى (ثلاثة ملايين ضحية، معظمهم من المدنيين، في نزاع الكونغو). إن استخدام الإرهاب في إفريقيا، اليوم، يذكرنا بوقائع حرب الثلاثين عاما. ففي سياق العولمة، صارت إفريقيا، على نحو غير مباشر، هدفا للإرهاب، كما تشهد على ذلك تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في تانزانيا وكينيا. وأما أمريكا اللاتينية، فقد احتضنت العديد من بؤر حرب العصابات، بما فيها حرب العصابات الحضرية. ولجأ مقاتلو حرب العصابات، طبعا، إلى استخدام تقنيات الإرهاب، ولا سيما في حرب العصابات الحضرية (توباماروس).
وفي عام 1979، أَضَجّت الحركة الإسلامية المتطرفة، في صيغتها الشيعية، بظهورها في إيران. وفي العام نفسه، سمحت الحرب في أفانستان – بفضل الولايات المتحدة، المملكة العربية السعودية وباكستان – بصعود الحركة الإسلامية المتطرفة السنية. وبعد انسحاب الاتحاد السوفياتي من أفغانستان، انقلب هذا التيار، الذي كان يضم في صفوفه عناصر قادمة من معظم البلدان الإسلامية، باستثناء إفريقيا السوداء، على الولايات المتحدة ووقف منها موقفا مضادا. ومنذ منتصف التسعينيات، تجسد العداء للولايات المتحدة في سلسلة من الهجمات الإرهابية. وبلغت هذه الهجمات ذروتها في هجمات 11 أيلول/شتنبر 2001 التي قادت واشنطن إلى شن حملة عسكرية تأديبية على نظام طالبان وعلى ما يسمى بالقاعدة. وبمبادرة من إدارة بوش، تم اتهام العراق بحيازة أسلحة الدمار الشامل، وبربط علاقات مع تنظيم القاعدة، وبتهديد السلام العالمي وأمن الولايات المتحدة.
وبعد سقوط النظام البعثي، تبين أن هذه الحرب، التي تقرر خوضها من جانب واحد، بدعم شبه حصري من بريطانيا العظمى، والتي شنت مبدئيا على الإرهاب، تنطوي على ويلات لم يتصورها البنتاغون ولا جرت على باله.
ولا يسوغ لنا شجب الظاهرة الإرهابية من جانب واحد، اللهم إلا إذا تم شجب كل عنف، كائنا ما كان. وإنما ينبغي لنا، على أقل تقدير، أن نتقصى عن سبب حدوثها وعن الجهة التي تقف وراءها. وكما هو الحال في الحرب، وربما بدرجة أعلى، يلعب الإرهاب على الأنفس والعزائم. فلأول وهلة، تبدو الديمقراطيات عرضة للعطب بصورة كبيرة. ولكن إذا أصبح التحدي جديا، بل جوهريا، فإن القدرة على مقاومة هذه الاستراتيجية، المبنية على التوتر السيكولوجي، تبدو في صفوف السكان المدنيين أعلى بكثير مما يمكن ملاحظته من ردود الأفعال الأولية.
يلفي الإرهاب أعذاره بوصفه ملاذا أخيرا. والحال أن الضعيف، في عالم اليوم، لا يملك سلاحا آخر غيره في مواجهة القوي. وقد استخدمته في الماضي العديد من الحركات التي حازت على المشروعية في زمن لاحق. أما الدول، التي تملك الحق في استخدام العنف المشروع، فإن مهمتها وواجبها يتمثلان في دفاعها عن نفسها.
وبالجملة، إن استخدام الإرهاب، بوصفه تقنية للضغط، من طرف حركة ذات عمق اجتماعي معين، إنما يهدف إلى انتزاع تنازلات من الدولة والحصول على حل متفاوض في شأنه. أما الحركات الإسلامية الجهادية، فإن السمة الفارقة المميزة لها عن سائر الحركات التي سبقتها تكمن في انعدام أي شيء يمكن التفاوض في شأنه. إن الأمر يتعلق، في الواقع، بالصراع حتى الموت.
إن الإرهاب، من حيث هو ظاهرة دولية، أقرب إلى أن يمثل ضررا بالغا من أن يشكل قوة باعثة على عدم الاستقرار بالفعل، اللهم إلا أن يكون باعثا على عدم الاستقرار السيكولوجي. إن الإرهاب هو الثمن – الزهيد في نهاية المطاف – الذي ينبغي لبلدان الغرب، وللولايات المتحدة على وجه الخصوص، أن تدفعه لقاء هيمنتها وتحكمها. بيد أنه يجب علينا، بفضل البصيرة السياسية، أن نبذل غاية وسعنا، لتفادي تغذيته وإمداده بأسباب البقاء من حيث نحسب أننا نحاربه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
[1]– هذه معطيات الكتاب، في طبعته الفرنسية، مع أرقام الصفحات المترجمة:
Gérard Chaliand & Arnaud Blin (éd.), Histoire du terrorisme de l’Antiquité à Daech, Fayard, 2015, p. 13-26. (م)
[2]– أورده:
Jean Artrarit, Robespierre ou l’impossible filiation, Paris, La Table Ronde, 2003, p. 7.
[3]– أسفر قصف 10 آذار/مارس 1945 عن مقتل 80.000 شخص.
[4]– في الأصل:«secte» ؛ وقد ترادف «جماعة»، «طائفة»، «نِحلة»…إلخ. (م)
[5]– انظر:
Bernard Lewis, Les Assassins, préface de Maxime Rodinson, Berger-Levrault, 1987.
[6]– انظر:
Norman Cohn, Les fanatiques de l’apocalypse, Payot, 1983.
[7]– انظر:
Ehud Spinzak, Brothers against Brothers, New York, Free Press, 1999.
[8]– قضى في سجون الولايات المتحدة بتاريخ 18 شباط/فبراير 2017. (م)
[9]– أورد المؤلفان بين قوسين هلاليين عبارة«Dar we Dawla» ؛ وهي، كما نرى، نقحرة لعبارة «دار ودولة»؛ ولعل الصواب: «دين ودولة»، كما هو معلوم من أدبيات «الإخوان». ويتكرر هذا الأمر في كتاب:
Gérard Chaliand, Guerres et civilisations, Odile Jacob, 2005, p. 380.
(م)
[10]– في الأصل: «passage de témoin»؛ وهي عبارة مستعارة من معجم ألعاب القوى. (م)
[11]– في الأصل: «terrorisme «d’en bas»» . (م)
[12]– في الأصل: «terrorisme «d’en haut»» . (م)
[13]– في الأصل:agents» » ؛ وكلما وردت كلمة«agent» بهذا المعنى الاجتماعي، ترجمناها بكلمة «فاعل». (م)
[14]– نلفي هذا الأمر، على الخصوص، عند كيلب كار(Caleb Carr) الذي يرى أن العمل الإرهابي موجه حصرا إلى المدنيين، الأمر الذي يؤدي، بحسب رأيه، إلى استبعاد تاريخ فرقة «الحشاشين» كله من دائرة الإرهاب. انظر:
Caleb Carr, The Lessons of Terror, A History of Warfare against Civilians, New York, Random House, 2003, p. 66-67.
[15]- في الأصل:prédémocratique ؛ أي: «سابق الوجود على الديمقراطية». (م)
[16]– في الأصل:«mort au tyran» ؛ وهي ترجمة فرنسية غير دقيقة للعبارة اللاتينية«sic semper tyrannis» ، المنسوبة إلى ماركوس يونيوس بروتوس(M. J. Brutus) ، أحد قتلة الجنرال الروماني يوليوس قيصر، والتي يقال إن جون ويلكس بوث(J. W. Bouth) ، قاتل الرئيس الأمريكي، رددها بعد ارتكابه لجريمته (وليس قبل ذلك كما ذكر المؤلف)؛ ومعناها تقريبا: «هكذا يموت الطغاة». (م)
