البحث عن هوية دينية للعلم والمعرفة
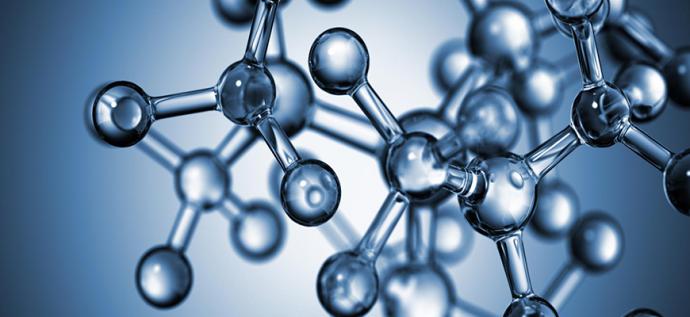
في شهر فبراير الماضي 2018، اعترف المفكّرُ الإيراني رضا داوري أردكاني[1] في رسالة نشرها بالفارسية، وهو في عمر 84 عاماً، بأنه وقع ضحيةَ وهمٍ كلَّ حياته في بحثه من دون جدوى عن هويةٍ محليةٍ ودينيةٍ ضائعةٍ للعلم[2]، وأن جهودَه ذهبت هدراً في العمل على تحويل العلوم الحديثة إلى علوم دينية. أثارت هذه التوبةُ المتأخرةُ عاصفةً من ردود الأفعال، فقد تحمّس بعضُهم فبالغ في تبجيل موقف صاحبها، وأثنى على شجاعته في الاعتراف، وإنْ جاءت في نهاية عمره، وأدان آخرون موقفَه هذا. وتنوّعت المواقفُ منه تبعاً لاختلاف مرجعيات المتحدثين؛ فمنهم من طالبه بالتريث، ومنهم من استهجن تلك التوبةَ بعد فوات الأوان. فمثلاً كتب المفكّرُ المعروف عبدالكريم سروش نقداً لاذعاً لرسالة داوري، لا يخلو من سخرية وتهكّم وإدانة، بوصف سروش كان من أوائل الذين تحدّثوا عن لا جدوى البحث عن تلك الهوية الضائعة، في الوقت الذي لبثَ داوري وأضرابُهُ من أصلب المدافعين عن ضرورة البحث عن البصمة الدينية والمحلية في العلوم.
ولأهميةِ هذه القضية، وحضورِها المكثف منذ أكثر من نصف قرن في التفكير الديني في عالَم الإسلام، وتجديد النقاش بشأنها اليوم، نحاول هنا إيضاح الرهاناتِ التي تشكّلت في فضائها، وآفاقِ الانتظار المولّدة لها، والرغباتِ التي غذّتها، وما اكتنفها من تمنيات وأحلام والتباسات.
تلاعبُ المُعتقَد والهوية المغلقَين بالمعرفة
ولّد الموقفُ الهجائي للفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع، الذي تبنّاه جماعة من الخطباء والكتّاب، كراهيةً وحذراً شديداً منها، وتعزّزت حالةُ الكراهية هذه حتى صارت من المسلّمات في كثيرٍ من أدبيات الجماعات الدينية؛ فمثلاً يكتبُ سيدُ قطب في كتابه معالم في الطريق: "نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلامُ أو أظلم. كلّ ما حولنا جاهلية. تصورات الناس وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم وآدابهم، شرائعهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية، ومراجع إسلامية، وفلسفة إسلامية، وتفكيراً إسلامياً، هو كذلك من صنع هذه الجاهلية!"[3]. وكلامُه هذا نموذجٌ لطريقةِ تفكيرٍ استلهمتْها وتشبّعت بها أكثرُ أدبيات الجماعات الدينية سنية وشيعية، حتى أضحى هذا الفهمُ مرجعيةً استقى منها تفكيرُ ومواقفُ ومشاعرُ عدة أجيال من أتباع هذه الجماعات أمس واليوم.
إن أكثرَ دعاة البحث عن هوية دينية للعلوم والمعارف الحديثة في بلادنا هم ممن ابتنت مواقفهم على "جاهلية" هذه العلوم والمعارف. وتعد جماعةُ "إسلامية المعرفة" أبرزَ مصداق لذلك في المجال العربي الإسلامي[4]. لذلك، كانت دعوتُهم تجد تبريرَها في التشديد على غواية العلوم والمعارف الحديثة وضلالها.
في فضاء هذا اللون من التفكير، المعادي للفلسفة وعلوم الإنسان والمجتمع، وقعَ تفكيرُ المسلم في حيرة، فهو حائرٌ بين أن يدع َكلَّ المكاسب الحديثة لهذه العلوم، وهو موقف يتعذّر اتخاذُه على من يريد أن يحضر في العالم اليوم، وبين أن يلجأ إلى خيار يحسب أنه يخرجه من المأزق، ويتمثل بالعملِ على إثراءِ رصيدِه من هذه المكاسب من خلال خلع غطاء من النصوص الدينية عليها، وليرضي ضميره بتوهم أن هذه العلومَ دينيةٌ، لأنه استحوذ عليها من خلال هذا الغطاء، فأصبح يتملّكه شعورٌ بأنه هو من أبدعها، وكأن النصوصَ الدينيةَ اكسيرٌ تتبدّل به طبيعةُ الأشياء، فبمجرد أن نسقيها إلى أيّ علم ومعرفة تتبدّل فجأة من دنيوية إلى دينية. من الواضح أن هذه العمليةَ شكليةٌ فارغةٌ من دون مضمون حقيقي. العلومُ كونيّةٌ لا هويةَ دينية واعتقادية لها، وإلّا لو حاول كلُّ مجتمع أن يبتكر هذه العلومَ من جديد، ويشتقّها في فضاء دينه ومعتقده وميراثه وبيئته فإن ذلك مُتعذَّر، لأن البشريةَ احتاجت لآلاف السنين حتى وصلت العلومُ إلى هذه المرتبة. تطوّرُ العلم تراكمي، يحذف الأخطاءَ دائماً، ويثري رصيدَه بمكاسب جديدة. لا يبدأ العلمُ من الصفر في كلّ مرة، ولا تعمد المجتمعاتُ لإعادةِ اكتشاف ما اكتشفه غيرُها، أو البحثِ من جديد عمّا هو ناجزٌ ونهائيٌّ من معطيات العلم.
لقد قادَ الموقفُ الأعمى من العلم والمعرفة الحديثة للتلاعب بها، فكما يتلاعب المعتقدُ، تتلاعب الهويةُ المغلقةُ أيضاً بالعلم والمعرفة. إن كلّاً من الهوية والمُعتقَد متفاعلان لكن تأثيرَ كلٍّ منهما على شاكلته وبطريقته الخاصة. الطريقةُ التي تلاعب بها المعتقدُ تشاكلُ شباكَ المعتقد وتشعّبه، والطريقةُ التي تلاعبت بها الهويةُ تشاكلُ شباكَ الهوية وتشعّبها.
لكلّ جماعةٍ بشرية شغفٌ بإنتاج هوية خاصة مُصطفاة، عل وفق ما ترسمه احتياجاتُها وأحلامُها وآفاقُ انتظارها، وما تتعرض له من إخفاقات وإكراهات. وكل ذلك يسهم في كيفية بناء معتقدها، ويحدد ألوان رسمها لصوره المتنوعة وتعبيراته في الزمان والمكان، ثم تدمج صور المعتقد لتدخل عنصراً في مكونات هذه الهوية، بجوار العناصر الإثنية والثقافية واللغوية والرمزية وغيرها، بالشكل الذي يجعل المعتقد عنصراً فاعلاً ومنفعلاً داخل الهوية. كذلك تدخل الهوية في مكونات المعتقد، إذ تتغذى منه الهوية ويتغذى منها، فإن كان المعتقد مغلقاً يؤدي ذلك إلى انغلاق الهوية، وإن كانت الهوية مغلقةً يؤدي ذلك إلى انغلاق المعتقد. ويتشكل مفهوم الحقيقة وفقاً لهما؛ ذلك أن المعتقد والهوية ينشدان إنتاج الحقيقة حسب رهاناتهما ومطامحها ومعاييرهما، سواء كانت تلك الحقيقة دينية أو غير دينية.
وكما يتلاعبُ المعتقدُ والهويةُ المغلقان بالمعرفة يتلاعبان بالذاكرة أيضاً، إذ تعمل الهوية المغلقة على إعادة خلق ذاكرة موازية لها، تنتقي فيها من كل شيء، في تاريخها وتراثها، ما هو الأجمل والأكمل، ولا تكتفي بذلك، بل تسلب ما يمكنها من الأجمل والأكمل في تاريخ وتراث ما حولها، فتستولي على شيء مما هو مضيء فيه.
ويجري كل ذلك في ضوء اصطفاء الهوية لذاتها، لذلك تعمد لحذف كل خسارات الماضي وإخفاقاته من ذاكرة الجماعة، ولا تتوقف عند ذلك، بل تسعى لتشويه ماضي جماعات مجاورة لها، والتكتم على مكاسبها ومنجزاتها عبر التاريخ.
في الهوية المغلقة يعيد متخيل الجماعة كتابة تاريخها، في أفق يتحول فيه الماضي إلى سردية رومانسية فاتنة، ويصبح العجز عن بناء الحاضر استعادة استيهامية مهووسة بالأمجاد العتيقة، ويجري ضخ الذاكرة الجمعية بتاريخ متخيل يضمحل فيه حضور التاريخ الأرضي، وتخلع على الأحداث والشخصيات والرموز والأفكار والمعتقدات والآداب والفنون هالة أسطورية، تتحدث عنها وكأنها خارج الزمان والمكان والواقع الذي ظهرت وتكونت وعاشت فيه.
وتشتد حالة اصطفاء الهوية ووضعها فوق التاريخ في مراحل الاخفاق الحضاري، وعجز المجتمعات عن المساهمة في صناعة العالَم الذي تعيش فيه. لذلك، تسعى للاستيلاء على المكاسب الكبيرة للآخر، وإيداعها في مكاسبها الموروثة، عبر القيام بعمليات تلفيق متنوعة، تتسع لكل ما هو خلّاق مما ابتكره وصنعه غيرها. وذلك أبرز مأزق اختنقت فيه هويتنا في هذا العصر الحديث.
الهوية المغلقة ضحية التلفيق
كان التنكر للأبعاد الكونية في الفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية أعقد مأزق تورط فيه العقل الديني والقومي هذا العصر في مجتمعاتنا. وظهر ذلك بوضوح في العمل، الذي استنزف مالاً وفيراً وضاعت فيه عقول فذة، وظل وهمُهُ يطارد عدةَ أجيال إلى اليوم، والذي يسعى لاكتشاف هوية دينية للعلوم والمعارف، ويفتش عن هوية قومية ضائعة للعلم والمعرفة.
وعيُ المتشبثين بمنطقِ استئناف الماضي كما هو لمأزق الهوية ألجأهم لتلفيقِ المتنافرات، وتركيبِ كلِّ شيء يبهرنا في الحاضر بكلّ شيء مازال يكبّل عقولَنا في الماضي، وقد أفضى ذلك إلى أن تتيه عقولُنا في الموضات الأيديولوجية والفكرية والسياسية، ويغرق تفكيرُنا في إسقاط كلّ شيء يفتننا اليوم على النصوص الدينية، في محاولة يائسة للاستحواذ على ما كل يبهرنا عبر لصقِه بهويتنا.
ويغذي هذه الحالة شغفُ مجتمعاتِنا بإنتاج المقدّس، فشغفُها بإنتاج المقدّس أشدُّ من شغفِها بإنتاج العلم والمعرفة والأدب والفن، والغذاء بل كل حاجاتها المادية الحقيقية. إنتاجُ مجتمعاتنا للمقدّس أكثر من إنتاجها لكل شيء تحتاجه، مثل الغذاء والأشياء الآنية التي تستهلكها، لأن ما تأكله وتستهلكه ينتجه غيرُها، لكنها تنتج الأوثانَ التي تعبدها. حتى العلم والمعرفة والأدب والفن لا تستسيغه مجتمعاتُنا، إلّا إذا خلعت عليه رداءً مقدّساً.
لو قرأنا نماذجَ من أدبيات النهضة، بعد صدمة اكتشافنا الغربَ وعلومَه الجديدة، نجدها تسقط بعضَ ما يفتنها من الاكتشافات العلمية التي أنجزها غيرُنا على النص الديني، وكأنها تقوم بعملية تعويض نفسي للمسلم الذي لم يحقق ذاته في العالَم الجديد، بعد ضياع عقله في المتاهات، وعجزه عن المساهمة في إبداع الفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والطبيعية المتنوعة، لذلك لجأ لإيهام نفسه بأنه ممن أسهموا في إنجاز هذه المكاسب، وممن عملوا على صناعة العالَم الحديث.
من هنا نجد الشيخُ طنطاوي جوهري "ت 1940" مثلاً يحشدُ في تفسيره: "الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات"[5]، كلَّ ما اطلع عليه وقتئذٍ من العلوم الحديثة، حتى صارت موسوعته هذه تتسع لكلِّ شيء ما خلا التفسير، وهكذا فعل كثيرون غيره في تلك الحقبة وما تلاها.
وفي مرحلةٍ لاحقةٍ، أُغرم بعض الكتاب بالموضاتِ الأيديولوجيةِ والفكرية والسياسية الجديدة. مع موضة الاشتراكية أصبح النبي محمد "ص" وبعضُ الصحابة كأبي ذر والخلفاءُ وغيرهم اشتراكيين، إذ كتب مصطفى السباعي سلسلته عن الاشتراكية والاشتراكيين في الإسلام، وهكذا فعل محمود شلبي، وغيرهما. كذلك اجتاحتنا موضةُ اليسار، فتفشّتْ كتاباتٌ تفتّش عن اليمين واليسار في التراث، كي تفسر الإسلام تفسيراً ماركسياً ويسارياً، كما فعل بعضُ الكتّاب العرب، وآخرُهم صديقنا حسن حنفي، الذي أصدر العددَ اليتيمَ من مجلته "اليسار الإسلامي"، وكتاباته الغزيرة في هذا السياق، التي يصرّ فيها على تلفيق مقولات متكلمي الفرق المختلفة وفتاوى فقهاء المذاهب المتعددة مع مقولات ومفاهيم اشتراكية وغيرها.
في وطننا العراق مثلاً، تفشى مصطلحُ "مدنية" سياسياً اليوم، وكما هو معروف، فإن هذا المفهومَ ولد وتطور في سياق الفكر الغربي الحديث، وهو يشي بدلالاتٍ لم تولد أو تتشكّل في سياقٍ إسلامي. وكلُّ من له أدنى خبرة بالفكر السياسي الحديث يعلم ألّا دولة مدنية بلا ديمقراطية، ولا ديمقراطية من دون رؤية فلسفية للإنسان والعالم، تبتني على مركزية الإنسان، وما ينبثق عنها من تكريس للفردية، وللحريات والحقوق. ولا ديمقراطية من دون فصل للديني عن الدنيوي، ولا ديمقراطية من دون فصل للدين عن الدولة.
تجاوزُ الدينِ لحدوده ينتجُ نسخَهُ المضادّة
كل نصوص الديانات يفهمها إنسان، وليس هناك فهم للدين خارج ذات الكائن البشري ورؤيته للعالم ومعادلات الواقع الذي يعيش فيه. وطالما فرضت معادلات الواقع على كلّ ديانة إنتاج نسخها المضادّة. ولا يمكن أن تحمي الديانةُ نفسَها من تزوير النسخ المضادّة وتزييفها إلّا بالكف عن استبعاد العقل في فهم الدين وتفسير تمثلاته في حياة الفرد والمجتمع، واعتماد العقل مرجعية في اختبار صحة معتقدات الديانة وقبولها، ومواكبة الديانة لمعطيات العلوم والمعارف، وتوظيفها في إعادة اكتشاف ما تبدّد من معناها الروحي ورسالتها الأخلاقية. والكف عن استعمال الدين كأداة للتخويف والقهر والاستعباد، والعمل على ايقاظ القيم السامية في الدين، وتبني كل مفهوم منحاز لحقوق الإنسان وحرياته بوصفه إنساناً، وطرد كل مفهوم ديني ينفي هذه الحقوق والحريات.
إن لم يضع كل دين حداً لتماديه في اللامعقول يتحوّل إلى مجموعة من المواقف العبثية والتصورات الخرافية والحكايات اللامعقولة. يحدثنا التاريخ أن كل الأديان التي تستبعد العقلَ في تعليمها، يستنزفها الجهلُ، وتتغلب عليها الأساطيرُ، وتنهكها الخرافاتُ، وتصير متحفاً للمعتقدات المحنطة، وملاذاً للهويات المتحجرة. ولن يخرجَ أيُّ دينٍ من مأزقه، ولن تخرج مجتمعاتُ الإسلام من مأزقِها التاريخي، مالم ترسم حدوداً يتكشّف فيها مجالُ الديني وحدودُه، ومجالُ الدنيوي وحدودُه، ويكفّ كتّابنا عن الفهم اللامعقول للدين ونصوصه، والتلفيق بين الديني والدنيوي، ولصق كلِّ شيء بالدين.
ولن نكتشف خارطة لطريقنا مالم يكن الدينُ ديناً لا غير، والمقدّسُ مقدّساً لا غير، والدنيا دنيا لا غير، والآخرةُ آخرةً لا غير، والعقلُ عقلاً لا غير، والفلسفةُ فلسفةً لا غير، والعلمُ علماً لا غير، والأسطورةُ أسطورةً لا غير، والمتخيّلُ متخيلاً لا غير، والأدبُ أدباً لا غير، والفنُ فناً لا غير. لا بمعنى القطيعة الجذرية بين كلّ منها، لأنها متفاعلة يؤثر كل منها في الآخر ويتأثر به، وإنما بمعنى رسمِ صورةٍ لكلِّ منها تضئ ملامحَه، وتتعرّف على ماهيتِه، وتكتشف حدودَه، وتحدّد إطارَ موضوعه، وتعلن عن وظيفته.
تجاوزُ الحدود أنتج الكثيرَ من مشكلات حياتنا. من هنا لا يمكن الوثوقُ بخارطةِ طريقٍ لبناءِ دولةٍ وتطورِ مجتمعٍ لا يعرف الدينُ فيها حدودَه، ولا تعرف الفلسفةُ فيها حدودَها، ولا يعرف العلمُ فيها حدودَه، ولا يعرف الفنُ فيها حدودَه، ولا تعرف الدولةُ فيها حدودَها، ولا تعرف السياسةُ فيها حدودَها.
توفيقية الوسطية
يستعمل بعضُهم "الوسطية"[6]، وكأنها تسمية بديلة لتلفيق مقولات متضادة، لا تجتمع إلا في الشكل بينما تفترق في المضمون، إذ تحاول بعضُ كتابات وأحاديث دعاتها التلفيق مثلاً بين حقوق الإنسان وحرياته بمعناها الحديث والإسلام بمعناه الفقهي.
وقد شاعت تسمية الوسطية أخيراً في الأدبيات الدينية في بلادنا، بوصفها تحيل إلى معنى قرآني: "وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا"[7]؛ لكن المعنى القرآني يشير إلى أن الأمة المسلمة تمثل عقيدة لا تنسى الله كما فعلت الوثنية، ولا تنسى الإنسان وطبيعته البشرية كما فعلت الرهبنة المسيحية. إنها لا تنسى حاجات الإنسان المعنوية، كما لا تنسى حاجات المادية، كما فعلت أديان وثقافات محلية معروفة لدى عرب الجزيرة.
وهذا المعنى القرآني للوسطية غير المعنى المستعملة فيه هذه التسمية اليوم، لأن دلالته لدى من يستعمله في كتاباته وأحاديثه تحيل إلى معنى يحاول أن يعالج المأزق الراهن للتفكير الديني في عالَم الإسلام، وهو مأزق يريد الخلاص منه بحلول توفيقية. المأزق يتطلب حلولاً جذرية، لا مسكنات مؤقتة. المسكن لا يشفي من الأمراض المزمنة، وإن كانت آلام المريض تغيب معه لبرهة.
نحتاج اليوم إلى عملية تفكير جسورة تستأنفُ نصابَ العقلِ في التفكير الديني، كي يفضح اللامعقول في فهم الدين، ويعمل حفريات على التراث تخترق بنيته التحتية، لتكتشف الروافد العميقة لتشكيله، وتتعرف على أنساقه المضمرة التي تعيد إنتاج مكوناته، ويفكك المعرفة الدينية المنتجة في سياقات الاستحواذ على السلطة السياسية والروحية والهيمنة على مختلف أشكال الثروة المادية والرمزية.
الوسطية بمعناها الجديد ليست خياراً للخلاص. من يريد الانتماءَ للعصر خيارُه واضح، ومن يريد الانتماءَ للماضي خيارُه واضح. أما إسقاطُ كلِّ ما نتمناه اليوم على نصوصِنا الدينية وتراثِنا البعيد والقريب، فهو ضربٌ من تشوّهِ العقل واضطرابِ الرؤية.
تقديم القديم بأشكال جديدة
يكمن مأزق الإصلاح في الإسلام الحديث، منذ الأفغاني حتى اليوم، في عمل أكثر المصلحين على التلفيق، وتقديم المحتوى القديم بأشكال ولغة وأساليب جديدة، من دون تحديث مناهج القراءة وأدوات النظر للنص الديني، مع أنه لا يمكن إنتاج فهم جديد للنص الديني بأدوات النظر ومناهج القراءة القديمة التي أنتجها إسلام الآباء[8] وأنتجته.
لا تحديث عميق يطال البنية التحتية للتفكير الديني في الإسلام من دون تجديد أدوات فهم الدين وقراءة نصوصه. الفهم يتشكل دائماً تبعاً لزاوية النظر التي ينظر من خلالها المتلقي، ويتلوّن الفهم بذات المفسّر ومنهج قراءته للنص ورهانات الواقع، فإذا أردنا إنتاج تأويل جديد للنص، وتحيين معناه، بما يجعله منخرطاً في رهانات المسلم اليوم، لا يمكننا أن نتعاطى معه من زاوية نظر أصول الفقه وعلوم القرآن والتفسير ورؤية علم الكلام القديم للعالَم. تحيين رسالة القرآن وتموضعها في سياق روح وأخلاقي يستجيب لما يفرضه الواقع على المسلم اليوم لن تنجزه أدوات القراءة ومناهج الفهم القديمة، لأنها تمثل عبئاً ينهك دلالة النصوص، وتمارس إكراهاً يصادر تعدد المعنى، ويفرض على النص الدلالة التي فرضتها السياقات التاريخية للمجتمعات المسلمة؛ وبكلمة أخرى: لا خلاص مادام العقل والروح والضمير تحت وصاية الآباء. الحق في تقرير مصير الذات ووضعها خارج الوصايات شرط أساسي لكل عملية تحديث ونهوض.
ما تعد به الفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية
لا أفق لتحديث التفكير الديني خارج دراسة الفلسفة الحديثة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مادام التعليمُ الديني لم يخرج من حديث التراث للتراث، وحديث الآباء للأبناء، ومادامت الفلسفةُ والعلومُ الإنسانية والاجتماعية لم تتخذ مكانتَها المناسبةَ في الحياة الفكرية لمجتمعات عالَم الإسلام، فلن تنبعث حركةُ تحديثٍ عميقةٍ للتفكيرِ الديني في عالَمنا.
وظيفةُ الفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية حماية العقل من أن تبدّده الأوهام، وتسكنه الخرافات، وما تفضي إليه من تشوهاتٍ في رؤية العالم. ولعل من أهم ما نترقبه اليوم منها في مجتمعات عالم الإسلام أن تكتشف خارطةَ ما هو دنيوي وما هو ديني، وترسم الحدودَ الخاصة بكلّ منهما، وتبين المجالاتِ التي يتحقّق فيها الدنيوي، والمجالاتِ التي يتحقّق فيها الديني، والآثارِ الناجمةِ عن اجتياحِ أحدهما للآخر، فلو ابتلع الديني الدنيويَ يحتجب العقلُ ويدخل في حالة سبات، ويضيع الإنسانُ في ظلمات بعضُها فوق بعض، ولو ابتلع الدنيوي الدينيَ يحتجبُ اللهُ عن العالم، وتدخلُ الروحُ حالةَ سبات، ويضيعُ الإنسانُ في القلق واللامعنى.
أعرف أن الدين ليس رياضيات محكومة ببداهات وقوانين صارمة. الدين طبقات جيولوجية، في طبقاته ما يمكن اكتشافه بالعلوم الحديثة، كما تتضمن طبقاته ما هو خارج حدود العلم بالمعنى المحسوس في العلوم الطبيعية، لكن تظل المرجعية في اكتشاف هذه الطبقات وفهم مدياتها للعقل. العقل وإن كانت مدياته أوسع من العلم، لكن العقل بالمعنى المتداول عند دارسي العلوم الطبيعية يجري استعماله بمعنى العلم بالمجال المادي. العقل يمكنه أن يفكر خارج عوالم المادة، ولا أعني يفكّر فيما هو أوطأ من مرحلة التفكير العقلاني، بل يستطيع العقل تعقّل ما هو أعلى من المعقول المحسوس المادي، ونعني بذلك ما يتصل بالميتافيزيقا وآفاقها الرحبة، والدين ومدياته العميقة وخبراته الروحية والأخلاقية العميقة.
التلبيس في تلقي الفلسفة
الفلسفةُ تفكيرٌ عقلي نقدي حرّ يتحرك خارجَ الأطر والأوعية والأسوار، وأيّةُ محاولة لتعليبه في أوعية جاهزه تسجنه، وتنتهك حريتَه. الفلسفةُ معرفةٌ كونية، لا تتحيز لمعتقد أو أيديولوجيا، وإلّا ستنفي ذاتَها، إن كانت تتخذ من المعتقد الديني مرجعية، أو الهوية، أو الأيديولوجيا، أو ما هو قومي، أو محلي، أو جغرافي. والفلسفةُ لا تستمدّ حياتَها من كل ذلك، ولا تفتقر إلى مشروعية تمنحها لها تلك الأشياء، لا مشروعية لها خارج عقلانيتها وتحررها من تسلط أية مرجعية على العقل. الفلسفةُ كونيةُ، لا بوذية، ولا يهودية، ولا مسيحية، ولا إسلامية، ولا مذهبية، ولا قومية، ولا محلية، ولا جغرافية.
نعم، ولدتْ الفلسفةُ في سياقاتٍ معرفية وميتافزيقية مختلفة، تنوعت بتنوع بيئات وعصور الفلاسفة، وعلى هذا يمكن التعبير عنها بوصفها: فلسفة مسلمين، أو فلسفة يهود، أو فلسفة مسيحيين، أو فلسفة بوذيين، أو فلسفة غربيين، أو فلسفة شرقيين، أو فلسفة قديمة، أو فلسفة حديثة، أو فلسفة معاصرة، وإلّا لو كانت أسيرة معتقدات ومقولات دينية أو أيديولوجية، فإنها تصبح: لاهوتا، أو علم كلام، أو أيديولوجيا.
بعضُ الإسلاميين مولعون اليوم بالفلسفة الغربية، لكنهم يدخلونها من غير أبوابها، إذ يعتمدون في تلقيها بعضَ الترجمات الرديئة والمستخلصات المبسطة، فيلتبس فهمُهم لها، ويقدّمون صوراً مضحكةً أحياناً لمفاهيمها، عندما يركّبونها على مفاهيم دينية وتراثية، هي على الضدّ منها.
وهناك بعض الخبراء ممن يمتلكون تكويناً أكاديمياً جاداً في الفلسفة والمنطق الأوروبي الحديث، ولديهم معرفة جيدة باللغات الفرنسية والألمانية والإنجليزية، يتسيّدون المشهد الفلسفي في دول المغرب، ويحتفي بكتاباتهم الغزيرة الجامعيون المتدينون، غير أنهم يتفلسفون على طريقة الغزالي وابن تيمية، فيقدمون قراءات موهمة ومضللة للفلسفة الأوروبية الحديثة، تلوّنها بألوان مشوهة، فتقوّلها ما لا تقول. القارئ الخبير يدرك أنهم يتفلسفون ضدّ الفلسفة.
وتشهد المؤلفات الفلسفية وكتابات التصوف ونقد التفكير الدين اهتماماً لافتاً من القراء في السنوات الأخيرة، وأظن أن اهتمامَ القراء في بلادنا بهذه الآثار يحيل إلى تفاقم أزمات المعاني الروحية والأخلاقية والعقلية التي تعيشها مجتمعاتُنا، وكلُّ مجتمع تجتاحه أزمات معاني يبحث عن خلاص. الفلسفةُ والتصوّفُ كلٌّ منهما يسهم في الخلاص من شكل من أشكال هذه الأزمات، وكلُّ إنسان يغترف منهما على شاكلةِ وعيه، ووعاءِ استعداده، ونمطِ احتياجاته. الفلسفةُ تداوي أمراضَ العقل، وتمكّنه من اكتشاف خارطة طريق للتفكير النقدي الذي يحرّرُ وعيَهُ من الأوهام والخرافات اللامعقولة التي تعبث به، والتصوّفُ يروي ظمأَ الروح، ويسهم في إضفاء معنى على ما لا معنى له. تفشي الأوهام والخرافات ضربٌ من مرض العقل، وتشوهاتُ المقدّس ضربٌ من مرض الروح. لذلك حيثما تتوطن الفلسفةُ مجتمعاً تهرب منه الكهنة، لأن الفلسفةَ تفضحُ النسخَ المزورة التي ينحتها هؤلاء للمقدس، وتكشف إغواءَهم للناس باسم الدين.
[1] رضا داوري أردكاني "1932 - "، أستاذ فلسفة في جامعة طهران. من مريدي المفكّر الإيراني أحمد فرديد وأشد المدافعين عن رؤيته للعالَم وفهمه ومفاهيمه. للتعرف على فرديد وأفكاره راجع مقالتنا: "أحمد فرديد فيلسوف ضد الفلسفة" المنشورة في مجلة الكوفة التي تصدرها جامعة الكوفة "السنة 2، العدد 3، صيف 2013".
[2] نشرت الصحافةُ الإيرانية هذه الرسالةَ بتاريخ 20-2-2018، فأثارت النقاشَ مجدّداً حول هذه المسألة.
[3] سيد قطب. معالم في الطريق. القاهرة: الحدود للنشر والتوزيع، 2012، ص ص 39 - 40
[4] كان معظم الفريق الذي يقود "المعهد العالمي للفكر الإسلامي" قد تشبعت ثقافته ورؤيته للعالَم بأدبيات جماعة الاخوان المسلمين، خاصة كتابات سيد قطب، في مرحلة التكوين الأساسية من حياته.
[5] يقع هذا التفسير في 25 مجلداً، صدر في القاهرة عام 1931. ويسمى: "الجواهر في تفسير القرآن الكريم" لأن المؤلف يفرعه على جواهر بدلاً عن الفصول، والجوهرة يتفرع عنها الماسة الأولى والثانية والثالثة، وهكذا. يكتب الشيخ طنطاوي جوهري عن سبب تأليفه لهذا التفسير، فيقول: "أما بعد، فإني خلقت مغرما بالعجائب الكونية، معجبا بالبدائع الطبيعية، مشوقاً إلى ما في السماء من جمال، وما في الأرض من بهاء وكمال آيات بينات وغرائب باهرات، ثم إني لما تأملت الأمة الإسلامية وتعاليمها الدينية ألفيت أكثر العقلاء وبعض جلة العلماء عن تلك المعاني معرضين، وعن التفرج بها ساهين لاهين، فقليل منهم من فكر في خلق العوالم وما أودعت من الغرائب، فأخذت أؤلف لذلك كتابي".
[6] أشاع استعمال هذا المصطلح الشيخ يوسف القرضاوي، لاحظ كتاب: يوسف القرضاوي. كلمات في الوسطية الإسلامية ومعالمها. الكويت: المركز العالمي للوسطية، 2007. وتحت عنوان "صلتي بالوسطية" يقول القرضاوي: "إن الله تعالى أكرمني بتبني هذا التيار الوسطي من سنوات طويلة...".
[7] البقرة، 143
[8] "دين الآباء، وإسلام الآباء" مصطلحان استعملتهما مقابل "دين الأبناء، وإسلام الأبناء". معنى الآباء يحيل إلى أنماط فهم السلف للدين وكيفية قراءتهم لنصوصه في مختلف عصورهم. أما معنى الأبناء، فهو يحيل إلى نمط فهم الأبناء للدين وكيفية قراءتهم لنصوصه في عصرهم. القرآن يذم دين الآباء، كما جاء في الآيات: "بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍإِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ". الزخرف: 22 - 24:
المصدر:http://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D...
