المثاليّة والدّاروينيّة في نظريّة واحدة للمعرفة
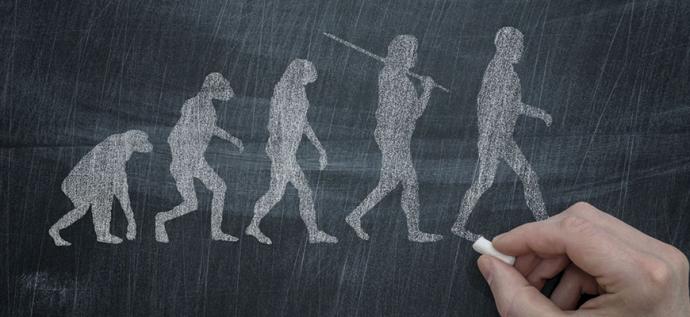
للعودة إلى مسائل من قبيل الفصل بين الذّات والموضوع الّتي عرفت بها المثاليّة الألمانيّة مظهرًا رجعيًّا في هذه الأيام، لكنها - بلا شكّ - مسائل جذّابة لها بريقها الخاصّ لأنّها تطرح أسئلة حيويّة وجذريّة تحتاج إلى إجابة، لكنّها تبدو في كلّ مرّة غير قابلة للحلّ، فيكون المخرج الوحيد هو تجاهلها، لذلك سيجادل هذا المقال - أوّلًا - صعوبة نفي المبدأ الأساسيّ للمثاليّة؛ وهو الفصل بين الذّات والموضوع من جهة، واستحالة وجود أيّ خبرة أو معرفة بمعزل عن تأثير الذّات من جهة أخرى، عن أي من المناهج الفلسفيّة بما فيهم أكثر المناهج إغراقًا في المادّيّة.
ثانيًا: سيُناقش إمكانيّة تأصيل فلسفة للوعي على خلفيّة نظريّة التّطوّر، وحديثًا، علم النّفس التّطوريّ، وإمكانيّة أن تسهم هذه الفلسفة في اختصار المسافة بين الذّات والموضوع، على اعتبار انتماء علم التّطوّر نفسه - على الرّغم من خضوعه لمنهج مادّيّ تجريبيّ صارم - لنوع من المثاليّة الخفيّة، وأخيرًا: كيف يمكن إنشاء فلسفة للعلم بناءً على ذلك، تتلاشى عيوب المادّيّة من جهة، وتوسّع حدود إمكانيّة المعرفة من جهة أخرى؛ أي أقل تناقضًا وأكثر مرونة، هذا الأمر يبدو كالتلفيق بين نظرتين متعارضتين، لكنّهما - بهذه المعالجة - لن تكونا كذلك أبدًا؛ بل توأمين كان لا بدّ لهما من نفس المصير في النهاية.
في البداية: علينا أن نوضّح أيّ نوع من المثاليّة نقصد، وأيّ مبادئ للمثالية نتحدّث عنها؛ إذ لا يمكن - على أية حال - التوفيق بين مبدأ عامّ يلخّص المثاليّة في كونها تنفي أيّ وجود للمادّة، وتثبت - فقط - وجود عالم من الأرواح أو المثل العليا أو الأفكار، أو أيًّا كان من هذه المثاليّات الّتي تجازف بنفي الواقع جملة، وبين الدّاروينيّة - هذا من جهة ومن جهة أخرى - فإنّه من الصعب - أيضًا - الزّجّ بجانب من مثاليّة بعض الفلاسفة الّتي تلخّص العالم في علاقة بين الذّات والمطلق، وتتجنّب العالم الواقعيّ تمامًا، وتمنح الرّوح الكليّ أو أيًّا ما يكون من تلك المبادئ الغيبيّة - صعبة الإثبات وصعبة النّفي - أهميّة مطلقة، على حساب العالم الإنسانيّ الّذي هو غاية كلّ فلسفة وكلّ علم، وأخيرًا، كيف يتجنب هذا التّوفيق - ولنتحفظ على هذا التّعبير مؤقّتًا - بين مبدأ أساسيًّا في المثاليّة الحديثة وبين الدّراوينيّة الخارجة عن منهج مادّيّ تجريبيّ، صرف الوقوع في فخّ الثّنائيّة المنهجيّة تلك الّتي تفصل بين الجسد والعقل.
لذلك، سوف يكون نموذجنا: المثاليّة الألمانيّة الّتي بدأت من بعد كتاب "نقد العقل المحض لكانط"، حتى نهاية توهّجها عند "هيجل"، وتحديدًا، حول المبدأ الرّئيس الّذي يفصل بين الذّات والموضوع، ويعترف جملة بأنّه لا إمكانيّة للتّعرف إلى أيّ موضوع دون ذات، لكنّنا سنجازف بالقول: "إنّه بإمكاننا - وفقًا للدّاروينيّة - تحديد العلاقة بين الذّات وموضوعها، والإجابة عن السؤال الأساسيّ، وهو: كيف تتعرّف الذّات إلى موضوعاتها، وما مدى صلاحيّة هذه المعرفة؟ دون الاضطرار إلى الاستعانة بمفاهيم معقّدة صعبة الإثبات وصعبة النّفي؛ كالرّوح الكلّيّ والمطلق، ودون الوقوع في فخّ إثبات الوجود الأنطولوجيّ للذّات العارفة أو أيّة ذات أخرى.
يتحدّث روجيه جارودي (1913 - 2012م)، في كتابه "النّظريّة المادّيّة في المعرفة"[1]، نيابة عن لافيل (Lavelle/ 1883 - 1951م)[2]، موجّهًا إليه سهام النّقد؛ حيث يقول لافيل: "لقد تساءل الفلاسفة دومًا: ما هي الواقعة الأوليّة الّتي ترتبط بها الواقعات الأخرى؟ غير أنّ هذه الواقعة الأوليّة؛ هي أنّه لا يمكنني أن أطرح الكون مستقلًّا عنّي أنا الّذي أدركه، ولا يمكنني أن أطرح الأنا مستقلًّا عن الكون الذي نُقِشَ فيه"، ثمّ يعقّب بعدها جارودي على هذا الكلام منتقدًا المثاليّة والوجوديّة معًا على هذا المبدأ، "إذن، فهذه هي الحجّة الوحيدة للمثالية؛ أي أنّه لا يمكن بلوغ مادّة دون روح؛ تقود - بالضّرورة - إلى وحدانيّة الذّات أو إلى اللّاهوت"، لكنّنا إذا ما اختبرنا هذه الحجّة الأساسيّة والوحيدة في المثاليّة على مرآة نظريّة التّطوّر، فإنّها لن تقود - بالضرورة - إلى الرّوح أو وحدانيّة الذّات، على العكس من كلام جارودي، وهو ما سيكشف عنه هذا المقال.
كيف نتأكد أنّ ما نعرفه عن العالم هو ترجمة صادقة عن حقيقة هذا العالم؛ الحقيقة - كما هي في الواقع - لا الحقيقة الّتي تعبّر عنها أهواؤنا وميولنا الذّاتيّة، وعقدنا النّفسيّة القديمة، وتصوّراتنا سريعة البنيان وسريعة السّقوط، الّتي قد تكون محض غرور أو هوس أو خيال، كيف نتأكّد أنّ توصيف عالِم الأحياء لتطوّر الكائنات الحيّة عن كائن وحيد الخليّة هو توصيف حقيقي لما حدث، لا مجرّد حلم ملحميّ جميل راود الشّاب داروين وهو مستلق على ظهر السّفينة "بيجل"، هل توصيف عالم النّفس لمشاكلي النّفسيّة هو توصيف فعليّ لمشاكلي أنا، أم لمشاكل طفولته هو، هذا السّؤال الّذي قد يعرِّض داروين لتبديل موقع كتابه "أصل الأنواع" في المكتبة من رفّ العلوم إلى رفّ الرّوائيّين المبدعين، أو فرويد - بوصفه شتامًا - يُلصِقُ عُقَد نقصه بمرضاه أكثر من كونه عالم نفس، وقد يعرض رجل دين - أيضًا - لمساءلة نصوصه المقدّسة باعتبارها حقيقية أم متاهفتة.
سؤال المعرفة هذا كان - ولا زال - السّؤال المحوريّ في الفلسفة، فانبثقت عنه جلّ نظريّة المعرفة، وتفرّعت عنه المناهج الفلسفيّة كافّة، وليس هناك من علم يستعدّ لتعميد نفسه علمًا حقيقيًا لا زائفًا، إلّا وهو رهن هذا السّؤال، لكنّ لميلها الجذري نحو التّجريد، وطبيعتها الّتي تملي عليها النّبش الدّائم عند الجذور، كان سؤال الفلسفة أبعد من المسألة النّفسيّة وأخطر شأنًا؛ فقد طبعنا جميعًا على النّظر للعالم بنفس الحواس، وعلى إخضاعه - أيضًا - لحزمة من المقولات المنطقيّة لا نعرف من أين أتت، ولا نستطيع أن نثق في صدق هذه الحواس بشكل نهائيّ، لكنّنا لا نملك سواهما طريقةً للتّعرف إلى موضوعات هذا العالم، لذلك، فحصيلة معرفتنا عن العالم قادمة من الذّات أساسًا، طالما أنّ الحواس هي ملك لهذه الذّات، والمقولات هي مقولاتها أيضًا.
لذلك، فهناك احتمال أن تكون موضوعات هذا العالم - بجملتها - شيئًا آخر يختلف عن نفس الموضوعات، بعد أن ندركها بحواسنا، ونطبّق عليها مقولاتنا منتجين ما يُعرَف في الفلسفة المثاليّة بـ"عالم الخبرة"، إلى أي مدى سوف يتطابق عالم الخبرة ذاك مع العالم الواقعيّ، هذا أمر من الممكن أن يختلف عليه الفلاسفة المثاليّون، لكن ما لا بدّ أن يتّفق فيه جميعهم؛ هو أنّ الذّات هي صانعة عالم الخبرة هذا، ونحن لا نستطيع أن نعرف أي عالم آخر سواه، وبتعبير آخر: فهو العالم الوحيد الموجود بالنّسبة إلينا، العالم الّذي يمكننا امتلاكه والتّعبير عنه بوصفه عالمنا، بغضّ النّظر عمّا إذا كان مطابقًا للعالم الحقيقيّ أم لا، وهو ما يقود - مباشرة - إلى التّعبير القائل "إنّ الذّات هي صانعة العالم"، وهو تعبير مجازيّ سيصبح أكثر دقّة إذا قلنا: "إنّ الذّات هي صانعة عالمها".
بيد أنّ الجملة الأخيرة تحتاج توضيحًا آخر يضعها في سياقها الصحيح، الذّات صانعة عالمها لن تعني بحال أنها قادرة على الخلق من عدم، فالأمر مع الذّات العارفة لا يتخطّى كونه وعاءً فارغًا يُملؤ باستمرار بالمادّة الواردة عبر الحواس، وهذا الوعاء أو بمعنى آخر "القالب" ما هو إلّا المقولات المنطقيّة، وهي بالنّسبة إلى كانط مقولات قبليّة لا تحتاج إلى عالم الحواس كي توجد، ولا تحتاج لاستنتاج أو تجربة؛ بل هي الأساس اللّازم الّذي تنبني عليه خطّة أيّة تجربة ونتائجها، وهذه المقولات الكانطيّة القبليّة هي (الزّمان والمكان والعليَّة)[3].
لذلك، فما أرساه كانط - وتبعه فيه المثاليّون الألمان من بعده - يختلف كليًّا عما تحدّث عنه بيركلي*؛ من محو للعالم الواقعيّ كلّه وعدّه خلقًا خاصًّا بالذّات؛ حيث تصبح الذّات خالقة لا عارفة، ولا وجود لأيّة موضوعات خارجها، وما هي إلّا تصوّرات تصنعها الذّات من العدم ولا تمتثل إلّا أمامها، يبدو أن بيركلي - كي يهرب من الإحراج الذي ستتسبّب فيه مسألة الخلق من عدم هذه - اضطّر إلى الاعتراف بوجود واقع خارج الذّات يؤثر فيها، لكنّ هذا الواقع سيكون روحيًّا صرفًا لا مادّة فيه، كانط نفسه لم يقتنع بالوقوف عند حدود هذه الحجّة، فذهب إلى الاعتراف بوجود واقع للأشياء، هذا الواقع عند كانط سيكون هو الجوهر الّذي لا يمكن التّعرّف عليه أبدًا، أو الولوج إلى طبيعته - مادّيّة كانت أو روحيّة - لذا سنكتفي بالتّعرّف إلى ظواهره[4]، والمثاليّون الألمان من بعد كانط لم يقتنعوا بالوقوف عند الحدود الكانطيّة، وها هو شلنج - على سبيل المثال - يقترب من أن يكون مادّيًّا صرفًا كما سنرى، وها هو هيجل - رغم نظريّته في المطلق والرّوح الكلّيّ - يتّجه إلى العالم الواقعيّ في ديالكتيك الفرد وديالكتيك المجتمع؛ أي أنّ المثاليّة الحديثة، على الرّغم من مملكة الفضاء التي كونوها بحسب تعبير جوزايا رويس*، لم يكونوا منكرين للواقع - كما نتخيّل لأوّل وهلة - وكلّ ما علينا فعله هو تنقية هذا الإنتاج الضّخم والعظيم، الّذي خلّفوه من المفاهيم الميتافيزيقيّة صعبة الإثبات، لا التّضحية بنتاج هذه المدرسة المهمّة جملة، ولا سيّما التّضحية بهذا المبدأ الأساسيّ والضّروريّ الّذي يتمثّل في العلاقة بين الذّات والموضوع.
حسب جوزايا رويس - أحد أهم شارحي المثاليّة الألمانيّة - وله مذهب خاصّ به يجمع فيه بين البراغماتيّة والمثاليّة، وهو ليس موضوعنا الآن على أيّة حال، فإنّ كانط لم يجب عن أسئلة شتّى من أهمّها من أين أتى بالمقولات القبليّة، ولماذا هذه المقولات بالذّات (الزّمان والمكان والعليّة) دون غيرها.
كان ذلك ليعرض البناء الكانطيّ كلّه لشبهة الاتّكاء على ميتافيزيقا بديلة، فكانط - وهو يحاول أن يتخلّص من الميتافيزيقا - إلى غير رجعة وقع في نفس الفخّ الّذي سبقه إليه جلّ الفلاسفة، وعلى رأسهم ليبنتز الّذي كان قد انتقده بنفسه، وهي شبهة تتأكّد لنا إذا ما استعرضنا مفهومه عن الجوهر وتقسيمه للعالم إلى "نومينا" و"فينومينا"، لكنّها موجودة على أية حال، وإن كانت بطريقة أقلّ ظهورًا في استعراضه للمفاهيم القبليّة باعتبارها أمرًا لا يمكن الاستدلال عليه بالتّجربة، ولا بالبرهان العقليّ؛ فهي - على كلّ حال - المنظّمة لكلّ من التّجربة والبرهان[5]؛ أي إنّها تدلّ ولا يُستدلّ عليها، وهو ما لا يمكن أن يتّكأ على مقدّمات تحتاج - في حدّ ذاتها - إلى استدلال، لكنّنا لا نجد مثل هذا الاستدلال أبدًا، لذلك يصبح السّؤال عن المصدر الّذي أتى منه كانط بهذه المقولات سؤالًا في محلّه، ولماذا هي دون غيرها؟ اللّهم إلّا إذا كانت قفزة من قفزات الفكر الكانطيّ، هذا الأمر لم يذكره جوزايًّا، فهو - ببساطة - لم يكن يحمل للميتافيزيقا هذا العداء الّذي يكنّه المادّيّون، لكنّه نوّه لهذا السّؤال بشكل مقتضب في محاضراته عن المثاليّة الألمانيّة، على اعتباره قد ظهر عند المثاليّين من بعد كانط، لا باعتبارهم أعداءً للميتافيزيقا - أيضًا - لكن هذه المرّة من أجل الوصول إلى أقصى مسافة ممكنة مع الميتافيزيقا الكانطيّة، ومساءلتها والبناء عليها، لكنّه - أي جوزايًّا - يشير إلى نقطة ضوء عند المثاليّ الأكثر حماسة وعبقريّة من بينهم، وهو "شلنج"؛ حيث يتحدّث عن توفيق بين المثاليّة والتّاريخ الطّبيعيّ[6].
لم تكن نظريّة داروين في أصل الأنواع قد تبلورت[7] بعد في وقت ظهور "المثاليّة الترنسنتندالية" لشلنج، لكنّ نظريّات التّطوّر كان لها أصل بعيد في التّاريخ الإنسانيّ من قبل داروين، وكان لشلنج تحليله الخاصّ - على ما يبدو - إضافة إلى هذه النّظريّات، ونظريّته في الطّبيعة الّتي رآها تترتّب على مستويات عدّة، كلّ واحد فيها أعلى وأكثر ارتقاءً وتعقيدًا من الآخر، وكذلك الذّات بالنّسبة إليه، وهو الّذي كان يؤمن بالتّطوّر، رأى أنّ مقولة: "إنّ الوعي ناتج عن التّطوّر وآتي من الطّبيعة نفسها" قول منطقيّ.
فهذه المقولات ملك للعالم، وتعبّرعنه كما تعبّر عن الذّات العارفة للإنسان، لسبب بسيط: هو أنّ العالم موجود بمواضيعه من قبل الإنسان، وأنّ عقل الإنسان - نفسه - قد تطوّر ليستوعب العالم بمقولاته القديمة الّتي سبقت العقل نفسه إلى الظّهور، فالعالم كان راسخًا هناك بمقولاته الّتي هي قوانينه الخاصّة، قبل أن يتطوّر العقل ليستوعبها، وشلنج لا يرى أيّة إمكانيّة للتّعرف على العالم دون الذّات، ويعترف بالطّبيعة والعالم جملة، في تمييز واضح بين أن تكون الذّات خالقة العالم، وبين أن تكون خالقة عالمها، وهذا الأخير هو ما آمن به شلنج تمامًا.
لكنّ شلنج الّذي أوشك أن يكون ماديًّا بهذا الفكر، قد توقف عند هذه المرحلة ليتفرّغ لبناء تصوّره المثاليّ عن الذّات والعالم والمطلق، وهو موقف - وإن كان يشي ظاهريًّا بالتّناقض - لكنّه لم يكن كذلك أبدًا، لسبب بسيط؛ هو أنّ محاولة شلنج لم تكن مجرّد محاولة تلفيق بين شيئين لا يجتمعان، فنظرته إلى العقل - باعتباره خارجًا عن المادّة خلال عملية تطوريّة - أي أنّ قوانينه تطابق قوانين المادّة نفسها، لن تصل بنا بعد ذلك لاستبدال ثنائيّة الذّات والموضوع المتعارَف عليها في الفلسفة المثاليّة، وهي المعضلة الّتي سيخصَّص الجزء المتبقيّ من المقال نفسه لمحاولة حلّها.
لم يعد الأمر غريبًا الآن بعد نشأة علم النّفس التّطوريّ (Evolutionary psychology) الّذي بدأت أولى إرهاصاته في ستينات القرن الماضي، ومن روّاده ديفيد م. بوس (David M. Buss) وآخرين، ومع انتشاره واتّساع تأثيره، بدأ يرد الكثير من السّلوك البشريّ والظّاهرات النّفسيّة والنّفسجنسيّة، وكذلك الثّقافيّة أيضًا، إلى عمليّات تطوريّة صاحبت الإنسان عبر مئات الآلاف من السّنين، وكانت تدفع بعقل الإنسان للتّكيف مع بيئته المحيطة، وهو - لذلك - علم خارج من صلب نظريّة التّطوّر الدّاروينيّة الّتي لا يخفى استخدامها للمنهج المادّيّ التّجريبيّ على أحد، بينما يحاول اختصار الهوّة بين العلوم المادّيّة والعلوم الإنسانيّة بالبحث في ماهيّة الوعي الإنسانيّ ومصدره، لذلك؛ لم يكن غريبًا أن يتّخذ كتاب ديفيد بوس الضّخم "علم النّفس التّطوريّ" عنوانًا فرعيًّا، وهو "علم جديد للعقل"[8]
لأنّ النّظريّة المادّيّة في المعرفة ترى أنها قد تجاوزت النّظرة الأساسيّة للمثاليّة عبر توحيد الذّات والموضوع في كيان واحد هو المادّة؛ حيث ستكون "حوادث العالم هي الأوجه المختلفة للمادّة المتحرّكة" من جهة، ومن وجهة أخرى؛ هي "الواقع الأوّل وليست إحساساتنا وفكرنا سوى نتاج هذا الواقع"[9]، فإنّنا أمام فلسفة إضافة إلى أنّها تقدّم ميتافيزيقاها الخاصّة بها عند نقطة البداية، دافعة بأزليّة المادّة في مقابل الميتافيزيقا القائلة بوجود "خالق أول"، فليس لدينا تبرير منطقيّ يغلب أحدهما على الآخر، ويخرجه من حيز الميتافيزيقا - هذا على عكس الادّعاء الدّائم للمادّيّة، ثمّ تجد نفسها عند نقطة النّهاية مطالبة بتقديم تفسير لسؤال صعب من نوعيّة: "كيف تعبّر المادّة عن نفسها بقوانينها الخاصّة في دماغ الإنسان؟" ولِم تعبّر عن قوانينها تلك بهذه الكيفيّة الواضحة والمتطوّرة في دماغ الإنسان دونًا عن بقية الكائنات الحيّة، على الأقل تلك التي تمتلك جهازًا عصبيًا متطورًا؟ لذلك كلّه، لن يبق أمام النّظريّة المادّيّة للمعرفة لتستكمل مسيرتها في البقاء كونها نظريّة متربّعة على عرش فلسفة العلم، سوى أن تعترف بدخول آليّة التّطوّر ضمن تكوين الوعي البشريّ، وهو حقّ مشروع لها طالما استخدمته بالطّريقة المناسبة وغير المتناقضة، إذا ما عرضناها للنّقد المحايث؛ فهي - وإن فشلت في التّبرير التام لوجودها عند نقطة البداية - فإنّ من حقّها أن تدافع عن تبرير لها عند منعطف النّهاية، لكنها حين تلجأ إلى آليّة التّطوّر، تنجح - في النّهاية - في العثور على مبرّر قويّ، لكنّها، في مفارقة عجيبة، تضع نفسها في مأزق الاعتراف بأنّه لا توجد إمكانيّة لمعرفة أي موضوع دون ذات، فتتّفق مع المثاليّة في حجّتها الأساسيّة.
فطالما أن العقل ناتج من منتجات التطور البيولوجي؛ فلا بدّ أنّه تطوّر بالشّكل الّذي يجعله يتكيّف مع العالم المادّيّ المحيط ليس أكثر، يبدو أن هذا الفعل التّكيفيّ لا يستلزم - بالضّرورة - أن يكون معبّرًا عن حقيقة موضوعات العالم المحيط بالدّماغ المتكيَّف، كما يستلزم أن يكون الوعي متكيّفًا مع هذه الموضوعات، فالتّكيّف الّذي تقوم به الفيلة الآن لاستيلاد أجيالًا جديدة بلا أنياب عاجيّة، لا يتطلّب - بالضّرورة - أن تكون الفيلة نفسها على دراية بأن هذا الفعل سيحمي الأجيال القادمة من محاولات الصّيد غير القانونيّة، لكنّها - على العكس - لن تنتبه أبدًا إلى الآليّة الّتي تحدث رغمًا عنها، وستكون ذات أثر إيجابيّ على مستقبل نوعها، هذا يعني - بالضّرورة - أن يكون الوعي النّاتج عن عمليّة التّطوّر هذه ناقصًا، هذا لأنّه يتطلّب وعيًا متكيّفًا أكثر من كونه وعي حقيقيّ[10]، هذا الأمر لن يُدرَج في صفّ نقض نظريّة التّطوّر - كما سنرى - لكنّه سيكون مفيدًا في البحث عن فلسفة أكثر تماسكًا وأقل تناقضًا من الفلسفة المادّيّة.
لا يكون التّأمّل في طبيعة العلم المادّيّ وحده، لكن في منتجاته الضّخمة، وذلك كفيل بأن يحلّ تلك المعضلة الدّائريّة، فهذه الإنجازات التّكنولوجيّة الّتي يصعب حصرها، وتخضع في كلّ مرّة للفهم العلميّ عن قوانين المادّة، تثبت صحّة هذا الفهم بغير جدال، وإذا كنّا نريد أن نضحّي بالدّلائل المادّيّة الّتي تثبت التّطوّر البيولوجيّ بحجّة أنّ العقل المتطوّر تطوّرًا ناقصًا أنتج تلك الأدلّة، فعلينا أن نضحي - أيضًا - بيقينيّتنا بوجود السّيارة والحاسوب وجهاز الأشعّة السّينيّة، والقنابل الّتي تحتوي ذرات اليورانيوم المشعّة، والأجهزة الّتي تستخدم النّظائر المشعّة للتّأكّد من عمر الحفريات في العصور الجيولوجية المختلفة، تضحية من هذا القبيل بوجود المادّة لن تقودنا إلّا إلى خطل في الرّؤية كتلك التي أنتجها بيركلي الّتي سيصبح لزامًا عليها– أي تلك الرّؤية - أن تثبت أنّ الذّات العارفة خالقة لموضوعات العالم من العدم، أو أنّ هناك - على أقصى تقدير - أرواح فقط لا موادّ تتحرّك أمام حواسنا، روح للسّيارة وأخرى للحاسوب، وأخرى لجهاز التّحقّق من عمر الحفريّات، إذا هضمنا هذا التأمّل ونتائجه جيّدًا، فسوف ندرك أنّ العقل في تطوّره البيولوجيّ الطّويل انتقلت إليه دزينة لا بأس بها من القوانين الأوليّة المنظّمة للمادّة، وهي - على أقل تقدير - ستكون الزّمان والمكان والعلية، ولسنا في حاجة - الآن - إلى مراجعة الفكرة القائلة: "إنّ المثاليّة قد اختلفت تمامًا من بعد كانط، عن تلك الرّؤية الغريبة لبيركلي".
إذا كان كلّ الجدال السّابق قد نجح - حتّى الآن - في إثبات أنّ الفلسفة المادّيّة رغم تعنّتها الشّديد تجاه المثاليّة في قضيّتها الأساسيّة عن الذّات والموضوع، تجد نفسها - في نهاية المطاف - ملزمَة بالاعتراف بهذه القضية، يبدو - أيضًا - أنّ الّذي يحاول بعض الماديّين نقده، ليس كون الذّات خالقة عالمها، بمعنى أنه لا توجد إمكانيّة لمعرفة العالم من دون الذّات، مثلما ينتقدون مبدأً آخر غريبًا تمامًا عمّا نتحدّث عنه؛ هو أن تكون الذّات خالقة لمواضيعها من العدم، أو أنّه لا وجود لموضوع دون ذات[11]، اللّهم إلّا إذا أخذ المادّيّون جملة مجازيّة كتلك على محمل حرفيّ.
لذلك فأوجه الاختلاف - هنا - بين فلسفة تجمع في طيّاتها الحجّة الأساسيّة للمثاليّة والدّاروينيّة معًا من جهة، وبين المادّيّة من جهة أخرى، ستكون كالآتي:
أوّلًا: لا يمكننا نفي وجود عوالم أخرى غير المادّة بذلك الاطمئنان الّذي تذهب إليه الفلسفة المادّيّة، فطالما أنّ الوعي الّذي نتج عن التّطوّر هو وعي متكيّف أكثر من كونه وعيًا حقيقيًّا، فهذا الأمر سيشكّل حدود الذّات العارفة، ويجعلها مجبرة على الاعتراف بأنّها غير قادرة على التّعرف إلى أيّ شيء خارج هذه الحدود، بيد أنّه لا يمكننا إثبات هذه العوالم غير المادّيّة أيضًا، طالما أنّ هذا الأمر يمكث خارج إمكانيّات العقل البشريّ، ويتحدّث عن عوالم لا يمكن أن نراها، لذلك، فهذ القضيّة قضيّة لا إدريّة بامتياز، لا يمكننا الفصل فيها أبدًا، وهي شبيهة بالنّظرة الكانطيّة إلّا في اختلاف واحد مهمّ؛ هو أنّها لا تتّكأ على ميتافيزيقا بديلة كتلك الّتي أنشأها كانط على مسألة الجوهر "نيومينا"، ولا على أيّة ميتافيزيقا أخرى.
ثانيًا: في الوقت الّذي نرسم فيه حدودًا واضحة لإمكانيّة المعرفة، فإنّنا نكون قد وسّعنا حدود هذه المعرفة في جانب آخر أكثر أهميّة، وهو الجانب المتعلّق بفلسفة العلم، وبالرّغم من قصور الوعي باعتباره متكيّفًا أكثر من كونه وعيًّا حقيقيًّا، إلّا أنّ هناك جانب حقيقي في هذا الوعي لا يمكن إنكاره - كما أوضحنا سالفًا - وهي جملة المقولات الأوّليّة الّتي انتقلت من المادّة كونها بيئة محيطة تقوم بوظيفة الاصطفاء الطّبيعيّ إلى الوعي البشريّ، هذه المقولات الحقيقيّة تمامًا هي السّبب في كلّ ما نراه من إنجازات حقّقها العلم المادّيّ حتّى الآن؛ فهي أساس البرهان الرّياضيّ والتّجربة العمليّة، لكنّ ما يحدث - ولأوّل مرّة - أنّه حين نضع قضيّة هذه المقولات على مرآة الذّات والموضوع ونظريّة التّطوّر، سنخرج باحتمال عظيم الشّأن، هو الآتي:
طالما أنّ بعض قوانين الطّبيعة الأوليّة، كالمكان والزّمان والعليّة، قد انتقلت إلى وعينا المتطوّر وتسبّبت في كلّ معرفتنا عن الكون حتّى الآن، فهناك احتمال لقوانين أو مقولات أخرى تماثل هذه المقولات في بدائيتها وأصالتها، لنتخيّل كم من البراهين الرّياضيّة والتّجارب العمليّة الّتي لا نستطيع إنجازها الآن لكنّنا سنتمكن من إنجازها إذا ما اكتشفنا مثل هذه المقولات! (تلك الّتي لا نستطيع أن نتقوَّلهَا حتى الآن).
يبدو أن هذا الأمر الأخير مستحيل ظاهريًّا، كاستحالة تحقيق معرفة ميتافيزيقيّة خارج حدود الوعي الإنسانيّ، لولا فلسفة الكمّ والنّسبيّة الخاصّة الّتي تظهر في بعضها مناقضة للمقولات الأوليّة الأخرى؛ كالسببيّة، فهذا العالم (الميكروسكوبيّ) يبدو كأنّه يسير على قوانين بدائيّة وأصيلة، تختلف عن تلك الّتي للعالم الكبير (الماكروسكوبي)، والسّبب في ذلك بسيط جدًا إذا ما قرأناه على ضوء الفلسفة الّتي نتحدث عنها؛ هو أنّ الإنسان صاحب وعي تطوَّر عبر عصور طويلة من التّكيّف مع العالم الكبير هذا لا عالم الجسيمات تحت الذّريّة، لذا، فلم ينقل عالم الجسيمات متناهية الصّغر ذاك مقولاته إلى وعي الإنسان في عصور تطوّره البيولوجيّ.
لكنّ هناك أمر وحيد مبشّر وخطير جدًّا، هذا الخبر الجيّد هو الآتي: "البرهان الّذي استخدمناه للوصول إلى معادلات رياضيّة تتعارض مع السّببيّة الّتي هي قانون العالم الكبير، مبنيّ - أصلًا - على بديهيّات أصيلة انتقلت إلى وعي الإنسان في تطوّره مع العالم الكبير، كذلك - أيضًا - التّجارب الّتي أقيمت لإثبات القوانين الغريبة للجسيمات تحت الذّريّة، مبنيّة على نفس البديهيّات الأصيلة، هذا يعني؛ ربما بالإمكان الوصول لمقولات هذه العوالم (المادّيّة أيضًا) عبر قوانيننا الّتي تطوّرنا عليها وبها، ربّما يحتاج هذا الأمر - إن شئنا التّحقق منه - إلى بحث منفصل ومساحة منفصلة.
هذه القوانين الّتي سمّاها كانط ب "المقولات القبليّة"، لم تعد قبليّة أو غيبيّة مجهولة المصدر، لأنّنا بتنا الآن نعرف مصدرها، وهذه الذّات العارفة لا يمكننا الآن - على ضوء الداروينيّة - أن نمنحها وجودًا أنطولوجيًّا؛ بل سيكون وجودها هو نفسه (الوعي أو الذّهن أو العق)، أو أيًّا ما يكون، وهو مبنيّ على الدّماغ وغير منفصل عنها، لذلك؛ لن نجازف بالقول: "إنّ فلسفة كهذه ستكون بعيدة تمامًا عن الثّنائيّة المنهجيّة (Dualism) الّتي تفصل بين العقل والجسد".
لذلك كلّه، أصبح بإمكاننا إيجاد معبر بين المبدأ الأساسيّ في المثاليّة الألمانيّة والدّاروينيّة، هذا المعبر هو أكبر من مجرّد توفيق بين فلسفتين، إنّه ديالكتيك متحرّك بين الاثنتين؛ ففي الوقت الّذي تنقِّي فيه الدّاروينيّة المبدأ الأساسيّ للمثاليّة من ميتافيزيقاه العديدة، فإنّ هذا المبدأ الضّروريّ لكلّ فلسفة سيمنح الدّاروينيّة بعدًا اعمق، يؤهّلها لأن تكون فلسفة أعظم صلابة وأكثر مرونة، وقادرة - في الوقت ذاته - على أن تفتح حدودًا أكبر لفلسفة العلم.
[1] جارودي، روجيه: النّظريّة المادّيّة في المعرفة، تعريب: إبراهيم القط، دار دمشق، ط1، 10، كتب جارودي هذا الكتاب الّذي نال عنه جوائز مرموقة في مرحلة دفاعه عن المادّيّة، وقبل اعتناقه الدّين.
[2] لويس لافيل (Louis Lavelle): فيلسوف وجوديّ؛ حيث كان يضع روجيه جارودي الوجوديّين مع المثاليّين في سلّة واحدة.
[3] كانط، إيمانويل: نقد العقل المحض، ترجمة: موسى وهبة، مركز الإنماء القوميّ، ط 1، ص ص 83 - 114
[4] شوبنهاو أرثور، العالم إرادة وتمثّلًا، المركز القوميّ للتّرجمة، القاهرة، ط 1، ص ص 55 - 56. جارودي روجية، النّظريّة المادّيّة في المعرفة، دار دمشق، ط1، ص ص 7 - 10، نقلًا عن محاورات هيلاس وفيلونوس (1713) لبيشوب بيركلي.
[5] كانط إيمانويل، نقد العقل المحضّ، ترجمة: موسى وهبة، مركز الإنماء القوميّ، ط 1، ص ص 83 - 114
[6] كوامن ديفيد، داروين متردّدًا، ترجمة: مصطفى إبراهيم فهمي، الهيئة العامّة للكتاب، القاهرة، 2013م، ط 1، ص 25
[7] رويس جوزايا، محاضرات في المثاليّة الألمانيّة، ترجمة: أحمد الأنصاريّ، مراجعة: حسن حتفي، المركز القوميّ للتّرجمة، القاهرة، 2003م، ط 1، ص ص 100 - 101
[8] بوس ديفيد، علم النّفس التّطوريّ (علم جديد للعقل)، ترجمة: مصطفى حجازي، هيئة أبوظبي للثّقافة والتّراث (كلمة)، 2009
[9] جارودي روجيه، النّظريّة المادّيّة في المعرفة، دار دمشق، ط 1، ص 5
[10] راجع كتاب "أعظم استعراض فوق الأرض (أدلّة التّطوّر)" لتشارلز دكنز، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، ج 1، ط 1، ص ص 50 - 150
[11] جارودي روجيه، النّظريّة المادّيّة في المعرفة، دار دمشق، ط 1، ص 6
المصدر: http://www.mominoun.com/articles/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9...
