مسألة النَّوع الأدبي
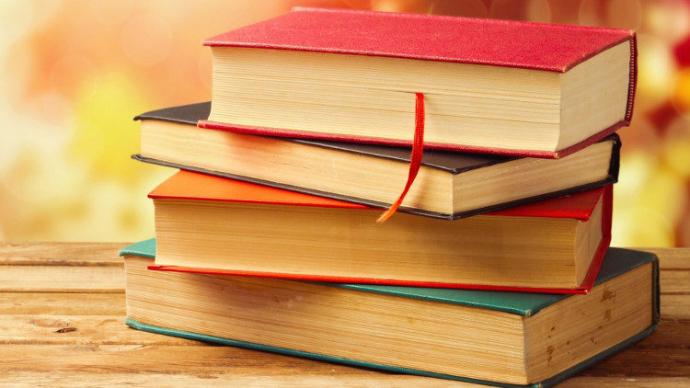
مصطفى الغرافي
1
لم يعد يخفى على أحد من المشتغلين بقضايا النص الأدبي مدى الأهمية القصوى التي تكتسيها “قضية الأنواع” في الدرس الأدبي الحديث، فقد أصبح من الواضح تماما أن كل كاتب إنما ينطلق، فيما يحاول من إبداع، من تصور عام لـ “قواعد النوع” الذي ينتج وفقه نصوصه. ووعي الكاتب بأنه يكتب نصا مندرجا، بالضرورة، ضمن نوع بعينه يقتضيه الخضوع لـ “تقاليد النوع” الذي يكتب وفق مقتضياته. لهذه الاعتبارات كان لزاما على الدارس الأدبي أن يعنى بتحديد “نوعية” النصوص التي يروم دراستها إن أراد بناء معرفة صحيحة بها. ولذلك رأينا أن نختص هذه الدراسة ببحث مسألة الأنواع محاولين استقصاء المسألة في الثقافة الغربية ثم العربية، فتوقفنا عند بعض القضايا التي قدرناها هامة بالنسبة لخطة البحث وغاياته، من قبيل النوع بين الإثبات والنفي ومعضلة التجنيس، والموقف من قضية الأنواع، والعلاقة بين الأثر الفردي والنوع الأدبي، ومشكلة التصنيف والنوع وجماعة التلقي وأصل الأنواع.
أسئلة النوع في التقليد الغربي:
تحرص معظم الدارسات التي انشغلت بقضية الأجناس على ربط نظرية الأجناس الأدبية بأصولها الإغريقية وخاصة أرسطو، الذي يعتبره الكثيرون المؤسس الحقيقي للنقد الأدبي؛ فهو أول مفكر ينشغل بقضايا النقد الأدبي ويعنى بتفصيل قواعده في كتابين شهيرين أفردهما لدراسة ظواهر الخطاب هما “فن الشعر” و”فن الخطابة”.
لقد اعتبر الكتاب الأول “كتابا خصص بكامله لنظرية الأدب”[i]. وهو في الوقت نفسه أهم ما كتب في الموضوع[ii]. ونظرا لأهمية الإسهامات الإغريقية في التأسيس لنظرية الأجناس وتأصيلها، فإنه لا تكاد تخلو دراسة حول الأجناس من الإشارة إليها سواء بالبسط والتعريف أو الرد والمناقضة، يقول صاحبا “نظرية الأدب” في الفصل الذي عقداه لـ “الأنواع الأدبية” من كتابهما “نظرية الأدب”: “إن مؤلفات أرسطو وهوراس هي مراجعنا الكلاسيكية لنظرية الأنواع”[iii].
تفصح هذه القولة عن التقدير الكبير الذي حظيت به الاجتهادات الأرسطية في الدراسات الحديثة فيما يتصل بقضية تجنيس الخطابات وتصنيفها، فقد شكلت مقررات أرسطو والشذرات الموجزة المأثورة عن أفلاطون وبعدهما هوراس الأصول الأولى لنظرية الأجناس، التي بلورتها الثقافة الغربية الحديثة. وهو ما لحظه شكري عياد في مقالته عن “مشكلة التصنيف في دراسة الأدب” حين استخلص أن التصنيفات الحديثة منذ عصر النهضة الأوربية إلى اليوم “ظلت تتحرك داخل الدائرة التي وضعها أرسطو”[iv].
من أهم القضايا التي عالجتها نظرية الأجناس في الغرب:
مسألة النوع بين النفي والإثبات:
يمكن اعتبار الدعوة إلى إلغاء الأنواع بمثابة رد فعل متطرف على دعوة أخرى متطرفة تثبت الأنواع وتقول بنقائها، وهي دعوى ترقى أصولها إلى أرسطو الذي وضع الأسس الأولى لنظرية الأجناس الخاصة بالشعر التمثيلي عند الإغريق عندما ميز المأساة من الملحمة والملهاة، وضبط لكل جنس من أجناس هذا الشعر الخصائص والأشكال. يقول الفيلسوف الاستاجيري في مفتتح الفصل الأول من كتابه “فن الشعر”: “حديثنا هذا في الشعر: حقيقته وأنواعه والطابع الخاص بكل منها، وطريقة تأليف الحكاية حتى يكون الأثر الشعري جميلا، ثم الأجزاء التي يتركب منها كل نوع: عددها وطبيعتها […] وفي هذا نسلك الترتيب الطبيعي فنبدأ بالمبادئ الأولى: الملحمة والمأساة بل والملهاة والديثرمبوس، وجل صناعة العزف بالناي والقيتارة، وهي كلها أنواع من المحاكاة في مجموعها لكنها فيما بينها تختلف على أنحاء ثلاثة: لأنها تحاكي إما بوسائل مختلفة، أو موضوعات متباينة، أو بأسلوب متمايز”[v]. وقد ظلت هذه التصورات الأجناسية التي فصل الفيلسوف في “شعريته” أصولا تأسيسية تلقفها منه المصنفون في نظرية الأجناس بعده، فرسموها معايير وضوابط معتمدة في تجنيس الخطابات وترتيبها ضمن أنظمة وصنافات أجناسية.
ينظر أصحاب هذا التصور إلى الأنواع بوصفها كائنات طبيعية قائمة فعليا ومستقلة عن بعضها استقلالا تاما، حيث كل نوع متميز بخصائص ومتعلقات تدمغه بسمات خاصة فتفرده عن غيره من الأنواع الأدبية، وليس يجوز لها، تبعا لهذا التصور، أن تتحاور أو تتفاعل لأن كل نوع يشكل قارة يمارس على أرضها “استقلاله الذاتي”، بحيث لا يحتاج أو لا يجوز له، بعبارة أصح، أن يستعير أي مقوم يعتبر من مقومات نوع آخر.
يرتد مبدأ “نقاء النوع” إلى أرسطوـ معجزة النقد اليوناني في فصله الحاد بين المأساة والملهاة، حيث تحول هذا الفصل إلى مبدأ أساس في النقد الكلاسي، “فالنظرية الكلاسيكية لا تؤمن فقط بأن نوعا يختلف عن نوع بالطبيعة والقيمة، بل تؤمن أيضا بأن هذه الأنواع يجب أن تبقى منفصلة ولا تسمح لها بالامتزاج، هذا هو المذهب الشهير بمذهب “نقاء الأنواع”[vi].
وهو ما ستثور عليه الحركة الرومانسية التي عرف عنها النزوع إلى التحرر من تنظيرات الكلاسكيين وقيودهم بما فيها مبدأ “نقاء النوع”، فقد هاجم فيكتور هيجو “مبدأ فصل الأنواع الذي يقضي بألا تجتمع في المسرحية الواحدة مشاهد الملهاة إلى جوار مشاهد المأساة. حجته في ذلك أن هذا المبدأ مصطنع لا وجود له في واقع الحياة التي كثيرا ما تتقلب بين الجد والهزل، وتنقلب معها مشاعر الناس في أمكنة ولحظات متجاورة ومتقاربة. وإذا كان هذا صحيحا في الحياة فلماذا تشترط المسرحية الكلاسيكية أن يطرد فيها لون واحد إن قاتما وإن مشرقا”[vii].
على الرغم من محاولات الرومانسيين هدم مبدأ النقاء الأنواعي، فإنهم لم يتحرروا من سلطة النوع بإطلاق، إذ ظلت المقولات الأنواعية مثل “الرواية” و”الشعر” و”الدراما” سائدة بمفهومها الكلاسي في تنظيراتهم للأدب كما في منجزاتهم، فقد ظل لامرتين “شاعرا” كما ظل هيجو “روائيا”، بما يفيد أن الدعوة الرومانسية لم تكن دعوة لإلغاء مفهوم النوع بإطلاق، ولكنها كانت دعوة لإلغاء أنواع بعينها بغرض التأسيس لأخرى جديدة. وهذا الموقف من الرومانسيين يتضمن، من حيث المبدأ، اعترافا بوجود حدود فاصلة بين الأنواع، وهو اعتراف يترتب عنه، استتباعا، القول بوجود الأنواع الأدبية.
رغم الأثر الإيجابي الذي تركته دعوة الرومانسيين في نسق التصور الكلاسي، فإنها لم تستطع القضاء على فكرة النوع لأن إلغاء النوع بإطلاق لم يكن من مقاصدهم، ومع ذلك فقد أسهمت مواقفهم المناهضة لفكرة “نقاء النوع” في التخفيف من سلطة النوع، حيث أصبح المزج بين الأنواع قانونا طبيعيا فيها أو يكاد.
وقد ظهرت بعد حركة الرومانسيين دعوات تبنت فهمهم لقضية الأنواع، وإن جاءت منطلقات أصحابها مباينة لتلك التي وجهت نظر الرومانسيين؛ فبعد أن ظلت الأنواع حية مستمرة لا تعدو التعديلات التي تطرأ عليها أن تكون تحولات داخلية فيها، أو تظهر أنواع جديدة مستقلة تولدت منها، فإن سؤال النوع سيعرف طرحا مغايرا في العصر الحالي على صعيدي المنجز الإبداعي والتنظير النقدي، فقد دعا تيار الرواية الجديدة إلى تكسير رتابة الرواية التقليدية، وتوجهت القصة القصيرة في بعض نماذجها نحو الشعر، كما وجدنا النقد يتحول مع بارت مثلا إلى “إبداع”. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد وجد من بين النقاد المعاصرين من يجهر بالدعوة إلى هدم فكرة الأنواع وإلغائها. ويعتبر بينيديتو كروتشه وموريس بلانشو ورولان بارت من الأسماء اللامعة في هذا “المعسكر”، الذي عرف عنه مناهضة فكرة الأنواع ومعاداتها.
يطرح الباحثون في قضية الأنواع اسم عالم الجمال الإيطالي بينيديتو كروتشه بوصفه واحدا من أبرز المناهضين لفكرة الأنواع المنادين بضرورة نفيها ووجوب إلغائها[viii] متعللا في ذلك بعدم جدواها، إذ ينعت البحث في علم جمال النوع الأدبي بأنه لا يعدو أن يكون تعلقا من نقاد الأدب بمشكلات زائفة[ix] ما دامت القوائم التصنيفية التي ينتجها القائمون على هذا النوع من الدرس تبقى، فيما يقدر كروتشه، غير ذات جدوى، لأن وكد القائمين بها لا ينصرف إلى إبراز جمال الأثر أو قبحه، ولكنه منصرف بالأساس إلى المطابقة بين الأثر وقواعد النوع الذي يرتقي إليه[x]. ومن هنا فقد نعت نظرية الأنواع الأدبية بـ “التظرية الخاطئة”[xi].
ينطلق كروتشه، في دعوته إلى إلغاء النوع، من مبدأ الحدس واستقلالية الأثر[xii]، إذ الآثار، في تصوره، ناتج وعي فردي، ولذلك فهي لا تجسد سوى حالة مبدعها التي هي حالة نفسية خاصة ومتفردة تصدر مباشرة عن الحدس بشكل عفوي وتلقائي من دون تفكير مسبق في القواعد والأصول. وهو ما يترتب عنه استقلال الأثر بنفسه وتحرره من كل قانون أو قاعدة. يقول:”وقولنا إن الفن حدس يستبعد أن يكون الفن وسيلة لإيجاد صنوف ونماذج وأنواع وأجناس”[xiii]. وبهذا الاعتبار يكون الأثر تعبيرا عن تجربة فردية أصيلة وخاصة لا تقبل التصنيف[xiv]. فالمبدع، بمقتضى هذا الفهم، ليس يعبر إلا عن حالات فردية أما الأشكال التي يتخذها هذا التعبير فمن صنع النقاد. تأسيسا على هذا الفهم الذي لا يعترف، أمام الفرادة التعبيرية لكل أثر فني، إلا بالحدس (أو الفن) “نوعا أدبيا”[xv] صدع كروتشه بدعوته المناهضة لكل تقسيم أنواعي. يقول مخاطبا نقاد الأدب الذين يثبتون الأنواع ويدافعون عن وجودها واستمرارها: “ليس هناك سلسلة من الأجناس أو الأنواع. ليس بالفنان الذي يبدع الفن، أو بالمتأمل الذي يتذوق الفن، من حاجة إلى شيء آخر غير الكلي والفردي، أو قل بتعبير أصح الكلي المتفرد؛ أي النشاط الفني الكلي الذي تلخص وتركز بكامله في تصور حالة نفسية فردة”[xvi].
غير أن تدبر آراء كروتشة المعلنة إزاء فكرة الأنواع في نسقيتها يكشف أن موقفه مفتقد للصرامة والتماسك، فالدارس لا يعدم في كتابه عبارات واشية بالشك والارتياب في إمكانية الإلغاء التام لفكرة الأنواع، بل إنه لا يلبث أن يقرر أن نظرية الأنواع منطوية على فائدة لا تنكر وهو صريح قوله:
“على أننا نعترف أنه إذا كان الفنان المحض والناقد المحض، والفيلسوف المحض في الوقت نفسه لا يلتقون عند الأنواع أو الأصناف، فإن لهذه الأنواع أو الأصناف فائدتها من بعض الوجوه الأخرى. وهذا هو جانب الصواب الذي لا أحب أن أغفل ذكره في هذه النظريات الخاطئة. فمما لا شك فيه أن من المفيد أن ننسج شبكة من التصنيفات، لا من أجل الإنتاج الفني، فالإنتاج الفني عفوي وتلقائي، ولا من أجل الحكم على آثار الفن، فهذا الحكم حكم فلسفي، وإنما من قبيل الحصر للحدوس الخاصة التي لا حصر لها، ومن قبيل الإحصاء للآثار الفنية الخاصة التي لا تحصى. وذلك كوسيلة عملية تفيد الانتباه وتفيد الذاكرة[…]إن هذه الأنواع والأصناف تسهل معرفة الفن وتيسر التربية الفنية، فهي في المعرفة أشبه بثبت تذكر فيه أهم الآثار الفنية، وهي في التربية مجموعة من النصائح الضرورية التي توحي بها الخبرة الفنية”[xvii].
يشكل متصورا “النص” و”الكتابة”، اللذين يتخذان عند بارت معنى خاصا، المدخل الأساس الذي ينفذ منه هذا الناقد الأدبي للدعوة إلى نفي الأنواع وإلغائها، فالنص، عنده، ليس واحدا ولكنه “تعددي”. والتعدد هنا لا يرتبط بالكثرة، كثرة المعاني التي يمكن للنص أن يدل عليها، ولكنه متعلق بعدم دلالة النص على معنى محدد، لأن النص، في تصور بارت، سليل نصوص وقراءات يتحول النص معها إلى “تعدد” و”كثرة”، نقطة التقائهما القارئ وليس المؤلف. وهو صريح قول بارت: “النص يتألف من كتابات متعددة تنحدر من ثقافات عديدة تدخل في حوار مع بعضها البعض، وتتحاكى وتتعارض، بيد أن هناك نقطة يجتمع عندها هذا التعدد، وليست هذه النقطة هي المؤلف، كما دأبنا على القول، وإنما هي القارئ”[xviii].
إن النص، وفق هذا التصور، زمرة من النصوص أو “الاقتباسات” يضم المؤلف بعضها إلى بعض لكي تشكل “كلا” أجزاؤه غير قابلة للتوثيق، “والقارئ هو الفضاء الذي ترتسم فيه كل الاقتباسات التي تتألف منها الكتابة دون أن يضيع أي منها أو يلحقه التلف”.[xix] ولذلك تحدث بارت عما أسماه “موت المؤلف” باعتباره الثمن الذي ندفعه لميلاد قارئ[xx].
أما الكتابة فتتحدد، عند بارت، بوصفها “خلخلة”. يقول: “الكتابة لا تتوخى شيئا من ورائها، فعل الكتابة لازم وليس متعديا على الأقل بالمعنى الذي نستخدمه نحن، لأن الكتابة عندنا خلخلة والخلخلة لا تتعدى ذاتها، وإن أبسط صورة على الخلخلة هي العملية الجنسية التي لا تنجب، بهذا المعنى لا تتعدى الكتابة نفسها، إنها لا تنجب ولا تولد منتوجا، الكتابة خلخلة لأنها تتحدد كمتعة”[xxi].
يظهر من هذا الشاهد أن الكتابة، حسبما يفهم بارت، ليس لها من غاية سوى ذاتها، ولذلك فهي تتعالى على كل تراتب تصنيفي، لأنها لا تنجب غير النصوص، والنصوص لا تقبل التصنيف، إذ مجرد حضور هذا الإجراء يلغي الأنواع الأدبية، يقول بارت: “بمجرد أن نخوض ممارسة الكتابة فإننا سرعان ما نكون خارج الأدب بالمعنى البرجوازي للكلمة، هذا ما أدعوه نصا، وأعني به ممارسة تهدف إلى خلخلة الأجناس الأدبية: في النص لا نتعرف على شكل الرواية أو شكل الشعر أو شكل المحاولة النقدية”[xxii].
انطلاقا من هذا الفهم لمتصوري “النص” و”الكتابة” يقرر بارت عدم قابلية النص للدخول ضمن تراتب أنواعي: ” إن النص لا ينحصر في الأدب الجيد، إنه لا يدخل ضمن تراتب، ولا حتى ضمن مجرد تقسيم للأجناس، وما يحدده على العكس من ذلك هو قدرته على خلخلة التصنيفات القديمة”[xxiii].
يعتبر موريس بلانشو من أبرز المناهضين، في النقد الحديث، لـ “فكرة النوع” نفسها، ذلك أن الأدب، عنده، لا يتحقق إلا إذا “انتفى” و”تبعثر”، بما يعني أن وجود الأدب إنما هو في عدمه، حيث لا يمكن معرفته ولا التعرف عليه:
“لا يكون الأدب حقل الترابط المنطقي والمجال المشترك إلا ما دام غير موجود، غير موجود كأدب، غير موجود لنفسه إلا إذا بقي مستترا، فهو حالما يظهر الشعور البعيد بما يكون، يتبدد ويسلك سبيل التبعثر، حيث لا يمكننا معرفته والتعرف عليه بعلامات واضحة”[xxiv].
إن الكتابة، عند بلانشو، تتحدد بوصفها “تمردا” لا يخضع لأي سلطة أو قانون، بما فيها سلطة النقد وقانون النوع. وفعل الكتابة، في ضيقه بالقيود ورفضه القوانين، يشبه الدخول إلى معبد لا بنية الخضوع لتعاليمه ولكن بغرض هدمه:
“إذا كانت الكتابة هي الولوج لمعبد يفرض علينا، بغض النظر عن اللغة التي هي ملكنا بحق الإرث وبحتمية عضوية، قدرا من العادات وإيمانا ضمنيا وإشاعة تحول مسبقا كل ما يمكن أن نقوله ونحمله بنوايا تكبر فعاليتها بقدر ما يعترف بها. الكتابة أولا رغبة في هدم المعبد قبل بنائه، هي على الأقل التساؤل، قبل تخطي العتبة، حول القيود والأعباء التي يفرضها هذا المكان”[xxv] . وبهدم المعبد يتخلص الكاتب من القيود ويستعيد حريته، وفي تلك اللحظة فقط يصل الأدب إلى “نقطة الغياب” حيث تكمن “نقطة الصفر للكتابة”:
“أن نكتب بدون “الكتابة” أو نوصل الأدب إلى “نقطة الغياب”، حيث تكمن “نقطة الصفر للكتابة”، حيث لا نعود نخشى أسراره التي هي أكاذيب، هنا تكمن “نقطة الصفر للكتابة”[xxvi]. من الواضح أن بلانشو يستعيد في هذا الشاهد بارت الباحث عن “درجة الصفر في الكتابة”، والمناهض، هو الآخر، لفكرة الأنواع.
لقد دعا بلانشو الكتاب بكثير من الحماس إلى الإفلات من جميع القيود وعلى رأسها “قيود النوع”. ذلك صريح قوله:
“حالما ندرك أن الكتابة الأدبية، الأنواع، العلامات، استعمال الماضي، والضمير الغائب، ليست فقط شكلا شفافا، ولكن عالما مستقبلا تسود فيه المعبودات وتهجع الأحكام المسبقة، وتعيش غير مرئية القوى التي تحرق كل شيء، يكون من الضروري على كل منا أن يحاول الانفلات من هذا العالم فهو إغراء لنا جميعا بتخريبه”[xxvii].
ويرى بلانشو أن الكتابة لا تكون جيدة إلا إذا كانت “اعتباطية” وتتحقق خارج الأنواع والقواعد، لأن ذلك يمكن من استيعاب التجارب المتعددة، فالأدب عنده “متروك أكثر لاعتباطية […] خارج الأنواع والقواعد والتقاليد، يصبح الأدب المجال الفسيح للتجارب العديدة المضطربة”[xxviii].
وبالرغم من جهر بلانشو بالدعوة إلى إلغاء الأنواع فإنه لم يستطع التحرر، في كتاباته النقدية، من التفكير بوساطة النوع بشكل مطلق. وهو ما تنبه إليه تودوروف فسجله في مساق اعتراضه على تصورات بلانشو المناهضة لفكرة انتظام النصوص في أجناس وأنواع:
“لدى قراءة كتابات بلانشو نفسها التي يتأكد فيها ذلك الغياب للأجناس، نقع في العمل على زمر يصعب إنكار وجه الشبه بينها وبين تمايزات الأنواع، وهكذا نرى فصلا من كتاب المستقبل مخصصا للمذكرات الشخصية، وآخر للكلام التنبؤي، وفي معرض الكلام عن بروخ نفسه (الذي لم يعد يحتمل التمييز بين الأجناس)، يقول لنا بلانشو إنه “يركن إلى أنماط القول كافة –السردية والغنائية والمقالية- وأهم من ذلك أن كتابه بكامله يركز على التمييز بين اثنين قد لا يكونان من الأجناس، بل من الأنماط الأساسية هما القصة والرواية. فتتميز الأولى بالبحث العنيد عن مكان أصلها الخاص الذي تمحوه الأخرى وتخفيه، إذن ليست الأجناس هي التي توارت، بل هي أجناس الماضي، فاستبدلت بأخرى، فلم يعد الكلام يدور على الشعر والنثر وعلى البنية والتخييل، بل على الرواية والقصة، على السردي والمقالي، على الحوار وعلى الصحيفة”[xxix]. لعل في هذا الرد الحصيف من تودوروف ما يكشف بجلاء أن الدعوة لإلغاء النوع في صورتها عند بلا نشو، على الأقل، ليست قائمة، بحال، على أساس مكين.
في مقابل هذه الدعوات الصادعة بضرورة نبذ النوع والتخلي عن فكرة تصنيف النصوص في مراتب أنواعية، انبرت أصوات نقدية لها مكانتها وإسهاماتها في النظرية النقدية الحديثة مدافعة عن وجود الأنواع وداعية إلى بقائها واستمرارها. وقد أدخلها هذا الموقف في سجال مع معسكر النقاد المناهضين لفكرة الأنواع. من هؤلاء ميخائيل باختين وجيرار جونيت وتزيفتان تودوروف.
لعل الأول أن يكون أبرز المثبتين لفكرة النوع المعتقدين فيها إجراء تصنيفيا ومنهجيا ضروريا لإنتاج فهم متعمق بالظاهرة الأدبية، فقد شكلت “الأنواع”، بالنسبة إليه، “مفهوما مفتاحيا للتاريخ الأدبي”[xxx]. ولما كانت الأنواع “شاغلا متصلا من شواغل الفكر الباختيني” [xxxi] فقد بلور في أعماله المختلفة، خاصة في ضوء قراءة تودوروف، نظرية أجناسية متكاملة استنادا إلى مفهومه عن “الملفوظ”[xxxii].
لقد قرر باختين بعد تفكير متعمق في المسألة نظرا وتطبيقا أن “الشعريات ينبغي أن تبدأ بالنوع”[xxxiii]، وانطلاقا من هذا الوعي بالأهمية القصوى التي يكتمنها مفهوم النوع الأدبي في تأسيس المعرفة الأدبية وتطويرها، نعى باختين على مؤرخي الأدب نظرتهم السطحية التي وجهتهم إلى إغفال مبحث الأنواع، التي يعتبرها “الشخصيات الرئيسية الأولى”، والتوجه بدلا من ذلك إلى معالجة جوانب من الأدب يراها جزئية وأقل أهمية مثل “الاتجاهات” و”المدارس”. يقول: “لا يرى مؤرخو الأدب، فيما يتعدى الإثارة السطحية ورشاش اللون، المصائر العظيمة والجوهرية للأدب واللغة، التي تعد الأنواع الشخصيات الرئيسية الأولى فيها، بينما تعد الاتجاهات والمدارس شخصيات أقل أهمية[xxxiv].
ويذهب باختين بعيدا بقناعته في التلازم العضوي بين “الأجناسية” و”الأدبية” بل و”الخطابية” (بالكسر) عامة حيث يقرر في ضوء نظريته في الملفوظ أن الأجناسية ملازمة لكل الخطابات، بما فيها الخطاب اليومي والعادي. وهو طرح متقدم يجعل فكرة النوع لا تنحصر في الأدب وإنما تغوص عميقا في الواقع اللغوي، فتطول حتى جذر الاستخدام اليومي للغة، كما يمكن أن نتبين بوضوح من قوله:
“السؤال والتعجب والأمر والطلب هي جميعا من أكثر التلفظات اليومية المكتملة […] في ثرثرة الصالونات، القليلة الأهمية والتي لا يكون لها تبعات، حيث يشعر كل امرئ أنه في بيته. وحيث يكون التمييز و(الفصل) بين الحضور (أولئك الذين ندعوهم “الجمهور”) قائما على التمييز بن الرجال والنساء – في مثل هذا الموقف يتحقق شكل محدد من أشكال الاكتمال النوعي[…] هنا نمط آخر من أنماط الاكتمال النوعي يتحقق في حديث الزوج أو الزوجة، وحديث الأخ والأخت […] إن كل وضع يومي مستقر يتضمن جمهورا منظما بطريقة خاصة، ومن ثم فهو يضم مستودعا محددا وأكيدا من الأنواع اليومية الصغيرة”[xxxv].
وبذلك تكون نظرية الأجناس قد انعتقت، مع اجتهادات باختين، من ربقة “الأدب” لتشمل مختلف أجناس الخطاب دونما إنكار بالطبع لمكامن الخصوصية في هذا النوع أو ذاك، إذ يبقى “لكل نوع منهجه وطرائقه لرؤية الواقع وفهمه، وهذا المنهج وهذه الطرائق هي خصيصته الحصرية”[xxxvi].
ويقول جيرار جونيت مفندا مزاعم كروتشه حول خطأ النظرة الأنواعية إلى الأدب:
“ورغم ما زعمه كروتشي وغيره حول خطأ النظرة الجنسية إلى الأدب، إلا أن حالة التعالي حاضرة فيه باستمرار، ولكي يبطل هذا الاعتراض نذكر بأن عددا من الآثار الأدبية منذ الإلياذة خضعت لمفهوم الأجناس، فيما تخلصت منه آثار أخرى، مثل الكوميديا الإلهية، وأن مجرد المقابلة بين المجموعتين يشكل نظاما للأجناس، ونستطيع أن نقول بطريقة أبسط أن المزج بين الأجناس أو الاستخفاف بها يمثل في حد ذاته جنسا من الأجناس. ولا يمكن أن يفلت أحد من هذا التشكيل البسيط”[xxxvii].
أما تودوروف فقد ضمن كتابه “مدخل إلى الأدب العجائبي” ردودا على اثنين من أبرز المنادين بنفي الأنواع وإلغائها هما كروتشه وموريس بلانشو، يقول في رده على دعوة كروتشه إلى اطراح مفهوم الجنس الأدبي:
“يستحيل اطراح مفهوم الجنس مثلما دعا إلى ذلك كروشيه مثلا فهذا الاطراح يستتبع ارتدادا عن اللغة، ولا يمكنه أن يكون مصوغا بالتحديد، بينما المهم بالمقابل هو الوعي بدرجة التجريد المضطلع به، وبوضع هذا التجريد أمام التطور الفعلي، فهذا الأخير ينوجد منخرطا بهذه الطريقة في نظام مقولات أو أقسام يؤسسه ويرتهن به في الآن نفسه”[xxxviii].
كما أورد تودوروف شاهدا اقتطعه من مؤلف “الكتاب الآتي” يظهر بلانشو زاهدا في قسمة الأدب إلى أجناس وأنواع حيث يعلن:
“وحده الكتاب مهم كما هو: بعيدا عن الأجناس خارج خانات النثر والشعر والرواية والشهادة التي يأبى أن ينتظم تحتها، والتي يدين سلطتها في أن تثبت له مكانه وتحدد شكله، لم يعد كتاب ينتمي إلى جنس، كل كتاب يرجع إلى الأدب الواحد كما لو كان هذا الأخير يحجز مسبقا الأسرار والصيغ، التي وحدها في عمومها تسمح بأن تعطي لما يكتب حقيقة كونه كتابا”[xxxix].
وقد عقب تودوروف على هذه القولة لموريس بلانشو بما يثبت ضرورة وجود الأنظمة الأنواعية فهي “المعيار المحسوس”، الذي باطراحه تنتفي كل إمكانية “للخرق”. كما شكك تودوروف في زعم البعض أن الأدب المعاصر قد تخلص مطلقا من قبضة النوع. يقول:
“فلكي يكون ثمة خرق يجب أن يكون المعيار محسوسا، والمشكوك فيه بأي حال هو أن يكون الأدب المعاصر قد تخلص مطلقا من التفريقات الجنسية […] إن عدم الإقرار بوجود الأجناس يرادف الادعاء بأن الأثر الأدبي لا يرتبط مع الآثار الموجودة سابقا، فالأجناس هي تحديدا هذه الخيوط التي بها يكون الأثر في علاقة مع كون الأدب”[xl].
إذا كانت الدعوة إلى إلغاء الأنواع واجدة في الواقع الأدبي ما يدعمها ويرجحها، فإن ترتيب النصوص في أنظمة أنواعية كبرى يبقى مطلبا قائما وملحا، ليس يعدم من يتحمس له ويدافع عنه منذ أفلاطون إلى يوم الناس هذا، حيث ترسخ الاعتقاد بوجود الأنواع إلى درجة الإيمان بها “حاجة أدبية” و”ضرورة نقدية” قيامها واستمرارها لا ينبغي أن يكونا موضع شك أو محل طعن وجدل
معضلة التجنيس:
يطرح تصنيف النصوص الأدبية إلى أجناس وأنماط إشكالا حقيقيا يرتفع إلى مستوى “المعضلة”، وقد عبر غير واحد من الدارسين عن هذه المشكلة التي تواجه المشتغلين بالأدب عامة وبنظريته خاصة، من هؤلاء جيرار جونيت الذي عرض لهذا الإشكال في كتابه “مدخل لجامع النص”، حيث انتهى من تقليب النظر في هذه المسألة إلى أنه بالرغم من الاجتهادات العديدة المطروحة داخل نظرية الأجناس، فإنه لا يوجد من بين هذه “الاجتهادات” موقف، في ترتيب الأنواع، “أكثر طبيعية” أو “مثالية” من غيره، ذلك صريح قوله:
“نرى أنه لا يوجد بشأن ترتيب الأنواع الأدبية موقف يكون في جوهره أكثر “طبيعية” أو أكثر “مثالية” من غيره، ولن يتوافر هذا الموقف إلا إذا أهملنا المعايير الأدبية نفسها كما كان يفعل القدماء ضمنيا بشأن الموقف الصيغي. لا يوجد مستوى “جنسي” يمكن اعتماده كأعلى “نظريا” من غيره، أو يمكن الوصول إليه بطريقة “استنباطية” أعلى من غيرها، فجميع الأنواع أو الأجناس الصغرى والأجناس الكبرى لا تعدو أن تكون طبقات تجريبية، وضعت بناء على معاينة المعطى التاريخي، وفي أقصى الحالات عن طريق التقدير الاستقرائي انطلاقا من المعطى نفسه؛ أي عن طريق حركة استنباطية قائمة هي نفسها على حركة أولية استقرائية وتحليلية أيضا. ولقد رأينا بوضوح هذه الحركة في الجداول (الحقيقية أو القابلة للوجود) التي وضعها أرسطو وفراي، حيث ساعد وجود خانة فارغة (السرد الهزلي، السرد العقلاني، المنفتح) على اكتشاف جنس كان بالإمكان ألا يدرك مثل المحاكاة الساخرة”[xli].
من الواضح تماما أن نظرية الأنواع تصطدم في مباشرتها التجنيس والتصنيف بمعضلات عدة. وقد أثرت هذه “المعضلات” على كفاية الأنظمة المعتمدة في تصنيف نصوص الأدب، إذ بقيت قاصرة، بسبب هذه المعضلات، عن تحقيق الدقة والشمول اللذين ميزا أنظمة التصنيف في مجالات علمية عديدة كما هي الحال في البيولوجيا مثلا.
وإذا كانت عملية التصنيف، رغم ما يحف بها من صعاب، ممكنة في نطاق حقبة محددة، فإن المعضلة الحقيقية تظهر عندما يتصدى الدارس لتجميع أنواع ظهرت في حقب تاريخية مختلفة، إذ من الثابت المعلوم أن الأنواع تتغير من حقبة لأخرى تبعا لتغير الأنساق الاجتماعية والتاريخية التي تحف إنتاجها وتلقيها. وهو ما تفطن إليه توماشوفسكي وقرره بالقول: “لا يمكن إقامة أي تصنيف منطقي وصارم للأنواع. فالتمييز بينها هو دائما تمييز تاريخي، بمعنى أنه مبرر فقط خلال مدة زمنية معينة، فضلا على أن ذاك التمييز يصاغ في الوقت نفسه من ملامح متعددة، وملامح نوع يمكن أن تكون طبيعتها مختلفة كل الاختلاف عن طبيعة ملامح نوع آخر، في نفس الوقت تبقى تلك الملامح متساوقة فيما بينها نظرا لأن توزيعها لا يخضع إلا للقوانين الداخلية للتركيب الجمالي”[xlii].
لهذه الاعتبارات مجتمعة صدع توماشو فسكي بأن “تصنيف الأنواع هو عمل معقد، فالأعمال الأدبية موزعة في طبقات شاسعة تتمايز بدورها إلى أنماط وأصناف. في هذا الاتجاه سنذهب نزولا في سلم الأنواع من الطبقات المجردة إلى الفروقات التاريخية الملموسة […] وحتى إلى الأعمال الأدبية المفردة”[xliii].
نستخلص مما سبق أن قضية تجنيس النصوص وتصنيفها من أعقد المعضلات التي يمكن أن تواجه المشتغلين بنظرية الأدب، بالنظر إلى ما يكتنفها من غموض والتباس جعلا منها “قضية خلافية”، رغم الاهتمام الكبير الذي حازته هذه القضية في الدراسات النقدية قديمها وحديثها. يقول ماري شافر: “من بين كل المجالات التي تخوض فيها النظرية الأدبية يعتبر مجال الأجناس، دون شك، واحدا من أشدها التباسا”[xliv].
ويمكن لهذا الالتباس الذي يطيف بمتصور “الجنس الأدبي” أن يرتد إلى عوامل ثلاثة أساس: يتصل الأول بالعلاقة الجدلية بين الجنس والنص؛ فإذا كان تجنيس النصوص إنما يتحقق بفحص الآثار الأدبية المفردة لاكتشاف قاعدة تشتغل عبر عدة نصوص[xlv]، فإن الأثر الفردي لا يتشكل إلا من خلال الشروط التي يحددها الجنس. وهو ما يجعل العلاقة بين النص والجنس علاقة جدلية تتجه فيها الحركة من الأثر إلى الجنس، ومن الجنس إلى الأثر، لأن تحديد الجنس رهين بالنص، وتشكل النص متوقف على الجنس.
*******
[i] – تودوروف: الشعرية، تر. رجاء بنسلامة وشكري المبخوت، دار توبقال ،1987. ص: 12.
[ii] – نفسه، ص: 12.
[iii] – رينيه ويليك وأوستن وارين: نظرية الأدب، ترجمة: محيي الدين صبحي مراجعة حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1987ص: 2388.
[iv] – شكري عياد: مشكلة التصنيف في دراسة الأدب، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، ع 42 – 1993 ص: 113.
[v] – أرسطو: فن الشعر، ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه، عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة – بيروت 1973.صص: 3- 4
[vi] – رينيه ويليك وأوستن وارين: نظرية الأدب، ، ص: 246.
[vii] – محمد مندور: الأدب وفنونه، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة (د.ت) صص: 85-86.
[viii] -” لقد شن بينيديتو كروتشه في الاستيطيقا هجوما على المفهوم [الأنواع الأدبية] لم تقم بعده له قائمة رغم المحاولات العديدة التي جرت للدفاع عنه أو لإعادة صياغته بشكل مختلف”- رينيه ويليك، مفاهيم نقدية ، تر. محمد عصفور، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع. 110 ـ 1987، ص: 311.
[ix] – انظر كارل فيتور، تاريخ الأجناس الأدبية ضمن نظرية الأجناس الأدبية، ترجمة: عبد العزيز شبيل، ص: 19.
[x] – ب . كروتشه، المجمل في فلسفة الفن، ، تر. سامي الدروبي، الأوابد – دمشق، ط 2 – 1964 ص:81
[xi] – نفسه ص: 80
[xii]– نفسه ص: 69
[xiii] – نفسه ص: 41
[xiv] – نفسه ص: 87
[xv] – “إن كل نظرية متصلة بتقسيم الفنون غير ذات أساس، فالنوع والصنف هما في هذه الحالة، شيء واحد هو الفن نفسه أو الحدس”- كروتشه، المجمل في فلسفة الفن، ص: 855 .
[xvi] – كروتشه، المجمل في فلسفة الفن ، ص: 85 .
[xvii] – نفسه ، صص: 85 – 86
[xviii] – رولان بارت: “موت المؤلف” ضمن درس السميولوجيا، تر. عبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر- البيضاء 1993، ص: 877.
[xix] – نفسه، ص: 87.
[xx] – نفسه، ص: 87.
[xxi] – رولان بارت: “في الأدب” ضمن درس السميولوجيا، ص: 48.
[xxii] – نفسه، ص: 48.
[xxiii] – رولان بارت: “من الأثر الأدبي إلى النص” ضمن درس السميولوجيا، ص: 61.
[xxiv] – موريس بلانشو: أسئلة الكتابة، ترجمة: نعيمة بنعبد العالي وعبد السلام بنعبد العالي، دار توبقال للنشر، ط 1، 2004، ص: 344.
[xxv] – نفسه، ص: 40.
[xxvi] – نفسه ، ص: 41.
[xxvii] – نفسه، ص: 41.
[xxviii] – نفسه، ص: 35.
[xxix] – تودوروف: أصل الأجناس، ضمن مفهوم الأدب، ترجمة: عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 2002، ص: 222.
[xxx] – تودوروف، ميخائيل باختين: المبدأ الحواري، ترجمة: فخري صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 2، 1996، ص: 1533.
[xxxi] – نفسه، ص: 153.
[xxxii] – يقول باختين في تحديده العام للنوع: “النوع يعرف بموضوع التلفظ وغايته والوضعية الخاصة به “- المبدأ الحواري (ص:1599)، ومن أهم الأعمال التي أفادت –عربيا- من شعرية باختين الأجناسية المستندة إلى نظرية التلفظ أبحاث صالح بن رمضان الذي أقر بالفوائد الجمة التي يجنيها دارس الأدب العربي من تشغيل مقولة التلفظ. يقول في مقدمة أطروحته: “لعل أهم مقولة تم استغلالها في هذا المضمار [تصنيف الخطابات عامة والأدبية خاصة] هي مقولة التلفظ”- الرسائل الأدبية (ص: 8).
كما أفاد فرج بن رمضان من اجتهادات باختين في تسويغ أطروحته المركزية المتعلقة بقابلية الأدب العربي القديم للتجنيس كسائر الآداب في كل عصر ومصر، يقول محاججا ومساجلا: “فإذا كانت اللغة العربية قد قبلت، دون إشكال التحليل والدراسة في ضوء مكاسب اللسانيات الحديثة (والملفوظ الباخيتني مفهوم لساني بالأساس) ثم إذا كانت عموم الخطابات بما فيها مفهوم الملفوظ هذا مهما كان المستعمل واعيا به أو لم يكن، فأحرى بالأدب العربي القديم أن يخضع للتحليل والدراسة في ضوء نظرية الأجناس الحديثة، إذا سلمنا بأن الجنس إن هو إلا صيغة خاصة من الملفوظ” –الأدب العربي القديم ونظرية الأجناس- القصص (ص: 25).
[xxxiii] – تودوروف، مخائيل باختين: المبدأ الحواري، ص: 153.
[xxxiv] – نفسه ص: 154.
[xxxv] – نفسه ، ص: 155.
[xxxvi] – نفسه، ص: 158.
[xxxvii] – جيرار جونيت: مدخل لجامع النص، ترجمة: عبد الرحمان أيوب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط 1، 1985، ص: 922.
[xxxviii] – تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة الصديق بوعلام، دار الكلام، الرباط، الطبعة1، 1993ص: 31.
[xxxix] – نفسه، ص: 31.
[xl] – نفسه، ص: 31.
[xli] – جيرار جونيت: مدخل لجامع النص، ترجمة: عبد الرحمان أيوب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط 1، 1985، ص: 766.
[xlii] – توماشو فسكي: “نظرية الأغراض” ضمن “نظرية المنهج الشكلي”، نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة: إبراهيم الخطيب، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، مؤسسة الأبحاث العربية، ط 1، 1982، ص: 2177.
[xliii] – نفسه ، ص: 219.
[xliv] جان ماري شافر: من النص إلى الجنس ضمن “نظرية الأجناس الأدبية”، تعريب عبد العزيز شبيل، مراجعة حمادي صمود، كتاب النادي الأدبي الثقافي بجدة، ط 1، 1994، ص: 1300.
[xlv] – تودوروف: مدخل إلى الأدب العجائبي، ص: 27.
2
وقد اعتبر الجنس الأدبي، تأسيسا على هذا الفهم، “أوامر دستورية تلزم الكاتب وهي بدورها تلتزم به في وقت واحد”[i]. إن العلاقة بين النص والجنس علاقة تلازمية لدرجة يمكن معها القول “إن كل وصف لنص هو وصف لجنس”[ii].
ويتمثل العامل الثاني في نسبية المعايير، إذ ليس ثمة من اتفاق بين النقاد على المعايير التي ينبغي اعتمادها في تجنيس النصوص، كل ما اتفقوا عليه أن عملية التجنيس تقتضي وجود معيار يتشكل النص وفق قواعده، واستنادا إلى هذه القواعد تجري عملية تصنيف النصوص إلى أجناس وأنواع.
أما العامل الثالث فيكمن في اختلاف وجهات النظر بين الدارسين حول متصور “الجنس الأدبي” نفسه، وهو ما تؤكده مقررات تودوروف عن التعقيدات التي تطيف بهذا المتصور مما يفضي إلى تباين الأنظار النقدية بصدده تبعا لتباين المرجعيات واختلاف زوايا النظر:
“إن الأجناس توجد في مستويات متباينة من الكلية، وإن مضمون هذا المفهوم إنما يتحدد بوجهة النظر التي يقع عليها الاختيار”[iii].
وقد ترتب عن التباس متصور الجنس الأدبي أن تعددت التحديدات التي تعاقبت على هذا المصطلح منذ أرسطو إلى يوم الناس هذا، نظرا لاختلاف المعايير المعتمدة في تجنيس النصوص وتصنيفها، ففي الوقت الذي نجد فيه البعض يعتمد “السمات المهيمنة” معيارا في التجنيس، نجد بعضا آخر يميل إلى اعتماد “الصيغ المضمونية”.
وإلى جانب هذه العوامل الثلاثة يمكن أن ينضاف عامل رابع، يتصل بما هو مقرر عند بعض الدارسين من أن النص الأدبي الحقيقي ليس يخضع لمقتضيات النوع خضوعا تاما، ولكنه يخوض على الدوام، صراعا لا يهدأ ضد متطلبات النوع وقواعده، في محاولة منه لتحقيق طموحه إلى “الخصوصية” و”الفرادة”، اللتين تختصانه بسمات فارقة تميزه من غيره من النصوص الأخرى التي يشترك معها في الارتقاء لنفس النوع. إن النص العظيم، من منظور هذا التصور، هو الذي ينجح في شق عصا الطاعة على متطلبات النوع ومقتضياته.
غير أنه مهما بدت مشكلة التجنيس شاقة ومعقدة فإنه بمكنتنا الانتهاء، مع ذلك، من خلال فحص التحديدات المختلفة التي تعاقبت على متصور “الجنس الأدبي” إلى معنى يجعل الجنس مرتبطا بوضع التقاليد التي تشكل أفق الانتظار عند المتلقي فترسم له طريقة استقبال النص. كما يرتبط بالتقاليد المتصلة بنوع الموضوعات والأساليب التي يمكن أن تتحقق داخل النص نفسه؛ بما يعني أن الجنس الأدبي مرتبط أساسا بترسيخ “تقاليد” معينة[iv].
وإذا كان قد تقرر عند المهتمين بنظرية الأدب أن الأجناس مرتبطة، في الأساس، بترسيخ تقاليد معينة. فما الذ ي يجعل البحث في الأجناس الأدبية أمرا شائكا ومحفوفا بالمزالق؟.
إن مشكلة التجنيس لتبدو على درجة عالية من التعقيد عندما يتجاوز متصور الجنس الأدبي معناه البسيط الذي يربطه بتقاليد الإبداع (نماذج الإنتاج) أو تقاليد الاستقبال (صيغ التلقي) على النحو الذي نجد عند صاحبي “نظرية الأدب”، فقد تحدد الجنس الأدبي عندهما، في الفصل الذي أفرداه لفحص قضية “الأنواع الأدبية”، في أنه “مؤسسة كما أن الكنيسة أو الجامعة أو الدولة مؤسسة، وهو لا يوجد كما يوجد الحيوان، أو حتى كما يوجد البناء أو الأبرشيى أو المكتبة أو دار المجلس النيابي، بل كما توجد المؤسسة. إن بإمكان المرء أن يعمل من خلال المؤسسات القائمة أو يعبر عن نفسه بواسطتها أو يبتكر مؤسسات جديدة، أو أن يعيش بقدر الإمكان بدون أن يشارك في المؤسسات أو الشعائر، كما أن بإمكان المرء أيضا أن يلتحق بالمؤسسات ثم يعيد تشكيلها بعد ذلك”[v].
يتبين من هذا الشاهد أن ريليك ووارين صادران عن فهم متطور لمتصور الجنس الأدبي يتجاوز التصورات التقليدية، التي تجعل الجنس الأدبي مجرد مبادئ لإنتاج النصوص أولا وقواعد لتصنيفها ثانيا. إن تحديد الجنس الأدبي بوصفه “مؤسسة” يمنحه “الاستقلالية” التي تميز نظام المؤسسات، وإن كان ذلك ليس بحائل بينها والتفاعل مع المؤسسات الأخرى، بكل ما يقتضيه التفاعل من مبادلة لعلاقات التأثر والتأثير، الأمر الذي يمكن الجنس الأدبي من تطوير ذاته بحيث يستوعب جميع النصوص مهما تباينت سماتها وتنوعت خصائصها. وبذلك يصبح الجنس الأدبي قادرا على الاستجابة للعلاقة المعقدة التي تجمعه بالنص الذي يعمل، من أجل تحقيق أدبيته، على الاستجابة لمقتضيات الجنس وخرقها في ذات الآن. وهو ما ينكشف من تقرير الناقدين أن اندماج الكتابة داخل مؤسسة الجنس الأدبي يتيح لها التعبير عن نفسها من خلال قيودها وقوانينها من دون أن تفقد استقلالها. إن الأمر يشبه إلى حد كبير “الحكم الذاتي” داخل نظام فيدرالي، حيث المرونة التي تسم الجنس الأدبي بوصفه “مؤسسة” تجعله يفتح أمام الكتاب آفاقا رحبة، تتيح لهم الإبداع من داخل “مؤسسة الجنس الأدبي”، كما تتيح لهم إمكانية تفكيك المؤسسة وإعادة تشكيلها، بل إن الأمر قد يصل حد ابتكار مؤسسات جديدة؛ أي نصوص تتمرد على مؤسسة الجنس الأدبي في صورته التقليدية، بكل ما يقتضي من تكسير لمتصور الجنس أو تحريره استجابة لخصوصية النصوص الجديدة.
يكشف هذا التصور عن المرونة التي تسم “مؤسسة الجنس الأدبي”. وهو ما يمكنه من التطور ويقدره على استيعاب التجليات النصية الجديدة التي تفرضها التحولات التاريخية والثقافية التي تطرأ على العصر، فتفرض مفهوما للحياة والأدب مغايرا لما كان سائدا من قبل.
وإلى جانب هذا التصور لقضية التجنيس الذي بلوره صاحبا “نظرية الأدب” يمكن استحضار أعمال الناقد الفرنسي تودوروف التي عالج فيها المسألة الأجناسية بكثير من الحصافة والنباهة.
تناول تودوروف قضية الأجناس الأدبية في سياق محاولته الرائدة لتجنيس “العجائبي” في كتابه الشهير” مدخل إلى الأدب العجائبي” حيث انطلق في دراسته من سؤال هو بمثابة إشكال مركزي في نظرية الأجناس: هل يمكن حصر عدد الأجناس الأدبية؟ إذا أمكن حصرها فذلك يعني أن عددها نهائي، وإذا لم يمكن حصرها فإن عددها يكون غير نهائي[vi]. وقد أورد تودوروف في معرض، إجابته عن هذا السؤال- الإشكال مقالة لتوماشوفسكي يؤكد فيها أن الأعمال الأدبية تنقسم إلى أجناس واسعة، وهذه الأجناس تتوزع بدورها إلى أنماط وأنواع[vii].
تقوم نظرية تودوروف في الأجناس على تصور خاص للعلاقة بين الجنس والنص أساسه حركة مزدوجة: من الأثر في اتجاه الجنس، ومن الجنس في اتجاه الأثر[viii]. وانطلاقا من هذه العلاقة الجدلية والتلازمية بين الجنس والنص انتهى تودوروف إلى رفض الآراء المشككة في فعالية عملية التجنيس وإجرائيتها، إذ صدع بمقالته إنه “يستحيل اطراح مفهوم الجنس”[ix].
إذا كان الداعون إلى إلغاء التقسيمات الأجناسية منطلقون من اعتقاد مؤداه أن النص الأدبي الحقيقي يتوجب عليه خرق قواعد النوع، لكي يتميز من غيره من النصوص التي تشاركه الارتقاء إلى نفس النوع، فإن هذا الخرق يتطلب، لكي يتحقق، وجود معيار ملموس. وهو ما يبرر بل يستدعي وجود نظرية للأجناس، كما بين ذلك بحق تودوروف، فكل ما نحتاجه، في ضوء هذا الفهم، هو “تهييء مقولات مجردة لها قدرة التطبيق على آثار اليوم([x]. وقد ختم تودوروف مرافعته عن الأجناس بالقول:
“إن عدم الإقرار بوجود الأجناس يرادف الادعاء بأن الأثر الأدبي لا يرتبط بعلاقات مع الآثار الموجودة سابقا، فالأجناس هي، تحديدا، هذه الخيوط التي بها يكون الأثر في علاقة مع كون الأدب”[xi].
بعد مناقشة مفصلة لنظرية نورثروب فراي حول التصنيفات الأجناسية التي ضمنها كتابه “تشريح النقد” يلحظ تودوروف أن هذه التصنيفات تفتقد إلى التماسك المنطقي داخليا وخارجيا[xii]. ومن هنا قدم تودوروف مقترحه لنظرية أجناس تقوم أساسا على “تمثل الأثر الأدبي”[xiii] ، حيث يميز بين تصورين للأجناس اثنين: تصور تاريخي يتشكل عبر ملاحظة الوقائع الأدبية ويفضي إلى تكون “الأجناس التاريخية”، وتصور نظري هو عبارة عن نظرية للأدب تنتج عنها “الأجناس النظرية”[xiv].
لقد صاغ تودوروف نظريته في الأجناس على أساس تصوره للأثر الأدبي، حيث تجنيس الآثار قائم، عنده، على مرتكزين اثنين:
1/ رصد الخصائص المجردة التي تشترك فيها هذه الآثار وتشكل، بالتالي، “ثابتا بنيويا” فيها.
2/ استخلاص القوانين العامة التي تربط بين هذه الخصائص.
. النوع بين الشعرية وتاريخ الأدب:
إن النوع ليس جملة من المقومات أو زمرة من العناصر، متى توافرت في النص أمكن إدراجه تحت هذه التسمية أو تلك، فإن لم تتوافر وكانت ثانوية نظر إليه باعتباره علامة في سياق تطور ذلك النوع، وإن كانت رئيسة اعتبر النص إيذانا بولادة نوع أدبي جديد[xv]. فهذا الفهم للنوع ضيق وقاصر، ولا ينبغي أن يعد معيارا في ترتيب الأنواع ضمن “قائمة” أو “صنافة”.
إن النوع في فهمنا وتشغلينا قوانين في النص دينامية، يتطلب الوعي بها نبذ التصور المعياري التقليدي الوافد على الأدب من حقل البيولوجيا المنسوبة إلى الدقة والصرامة[xvi]، والنظر بدلا من ذلك إلى النوع في سياق الشرط التاريخي، لأنه وحده القادر على تمكين الباحث من تعرف خصوصية النوع في ديناميته وليس سكونيته، التي لا تعني سوى التصورات المعيارية التقليدية.
ونعني بالدينامية هنا سيرورة النوع في التاريخ نشأة ومآلا: كيف تخلق؟ متى؟ وأين؟ ولماذا تخلق هو بالذات وليس غيره في فترة تاريخية معينة؟ والتحولات التي تعتري النوع: أسبابها؟ مظاهرها؟ دلالتها وأبعادها؟.
ومن سؤال التحولات ينبثق سؤال المصير والمآل: ما الأسباب الباعثة على تداول النوع؟ أو تهميشه؟ أو اضمحلاله وتلاشيه؟ ولماذا يعاود بعضها الظهور؟ في حين يختفي بعضها مؤقتا أو نهائيا؟ كيف ينتقل النوع من دائرة الأدب الرسمي إلى الشعبي والعكس؟ كيف يحرم النوع من الانتساب إلى دوحة الأدب في فترة تاريخية ليعود في أخرى إلى دائرة الأدب وسط ترحيب النقاد والقراء؟.
إن حدود الدراسة الشعرية الباحثة في محددات الأنواع شكلا وأغراضا، لتضيق عن مثل هذه المشكلات العويصة ما لم تنفتح على “تاريخ الأدب” بكل أبعاده الاجتماعية والجمالية والإيديولوجية. وهو ما نبهت عليه اجتهادات باختين في صيغتها المطورة عند تودوروف عندما دعا لأن تصبح “أسلوبية النوع” جزءا لا ينفصل عن “علم الاجتماع”. يقول: “إن الشعريات الحقيقية للنوع يمكن أن تكون فقط علم اجتماع النوع”[xvii]، ويعقب تودوروف على هذا الرأي قائلا: “إن النوع كينونة اجتماعية – تاريخية وهو كذلك كينونة شكلية، وينبغي أن تعالج تحولات النوع في سياق علاقتها مع التغيرات الاجتماعية”[xviii].
إن التأمل في العلاقة الواصلة بين الشعرية وتاريخ الأدب تؤكد أن التعارض بين النهجين مفتعل إن لم يكن غير ذي موضوع. إذ الشعري والتاريخي في الدراسة الأجناسية متلازمان تلازم محايثة واتفاق، وليس تلازم تلفيق أو اختلاق مادام البحث الأجناسي ليس بمقدوره الإجابة عن “المعضلات” التي تطرحها قضية الأجناس ما لم يزاوج بين رصد القوانين المنظمة لوجود الأجناس، والصلات بينها من جهة، والبحث في الأصول التي تحدرت منها والتحولات التي طرأت عليها والمآلات التي صارت إليها من جهة ثانية. وهو ما يجعل البحث الأجناسي مزاوجة منهجية بين البنيوي والتاريخي، بين الآني والزماني. إنها ذات الإجراءات المنهجية متنزلة في مستويين مختلفين، ولا يقتضي الأمر أي تدافع أو تنازع بين النهجين. يؤكد ذلك ويرجحه أن تودوروف اعتبر “تاريخ الأدب” في بعض كتاباته فرعا من فروع الشعرية، أطلق عليه “الشعرية التاريخية”[xix]. وهو الفرع الذي اعتبره في الستينات أقل قطاعات الشعرية تبلورا[xx].
إن سؤال النوع هو موضع التقاء بين الشعرية العامة وتاريخ الأدب، ولذلك نرى أن تصنيف النصوص في شبكة أنواعية مقتض المزاوجة بين المبدأين: مبدأ سكوني تزامني Synchronique الغرض منه نمذجة الأنواع في حقبة محددة للكشف عن نسقها من خلال العلاقات المشتركة التي تجمعها بنظائرها، ثم مبدأ تطوري دياكروني Diachronique القصد منه تتبع النوع في رحلة تشكله بترصد ما طرأ عليه من تعديلات وتحولات. والمزاوجة بين المبدأين وحدها تمكن من بناء معرفة صحيحة وعميقة بقضايا النوع الأدبي.
من القضايا التطبيقية التي تبرر هذه الدعوة إلى المزج بين مسعى “الشعرية” ومسعى “تاريخ الأدب”، فيما اصطلح عليه تودوروف “الشعرية التاريخية”، قضية نظام الأجناس الأدبية في الثقافة العربية، الذي يتميز، كما هو معروف، بمركزية جنس الشعر في مقابل هامشية جنس القصص. فلسنا نشك في أن أجهزة الشعرية في فحص الأنظمة الأجناسية لن تسعفنا في تفسير هذه الظاهرة التي تتنزل في صميم نظرية الأجناس، إذ لا منازعة في أن مركزية الشعر في الثقافة العربية لا ترتد إلى “شعريته” ولا هامشية القصص مرتدة إلى “قصصيته”. وبالتالي فالباحث عن تفسير لهذه الظاهرة لن يجده في تخريجات الشعرية، ولكنه واجده بالتأكيد في مباحث تاريخ الأدب، التي تربط الظاهرة الأدبية بالوقائع السوسيولوجية. وفي ذلك إقدار للباحث على تعرف علاقة نظام الأجناس العربية بالاتجاهات الإيديولوجية، سلبا وإيجابا، في الفترة التاريخية التي يفحص، لأن نظرية الأدب بعامة عند العرب، ومنها نظام الأجناس، ليست مفصولة عن المقاصد الإيديولوجية في المستوى السوسيولوجي. يتعلق الأمر بالإيديولوجيات التي تخترق المجتمع ويكون لها تأثير ومفعول في سائر مناحي الحياة ومنها الأدب. ذلك أن موضوع التاريخ في “الشعرية التاريخية” لا يتعلق، كما أوضح تودوروف، “بالأعمال الأدبية الدقيقة وإنما بما يتجاوزها، وأقصد أصناف الخطاب الأدبي وتأليفاتها المستمرة، التي نملك لها اسما تقليديا هو الأخبار الأدبية، نحن نتخذ هنا مكانا يتوسط في عموميته شمولية نظرية الخطاب وخصوصية التفسير، ونلتجيء في ذلك إلى التحليل الشكلي كما نلتجئ إلى التحليل الأيديولوجي. ذلك أن الجنس الأدبي مرتبط بالأشكال اللسانية ارتباطه بتاريخ الأفكار”[xxi]. أما باختين فإن التلازم بين الشعري والتاريخي يرتفع، عنده، إلى مستوى الضرورة في مبحث الأجناس، حيث الجنس في تصوره متملك لبعد تاريخي يغدو بمقتضاه جزءا من الذاكرة الجماعية، وليس مجرد تقاطع للخصائص الشكلية والأبعاد الاجتماعية. يقول: “يعيش النوع في الحاضر ولكنه دائما ما يتذكر الماضي وبداياته، إن النوع هو ممثل الذاكرة الخلاقة في عملية التطور الأدبي، وهذا هو السبب الكامن بالضبط وراء كون النوع قادرا على ضمان وحدة هذا التحول وتواصله”[xxii].
إن النوع الأدبي ظاهرة جمالية متنزلة، بالضرورة، في سياق ثقافي وتاريخي تفعل فيه مثلما تنفعل به. وعلى هذا الأساس فإن “النوع الأدبي محكوم في نشأته وتطوره بوضع تاريخي اجتماعي محدد، ومحكوم في طبيعته وطاقاته ووظيفته بالوفاء بحاجات اجتماعية معينة يحددها ذلك الوضع التاريخي والاجتماعي الذي أثمر هذا النوع”[xxiii]. ومن هنا كنا نرى أن تحقيق معرفة متعمقة بأجناس الخطاب الأدبي عامة، وقديمها خاصة تقتضي تنزيل هذه الأجناس في السياقات الاجتماعية والتاريخية والجمالية التي اشتبكت معها في مستوى الإنتاج والتلقي. فالأجناس، مهما تمايزت وتغايرت، تلتقي في أنها تتخلق في البداية عفوا لتتطور عبر التاريخ نحو الصنعة والتعقيد (المعايير والقواعد)، وهي في تحولها وتطورها لا تذهل، بالتأكيد، عن تمثل وتمثيل الحضارة التي انبثقت فيها وتقلبت بين أنظمتها الذهنية. حيث “الجنس الأدبي هو عبارة عن “كبسولة” مضغوطة ومشحونة بالمعلومات ذات الأبعاد الحضارية المتشابكة”[xxiv].
الأثر الفردي والنوع الأدبي:
يتعلق الأمر في هذا المستوى بقضية خصوصية الأثر الأدبي وفرادته في علاقتهما بالنوع الأدبي، بما هو “جمع” و”كثرة” و”تعدد”، فقد ذكر ديلتاي صراحة أن علاقة الأثر الفردي بالجنس الأدبي هي واحدة من مشاكل التأويل المستعصية على الحل نظريا[xxv].
ومن الأسئلة التي تربك الباحث في علاقة الأثر الفردي بالنوع الأدبي: كيف نجمع أعمالا أدبية “متعددة” تحت نفس التسمية المؤشرة على نوع أدبي بعينه؟ هل الأعمال الأدبية التي ترتقي لنفس النوع “نسخة واحدة”؟ وإذا كان ذلك كذلك ألن يكون في ذلك إنكار لخصوصية العمل الأدبي وإلغاء لفرادته؟ وإذا كانت الأخرى ألن تسقط مختلف المبررات التي تسوغ وجود الأنواع بوصفها “نماذج موحدة” لنصوص متباينة؟.
إن النوع الأدبي ظاهرة جمالية متنزلة، بالضرورة، في سياق ثقافي وتاريخي تفعل فيه مثلما تنفعل به، وعلى هذا الأساس فإن “النوع الأدبي محكوم في نشأته وتطوره بوضع تاريخي اجتماعي محدد، ومحكوم في طبيعته وطاقاته ووظيفته بالوفاء بحاجات اجتماعية معينة يحددها ذلك الوضع التاريخي والاجتماعي الذي أثمر هذا النوع”[xxvi].
وبالإضافة إلى هذه الوظيفة الاجتماعية التي ينهض بها النوع الأدبي فإن مقولة النوع تضطلع بوظيفة أخرى أدبية ونقدية هذه المرة، فهي صيغة تمكن من تجميع نصوص عديدة تحت نفس التسمية استنادا إلى مقاييس محددة ومعلومة. غير أن جمع النصوص في “زمر” أو “طبقات” ليس يتيسر إلا بحركة، فيما يقرر تودوروف، مزدوجة: من الأثر في اتجاه الأدب (أو الجنس)، ومن الأدب (أو الجنس) في اتجاه الأثر”[xxvii]. ذلك أن النص الأدبي لا يكون كذلك إلا إذا اشترك مع نصوص أخرى في جملة من الخصائص تشكل قيما مهيمنة بها يتقوم النوع. وهي التي تدمغه بسمات نوعية فارقة يختص بها، فتفرده عن غيره من الأنواع الأدبية الأخرى.
إن الإشكالية الأنواعية مرتدة في أصلها إلى هذه العلاقة الملتبسة التي تجمع بين النوع الأدبي والأثر الفردي، فما من شك في أن صاحب الأثر إنما ينتجه في تحاور وتفاعل مع آثار أخرى سابقة، إما أنه يحاكيها فينهج نهجها وينسج على منوالها أو يتمرد عليها فينتهك أسسها ومقوماتها. وعندما يستقبل القارئ هذا الأثر فإنما يستقبله وفق “أفق انتظار” معين أساسه جملة من القواعد مستخلصة من قراءات سابقة، تشكل – في مجملها- “تقاليد النوع”. لهذه الاعتبارات كان من الصعب الدفاع عن الأطروحة التي ترى أن الأثر فردي وناتج إلهام شخصي من دون أن يدخل في علاقة مع آثار الماضي، ثم إن النص ليس مجرد نتاج تركيبة سابقة الوجود مكونة من الخصائص الأدبية المفترضة، ولكنه، إلى جانب ذلك، تحويل لهذه التركيبة[xxviii].
إن خصوصية الأثر لا تحول دون تجنيسه، حيث إنماء الأثر إلى نوع بعينه ممكن – تبعا لمقترح تودوروف- عبر حركة ذهاب وإياب: من الأثر إلى النوع ومن النوع إلى الأثر. وهو ما يجعل كل وصف لنص وصفا لجنس[xxix].
إن دراسة الأنواع عمل متأرجح بين الممارسة التطبيقية التي تنطلق من النصوص، والعمل التصوري التجريدي الذي ينطلق من التنظير. ومن هنا رأى بعض الدارسين في النوع مرتبة وسطى بين النص والنمط، حيث “النمط هو النموذج والمثال الذي يختزن مجموعة من السمات الأسلوبية، والنوع هو المتصرف بطريقة أو بأخرى في تلك السمات. أما النص فهو المنجز أو المظهر الملموس للنمط والنوع”[xxx].
يرتد أصل المشكلة الأنواعية إلى علاقة النوع بالأثر: هل هي علاقة تدجين واحتواء أم صراع وتمرد؟
تكون العلاقة بين الأثر والنوع تدجينا واحتواء عندما ينزع الأثر إلى “الثبات”، وتكون تمردا وصراعا إذا نزع الأثر إلى “التحول”. في حال الثبات يخضع المؤلف للنوع فينشئ أثره وفق مقتضيات النوع وتقاليده. ويكون استقباله – تبعا لذلك- وفق “السنن” التي ترسخت في ذهن القارئ من قراءات سابقة تخلق لديه “أفق انتظار” يتوافق وتقاليد النوع.
أما التحول فيظهر عندما ينزع الأثر إلى التحرر من قبضة النوع فيجاوز عامدا حدوده ويخرق قواعده وتقاليده. وتتميز خصيصة “التحول” هاته بأنها لا تتوافر في جميع النصوص، ولكنها وقف على نصوص بعينها تمثل في تاريخ الأدب نصوصا- معالم تنتهك المعايير وتتمرد على السنن الأدبية السائدة في عصرها بما يقود، في المحصلة، إلى توسيع النوع حيث “كل رائعة حقيقية تخرق قانون جنس مقرر زارعة بذلك البلبلة في أذهان النقاد الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى توسيع الجنس”[xxxi].
إذا كان ثبات النوع يقود إلى الإقرار بوجوده، فإن تحوله يساعد على تبين رحلة تشكل النوع وتطوره. وقد ذهب بعض الدارسين إلى أن هذه العلاقة المتقلبة بين النوع والأثر، تقتضي الانطلاق من مجموعة من النصوص المفردة للوصول إلى نمط النوع، الذي يشكل صيغة جامعة عليا يحددها كارل فيتور بأنها “تجريد […] أو الرسم التصوري كما يكون، إن جاز القول، البنية الأساسية التي لا توجد إلا في شكل خصوصيات صافية؛ أي أجناسية الجنس”[xxxii].
إن أجناسية الجنس، باصطلاح فيتور، لا ترتبط بأثر واحد يمكن اتخاذه أنموذجا لذلك النوع، ولكنها متعلقة باستقراء جملة من الآثار الفردية، لأنه “لايمكن لأي نسخة مفردة أن تكون نمط الجنس […] إننا نحصل على نمط جنس أدبي معين بفضل دراسة جامعة لكل الآثار الفردية التي تنتمي إلى هذا الجنس”[xxxiii].
ومع ذلك فإننا لا نعدم “أثرا” يمكن أن ينمى إلى أكثر من نوع إذا توافرت فيه السمات المهيمنة التي يتقوم بها النوع؛ فرسالة “حي بن يقظان” مثلا صنفها صاحبها ابن طفيل ضمن “الأدب الرسائلي” لأنها موجهة إلى مرسل إليه مفترض (الأخ الكريم والصفي الحميم)، والرسالة “جواب” مطول عن سؤال وجهه لابن طفيل سائل حقيقي أو مفترض طالبا إليه الكشف عن أسرار “الحكمة المشرقية” التي ذكرها ابن سينا. وقد حافظ المؤلف على مراسيم الكتابة الرسائلية من بسملة وتحميد، وبيان للمقصد في المفتتح، ثم تلخيص ما تقدم، وطلب للتجاوز والعفو من الله، والسلام على الأخ المفترض في المختتم[xxxiv].
وبالرغم من هذا “الميثاق الأنواعي” الصريح بين المؤلف والقارئ، فقد وجدنا من الدارسين من يتصدى لإعادة تجنيس هذا “الأثر” لما رأى في نظامه من مقومات نوعية يمكن أن تلحقه بنوع آخر غير “الرسالة”. وهكذا رأى فيه محمد الداهي “سيرة ذاتية ذهنية” بين فيها ابن طفيل “طريقته أو منهجيته في تحصيل المعرفة واستخدامها للارتقاء من المحسوس إلى معرفة الله. لم يعبر عن تجربته الفكرية والوجودية بطريقة مباشرة بل خلق تباعدا بينها بتوظيف قناع حي بن يقظان”[xxxv] . فيما رأى محمد طرشونة في كتاب ابن طفيل “قصيدة صوفية” مبررا ذلك بالقول: “إننا رأينا فعلا في كتاب ابن طفيل نصا شعريا تتوفر فيه جل مقومات الشعر من إيحاء وتمليح وترميز وتخييل وإيقاع. والشعر في جل التعريفات لا يكاد يخرج عن هذه المقومات”[xxxvi] . أما فرج بن رمضان فقد أطلق عليها تسمية أجناسية وتصنيفية جديدة هي ” الرسالة القصصية”[xxxvii]. وإلى جانب هذه التصنيفات يمكن أن نرى في هذا الأثر “قصة” إذ طالما كان “القصصي” ملازما “للرسائلي”، ومن ثم يمكن لرسالة “حي بن يقظان” أن تخرج، بالنظر إلى طولها، من الإخوانيات لتنزل، بمقتضى ذلك، منزلة “القصة” أو “الحكاية”[xxxviii]. يدعم هذا الرأي أن ابن طفيل يصرح باعتماده مقومات قصصية في سرد “حكاية حي بن يقظان” مثل أسلوب التشويق الذي يوظفه ابن طفيل اجتذابا لإصغاء القاريء وترغيبا له في متابعة “الأحداث” المسرودة. يقول: “لم أفعل ذلك إلا لأني تسنمت شواهق يزل الطرف عن مرآها، وأردت تقريب الكلام فيها على وجه الترغيب والتشويق في دخول الطريق”[xxxix].
وفي ذلك تصريح من ابن طفيل باستثماره متعلقات الخطاب القصصي لتحقيق غاية تعليمية وتوجيهية، تمثلت في تشويق القارئ اجتذابا لانتباهه من أجل تبليغه “الحكمة” المقصودة.
ومما له أكثر من دلالة في هذا السياق أن نشرة فاروق سعد لكتاب “حي بن يقظان” أثبتت عبارة “قصة فلسفية” تحت عنوان الكتاب[xl]، فيما نعتها عبد الفتاح كيليطو بـ”الرواية الفلسفية”[xli].
وقد رأى بعض الدارسين بوحي من هذه الظاهرة تناظرا بين علاقة الأثر بالنوع، وعلاقة الكلام باللغة في ثنائية سوسير الشهيرة، فقدر أنه لم يعد مستغربا أن نرى كتابا “يستخدمون ثنائية سوسير: لغة/كلام لتوضيح العلاقة بين النص والجنس المناسب، إن القياس بالتأكيد ليس مبررا، فبالفعل إذا كانت اللغة هي التي، في المستوى اللساني الصرف، تجعل الكلام نظريا مفهوما، فإن النص يتأسس انطلاقا من الجنس وقواعده في شكل وحدة اصطلاحية للممارسة الاجتماعية”[xlii].
إن هذا الفهم لمتصور النوع بما هو قاعدة تشتغل في عدة نصوص ليساعد على تنزيل النوع ضمن النظام الأدبي في مجتمع من المجتمعات، ولذلك يتعين على الباحث عن أنظمة أنواعية للنصوص أن يعتبر كل نص بمثابة “تحول” داخل “الثابت”، وباستقراء هذه النصوص استنادا إلى مقاييس محددة ومعلومة يتم ترصد الثوابت وفصلها عن المتحولات، بما يقود، في المحصلة، إلى إنجاز خطاطة تصورية يفترض فيها أنها البنية الأصلية التي منها يتولد سائر النصوص.
إن هذا التقلقل في تجنيس الأثر الفردي مرتد، بالأساس، إلى الازدواجية التي تسم النص الأدبي؛ فهو من جهة “فرد” في إنتاجه وإنشائه، ولكنه من جهة مقابلة “جمع” في قراءته واستقباله.
مشكلة التصنيف:
يستند تصنيف الأنواع، عند محاوليه من المعتقدين فيه، إلى إيجاد صيغة تجميعية نسقية تمكن من إدراج عدد من الأنواع لا يقل عن اثنين تحت نفس التسمية. وهذا الإجراء يحوج من يحاوله إلى ضبط السمة أو السمات التي يتقوم بها النوع بما يمكن، في المحصلة، من إفراد كل نوع وجد له موضعا في شبكة الأنواع بمفهوم خاص. ويفترض، طبعا، أن يقف وراء كل علمية تصنيف مبدأ أو عدة مبادئ تضبط التصنيف وتوجه الاختيار.
وبالرغم من المعضلات التي تواجه كل من يتصدى لتصنيف الأنواع، فإن ذلك لم يمنع التصنيفات المقترحة لترتيب الأنواع وتنظيمها من التعدد والتنوع، حتى ليمكن القول إنه ما من دارس منشغل بقضية الأنواع إلا وله “اجتهاد” في التصنيف و”مقترح”، وقد أحصى رشيد يحياوي من هذه الاجتهادات التصنيفية في نظرية الأنواع الغربية ثمانية[xliii]:
1- التصنيف المضموني: ويستند فيه تصنيف الأنواع إلى مادة الموضوع، كتقسيم الرواية إلى تاريخية وسياسية ودينية وغيرها.
2- التصنيف الهرمي: تصنيف تراتبي يقوم بإحصاء الأنواع وفق خط عمودي ذي قاعدة هرمية.
3- التصنيف النمطي: يعتمد هذا التصنيف عندما يرتفع النوع إلى درجة النمط.
4- التصنيف الإحصائي: يكون بوضع لائحة بعدد الأنواع في محاولة لاستقصاء الأنواع الموجودة بالفعل.
5- التصنيف الانتقائي التحليلي: يكون المقصد هنا معالجة نوعين على الأقل لإبراز المشترك الأسلوبي بينهما أو ما يختلفان فيه.
6- التصنيف التأسيس: يناقش المبادئ التصنيفية بغرض التأسيس لتصنيف بديل.
7- التصنيف التكاملي: يزاوج بين طرح القضايا النظرية وتحديد الخصائص الأسلوبية.
8- التصنيف الاستعادي: يستعيد الثلاثية اليونانية.
إن تصنيف النصوص لا يستند إلى السمات المشتركة فقط ولكنه يترصد، إلى جانب ذلك، السمات غير المشتركة، إذ عليها المعول في الكشف عن خصوصية النوع، لما يتوقف عليها من تفريد النوع وتمييزه. انطلاقا من الفهم وتأسيسا عليه نشايع عبد الفتاح كيليطو في تقريره أن “خصائص نوع لا تبرز إلا بتعارضها مع خصائص أنواع أخرى، تعريف النوع يقترب من تعريف العلامة عند سوسير: النوع يتحدد قبل كل شيء بما ليس واردا في الأنواع الأخرى[xliv].
ونرى أن ينضاف إلى ذلك عنصر آخر نراه أساسا في كل عملية تصنيف، إنه الزمن الذي يمكن من تعرف خصائص النوع ومتعلقاته بما يفضي، في المحصلة، إلى الكشف عن تأثر الأنواع اللاحقة بأسلافها وسوابقها، التي تمثل “أشباها” لها و”نظائر” (ما أضيف إلى النوع وما تلاشى منه في كثيره أو انقرض).
إذا كان الإجراء الأول منشغلا بالعلاقات الداخلية المتبادلة بين الأنواع مما يدخله في “الشعرية العامة”، فإن الإجراء الثاني يطرح أسئلة النوع في سياق أدبي معين وهو ما يجعله متنزلا في صميم “تاريخ الأدب”، حيث دراسة الأنواع، من هذا المنظور، تتجاوز صياغة المفهومات وإقامة التقسيمات إلى تأسيس نظرية في تجنيس الأنواع وتصنيفها على أسس مختلفة، تستند إلى السياق التاريخي الذي يحف إنتاج النوع وتلقيه.
إن أسئلة النوع، في هذا الضرب من الدرس، ليست منفصلة عن الخلفية الفلسفية والمعرفية التي تحكم العلاقة بين من ينتج النوع: أفرادا وطبقات من جهة، ومن يتلقاه من جهة مقابلة من أفراد وطبقات أيضا. وهو ما يقود إلى طرح جدل الواحد والمتعدد وطبيعة الكليات. إن نظرية الأدب “مبدأ تنظيمي: فهي لا تصنف الأدب وتاريخه بحسب الزمان والمكان (المرحلة أو اللغة القومية) وإنما بحسب أنماط أدبية نوعية للبنية والتنظيم”[xlv].
ولما كان سؤال النوع يشكل موضع التقاء بين الشعرية العامة وتاريخ الأدب، فإننا نرى أن تصنيف النصوص في شبكة أنواعية يقتضي المزاوجة بين المبدأين: مبدأ سكوني تزامني Synchronique الغرض منه نمذجة الأنواع في حقبة محددة للكشف عن نسقها من خلال العلاقات المشتركة التي تجمعها بنظائرها، ثم مبدأ تطوري دياكروني Diachronique القصد منه تتبع النوع في رحلة تشكله بترصد ما طرأ عليه من تعديلات وتحولات. إن المزاوجة بين المبدأين وحدها تمكن، فيما نقدر، من بناء معرفة صحيحة وعميقة بقضايا النوع الأدبي.
لعل أرسطو أن يكون أول من قدم نظرية منسجمة وواضحة المعالم فيما يتصل بالأجناس التي يتفرع إليها الأدب، كما يمكن أن نستبين من تحديد أرسطو لموضوع دراسته في “فن الشعر” بأنه النظر في الشعر من جهة “حقيقته وأنواعه والطابع الخاص بكل منها وطريقة تأليف الحكاية، حتى يكون الأثر الشعري جميلا، ثم الأجزاء التي يتركب منها كل نوع: عددها وطبيعتها”[xlvi].
وقد أقام أرسطو تصوره للأجناس على أساس فهم خاص يعتبر الشعر (والفنون الجميلة كلها) محاكاة. وانطلاقا من هذا الفهم الخاص لطبيعة الفن قسم أرسطو الشعر إلى أجناس مستندا في ذلك إلى معيارين اثنين: يتصل المعيار الأول بموضوع المحاكاة حيث يحاكي الشاعر في التراجيديا أبطالا متفوقين عن غيرهم من الجنس البشري، وفي الكوميديا يحاكي الأراذل من الناس. إن التمييز بين التراجيديا والكوميديا يتم استنادا إلى موضوع المحاكاة “فهذه [الكوميديا] تصور الناس أدنياء، وتلك [التراجيديا] تصورهم أعلى من الواقع”[xlvii].
أما المعيار الثاني فيتعلق بالطريقة أو الصيغة التي تعتمدها المحاكاة، وقد اعتمد أرسطو صيغتين اثنتين للتمييز بين الأجناس هما القص (ما يقال على لسان الشاعر أو على لسان شخصياته)، والتمثيل أو التصوير الدرامي (محاكاة الشخصيات وهي تفعل)، ففي الشعر يمكن ” أن نحاكي عن طريق القصص[…] أو نحاكي الأشخاص وهم يفعلون”[xlviii].
وانطلاقا من هذين المعيارين قدم أرسطو أربع خانات، تملأ كل خانة بجنس أدبي يلتقي فيها موضوع المحاكاة وصيغتها. وفيما يلي نثبت الجدول كما استخلصه جيرار جونيت[xlix]:
| الصيغة
الموضوع |
المأساوية | السردية |
| المتفوق | المأساة | الملحمة |
| المتدني | الملهاة | الشعر الساخر |
إلى جانب هذه الأنواع الثلاثة ذكر أرسطو في كتابه عديد أنواع شعرية ونثرية مثل تشبيهات سوفرون والمحاورات السقراطية والمحاكيات المنظومة على أوزان ثلاثية أو إيليجية[l]. لكن الحديث عن هذه الأنواع جاء في الكتاب عرضا، فلم يكن من مشاغل أرسطو، فيما يبدو، توحيد هذه الأنواع تحت اسم جامع فكان أن ظلت، عنده، أشكالا متفرقة، بعضها كان ما يزال رائجا في عصره، في حين كان بعض آخر قد اندثر. ولذلك لم يكن بين هذه الأنواع، عند تدبرها، من جامع سوى “المحاكاة”.
[i] – رينيه ويليك وأوستن وارين: نظرية الأدب، ترجمة: محيي الدين صبحي، مراجعة حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1987، ص: 2366.
[ii] – تودوروف: مدخل إلى الأدب العجائبي، ص: 31.
[iii] – نفسه، ص: 29.
[iv] ـ تقاليد النوع عند تودوروف عبارة عن “قاعدة تشتغل عبر عدة نصوص” ـ مدخل إلى الأدب العجائبي، ص: 27. وعند رينيه وليك “تقاليد استطيقية في الأساليب والمواضيع”- مفاهيم نقدية، تر. محمد عصفور، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع. 110 ـ 1987، ص: 311. وعند فانسون “صيغ فنية عامة لها مميزاتها وقوانينها الخاصة وهي تحتوي على فصول أو مجموعات ينتظم خلالها الإنتاج الفكري على ما فيها من اختلاف وتعقد” ـ نظرية الأنواع الأدبية. تر. حسن عون، منشأة المعارف ـ الإسكندرية، (د.ت)، ص: 31.
[v] ـ رينيه ويليك، أوستن وارين، نظرية الأدب، ترجمة: محيي الدين صبحي، مراجعة حسام الخطيب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1987، ص: 2377.
[vi] – تودوروف: مدخل إلى الأدب العجائبي، ص: 28.
[vii] – نفسه، ص: 28.
[viii] – نفسه ص: 30.
[ix] – نفسه، ص: 31.
[x] – نفسه، ص: 32.
[xi] – نفسه، ص: 32.
[xii] – نفسه ، ص: 36.
[xiii] – نفسه، ص: 42.
[xiv] – نفسه، ص: 43.
[xv] – عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة، صص: 21-22.
[xvi] – يقرر صاحبا “نظرية الأدب” أنه “من المتفق عليه أن برونتيير ألحق الأذى [بعلم الأنواع] عن طريق نظريته البيولوجية الزائفة”- نظرية الأدب، ص: 3100.
[xvii] – تودوروف، ميخائيل باختين، المبدأ الحواري، ص: 154.
[xviii] – نفسه، ص: 154.
[xix] – تودوروف: الشعرية، ص: 79.
[xx] – يقول تودوروف “الشعرية التاريخية هي القطاع الأقل تبلورا من قطاعات الشعرية”- الشعرية، ص: 79.
[xxi] – تودوروف، “الشعرية ماضيا ومستقبلا”، المقدمة التي خص بها المؤلف ترجمة كتابه “الشعرية” إلى العربية، ص: 188 وعن فكرة تودوروف حول تناسب نظام الأجناس مع الإيديولوجيا السائدة في المجتمع راجع كتابه “مفهوم الأدب” ص: 29
[xxii] – تودوروف، ميخائيل باختين: المبدأ الحواري ص: 160.
[xxiii] – عبد المنعم تليمة، مقدمة في نظرية الأدب، دار العودة، بيروت، ط 2، 1983، ص: 123.
[xxiv] – مازن الوعر: علم تحليل الخطاب وموقع الجنس الأدبي، مجلة آفاق الثقافة والتراث، ع 14، 1996، ص: 155.
[xxv] – كارل فيتور: تاريخ الأجناس الأدبية ضمن نظرية الأجناس الأدبية، ترجمة: عبد العزيز شبيل، ص: 38.
[xxvi] – عبد المنعم تليمة، مقدمة في نظرية الأدب، دار العودة، بيروت، ط 2، 1983، ص: 123.
[xxvii] – تودوروف: مدخل إلى الأدب العجائبي، ص: 30.
[xxviii] – نفسه ص: 30.
[xxix] – نفسه، ص: 31.
[xxx] – رشيد يحياوي: مقدمة في نظرية الأنواع الأدبية، ، إفريقيا الشرق، ط 2، 1994 ص: 8.
[xxxi] – القولة لعالم الجمال الإيطالي كروتشه وردت في “أدب العصور الوسطى ونظرية الأجناس” ضمن نظرية الأجناس الأدبية، ترجمة: عبد العزيز شبيل، ص: 544. . وقد سخر كروتشه من هذا الإجراء الذي يعتبره قصورا في نظرية الأنواع التي يعتبر من أبرز مناهضيها. يقول في كتابه “المجمل في فلسفة الفن”(ص: 82): “ما من أحد يجهل أن التاريخ الأدبي مملوء بالحالات التي يخرج فيها فنان عبقري على نوع من الأنواع الفنية المقررة، فيثير انتقاد النقاد، ثم لا يستطيع هذا الانتقاد أن يطفئ إعجاب الناس بهذا الأثر العبقري، ولا أن يحد من ذيوعه، فما يسع الحريصين على نظرية الأنواع إلا أن يعمدوا إلى شئ من التساهل، فيوسعوا نطاق النوع أو يقبلوا إلى جانبه نوعا جديدا، كما يقبل ولد غير شرعي، ويظل هذا النطاق قائما إلى أن يأتي أثر عبقري جديد، فيحطم القيود ويقلب القواعد”.
[xxxii] – كارل فيتور: تاريخ الأجناس الأدبية ضمن نظرية ألجناس الأدبية، ص: 33.
[xxxiii] – نفسه، ص: 32.
[xxxiv] – يبدأ ابن طفيل كتابه بـ “سألت أيها الأخ الكريم، الصفي الحميم، منحك الله البقاء الأبوي وأسعدك السعد السرمدي، أن ابث إليك ما أمكنني بثه من أسرار الحكمة المشرقية التي ذكرها الشيخ الرئيس علي بن سينا…”- حي بن طفيل، ص: 106. ويختم بالقول: ” …والسلام عليك أيها الأخ المفترض إسعافه، ورحمة الله وبركاته” ص: 236
[xxxv] – محمد الداهي: شعرية السيرة الذهنية، فضاءات مستقبلية، البيضاء، ط 1، 2000، ص:49.
[xxxvi] – محمد طرشونة: حي بن يقظان قصيدة صوفية، ندوة الجنس الأدبي في الأدب العربي القديم، منشورات كلية الآداب، منوبة، تونس، 1994، ص: 1566.
[xxxvii] – فرج بن رمضان، الأدب العربي القديم ونظرية الأجناس ، دار محمد علي الحامي ، تونس ، ط ، 2001 صص: 187 – 188
[xxxviii] – تندرج الرسائل – عند أنيس المقدسي- ضمن “الحكايات- التي يدخل فيها أنواع القصص المختلفة والمقامات ” – تطور الأساليب في النثر العربي- دار العلم للملايين، بيروت، ط 8- 1989، ص: 3244.
[xxxix] – ابن طفيل: حي بن يقظان، تحقيق فاروق سعد، منشورات دار الأوقاف الجديدة بالمغرب، ط 5، 1992، ص: 2366.
[xl]– نفسه، ص: 103.
[xli] – عبد الفتاح كيليطو:من شرفة ابن رشد، ترجمة: عبد الكريم الشرقاوي، دار توبقال للنشر، ط 1، 2009، ص: 311.
[xlii] – وولف ديتر ستمبل: المظاهر الأجناسية للتلقي، ضمن نظرية الأجناس الأدبية، ترجمة: عبد العزيز شبيل، ص: 1100.
[xliii] – رشيد يحياوي: مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية، إفريقيا الشرق، ط 2، 1994، صص: 80-87.
[xliv] – عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة، ص: 22.
[xlv] – رينيه ويليك وأوستن وارين، نظرية الأدب، 1987، ص: 238.
[xlvi] – أرسطو: فن الشعر، ، ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه، عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة – بيروت 1973.
ص: 3. رسطو أر
[xlvii] – نفسه، ص: 9.
[xlviii] – نفسه، ص: 10.
[xlix] – جيرار جونيت: مدخل لجامع النص، ص: 26.
[l] – أرسطو: فن الشعر، ص: 5.
المصدر: https://www.alawan.org/2016/10/15/%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%...
