أبعاد العيش المشترك
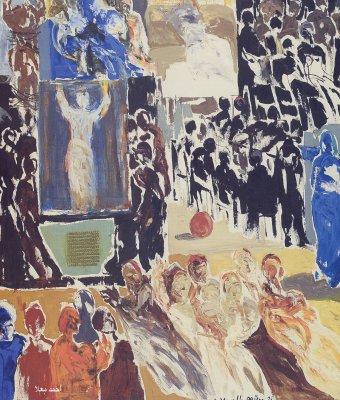
يوسف أحمد مكي
أصبحت مسألة التعدُّدية من المسائل البارزة في الخطاب السياسي خصوصاً والخطاب الثّقافي بوجه عام. كما ارتبط بروز الحديث عنها ببروز ظاهرة العولمة من جهة، والسقوط المدوي للاشتراكية بنسختها السوفياتية والأنظمة الشمولية من جهة ثانية وتفكُّك بعض الدول الاشتراكية من جهة ثالثة إلى إثنيات وأعراق كيوغسلافيا سابقاً، حيث شهدت صراعاً إثنياً وعرقياً إلى حَدّ الوصول إلى التطهير العرقي المتمثل في قيام الصرب بقتل وتشريد عشرات الآلاف من المسلمين من كرواتيا.
ولا نعرف مدى منطقية هذا الارتباط، لكننا نعرف مدى موضوعية هذا الارتباط. بمعنى الارتباط الزمني بين هذه الظواهر الثلاث. سقوط الاشتراكية وتفكُّك بعض دولها، وظهور العولمة، وبروز قضية التعدُّدية الثّقافيّة على الساحة الدولية.
ومع ذلك لابد من التمييز في هذا الشأن بين أمرين مهمين فيما يتعلّق بالتعدُّدية، والمقصود هنا التعدُّدية الثّقافيّة بكل أشكالها. أما الأمران فهما: أن الحديث عن التعدُّدية شيء، والتعدُّدية كظاهرة أو ظواهر ذات أبعاد اجتماعية تاريخية وثقافية شيء آخر.
فبالنسبة للأمر الأول لا يتجاوز الحديث عن ظواهر التعدُّدية على مختلف أشكالها وتجلّيّاتها أبعد من نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، بحيث أصبحت بعد طول نسيان من القضايا المثارة محلياً وإقليمياً ودولياً وجاء الحديث عنها مباشرة في أعقاب سقوط حائط برلين وما يمثله من أفول مرحلة تاريخية من تاريخ العالم وليس أوروبا فقط، وبدء مرحلة تاريخية أخرى يكون شعارها التعدُّدية الثّقافيّة. أي التنوّع بدلاً من الشمولية والإقصاء والتطهير.
أما بالنسبة للأمر الثاني فإن قضية التعدُّدية الثّقافيّة هي قضية قديمة قِدَم المجتمعات، بمعنى أنها تاريخية وكانت دائماً موجودة بهذا الشكل أو ذاك وفي كل مكان على وجه الأرض. فهي بهذا المعنى ذات بعد تاريخي، وهي أيضاً في الوقت نفسه تعيش في الحاضر وستظل في المستقبل قضية قائمة. كما أن لها تلوينات ومظاهر عديدة حسب الظروف والحيثيات وأساليب المعالجة.
ولكن التعدُّدية التي تُلحق بها صفة الثّقافيّة، ليست مسألة ثقافية دائماً، وليست دائماً سياسية. فهناك في التعدُّد ما هو ثقافي كالإثنية وما هو غير ثقافي من قبيل العنصر أو العرق وهي مسألة ذات طابع بيولوجي، واقتصادية من قبيل الطبقة، أو جغرافية، من الإقليم أو الجهة على سبيل المثال، ولغوية من قبيل تصنيف المجموعات على أساس اللّغة أو الدينية والطائفية أو حتى مسألة المهاجرين. ولكنها في كل الأحوال والتجلّيّات مسألة اجتماعية أو سوسيولوجية تتخذ تعابير أو تجلّيّات شتى، وذلك حسب الظروف الملموسة.
وبهذا المعنى فإن ما نطلق عليه الآن تعدُّدية ثقافيّة هو بالأصل تعدُّد اجتماعي يمثل تباينات فيما بين مكوّن اجتماعي وآخر يتم التعبير عنه في كثير من الأحيان بتعابير ورموز وممارسات ثقافية وعادات وتقاليد تميّز مجموعة سوسيولوجية عن أخرى كما أن المجموعات الأخرى تعرفها بهذا التميّز أو السلوك الثّقافي. وقد تكرّست عبر الزمان والمكان، وباتت تشكّل نوعاً من الهويّة الجمعية قبالة الهويّات الجمعية الأخرى.
فعندما نقول إن هذا المجتمع يتكوّن من تعدُّدية ثقافيّة فإن معنى ذلك أن هذا المجتمع قوامه مجموعات اجتماعية ثقافية مختلفة، وأن هذا المجتمع على أقلّ تقدير يتكوّن من مجموعتين ثقافيتين: مثلاً من مجموعتين اثنيتين كالتاميل والسينهال في سريلانكا، أو مجموعتين تنتسبان إلى دينين مختلفين كالمسيحيين والمسلمين في لبنان، أو من أقليّة وأكثريّة عرقيّة أو دينيّة أو لغويّة فما فوق وهكذا.
ومن ثَمّ فإن التعدُّدية الثّقافيّة هي في حَدّ ذاتها إنما تعبر عن ميول مجتمعية تدلل على أن هذا المجتمع بالإضافة إلى المكوّن الرئيسي فيه، وكذلك ما يبدو عليه من انسجام ووحدة فإن فيه أيضاً تباينات واختلافات ذات طابع سوسيولوجي ( أقليّات لغويّة أو دينيّة أو عرقيّة مثلاً) تتمظهر في تجلّيّات عديدة ومختلفة عن الميل العام في المجتمع المعني، الميل الظاهر الذي تشكّله الأغلبية، أو الثّقافة العامة للمجتمع بحيث نجد إلى جانب ذلك ثقافات خاصة أو فرعية تمثل مجموعات من بين السكان.
أما بروز التعدُّدية الثّقافيّة الآن على أكثر من صعيد، وخاصة فيما يتعلّق بالبعد السياسي واكتسابها بعداً حقوقياً وكذلك ارتباطها بمبادئ العدالة والمساواة إنما يعود إلى التاريخ المثقل بنكران واستبعاد وإقصاء كل ما لا يتناسب والتفكير الشمولي أو ثقافة الأغلبية. أي عدم الاعتراف بالتنوّع الاجتماعي والحضاري والثّقافي وكل أنواع التنوّعات بحجة الحفاظ على وحدة واقعية أو مفترضة وإلغاء ما عداها حتى لو تطلّب الأمر قمعها، وهذا ما يحدث بالضبط في أكثر من مكان، وخاصة في الوطن العربي ذي التنوّع الفسيفسائي. هذا التنوّع الذي خضع لكثير من أشكال القمع في ظِلّ أنظمة شمولية بحجة الحفاظ على الوحدة العربية أو بناء الدولة الأمة.
إن التعدُّدية أياً كان نوعها إذا ما تَمّ التعامل معها من منظور اجتماعي وسياسي واقعي ورشيد فهي تُعدّ مصدر ثراء بحكم طبيعة مبدأ التنوّع وفائدته كما في الطبيعة كذلك في الاجتماع البشري. فالمجتمع المتنوّع أو المتعدّد في مكوناته السوسيولوجية ومن ثَمّ الثّقافيّة يمثل سبباً وجيهاً ومفيداً لمزيد من التقدّم ومزيد من التكامل والتفاعل الخلّاق وليس التشرذم كما يعتقد أصحاب الفكر الشمولي الإلغائي والإقصائي. لأن الأصل هو التفاعل والتعايُش والاختلاف فيما بين القاطنين في مكان وزمان معينين بالرغم من اختلافهم كتجمعات عرقية أو دينية أو طائفية، وليس الإلغاء، أي التعدُّد والتسامح مع المختلف في إطار من الوحدة البناءة التي تسهم في نمو الكل والجزء على حَدٍّ سواء..
وإذا كان منطق الإقصاء الاجتماعي والثّقافي والسياسي قد مثل الخط العام في كيفية التعامل مع التنوّع الثّقافي على امتداد سحابة القرن العشرين وتحت ذرائع شتى بطبيعة الحال، مما تسبب في الكثير من الخسائر والنزاعات والضحايا البشرية، يصبح من الأهمية بمكان سواء على صعيد منطقتنا العربية، وفيها من التعدُّدية الثّقافيّة المقموعة الكثير، أم في مختلف مناطق العالم، أن تتم الاستفادة من المحاولات الدؤوبة التي قطعت شوطاً في هذا المجال وغيّرت من تكتيكاتها واستراتيجياتها لصالح منطق التعايُش مع التعدُّدية الثّقافيّة بغض النظر عن تجلّيّاتها والاعتراف بها ضمن ضوابط مُحدّدة حسب الأوضاع الاجتماعية والسياسية والتاريخية الملموسة، التي يتم الاتفاق بشأنها.
بمعنى آخر توجد حلول لمسألة التعدُّدية الثّقافيّة، لكن لا توجد وصفة واحدة سحرية لحلّ مشكلة التعدُّدية، فلكل مجتمع ولكل دولة ظروفها وكيفياتها التي تناسبها في حلّ إشكالية التنوّع الثّقافي والاجتماعي.
فعلى سبيل المثال قد تحتاج قضية التنوّع إلى حلول سياسية، كما حدث مثلاً في أيرلندا، أي تقاسم السلطة بين الكاثوليك والبروتستانت وضمن ضوابط يتفق عليها الفرقاء. وقد تكون المسألة أقلّ من ذلك من قبيل حقوق ثقافية للأقليّات الصغيرة التي تعيش في بلدان فيها أكثرية كبيرة كاسحة من باب التمييز الإيجابي لهذه الأقليّات لكي لا تذوب في بحر الأكثرية، كما بالنسبة للمسلمين في الهند مثلا. أو الاعتراف للأقليّات ضمن ثقافة المجتمع بحق الممارسات الثّقافيّة ووفقاً للقانون العام، وكنوع من الحفاظ على هويّة ما مهدّدة بالزوال، ولا تتعارض مع أسس الوحدة الوطنية..
بتقديري التنوّع أو التعدُّد الثّقافي هائل جداً، ومن ثَمّ فإن حلوله ليست واحدة وإنما متعدّدة ومتباينة، فما يصلح لهذا البلد قد لا يصلح لبلد آخر، وذلك وفقاً للوضع الملموس والتاريخ الخاص لذلك البلد وتنوّعاته الثّقافيّة / الاجتماعية.
وإذا كان التنوّع الثّقافي ظاهرة قائمة في كل المجتمعات ودون استثناء، ومن ضمنها كما أسلفت القول البلدان العربية وتمثل في الوقت نفسه إحدى المشكلات المزمنة والمعلّقة دون حلول تذكر، فإن الخطوة الأولى في سبيل إيجاد الحلول العقلانية، هي الاعتراف بها أولاً والكفّ ثانياً عن التعامل بمنطق الأكثرية المهيمنة أو المركزية الإثنية بإزاء الأقليّة أو الأقليّات من أي نوع واعتماد مبدأ التعايُش السلمي بين مختلف المكونات الاجتماعية التي يتكوّن منها المجتمع ككل وبغض النظر عن حجمها.
لأن مبدأ التعايُش أو العيش المشترك أو الاعتراف المتبادل مهما بدا أنه شاق وطويل فهو أقلّ كلفة من مبدأ الصراع المميت، وفي نفس الوقت أكثر فائدة وجدوي من النواحي الاجتماعية، حيث الوئام والسلام هو الذي يسود، ومن الناحية السياسية حيث الشعور بالإقصاء لدى المجموعات الثّقافيّة يكون في أدنى درجاته ويكون الأمان في أعلى درجاته، ومن الناحية الثّقافيّة، حيث يكون شعور المجموعات بأنها تمارس ثقافتها في جو من الوئام والمحبة وعدم الرفض، بل القبول من الآخر، وبأن الآخر الشريك معها في الوطن يعترف لها بحقوقها وكافة ممارساتها الثّقافيّة والاجتماعية. وهي بالمقابل تعترف له بهويّته.
بالنتيجة نخلص إلى القول إن التعدُّدية الثّقافيّة هي ظاهرة قائمة دائماً ولا يخلو منها مجتمع من المجتمعات. لكن ما هو غير موجود هو التعايُش في الغالب، هو غياب التعايُش فيما بين المكونات، وهذا في الحقيقة من صنعنا. فنحن نستطيع أن نغلّب مبدأ التعايُش ضمن التعدُّدية الثّقافيّة أو نغلب مبدأ الصراع والإقصاء وحتى الاقتتال كما هو واقع الحال محليّاً وعالميّاً.
أما على الصعيد العربي فقد حان الوقت لانتهاج سياسات رشيدة إزاء التعدُّدية الثّقافيّة مهما يكن نوع ومكونات هذه التعدُّدية، ذلك أن الأصل في المجتمعات هو التنوّع والتعدُّد والتعايُش والحوار في إطار من الوحدة ولكن الطوعية وليس القسرية. فالتعايُش يحافظ على كينونة ووحدة المجتمع ويساهم في التفاعل البنّاء فيما بين المكوّنات الاجتماعية، ويجنّب المجتمعات الكثير من الصراعات الخفيّة أو المعلنة، والتعايُش بهذا المعنى يمثل الاعتراف المتبادل والاحترام المتبادل والجهد المتبادل والمسؤولية المتبادلة بين مختلف المكوّنات والتعدُّديات في الانتقال بالمجتمعات من حال المواجهة إلى حال أرقى من حيث النوع والحضارة والسلام، ومن شأن ذلك أن يحافظ على استقرار المجتمعات من الهزات الاجتماعية والسياسية. فالمجتمعات التي تسوس تعدُّدياتها الثّقافيّة بسياسات رشيدة واعتراف متبادل، هي أكثر استقراراً ووحدة. فهل يعي العرب هذه الوصفة الذهبية؟.
المصدر: http://www.aldohamagazine.com/article.aspx?n=1285196A-338E-4D7C-BF01-B96...
