الفتنةُ وأخَواتُها في النصّ والوعي والتاريخ
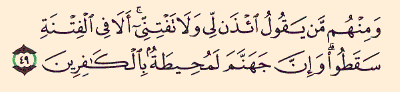
الدكتور رضوان السيد
أولاً: المصطلح في التجربة والتاريخ
تردُ "الفتنةُ" في القرآن الكريم بمعنيين رئيسيين: الاختيارُ والامتحان الإلهي للأفراد والجماعات قولاً وعملاً وسلوكاً، وهي تَرِدُ بهذا المعنى وبالصِيَغ الفعلية والاسمية في حَوالي الأربعين آية. والمعنى الثاني لمفرد الفتنة: الانقسام الداخلي والحرب الأهلية. وبهذا المعنى تُذْكَرُ في القرآن في سبعة أو ثمانية مواطن.
أمّا في الأحاديث والآثار التي انتشرت في القرنين الهجريين الأول والثاني، فإنّ المصطلح أو ما صار مصطلحاً يَرِدُ في الأغلب الأعمّ بالمعنى الثاني، أي الانقسام الداخلي، أمّا المعنى الأول للفتنة والذي يؤثِرُهُ القرآن، فإنّ الآثارَ من القرنين تُفَضِّلُ عليه مفرد: المحنة والامتحان، وهو أكثرُ للأفراد وليس للجماعات. ومحنةُ الإمام أحمد بن حنبل مشهورة، وقد بدأت عام 218هـ عندما أراد المأمون العبّاسي إرغامَهُ ومئاتٍ غيره في سائر ديار الإسلام على القول بخلق القرآن. والجديرُ ذكره أنّ فعلَ المحنة واسمَها يردُ في القرآن الكريم مرتين وبالمعنى الأول الوارد لمفرد "الفتنة" في القرآن أيضاً، دون المعنى الثاني. وفي كتاب "المِحن" لأبي العرب التميمي (من أواخر القرن الثالث الهجري) قَصَصٌ كثيرٌ عن تعرُضِ أفرادٍ من العلماء لامتحان في عقائدهم أفضى أحياناً بهم إلى الموت بسبب إصرارهم على اعتقادهم أو كلامهم (= الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) أو سلوكهم.
وَلْنَعُدْ إلى الأحاديث والآثار والأقوال في الفتنة. تردُ في "الفتنة" بمعنى الانقسام الداخلي ألوفُ الأحاديث والآثار والأقوال، وهي متنوعة الأغراض والمقاصد، لكنها بمجملها تشير إلى الرعب الهائل الذي أصاب المسلمين نتيجة الانقسام الأول الذي أفضى إلى مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين، ثم هلاك ألوف الناس في الصراعات التي دارت على السلطة في خلافة أمير المؤمنين علي، رابع الراشدين. والمرعب بالنسبة إلى المسلمين في تلك "الفتنة" أنها حدثت بين أصحاب رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وأنها أدّتْ إلى سفك دم كثير بين مسلمين "دعوتُهم واحدة"، أي أنهم جميعاً موحدون، يجمعُهُم الدينُ الواحد، ويعرفون حرمة القتل، وتوعُّد القرآن الكريم لسافك دم المؤمن عمداً بالخلود في النار: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها، وغضبَ اللهُ عليه ولعنه وأعدَّ له جهنم وساءت مصيرا﴾ ( سورة النساء: 93).
ويذهب كثيرٌ من الباحثين المُحْدَثين إلى أن هذه التجربة المؤسية وقعت في أصل نشأة علم الكلام أو علم أصول الدين، إذ كانت مسألة الإيمان ومقتضياته أول بحوث ذلك العلم، إضافةً إلى مسألة القدر. ففي مبحث الإيمان يجري التفكير في علائق القول (الشهادتان مثلاً) بالفعل (اتّباع الأوامر والنواهي)، وكيف ينبغي الحكمُ على كبار المسلمين الذين شاركوا في "الفتنة" أي خالفت أفعالُهُمْ مقتضى اعتقادهم عندما شاركوا في أفعال القتل العمد، ومن ضمنها قتل عثمان وعلي. وقد انقسمت الفرق الإسلامية الأولى بشأن هذه المسألة. أما المرجئةُ فيُرجئون الحكم على الذين شاركوا، ويكلون أمرهم إلى الله -عز وجل- العالم بالسرائر، لكنهم في ذلك التأخير إنما يقدّمون حُسن الظن بنيات أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالنظر إلى سابقتهم وصحبتهم. وأما المعتزلة الأوائل (معتزلة البصرة) فيتبرؤون من سائر المشاركين. في حين يذهب أهل السنة إلى تضليل الذين قتلوا عثمان، وتخطئة الذين قاتلوا علياًً، ويرجحون توبة الذي بقوا على قيد الحياة منهم، أما الذين لم يتوبوا فيعتبرونهم مرتكبي كبيرة، موكول أمرهم إلى الله -عز وجل- إن شاء غفر لهم، وإن شاء عذّبهم.
بيد أنّ الرعب الذي أصاب المسلمين في "الفتنة" الأولى ما اقتصرت أسبابُهُ على ارتكاب محرّم سفك الدم، وانقسام الصف، وتجرئة الأعداء، بل كان من ضمنه خوفُ الفوضى أو الخوفُ من الوقوع في الفوضى. وهم يستخدمون للفوضى -أي انعدام السلطة الضابطة والحامية- مصطلح "الهرج". ولا تعرفُ المعاجم العربيةُ القديمة أصل هذه الكلمة، بل تذكر أن معنى هَرَج الناسُ والقومُ أو تهارجوا، أي اختلط بعضهم ببعض وقاتلوا وقَتل بعضُهُم بعضاً. والطريفُ أنّ البخاريَّ في صحيحه، وبعد أن يروي حديثاً مرفوعاً إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- من طريق أبي موسى الأشعري، عن الفتنة، يُذكَرُ فيه الهرج، يفسّر المفرد بقوله: والهرجُ القتل. ونعرفُ اليومَ أنّ المفرد سبئي الأصل، أي من اللغة العربية الجنوبية قبل الإسلام، وهو يرد مراراً في الكتابات اليمنية الباقية محفورةً على الصخور، في وصف المعارك (=مَهْرَجة) التي يكثُرُ فيها القتل. وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري، راوي الحديث، يمنيٌّ، كان من حلفاء قريش قبل الإسلام لأنه كان يتردد على مكة للتجارة، وهو من قُدامى الصحابة، وقد استعمل ذلك المفرد اليمني لوصف الحالة بالمدينة المنورة عشية مقتل عثمان، أي حالة الفوضى وسقوط السلطة. ففي التقرير الذي كتبه سيف بن عمر في كتابه: "الفتنة ووقعةُ الجمل" يذكر أحد شهود العيان أنّ "العصائب" (أي الميليشيات بلغتنا المعاصرة) سيطرت على دار هجرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لثلاثة أيام، وكانت أبرزُها عُصْبَة أهل مصر التي كان يتزعمها الغافقيُّ بنُ حَرْب. ولذلك تعذّر إخراجُ جثمان الخليفة المقتول عثمان من داره لدفنه ليومٍ وليلةٍ، إلى أن تسلل به بعض خدمه وأقاربه تحت جنح الظلام إلى خارج المدينة، وما استطاعوا أن يلحدوا له. ويورد الطبري المؤرٍّخ في كتابه: "تاريخ الأمم والملوك" عن سيف بن عمر بيتين قالهما صحابي اسمه حنظلة ويُلقّب بالكاتب، يبدو أنه كان موجوداً بالمدينة خلال حصار عثمان وقتله، يشيان بهذا الرعب من سقوط السلطة وحلول الفوضى:
عجبتُ لِما يخوضُ الناسُ فيه يُرَجُّونهَ الخلافة أن تَــزولا
ولو زالت لزال الخيرُ عنهم ولاقوا بعدها شـرّاً وبيـلا
ويُسمّي الصحابي حُذيفة بن اليمان العبسي (المتوفى بعد عثمان بقليل عام 35هـ أو 36هـ) في تعليقٍ له على مقتل عثمان، الخليفة المقتول: "حبل الله"، ويقول: إنه انقطع فانكسر الباب الحاجزُ للفتنة. ويقصدُ حُذيفة بن اليمان بذلك التعبيرَ الوارد في الآية القرآنية (سورة آل عمران: 103): ﴿واعتصِموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألَّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا...﴾. ويذكر المفسِّران الأولان قتادة بن دعامة السدوسي(-117هـ) ومقاتل بن سلـيمان (-150هـ) أنّ "حبلَ الله" معناه في الآية: الجماعة أو الإمام. وبذلك يجزم عبد الله ابن المبارك (-161هـ) معاصِرُهُما في بيتٍ له:
إن الخليفة حبل الله فاعتصِموا به هو العروةُ الوثقى لمن دانا
وهكذا فإن تسمية أهل الشام للعام 40هـ عام البيعة لمعاوية بن أبي سفيان: عام الجماعة (أي الاجتماع على إمام) ما كانت مجرد دعاية أموية في ما يبدو، بل مستندُها الخوفُ الكبيرُ من الفوضى، والتي تجددت إثر مقتل الإمام علي على يد أحد الباقين بعد وقعة حروراء. ولا نعرفُ موقف الإمام علي من هذا التفسير للأمرين أو المصطلحين: حبل الله، والجماعة. لكننا نعرفُ أنه كان شديد الحملة على أولئك الذين يريدون "إلغاء" السلطة ولو باسم الحاكمية الإلهية، وهذا هو سبب خلافه مع أولئك الذين قاتلهم في حروراء.
وما دُمْنا قد ذكرْنا حُذيفةَ بنَ اليمان العبسي (-35هـ أو 36هـ) باعتباره القائل إن حبل الله هو الإمام وهو الجماعة، فنذكر روايته لحديثٍ آخر بالغ الدلالة على الرعب الذي سيطر على المسلمين في "الفتنة الأولى". يذكر حُذيفة أنه سأل رسول الله(صلى الله عليه وسلّم) عن السلوك الواجب في الفتنة، فقال له: "تلزمُ جماعة المسلمين وإمامَهُم! فقلت: فإن لم تكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: فاعتزلْ تلك الفِرَقَ كُلَّها ولو أنْ تَعَضَّ بأصل شجرةٍ حتى يُدْرِكَكَ الموتُ وأنت على ذلك" (صحيح مسلم). اختفاء السلطة بالنسبة إلى حذيفة إذن يُضاهي أو يؤدي إلى اختفاء الأمة، وعندها لا مخرج من الهلاك إلا بالاعتزال المميت أيضاً! والذي يبدو أن حُذيفة بالذات كان شديد الرعب من الحرب الأهلية، بدليل أنّ حوالي رُبع أحاديث وآثار الفتنة مرويةٌ عنه. ولا تعرفُ كتب تراجم الصحابة كثيراً عن شخصيته، فهو من قبيلة عبس القيسية، وحالف أبوه في الجاهلية بني عبد الأشهل بيثرب، وليس في حياته أحداثٌ بارزةٌ باستثناء شكواه إلى عثمان من اختلاف الغُزاة في قراءة القرآن بالشام وأذربيجان، فكان ذلك بين أسباب إقبال عثمان على جمع القرآن. ومع ذلك فإنّ المصادر تسمّيه: "صاحب سرّ رسول الله"، لأن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- كان يأتمنُهُ على أمرين: أسماء المنافقين، وأخبار الفِتَن التي تحدُثُ بعده! ويعلل حُذيفة ذلك بأنّ الناسَ كانوا يسألون النبي عن الخير ليفعلوه، أما هو فكان يسألُهُ عن الشر ليتقيه! وقد قمتُ بإحصاءٍ أوليٍّ لأسماءِ رُواةِ أحاديثِ الفتنة (بمعنى الحرب الأهلية)، وليس الفتن والملاحم (المتعلقة بأمارات الساعة)، فوجدتُ أنه يأتي بعد حُذيفة في التحذير من المشاركة في الفتنة، والدعوة إلى اعتزالها بأي ثمن: أبو موسى الأشعري، فعبد الله بن مسعود، فكعب الأحبار، فعبد الله بن عمرو بن العاص فأبو هريرة. وفي حين يربط كلٌّ من حذيفة والأشعري انطلاق الفتنة من عقالها بقتل عمر تارةً وعثمان تارةً أخرى، يهتم ابن مسعود وابن العاص وأبو هريرة بالأحداث الهائلة التي ستكون أيام بني أمية. ونعرفُ من التاريخ أن حُذيفة وابن مسعود توفيا خلال الاضطراب على عثمان أو بعده بقليل، وأنهما كانا حسني العلاقة بعلي، بل إنّ حُذيفة كان صديقاً لعمار بن ياسر الصحابي المعروف والمقتول بصفين مع الإمام علي. ويقول ابن عساكر إنّ حُذيفة ما تمنّى الموت إلاّ عندما سمع بمقتل عمّار. لكنّ الراجح أنه توفي قبل صفين بأكثر من سنة. أما أبو موسى الأشعري فمعروفةٌ مشاركتُهُ في التحكيم، واعتبارُهُ كلَّ ما حصل منذ مقتل عثمان فتنةً رجا الله أن يقيَهُ شَرَّها، لكنه عانى وتَشَرَّدَ بعد موقفه في التحكيم، ومات خائفاً من معاوية، سيئَ الرأْي فيه أيضاً. أمّا أولادُهُ فقد عملوا في الإدارة الأموية. وقد كان من الممكن اتهام كعب الأحبار بأن مروياته من الإسرائيليات، وهي ربما كانت كذلك. لكن المشكلة أن أكثر أحاديث وآثار الآخرين المرفوعة مشابهة في الصياغة، والمضمون، لآثار كعب الأحبار الموقوفة. ويبقى من ذلك كله -أياً يكن رأي علماء الرواية والدراية في الصحة والحجية- الرعب الذي أصاب العرب (الحديثي العهد بجاهلية، كما ورد في إثرٍ للحسن البصري) من أن يعودوا قبائل متنابذة يقاتل بعضها بعضاً، والرعبُ من زوال السلطة وحدوث الفوضى المدمِّرة.
ثانياً: تشبيهات الفتنة ومغرياتها والسلوك السليم تجاهها
اشتهر عن الإمام علي قوله: كنْ في الفتنة كابن اللَّبون، لا ضَرْعٌ فَيحْلَب، ولا ظهرٌ فيُركَب. والأثرُ نفسُهُ مرويٌّ عن ابن مسعود، وهو يشرح ذلك تارةً بالقول: أي اسلك سلوك الطفل البريء، أو لا تكن مفيداً أو أداةً بيد أي طرف من الأطراف. بيد أن المشكلة في نظر الصحابة والتابعين الذين عانوا من الفتن الثلاث في القرن الهجري الأول، أنهم وقعوا كل مرةٍ ضحايا اليقين أو التأكد أنهم على الحق، ذلك "أن الفتنة إذا أقبلت شَبَّهتْ، وإذا أدبرتْ تبيّنت"، بيد أنّ البيانَ بعد الإدْبار غَيْرُ مُجْدٍ، لأنّ الدمَ يكونُ قد سُفك، والواقعة قد وقعت. ثم إنّ الفتنةَ لا يشتُبه حقُّها بباطلِها فقط، بل هي مغريةٌ أشَدَّ الإغراء، وها هو عبُد الحميد كاتبُ بني أمية يصفُها في إحدى رسائله بأنها "تستشرفُ بأهلها متشوفةً بآنقِ منظرٍ وأَزْيَنِ ملبسٍ، تُجَرِّرُ لهم أذيالها، وتعدُهُم تتابُعَ لذاتها حتى ترميَ بهم في حَومات أمواجها مُسْلِمةً لهم، تَعِدُهُم الكِذَب، وتُمنّيهم الخِداع. فإذا لزمهم عِضاضُها، ونَفَر بهم شِماسُها، تخَلّتْ عنهم خاذلةً، وتبرأت منهم مُعْرِضةً عنهم..." إنها مثل حورية البحر الأسطورية، التي تتراءى للبحّارة فيتبعونها مسارعين إلى أن تصطدم سفينتهم بالصخور، فيهلكون، ولا يجدون الوقت للتفكير فيما أصابهم. ولذلك فقد رأى الصحابي أُهبان بن صيفي أن النجاة من الفتنة المشتبهة والأخرى المغرية إنما تحصل بالتعرب، أي بالعودة إلى البادية ولو كان ثمن ذلك فقدان أجر الهجرة التي وقعت في أساس الإسلام الأول. لكنه يعود للقول في أثرٍ آخرَ أنّ رسولَ الله -صلّى الله عليه وسلّم- أمرُه أن يَتّخِذَ في الفتنة سيفاً من خشب. ويحتار ابنُ حَجَر العسقلاني في شرحه على صحيح البخاري ماذا يعني ذلك: هل يعني أنه إذا اضطُرّ لسببٍ ما للمشاركة، فإنّ السيف الخشبي لا يقتل، أو يعني أنه يضعُ ذاك السيف في بيته حتى يتوهم المهاجمون أنه مسلَّحٌ فلا يصاولونه؟ فبحسب الآثار عن أبي موسى الأشعري وحُذيفة بن اليمان وأبي هريرة: حَبْسُ النفس في البيت هو السلوك الأمثَلُ في الفتنة (كن حِلْسَ بيتك) أو أنّ القاعدَ في الفتنة خيرٌ من القائم، والقائم خيرٌ من الساعي، فهو المرعوبُ الذي يروغ بدينه وعن دينه رَوَغَانَ الثعلب، ويستغيثُ اللهَ سبحانَه أن يمنَع عنه مُغْرَياتِ الفتنةِ ونيرانَها كما يستغيثُ "الغرِق"، أي المشرفُ على الغرق في البحر. بيد أنّ عبد الله بن هبيرة تلميذ حذيفة بن اليمان، والذي شارك في الفتنة الثانية(صراع الزبيريين مع الأمويين ) ما رأى سبيلاً للخلاص إلا بأن يكسر رجْلَهُ فلا يخضعُ لهوى نفسه، ولا يُرغمُهُ سلطانه!
لكن ماذا لو اتُهمْتَ بالجُبْن والعَجْز؟ يقولُ حُذيفة: لَيُخَيَّرَنَّ الرجلُ منكم بين العَجْز والفجور، فَمَنْ أدرك منكم ذلك فليختَرِ العَجْزَ على الفجور! وماذا لو دخل أحدٌ عليك بيتكَ في الفتنة، وأنت الذي اخترتَ العجز على الفجور؟ الحسنُ البصريُّ يقول له تلميذه كلاماً معناهُ إنّ مروياتِكَ هذه نظرية، إذ لا يستطيعُ أحدٌ التوقُّف في الدفاع عن نفسه! ويعترفُ الحَسَنُ بصعوبة ذلك، لكنه يذكُرُ لتلميذه مثلَ أبي سعيدٍ الخُدْري صاحب رسول الله -صلّى اللهُ عليه وسلَّم- والذي هربَ يومَ وقعة الحَرَّة عندما غزا جنودُ يزيدَ بن معاوية المدينةَ، فقد دخل عليه جنديٌّ شاميٌّ المغارةَ التي كان يختبئُ فيها، فرمى الخدريُّ سيفه، لكنَّ الشاميَّ اقتادَهُ ليضمَّهُ إلى جموع الأسرى، فلمّا بلغا وهدةً على سفح إحدى الحَرّات استعبَر الشيخ( نزلت دموعه) وقال: لقد قاتلتُ المشركين مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في هذا المكان، عندما كانوا يحاولون دخول المدينة! فقال له الشامي: مَنْ أنت أيُّها الشيخ؟ قال: أنا أبو سعيد الخدري صاحبُ رسول الله! فخلّى الشامي سبيله مترفقاً قائلاً: اذهب لا عليك يرحمك الله! ويختلفُ أبو بكرة الصحابي مع علقمة بن الأسود تلميذ ابن مسعود. فعلقمة يرى أنه إذا ظهر أهل الحق على أهل الباطل، فليس في الأمر فتنة، حتى لو سقط ضحايا بين الفريقين. أبو بكرة يجيبه بالأثر المشهور: إذا التقى المسلمان بسيفَيهما، فالقاتلُ والمقتول في النار. وهو يذكِّره بالأثر الذي رواه شيخُهُ ابن مسعود: كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل! لكنّ علقمَة لا يتوقف عن المجادلة: هل نترك الباطل يسيطر؟ وهل ندعُ "الهرج" (الفوضى والقتل) ينتشر؟ عندها يذكّره أبو بكرة بالأثر العجيب الذي سمعه أو سمعاه من عبد الله بن عمر بن الخطاب:عليكم بالأُلْفة ما لم يختلف الناس، فإذا اختلف الناسُ فَفِرُّوا منها، فإنّ القاتلَ فيها والمقتولَ بمنزلة ابنّي آدم! وبالأثر الذي سمعاهُ من أبي موسى الأشعري: إذا وقعت الفتنة فكسِّروا سيوفَكم، وقطِّعوا أوتاركم، والزموا أجوافَ البيوت، وكونوا فيها كالخير من ابنَي آدم! وفي الحالتين المقصودُ بابنَي آدمَ ما ورد في القرآن الكريم ( سورة المائدة: 25-32): ﴿واتلُ عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قَرَّبا قُرباناً فَتُقُبّل من أحدِهِما ولم يُتقبَّلْ من الآخَر، قال لأقتُلنّك، قال إنما يتقبّل الله من المتقين. لئن بسطْتَ إليّ يدَك لتقتُلَني ما أنا بباسطٍ يديَ إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين... فطوّعت له نفسُهُ قَتْلَ أخيه فقتَلُه فأصبح من الخاسرين﴾. وتمضي القصة القرآنية لتذكر أنّ قابيلاً ما اهتدى إلى كيفية دفن أخيه الذي قتله حتى دلّه على ذلك غُرابٌ ولتختم بالاستنتاج: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً...﴾. وهكذا فإنّ ممارسة العنف والقتل في الحرب الداخلية بحسب أبي سعيد الخدري وابن عمر وأبي بكرة وأبي موسى لا تسويغ لها حتى لو كان المرء يعتقد بأنه على الحق أو كان يدافع عن نفسه بالفعل. وكنتُ قد عجبتُ لاستعمال الأستاذ جودت سعيد مثل ابنَي آدم هذا في القرآن، في الاستدلال على مذهب اللاعنف في الإسلام، والذي قال إنه يفوقُ مذهب غاندي. وكانت حجتي أن الدفاع عن النفس في مواجهة العنف الخارجي ( الاحتلال الأجنبي مثلاً) أو الداخلي الفردي أو الجماعي أو السلطوي، إنسانيٌّ ومشروع. ثم رأيتُ في كتاب " مسائل الإمامة" للناشئ الأكبر (من القرن الثالث الهجري)، أنّ جماعةً سمّتْ نفسَها "صوفية المعتزلة" في بغداد في مطلع القرن الثالث كانت ترى مذهب ابنَي أو ابن آدم هذا، وتقول إنّ الله سبحانه لم يبعث محمداً لإقامة المُلك العظيم، بل بعثه رحمةً وحياةً، وتستشهدُ للمسالمة التامة بقصة قابيل وهابيل في القرآن. وما سُرَّ الناشئ لرأْي أسلافه هؤلاء، وسارع لاتهامهم بالتأثر بالنصارى والزنادقة. وهو يقصد بالزنادقة المانوية الذين كانوا يحرمون سفك دم الإنسان والحيوان!
ما معنى هذه الآثار الكثيرة في استفظاع العنف الداخلي؟ وهل كانت لها نتائجُ في التجربة الإسلامية القديمة؟
أكثرُ هذه الآثار المرفوعة لا تصح عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم-. لكن في التاريخ أنّ جماعةً من الصحابة هالهم مقتل عثمان، وما تلاه من أعمال فوضوية على أيدي الميليشيات المسلحة بالمدينة. وقد رفض بعضهم مبايعة علي باعتبار أن قتلة عثمان كانوا بين أنصاره. وقد اتُّهموا بالتحزُّب على علي، وكان بعضهم كذلك إذ انضمُّوا إلى حملة عائشة وطلحة والزبير عليه، أو إلى معاوية. لكنّ عدداً منهم ما شارك في أيٍّ من تلك الأحداث اعتزالاً للفتنة وسفك الدم.وفي كتاب "وقعة صفين" لنصر بن مُزاحم أنّ الذين رفعوا المصاحف بين الفريقين في صِفّين داعينَ لإيقاف القتال وتحكيم كتاب الله كانوا جماعةً أطلقوا على أنفُسِهم اسم "القراء" أي المتعبدين أو الزهّاد، وحاولوا التوسط بين علي ومعاوية، وقد انقسم هؤلاء في النزاع الأموي / الزُبيري فيما بعد، فأصرَّ بعضُهم على الاعتزال( ومن هنا جاءت تسمية المعتزلة الأوائل)، بينما انضمَّ بعضٌ منهم إلى ابن الزبير. وانجرفوا جميعاً بعد ذلك في الثورة على الحَجّاج بين يوسُف عام 82هـ، ربما باستثناء الحسن البصري. بيد أنّ مَنْ بقي منهم على قيد الحياة أظهر الندمَ والتوبةَ، وتحريمَ سفك الدم، وإن ظل يعتبر الأمويينُ طغاةً وجبابرة. وفي رسائل عبد الحميد الكاتب، رئيس الديوان الأُموي في عهدَي هشام ومروان بن محمد محاولةٌ واضحةٌ لوضْع الفتنة في مُقابل الطاعة والجماعة، الطاعة لأمير المؤمنين، والاجتماع عليه. على أن هذا النزوع السلمي ما تحول إلى اتجاه إلا لدى "المرجئة" الذين كانوا لا يرون استخدام العنف باسم الإسلام في النزاعات الداخلية، ولا يعتبرون الخلاف بين الأمويين وخصومهم خلافاً دينياً. وقد تحطمت وسطيتهم المُسالمة هذه على صخرة الراديكاليات خلال الصراع بين الأمويين والعباسيين، وبين الفرق الإسلامية في العصر العباسي الأول.
ثالثاً: الفتنة والبغاة والمعارضة السياسية
تركت النزاعات الداخلية الأربعة الكبرى في القرن الأول والثُلُث الأول من القرن الثاني الهجري آثاراً عميقة في الفكر والسلوك والتصرف. والمعنيُّ بالنزاعات أو الفتن الأربع: الأولى أو الكبرى والتي تبدأ بمقتل عثمان، وتبلغ ذروتها بمقتل علي (35-40هـ)، مع ما تخللها من نزاعات فرعية ومعارك دامية: معركة البصرة أو الجمل بين الإمام علي والخارجين عليه مع عائشة أمّ المؤمنين وطلحة والزبير، وحرب صفين بين علي ومعاوية، وحرب علي على المحكِّمة الذين انفصلوا عنه بعد صفين والتحكيم، وإلى مقتل الإمام علي والاختلاف على الحسن بن علي. والفتنة الثانية والتي تبدأ بمقتل الإمام الحسين عام 61هـ، وإلى استعادة الأمويين الزمام عام 72هـ بعد مقتل عبد الله ابن الزبير على يد الحجاج، مع ما تخلل فترة الأعوام العشرة من نزاعات دامية بين القيسية واليمنية، وبين الزبيريين والمختار بن أبي عُبيد، ثم بين الأُمويين والزبيريين، وغزو الأمويين للمدينة، ثم لمكّة، والنزاعات الدامية التي دارت بين قيس وربيعة، وبين قيسٍ واليمن، على الفرات، وأطراف الصحراء. في الفتنة الأولى تمثلت الفظاعة في أنها كانت بين صحابة الرسول -صلّى الله عليه وسلم-، وأنه قُتل فيها أربعةً من بين الأقرب إليه -صلّى الله عليه وسلّم-: عثمان وعلي وطلحة والزبير. وفي الفتنة الثانية تمثلت الفظاعة في مقتل الحسين سبط الرسول -صلى الله عليه وسلم- وفي انقسام السلطة، وظهور أميرين للمؤمنين. أما الفتنة الثالثة فكانت ما سمّي بثورة ابن الأشعث(82-84هـ)، وقد بدأت بالكوفة بالعراق، وضد الحجاج بن يوسف بالذات، ثم تطورت بعد النجاحات الأولى لتصبح ثورةً على الأمويين. إذ استولى الثوار على الكوفة والبصرة وسجستان وأجزاء من خراسان. وكان الأفظع في ما حدث فيها إمكان انفصال العراق عن الشام، وأنه كان بين المشاركين فيها في مواجهة السلطة الحجّاجية والأموية كثيرٌ من "القراء" أو تلك الطبقة من العلماء المتكونة حديثاً من بين تلامذة الصحابة بالحجاز والعراق. ولهؤلاء أو مَنْ بقيَ منهم على قيد الحياة نَدينُ بالتأمُّلات والمراجعات، والدروس المستخلَصة. والفتنة الرابعة هي بدأت بمقتل الوليد بن يزيد عام 125هـ، والاضطراب الهائل الذي صاحب سقوط الأمويين وقيام الدولة العباسية. وقد أدت الفتنة الرابعة إلى سفك كبير للدم، وظهور الدولة العباسية بعد الدعوة والثورات. والحقُّ أننا لا نسمعُ تنظيراً واضحا لمبدإ الاعتزال لأول مرة إلاّ من جانب الحسن البصري (110هـ) ومن تمرد يزيد بن المهلَّب على أثر وفاة عمر بن عبد العزيز عام 101هـ.
وأولُ تلك الدروس المستخلصة التحريمُ القاطعُ لسفك الدم أو حمل السيف بالداخل، مهما تكن الأسباب. وهذا معنى الأحاديث والآثار الكثيرة التي تحذّر من الفتنة لا فرق في ذلك بين المُحقٌ والمُبطل. أما البدائل للتعامل مع السلطة الظالمة فقد حدث في شأنها خلاف طويل ومعقد. فقد شجع الأمويون وأنصارهم من علماء الشام الميل الذاهب إلى الطاعة المطلقة للسلطة، وربطوا الطاعة بالجماعة، وأسقطوا اعتبارات البحث في الشرعية التأسيسية (=الشورى)، والشرعية الوظيفية (=العدل). وقال متطرفو المحكِّمة بالثورة الدائمة لاحتلال أو غياب الشرعيتين التأسيسية وشرعية المصالح. واتجهت المرجئة اتجاهاً آخر حينما فصلت الاختلاف السياسي عن الاختلاف الديني. فقالوا: إن الخلاف مع السلطان الظالم ليس أمراً دينياً، بل هو شأن سياسي، والمعارضة جائزة إنما لا ينبغي أن تصل إلى حد رفع السيف. ورأى القدرية (= نُفاة القدر) والشيعة والإباضية والمعتزلة الأوائل أن الانحراف الأموي سياسي وديني، ولذلك للثورة على الأمويين مسوِّغ واضح. إنما لا بد من الإعداد والاستعداد وجمع أكثرية الناس من حول المرشح المؤهل للخلافة حتى لا يُصاب العمل المسلح بالانتكاس، كما حدث لكل من ثاروا على الأمويين، قبل الدعوة العباسية. وظهر تَوَجُّهٌ لدى مَنْ عُرفوا في ما بعد باسم أصحاب الحديث وأهل السنة (وهم عدد من العلماء بالكوفة والمدينة ومصر) يقول بالطاعة للأئمة ما صلّوا وما جاهدوا، وعدم جواز حمل السيف مطلقاً في وجه السلطة أياً تكن الأسباب ﴿ما لم تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان﴾ إنما لا ينبغي إعانةُ السُلطة على الظُلْم أو التجنُّد معها ضد المتمردين عليها. وهذا هو مقتضى مبدأ "الاعتزال في الفتنة" عندهم، أي التسوية بين السلطة وخصومها في عدم التحيز إلى أحد الجانبين.
والراجح أن المرجئة وفقهاء أصحاب الحديث هم الذين حاولوا في النصف الأول من القرن الثاني الهجري فَتْحَ نافذةٍ للمعارضة السياسية السلمية حتى لو أدت إلى عنف جزئي أو عارض. إذ بعد زوال الأمل في إمكان العودة إلى الشورى من أجل المشروعية والرقابة، ما عاد مبدأ تحريم سفك الدم أو سلّ السيف قادراً على ضبط التوترات. فكان لا بد من أمرين إضافيَّين: شرعنة المعارضة السلمية المسوَّغة في شتى الظروف لكي لا تَحْدُثَ انفجاراتٌ مسلَّحةٌ كلَّ الوقت، وإعطاء الفرصة للذين يتورطون في عمل عنيف للعودة إلى حياتهم العادية، دونما خوفٍ أو اضطهاد. وقد احتجُّوا في ذلك بالآية القرآنية(سورة الحجرات: 9): ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلِحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأُخرى فقاتِلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسِطوا إن الله يحبُّ المُقسِطين﴾. الملاحظ في الآية أنها تشترع لكل النزاعات الداخلية، وليس تلك التي تكون بين السلطة والمعارضين فقط. فالخطاب في الآية بالجمع، أي للمؤمنين أو سائر المواطنين. لكنَّ فقهاء القرن الثاني-ولا ندري لماذا- فهموا أنها تعني التنازُع بين السلطة القائمة والمعارضة المسلّحة. وبناءً على هذا الفهم رأوا أن الواجب تبيُّن المُحِق وعرض الوساطة لإيقاف القتال والإنصاف. فإن ظهر إصرارٌ من جانب المعارضين على متابعة القتال، فللسلطة أن تُقْدِمَ في قتالهم حتى يُلقوا السلاح. لكنَّ الأَمْرَ بعد ذلك لا ينتهي بالهزيمة والقتل والسجن، بل بالإصلاح، وإنصاف الذين القَوا السلاح بالعدالة والقسط.
وكانت المشكلة الأُولى لدى الفقهاء في التعريف أو التفرقة بين المعارضة (المشروعة) والأخرى التي تدخل في أعمال العصابات المسلحة، والتي تعرضت لها آيةُ الحرابة في القرآن الكريم( سورة المائدة: 33): ﴿إنما جزاءُ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعَون في الأرض فساداً أن يُقتَّلوا أو يُصلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجُلُهُم من خلاف أو يُنفَوا من الأرض...﴾. فالتفرقة بين الجريمة السياسية والأخرى العادية أن تكون للمتمردين دعوى أو يكونَ لهم "تأويل" أو أنَّ عندهم مَظْلَمة. والتأويلُ المقصودُ هو الرأْيُ السياسيُّ أو الاقتصادي الذي يخالفُ رأْيَ أو سياسات أو مسلكَ السلطة القائمة. وفي الحالتين لا يتعرضُ السلطان (بحسب الفقهاء) للأفراد المعارضين وإن تكلموا أو خطبوا، ولا حتى إن تجمهروا من دون سلاح. وإنما عليه أن يرسل إليهم من يناقشهم ويستمع إلى مطالبهم، ويحاول إنصافهم إن كانت عندهم مطالب. فإن حملوا السلاح بعد الأخذ والرد، فالفقهاءُ مختلفون: هل يبدؤهم الأمير أو الإمام بالقتال أم ينتظر أن يبدأوه هم؟ الشافعي (-204هـ) الذي وصلَنا فصله في كتابه "الأم" لأحكام البُغاة (=أصحاب المطلب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي)، يرى ألا يبدأهم حتى يبدأوه، في حين يرى أصحاب أبي حنيفة أنه يجوز للسلطان أن يبدأهم بالهجوم خشية "الفتنة"، أي أن تزداد الثورة والانقسامات. بيد أن الفقهاء -كالعادة- يبحثون عن "السوابق" للقياس عليها. وفي هذا الأمر ما وجدوا سابقةً مثاليةً إلاّ في تصرفات الإمام علي تُجاه معارضيه المسالمين والمسلّحين على حدٍ سواء. فعليٌّ كان خليفةً شرعياً، وكان عادلاً. وقد أرسل إلى المتمردين بالبصرة من استمع إلى مطالبهم، وقد انحصرت في القَوَدِ من قَتَلَةِ عثمان، ووعدهم عليٌّ بالاقتصاص منهم بعد أن تهدأ الأوضاع، لكن الروايات التاريخية تذكر أنه كان هناك من أنشب القتال من داخل أحد الجيشين لمصلحةٍ له، أو أن المندسِّين من فرقة عبد الله بن سبأ هُمْ مَنْ بادروا لإنشاب القتال.
ويتابع سائر الفقهاء الأخذ عن الإمام علي وسلوكه تُجاه البُغاة (= أصحاب المطلب المشروع مبدئياً). فقد انهزم خصوم علي في موقعة البصرة، وهنا تختلف الروايات في كيفية تصرفه. روايات أهل السنة تقول إنه ما تعرض لمن ألقوا السلاح ولا للجرحى ولا تابع منهزماً، كما لم يصادر من المنهزمين سلاحاً أو مالاً. وهم يعللون ذلك بأنهم مسلمون، وأنهم أخطأوا وبغَوا (أي اعتدوا حسب الآية)، وقد لقوا جزاء بغيهم في الهزيمة ومَن سقط منهم في المعركة، وما داموا قد عبَّروا عن التوبة بإلقاء السلاح، فلا شيء عليهم. ثم إنّ النزاعات الداخلية لا تنتهي آثارُها السلبية إلاّ بالتوافُق والمصالحة وليس باستمرار القهر: ﴿فإنْ فاءت، فأصِلحوا بينهما بالعدل وأقسِطوا إنّ الله يُحبُّ المُقسطين﴾. والروايات الشيعية (الزيدية) تذكر أن الإمام علياً قال لجنده بعد موقعة البصرة: "لكم العسكرُ وما حوى"، أي ما خلَّفه الثائرون في أرض المعركة وحسب، ويضيفون إلى ذلك أنه قسّم بينهم ما تجمّع في بيت المال بالبصرة، لكنه شدّد في عدم الاعتداء على الأفراد الذين شاركوا في القتال حتى لو كانوا قد قَتَلوا أو جَرحوا، كما أنه نهى عن مصادرة أموالهم أو ممتلكاتهم خارج ساحة المعركة.
ويعود الرواة فيذكرون مسلك الإمام علي مع من سُمُّوا في ما بعد بالخوارج، وهم المحكِّمة (أي الذين رفعوا في وجهه شعار: لا حُكم إلا لله)، وقد انفصلوا عن جيش علي، وذهبوا إلى خارج الكوفة عندما قبل التحكيم. وقد ذهب إليهم الإمام بنفسه وجادلهم فرجع بعضهم، وظل البعض الآخر مصراً على الاعتزال إلى أن يرجع علي عن التحكيم. ومع ذلك فإن علياً ما قاتلهم -في ما يقال- إلا بعد أن قتلوا عبد الله ابن خَبّاب صاحبَ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-. وهكذا، وبغضّ النظر عن التفاصيل، لا شيءَ على المعارضة الفردية أو الجماعية إن ظلت سياسية، وإنما تبدأ المشكلات إذا "أصاب أهل التأويل دماً أو مالاً أو سدُّوا السُبُل" مستعملين في ذلك السلاح. وفي تاريخ أبي زُرعة الدمشقي (-281هـ) أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل العالم المدني المشهور الزهري (-124هـ) عن الحكم بعد إلقاء السلاح في "الفتنة " فقال الزهري: "أدركت الفتنةُ المسلمين وأصحابُ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- متوافرون، فرأوا أنه لا تَبِعةَ على أحدٍ في دمٍ أو مال في الفتنة".
ما معنى هذا كله، وهل كان له تأثير في مجريات الأحداث خلال الأزمنة الوسيطة؟
أول فصل وصل إلينا عن أحكام البغـاة موجود في كتـاب "الأم" للشافعـي (-204هـ)، كما سبق القول. لكن لا بد أن البحث بدأ قبل ذلك بمدّة. فكتُب (السِيَر) المؤلفة في النصف الأول من القرن الثاني مثل كتاب محمد النفس الزكية (-145هـ)، والأوزاعي (-157هـ) والفزاري (-186هـ) تعالج ثلاثة موضوعات: السلوك إزاء المجاهدين المستشهِدين، وإزاء المقاتلين الذين ينبغي تقسيمُ الغنائم بينهم وبين الدولة، والمرتدين عن الإسلام، والبُغاة الذين خرجوا على الإمام. والذي يظهر أن "البغي" كان مفرداً مُحايداً، ويعني ما تعنيه كلمة مُعارض أو صاحب مطلب، ثم صار يعني المعتدي أو المتجاوز للحد، وهو معنى تؤيده طريقة الاستخدام في القرآن الكريم. ولا شك في أن مبحث "أحكام البُغاة" في كتب الفقه أو في كتب مستقلة، ما كان المقصود به الجانب السياسي فقط، بل الجانب الجنائي إذا صح التعبير، وكيف يمكن مواجهته.
وعلى أي حال، فإن الذين درسوا الأمر من المُحْدَثين أي أمر المعارضة في الزمن الإسلامي الأول، ما فهموا مقصد الفقهاء في حماية المعارضين حياةً وحريةً وكرامةً، ولذلك انصرفت المعارضة السياسية عندهم إلى الخوارج والشيعة وحسب. ولا شك في أنها كانت معارضة سياسية في البداية، ثم صار الجميع إلى بناء تصور آخر للاعتقاد وللأمة. أما البُغاة فهم أُناس ما عارضوا السلطة لأنهم يريدون اعتقاداً آخر أو دولةً أُخرى، بل لأنهم يريدون المشاركة من خلال سماع الرأي واعتبار المصلحة. وقد يكون المؤلفون المحدَثون تأثروا بكتاب فُلهاوزن الصغير الذي ترجمه عبد الرحمن بدوي في الخمسينات من القرن الماضي بعنوان: "أحزاب المعارضة السياسية-الدينية في الإسلام: الخوارج والشيعة".
وما احترمت السلطات حلول الفقهاء السياسية كثيراً، ولا عهدت بالمعارضين للمحاكم العادية، بل كانت تقتل المستسلمين تارةً، وتعفو عنهم تارةً أخرى. والحليمُ جِدّاً من وُلاة الأمر القدامى، من كان يقبل عرض الأمر على مجلس المظالم الأسبوعي أو الشهري برئاسة السلطان أو وزيره أو حاجبه وحضور القضاة.
بيد أن التأثير الأساسي والباقي لأبواب الفقهاء المعقودة لأحكام البغاة في الكتب الفقهية العامة هو شرعنة المعارضة السياسية للسلطة القائمة ضمن حدود وحدة الأمة والسلطة، وعدم استخدام العنف من جانب الطرفين أو الأطراف المتنازعة. لكنْ حتّى المصير إلى العنف من جانب أحد الطرفين لا يُلْغي الحقَّ في المشاركة، ومن ضمن ذلك الحق التفرقةُ الحاسمةُ بين الجريمة السياسية، والجريمة العادية فرديةً كانت أو جماعيةً. ويذهب بعضُ الفُقهاء إلى أنّ التفرقةَ بين "الجريمتين" إذا صحَّ التعبير؛ أنّ الأُولى العاديّة هي فرديةٌ في الغالب (وإن صار القائمون بها عصابة كما في حالة قطْع الطريق: المحاربين)، ولا دعوى فيها ولا تأويل. بينما تكون الجريمة الثانية أي السياسية جماعيةً، أي تقومُ بها جماعةٌ تملكُ دعوى أو تأويلاً أو مطلباً سياسياً. ولذلك يشترطون في تحديدها: التجمْهُر والانحياز، أي الخروج من المِصْر، كما يُطالبون السلطة والجماعة المعارِضة بالتفاوُض السلمي، والعمل على التوافُق والتوفيق؛ بالإصغاء والاستجابة من جانب السلطة، وبعدم اللجاجة والتعنُّت من جانب المعارضين الثائرين.
وخُلاصةُ الأمر أنّ تجارب النزاعات الداخلية في القرن الهجريّ الأوَّل، ترتَّبتْ عليها عدةُ نتائج وتركت تأثيراتٍ كبرى في الوعي ومجرى التاريخ ومسارات الجماعة والأمة. وأُولى تلك النتائج والآثار ظهور أدبيات كبرى في وصْف الفتنة والتحذير من الوقوع فيها، والاحتجاج لذلك بمأثوراتٍ قرآنيةٍ أو منسُوبةٍ للنبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، والصحابة والتابعين الذين شاركوا في الأحداث عن قُربٍ أو بُعْد. وقد ارتبطت فيما بعد بأدبياتٍ نشوريةٍ تتعلّق بأَماراتِ الساعة وأهوالِ القيامة؛ فَبَدَتْ الفتنة والنزاعات الداخلية من الهَوْل بحيث إنها غدت تمهيداتٍ للفتن والملاحم على مشارف الساعة. والواقعُ أنه لا علاقةَ لأدبيات الفتنة ذات الأُصول العربية والظروف السياسية الحادثة في القرن الأول، بالنشوريات وعلامات القيامة المأخوذة في الأصل من المأثورات المسيحية. وعلى أي حال، فبعد القرن الثالث الهجري، تضاءل التأليف في الفتنة داخل الأمة، والكلامُ عنها، وسادت فصولُ وأبوابُ ومؤلَّفاتُ الملاحم والفِتَن وأمارات الساعة. وما يزال الأمر على هذا النحو حتى اليوم.
أمّا الأثَرُ الثاني للنزاعات الداخلية في القرن الإسلاميّ الأوَّل، فقد كان ظهور مبدأ "الاعتزال في الفتنة"، الذي تبنتْهُ فئةٌ من القراء والعلماء والفقهاء، وتحول في القرنين الثاني والثالث إلى جزءٍ من عقيدة أهل السنة والجماعة.
ودفع ضيقُ الأُفُق السياسي أو انسدادُهُ خلال القرنين الأولَين، أمام مشاركة الأفراد والجماعات، إلى تفكيرٍ فقهي جدّي في شرعنة المعارضة السياسية السلْمية، وفي تَوَازٍ مع مبدأ الاعتزال في الفتنة. فالبديلُ للثوران المسلَّح، ليس الطاعة المطلقة، كما يُشْعِرُ مبدأُ الاعتزال، بل المعارضة الإيجابية والسلمية، والتي تحفظُ الحقَّ في المشاركة السياسية، دونما وصولٍ إلى سفك الدم، والانقسام الداخلي المدمِّر. وقد يكونُ هذا المبدأُ المُهمُّ أبرز نتائج تجارب الفتنة وآثارها، وهو محتاجٌ لدراسةٍ خاصّة.
المصدر: http://www.ridwanalsayyid.com/ContentPage.aspx?id=95#.VyZoaHErLIU
