الإصلاح الديني ومنظومة حقوق الإنسان
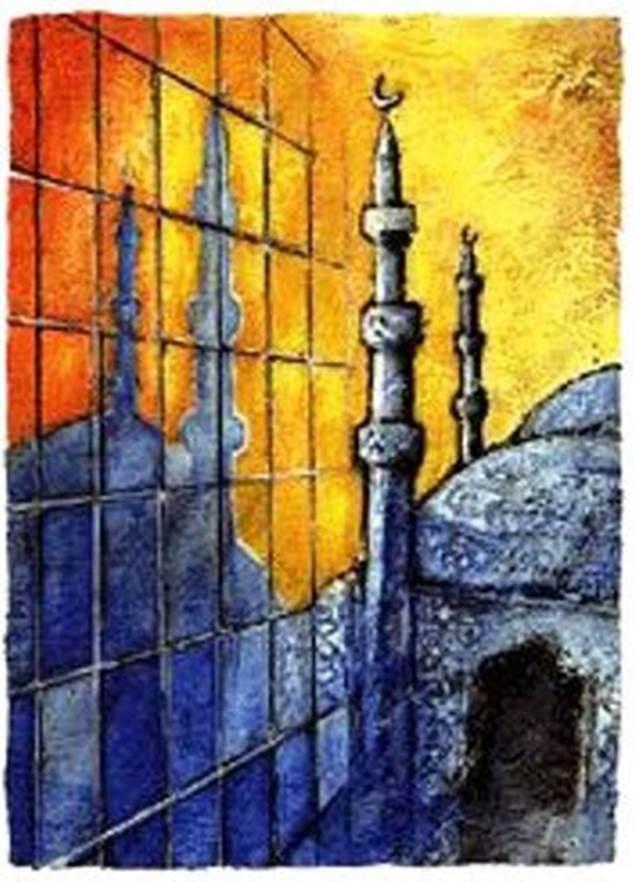
عمار بنحمودة
قد يطرح علينا مصطلح الإصلاح الديني من الإشكاليّات ما يجعل شرعيّة طرح المسألة محلّ نقاش؟
هل يعتبر حديثنا عن الإصلاح الديني ضربا من الفصل العلميّ والمنهجي بين أنواع الإصلاح مختلفة ؟ وهل يمكننا الحديث عن الإصلاح السياسي أو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعيّ أو الإصلاح الثقافي؟ وإزاء هذه الفرضيّة؛ فالأمر يستدعي النظر إلى الإصلاح الديني، ثمّ رصد علاقته بأنواع الإصلاح الأخرى سواء أكانت تلك العلاقة القائمة على التأثير أم فكّ الارتباط.
لعلّ مثل هذا الطرح، يبيّن أن الحديث عن الإصلاح الديني واقع تحت وهم تاريخي كان الدّين ممسكا فيه بزمام الأمور ومتحكّما في جميع مجالات الحياة، إذ هو المشرّع للسياسة والمؤثّر في العلوم التي ظلّت في عصور ازدهاره رهينة تصوّراته ملتزمة بسقفه المعرفيّ، وهو اليوم تابع لمنظومة تبدو أكثر سلطة وتفرض بحكم سيادتها العالميّة وقدرتها الفكريّة تجاوز عقليّة الصّدام والنزاعات بين الأديان من أجل فرض نفسها على من كانوا يعتقدون اعتقادا لا شكّ فيه بقدرتهم على الفتح وحمل المخالفين على الإذعان وأخذ الجزية منهم صاغرين .
فالدّين يقف في كفّة هذا الطّرح وحقوق الإنسان تقف في الكفّة الأخرى، وبينهما صراع خفيّ حول سلطة التشريع والمرجع؛ فالطّرح يقدّم انتصارا لمنظومة حقوق الإنسان، باعتبارها الثابت بينما الإصلاح يفرض على الدّين التحوّل من البحث فيه عن اعتراف بتلك الحقوق، وحمل المعتقدين فيه على الالتزام بها .
قد يكون مبرّر هذا الطرح إذن الإيمان بتاريخيّة الفكر الدّيني، والإقرار بأنّ ما صاغه الإنسان من منظومة حقوق الإنسان يظلّ استجابة لتطلّعاته إلى السلم العالميّ، والتزامه بحقّ أخيه الإنسان في العيش المشترك وضمان حرّية الفكر والاعتقاد، وهو ما يفرض علينا فهم أوجه الائتلاف والاختلاف بين الخطاب الدّيني ومنظومة حقوق الإنسان، ونقف هنا عند مفترق تأويلي خطير يشقّ الخطاب الديني إلى فهمين مختلفين:
الأوّل تجديدي، يرى أنّه لا وجود لتعارض جوهري ّ بين الخطاب الديني ومنظومة حقوق الإنسان، ويجد لأطروحته من الحجج النقليّة والعقليّة ما يبرّر هذا القبول، بل ويجعله مركزيّا حتّى يسود الاعتقاد عند بعضهم بأنّ الإسلام كان الأسبق إلى القول بحرّية الإنسان وضمان حقوقه، عتقا للعبيد واحترما لحرّية الناس في الحفاظ على أديانهم داخل حدود الدولة الإسلاميّة وغيرها من التشريعات والممارسات التي تؤكّد التزام الإسلام خطابا والمسلم ممارسة بحقوق الناس. ولقد نشأت طبقات تاريخيّة من هذا الفكر الإصلاحي المؤمن بالتحديث بدأت مع الجيل الأول تتلمّس أهم القضايا التي تأخّر فيها المسلمون، وتقترح حلولا لتجاوز حالة التأخّر وبلوغ النهضة المنشودة. ومن بينهم رفاعة رافع الطهطاوي (ت1873) الذي دعا إلى الاستفادة من تجارب الأوروبيين في التقدّم والمؤسسات السياسيّة وتجربة التعليم، وجمال الدين الأفغاني ومحمّد عبده، وسار على منواله محمد بيرم التونسي (1889) ومحمد رشيد رضا وخير الدين التونسي(ت1899) . ثمّ تلاهم جيل ثان يعتبر علي عبد الرازق أحد رموزه، من خلال كتابه "الإسلام وأصول الحكم"، وأسهم بعده طه حسين، وانتهى الأمر إلى جيل الإصلاح الثالث، ومن رموزه محمد أركون ومحمد عابد الجابري وحسن حنفي ونصر حامد أبو زيد وهشام جعيّط ...
ولكن هل استطاعت هذه الأجيال من المجدّدين صياغة نظريّات تجديد الخطاب الديني واستيعاب حقوق الإنسان ؟ أم أنها ظلّت رهينة تأثيرين: تأثير سلطة سياسيّة بيدها مقاليد الحكم، استبدّت طوال حكمها بالحقّ ولم تتبنّ مبادئ حقوق الإنسان إلاّ على الورق، وبين واقع لا يزال محكوما بوعي الرعيّة الغارقة في اليوميّ، والتي تستقيل الفعل السياسيّ مادامت ضرائبه السجن والنفي والقتل، أو لأنّها لا تزال تحلم بأبسط الحقوق في العيش والسكن، ولهذا ظلّ الدفاع عن حقوق الإنسان عملة تتداولها النخبة وتصادرها الأنظمة المستبدّة ولا يجني عامّة الناس ثمارها .
وحين حاولت بعض الشعوب حديثا إقامة ثورات وأنظمة ديمقراطيّة وجدت نفسها غارقة في انفلات للخطاب الديني ، لا يتداول عملة الحرّية إلا لسانيّا ، وتظلّ غارقة في بحثها عن القوالب التشريعيّة وسط النزاعات الحزبيّة، بينما الوعي الجماعي يرتدّ نحو أبسط أشكال انتهاك حقوق الإنسان، وتحوّل من إطار الاحتكار السلطويّ للدولة إلى نشوء مجموعات وفرق تتربّص بالآخرين لمواقفهم وآرائهم، وتستعيد الكابوس القديم الذي يحتكر فيه الناس سلطة الحقيقة والمقدّس.
الفريق الثاني: يرى في الإسلام حقيقة مطلقة يفيض عطاؤها على جميع الميادين السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، ويحتجّ بالماضي الذي استطاع فيه الدين تحقيق إنسانيّة المسلم ورفعه درجات في السلّم الحضاري، وجعل المسلمين أعزّة بعد أن كانوا فرقا متناحرة، وهذه القراءة التي تتناول التراث في صيغة مثاليّة ترى في الخطأ اجتهادا، يغرق في المتخيّل السياسي؛ لأنّه يرى الحاضر بمنظار الماضي، فيقع في الإسقاط والمماثلة المستحيلة بين واقعين مختلفين سواء في موازين القوى الدوليّة أو في مستوى القضايا المطروحة على المسلم المعاصر، فهو خطاب مفجوع بفقدان غلبته. [1] ولهذا فهو خطاب يعمد إلى إقامة ضرب من التماهي بين المنظومة القديمة والحديثة، فكفّار الأمس على اختلاف انتماءاتهم هم الغرب اليوم، والمقاصد غير واضحة، فهذا الغرب المتقدّم الممتلك لأسباب القوّة العلميّة والاقتصاديّة يصير هو العدوّ المتربّص بالإسلام والمانع لإقامته منهجا وشريعة للمسلمين، خوفا من أن يتوحّدوا ويصيروا خطرا عليه، مثلما كانوا في الماضي سادة في الأندلس. ويغرق هذا الخطاب في نزعة العدائيّة للغرب، فيعتبرخطابه متناقضا ومفاهيمه غير واضحة[2]، متناسيا أنّ ما أصاب المسلمين من ضعف وانحلال انتهى بتفكيك آخر إمبراطورياته العثمانيّة، هو نتيجة سلوك المسلمين أنفسهم سواء منهم الساسة أو النخبة السياسيّة، ويغضّون الطرف عن المشاكل الهيكلّية الكامنة في التراث، والتي بقيت كالبركان الذي يثور بين الفينة والأخرى، ليهدّد في الأخير كيان الحكم الإسلاميّ ويبيده، ولهذا فهم ينظرون إلى فترة النبوّة وخلافة الراشدين مرجعيّة لتلك الحقوق التي يحتاجها الإنسان، وفي نفسهم شعور أنهم يحققون هويّتهم كلّما لبسوا الحقوق من خزانة تراثهم ولم يستعيروها من غيرهم؛ "فالموروث القديم ليس إلاّ بناء شعوريّا معبّرا عن أنماط مثاليّة."[3]
لا يمكن أن نراكم إذن خطابا جديدا حول حقوق الإنسان إلا بفهم طبيعة المتلقّي، لماذا يفيض الخطاب الديني في وعيه، فيصير متدخّلا في كلّ كبيرة وصغيرة؟ ألأنّه عوّد الإنسان على عقليّة الانقياد في السلوك، وقدّم له عبر خطاب فقهائه الحلول لأبسط المعاملات الإنسانيّة؟ وهل يمكن للتشريع "الوضعي" المؤمن بالحقّ الإنسانيّ أن ينسخ بعض النصوص القرآنيّة الداعية إلى العنف، وهي في نظر الفقهاء تنسخ آيات كثيرة فيها دعوة للتسامح ؟ كيف يمكن إقناع مؤمن بتأويل محدّد فيه اعتقاد راسخ بضرورة محاكاة التجربة النبويّة غزوا وفتحا وجهادا بأنّ للآخرين حقوقا في الاختلاف؟ وكيف يمكن منعه من العنف، وهو يبرّره بالمحاكاة، ويحتجّ بأنّ الغرب هو المستعمر والمستنزف للثروات والمعتدي بجيوشه، بينما يرفع في المنابر شعارات الديمقراطيّة وحقوق الإنسان؟ ألا تنتصر مبرّرات العدوان على مبرّرات التسامح في ظلّ التهميش الاجتماعي وانتشار الفقر والبطالة على حجج التسامح التي يقدّمها الغرب لحماية مصالحه، ويستعملها ورقة متى توافقت مع تلك المصالح، بينما تسحب من سوق التداول متى كانت متضاربة مع تلك المصلحة؟ فمن يجب عليه إصلاح نفسه؟ هل هي تلك الشعوب الممتلكة لزمام القوّة التي تستعملها لإرضاء نهمها الرأسمالي، فتنشر بسياساتها المجحفة الأزمات والفقر والبطالة، أم الخطاب الديني الذي صيغ في عصور التهميش والضعف؟ أليس الخطاب الدّيني فيتامينا لتلك الشعوب يقدّم لها الحلول المتخيّلة وتعيش به وهم الحقيقة والتفوّق، ويضمن لها رأس مال رمزي حين لم تجد في السوق العالميّة رأس مال حقيقي ينقذها من أزماتها ويخفّف من مصابها الاجتماعيّ ؟
هل يمكن الحديث عن حقوق الإنسان كوثيقة نظريّة صاغتها ويلات الحرب العالميّة الثانية وموت خمسين مليون من البشر، أم عن حقوق الإنسان في العيش الكريم؟ فأيّ حقّ للجياع والعاطلين عن العمل وللشعوب القابعة تحت خطّ الفقر؟ أليس من حقّ الناس أن تتراجع الأنظمة الرأسماليّة عن جشعها وتلتفت بعين الإنسانيّة إلى أزماتها وتساعدها على حلّ مشاكلها بدل تصدير الحروب لها والصراع على ضمان المصالح على أرضها؟
تطرح مسألة العلاقة بين التجديد الديني ومنظومة حقوق الإنسان صداما حتميّا بين المقدّس الديني الذي يبرّر تمسّكه بالدين مرجعا للتشريع وفق مرجعيّاته الإلهيّة ونجاعته الماضية في تحقيق النجاح للمسلمين، والمقدّس الحداثيّ الذي يرى في الإعلان مبادئ كونيّة لا يجوز تأويلها. ففي المادة الثلاثين" ليس في هذا الإعلان نصّ يجوز تأويله على أن يخوّل لدولة أو جماعة أو فرد أيّ حقّ في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحرّيات الواردة فيه ". وإزاء مأزق الصدام بين قداسة الخطاب الديني عند معتنقيه وقداسة حقوق الإنسان عند المؤمنين بها، يظلّ التلقّي فيصل التفرقة في تحديد الثابت والمتحوّل؛ ففي المنظومة الدينيّة يكون قبول حقوق الإنسان على مقاس التأويل الديني غير خارج عن عقدة التسمية الإسلاميّة ومرجعيّة القرآن والسنّة وسلوك السلف الصالح، في إطار ما تقتضيه حتميّة الانتماء داخل حصن الهويّة التي تجسّدها اللغة والتسمية . أمّا في المنظومة الحداثيّة، فيظلّ الخطاب الدّيني قاصرا ما لم يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، فيصير محكوما بهاجس الاحتواء وتدجين الخطاب الديني، ليتلاءم مع خطاب الحداثة وينضبط لشروط المأسسة حتّى لا يطعن فيه ويصير عدوّا يستوجب العنف دفاعا عن مبادئ حقوق الإنسان؛ فتلك الحقوق قد تصير غاية تحقّقها الطائرات المغيرة والقنابل الفتّاكة والجيوش المدجّجة بالسلاح . ويظلّ السؤال المطروح على المنظومة الحداثيّة: هل تخلّص تصوّر حقوق الإنسان من عقدة المركزيّة وسلطة المصالح ؟ هل يمكن فعلا فرض القداسة الحداثيّة على متلقّ يجد في الدين أملا دنيويّا في الخلاص، وإجابة عن حقّ أعظم لم تستطع الحداثة الإجابة عنه، وهو الحقّ في الخلود؟
لقد سعت كثير من الدراسات إلى الإقناع بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إسلاميّ في مبادئه، واجتهدوا في تأويل الآيات لتكون مطابقة لتلك المبادئ، ولكن تظلّ عقدة المرجعيّة هي الأساس، ففي الوقت الذي تظلّ منظومة حقوق الإنسان مرتبطة بالتحوّلات الكبرى التي شهدها الفكر الإنساني في أوروبا وقطع أشكال الهيمنة الكنسيّة على المعرفة، فإنّ المرجعيّة الدينية تظلّ حاضرة بقوّة عند المتحصّنين بالإسلام حاميا للهويّة ومحقّقا للذات. ولهذا، فرغم قناعة أغلبهم بنجاعة حقوق الإنسان، فإنهم يجدون في ترجمة تلك المبادئ إلى مجال الخطاب الديني أمرا ضروريّا يحقق لهم توازنا نفسيّا وشعورا بأنّهم يصوغون حقوقا ذات لون إسلاميّ، ولا يقعون تحت منطق التبعيّة الذي سئموه فعلا فأرادوا تجاوزه قولا. ولهذا، فإنّ الإصلاح يعني في نظرهم إصلاح سياسات الغرب تجاه الشعوب الضعيفة، وليس تغيير الخطاب الديني، فهو في نظر الكثير منهم يهدف إلى حفظ حقوق الإنسان، وليس من مقاصده نسفها .
إنّ الإجماع حاصل حول الإصلاح الديني، ولكن الاختلاف واقع حتما حول طرائق ذلك الإصلاح، قد يعني الإصلاح نسف الأصول تمهيدا لاعتناق دين الحداثة وفق عقيدة دغمائيّة تنغلق أنساقها انغلاق الأنساق الدينيّة. فيصير حينئذ الإيمان بالإله التقليدي أقرب إلى الإنسان من الإيمان بإله العولمة الذي صنعه البشر بيده وأضفى عليه طقوس القداسة، ومنها تلاوة الآيات البيّنات من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، باعتبارها سورة من سور الكتاب المقدّس للحداثة، بل أقدس من كتب الأوائل لأنها لا تسمح بتأويله، بينما يظلّ الخطاب الديني قابلا للتأويل بدءا بالقرآن وانتهاء باجتهاد الفقهاء وفتاوى الأئمّة، ومحاولة المعاصرين بيان تاريخية النص وأحكام الشريعة. ومن هنا يأتي طرح الإصلاح الديني محاولة لتطويع الخطاب الديني كي يكون مؤمنا وخاضعا للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وقد نزعت عنه صفته التاريخيّة وسياقات إنتاجه ليصير قرآنا جديدا لا يقبل النسخ والتأويل. قد يصير من الممكن صياغة ميثاق آخر يستوعب السياقات التاريخيّة المتجدّدة، ويتضمّن ما طرأ على الواقع من تحوّلات ويستوعب التجاوزات التي تمّت في مستوى الممارسة السياسيّة للشعوب، ويحدّد العوائق الحقيقية التي تقف حائلا أمام تحقيق مبادئ حقوق الإنسان في الدول الفقيرة ومسؤوليّة الدول الغنيّة والمانحة في تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، بدل الدعوة لها واعتمادها خطابا في المنابر السياسيّة وتوظيفها قناعا لمصالح الدول الغنيّة، بمعنى تحويله من مجرّد إعلان إلى تشخيص عالميّ لوضع حقوق الإنسان يتدخّل جميع البشر في إبداء آرائهم وطرح مشاكلهم فيه .
لا يخفى أنّ حقوق الإنسان تظلّ محلّ سؤال كلّما خرجنا من دائرة الخطاب إلى دائرة الممارسة، ويصحّ القول على الخطاب الديني الذي يظلّ أكثر انفتاحا في أنساقه لقبوله التأويل والآراء المتباينة حول القضيّة الواحدة، وتنوّع الممارسة التاريخيّة التي ترينا حفظا لحقوق الإنسان في سياقات تاريخيّة كان فيها الرقّ منتشرا وغير منكر، وكانت فيها الحرب ممارسة طبيعيّة بين البشر، ولكن كيف آل الأمر واقعا بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؟ هل شهد العالم نقلة نحو تحقيق هذه الحقوق أم أنّ الوعي بالحقوق صار يحمل الأنظمة والشعوب على إخفاء انتهاكاتها وتلوينها كي تبدو احتراما للحقّ أو حفظا للواجب؟
يكفي مثلا، أن نسوق العلاقات الدوليّة أنموذجا لحقوق الإنسان، وأن نرى احترام تلك الحقوق بين الدول القويّة والدول الضعيفة، وما تنتهجه الأنظمة الامبرياليّة من استغلال فاحش لثروات الشعوب الفقيرة ومحاولات للاعتداء على هويّتها تحت سقف مشروع العولمة الذي يأخذ الضعفاء في تيّار الأقوياء. وهل يصير التوزيع غير العادل للثروات وتفاقم الفقر مؤشّرا على نجاح الإعلان ونجاعته؟ لقد صار الدين ملاذ كثير من الشعوب المستضعفة؛ لأنّها لم تستطع أن تستثمر في سوق العولمة، فصارت تستثمر برأس مال رمزي في سوق المقدّس. ولهذا، فلا غرابة أن تجد تلك الشعوب في الخطاب الديني ملجأ لآلامها وآمالها مادام الإعلان مجرّد إعلاء لمصلحة القويّ وتشريعا لظلمه وبطشه على الشعوب الضعيفة.
وقد تبشّر العولمة ببعدها الإنسانيّ الواسع وحقوق الأفراد والشعوب في تقرير مصيرها، ولكنّها تمنع البشر من التنقّل نحو مصادر الثروة في الوقت الذي تجعل فيه تبادل البضائع والمصالح أمرا مقدّسا لا يجوز انتهاكه. وحين يجد الإنسان أنّ الجنّة الموعودة التي تبشّر بها العولمة أمر لا يمكن بلوغه يصير الالتجاء إلى الجنّة الرمزيّة في الخطاب الديني أمرا طبيعيّا، لأنها تصير في وعيه أكثر مصداقيّة .
ويشعر الإنسان العربيّ في كثير من الدّول التي تعتنق الإسلام دينا رسميّا ضربا من الاغتراب، وهو يطّلع على منظومة حقوق الإنسان في واقع يفتقد لأبسط ظروف العيش الكريم، ويحتاج منّا الأمر هنا حتما مراعاة الاختلافات التي يفرضها منطق الدولة القطريّة، ففي الوقت الذي لا تزال فيه المرأة تعيش وضعها التقليدي السالب لحريتها في كثير من الدول الإسلاميّة، نجد المرأة في دول إسلاميّة أخرى، مثل تونس تتمتّع بحقها في التعليم والمشاركة السياسيّة منذ عقود طويلة، وتأويل الخطاب الديني يقبل الحقيقة الأولى، مثلما يقبل الحقيقة الثانية وفق اتساع دائرة التأويل . ولكن مادام الخطاب الديني قابلا لهذا الاتساع في أفق التأويل، حتّى أنّه يمكن الحديث عن خطابات دينيّة تصل فيها الحقائق حدّ التضارب واتساع مجال الاختلاف، فإنّ المسألة تبقى حتما في يد المتحكّمين بزمام السياسات العالميّة، فتغزى بعض الدول وفق منطق نشر الحريّة، وتحمى دول أخرى تنتهك حقوق الإنسان، فشرطي العالم ما عاد عادلا، وهو المنفرد في الساحة الدوليّة، وما عادت تعنيه حقوق الإنسان، وإنما صارت قناعا شفيفا لمصالحه.
ونتيجة لذلك، فالأزمة الحقيقيّة ليست أزمة خطاب، وإنما هي في الحقيقة أزمة ممارسة؛ لأنّ الإعلان مثله مثل الخطاب الديني آليّة لتنظيم علاقة الإنسان بالإنسان، لا تبدو قيمتها فيما ابتكرته من مبادئ، فهي لا تعدّ فتحا معرفيّا، فالمسلم قادرعلى استخراجها تأويلا من النصوص، القرآنيّة والأحاديث النبويّة وسيرة السلف الصالح، ولكن الأزمة الحقيقية تظلّ في الممارسة. فهل يمكن القول إنّ حقوق الإنسان قادرة على أن تكون أكثر فاعليّة في قرارات الدول الغنيّة متى تضاربت تلك الحقوق مع مصالحها؟ ولماذا يظلّ الخطاب الديني وحده الموضوع في قفص الاتهام، باعتباره المتخلّف عن ركب حقوق الإنسان في مفهومها المعاصر؟ والحال أنّ ممارسة من أنشؤوا الميثاق العالميّ ذاته تظلّ متخلّفة عمّا أعلنوه من مبادئ، ويكفي النظر إلى القضيّة الفلسطينيّة وحقوق الشعب الفلسطيني لنفهم أنّ ذلك الحقّ لا يمنح للمهجّرين، وقد أخرجوا من ديارهم كرها، ولا يمنح لهم حين يُذبحون كالخرفان على يد من يريد التوسّع من اليهود، وحين تُصادر أراضيهم دون وجه حقّ، فلا يُدان القاتل وكثيرا ما يدان المقتول. وتستفيق حقوق الإنسان لجرح بسيط يصيب مستوطنا، وتلحق أشنع التّهم بمن دافع عن أرضه، فيصير إرهابيّا يهدّد السلم المدنيّ.
فلتنظر الأنظمة الغربيّة إلى ما فعلت ولتلتزم بمبادئ حقوق الإنسان، فإنّ تشبّثها بمركزيّة مصالحها صار أعتى من مركزيّتها الإتنيّة القديمة، فلقد فقدت العولمة بريقها لأنّها تقوم على قسمة ضيزى، ينال فيها القويّ نصيب الأسد ويحرم الفقير من الفتات .
ليست الأزمة في الخطاب، وإنما في التوزيع غير العادل للثروات والاستغلال الذي تمارسه الأنظمة الرأسماليّة على الشعوب الضعيفة، ومحاولتها تغيير الهويّات قسرا، وعدم قدرتها على جعل تلك الشعوب شريكة فعليّة في مأدبة العولمة. فالدين بطبعه يحاول استيعاب كلّ ما من شأنه أن يبدو للإنسان مقدّسا، لأنّ معتنقيه لا يريدونه متخلّفا عن المقدّسات الكونيّة، ولكنّ الحداثة تحتاج إلى إيجاد آليّة تنسيق بين الخطاب والممارسة كي تبدو مقولاتها أكثر إقناعا، خاصّة عند المشكّكين فيها. لقد جاء الإعلان تكفيرا عن شعور الإنسانيّة العميق بالذنب، وقد أفنت حرب المصالح فيها أكثر من خمسين مليون قتيل، ولكنّها عادت إلى نشوتها القديمة وشعور أنظمتها الطفوليّ بحبّ التملّك، فصار الإعلان يتباعد عن الممارسة، وصارت الحرب من نوع آخر تستهدف الاقتصاد وتدير الصراع على المصالح، وتحتكر قوانين حقوق الإنسان داخل حدود الدول القويّة، بينما يظلّ الإنسان خارج تلك الحدود من درجة ثانية قد يستباح رزقه وقد تداس كرامته، وقد يحرم من أبسط حقوق الحياة من أجل حفظ مصالح السادة في منظومة لم تتخلّص من منطقها القديم القائم على جدليّة السيّد والعبد، ولم تتجاوز عقدتها النفسيّة بحبّ الملكيّة ونزعة العدوان.
المصدر: http://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/articles/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D...
[1] انظر عبد الوهّاب المؤدّب ،أوهام الإسلام السياسي،ط1، بيروت ، دار النهار ،2002، ص11.
[2] يتناول القرضاوي مثلا قضيّة الديمقراطيّة فيذهب إلى القول بأنّ هذا المفهوم يظلّ غير دقيق فكلّ فريق يدّعي أنّه صاحب الديمقراطيّة الحقّة ويقصد الليبرالي والاشتراكي والشيوعي والفاشي والنازي ، ويتساءل مفتعلا الحيرة :" أيّ هذه الديمقراطيّات هو الأصيل وأيّها الدّعيّ ؟" وكأنّه في شكّ من استبداد النازيّة والفاشيّة وعلى غير وعي بالفرق بين الليبراليّة والشيوعيّة . انظر كتابه الإسلام والعلمانيّة وجها لوجه،ط7،مصر،مكتبة وهبة،1997، ص166.
[3][3] نصر حامد أبو زيد ، الخطاب الديني ،ط2،مصر ، دار سينا 1994.،ص166
