لماذا استثني العالم العربي والإسلامي من حظيرة العلم بعد أن كان من رواده؟
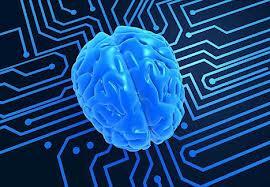
بقلم : حسن المصدق
مركز تاريخ أنظمة الفكر المعاصر، جامعة السوربون.
مؤتمر دولي حول آفاق العلوم المعاصرة في العالم العربي والإسلامي من وجهة نظر أوروبية وعربية.
نظم معهد العالم العربي في باريس، الشهر الماضي، في إطار الدورة الثامنة لمعرض الكتاب العربي الأوربي، وبمناسبة السنة الدولية للفيزياء، بالاشتراك مع جامعة باريس البينمناهجية، مؤتمرا دوليا حول مستقبل وآفاق العلوم في العالم العربي والإسلامي،، دارت أعماله حول ثلاث محاور توزعت بينها مداخلات العديد من العلماء ورجال الفكر والسياسة والتربية.
خصصت الجلسة الأولى لدراسة إشكالية "أي فلسفة للعلوم في العالم الإسلامي؟"، وهو سؤال يترجم ماهية هذه الفلسفة وأسسها ومنطلقاتها النظرية وأنظمتها المعرفية.
بالمقابل تمحورت الجلسة الثانية على "ما معنى أن تكون باحثا عربيا {في العلوم البحتة} اليوم؟"، وهو سؤال جد إشكالي يعكس طبيعة العلاقة بين وضع العالِم في المختبر ووضعه في الحياة الاجتماعية العربية بالقياس إلى مشاكلها وما يؤرقها من تحديات وما يتطلبه الوضع من أنجاز مهام جسيمة.
أما الجلسة الأخيرة فقد تم تخصيصها "لماهية السياسات العلمية التي يجب نهجها في العالم العربي" في ظل الفشل الكبير والبين لجملة السياسات والمخططات التي سادت وما زالت. ثم ما تطرحه تحديات العولمة، ومنها أن الطفرة التكنومعلوماتية سيَّدت المعرفة كسلطة للقوة والهيمنة. مما يفسر حالة الخضوع والخنوع التي عليها أغلب الدول العربية.
ترأس جلسة الصباح مؤرخ العلوم الفرنسي المعروف جون ستون، وافتتحها الأستاذ عبد الحق برينو كيدردوني عالم فيزياء الفلك ومدير وحدة أبحاث فيزياء الفلك والمجرات بالمركز القومي للبحوث العلمية بفرنسا بمداخلة ركزت على نوع المقاربات الموجودة في العالم العربي حول العلم من جهة وفلسفة العلوم من جهة أخرى، مشددا على الإشكالية الملتبسة بين العقل العربي والعلوم، وبينه والفلسفة.
لا مناص من الاعتراف أن جلسة الصباح شدّت الأنظار لعمق التحليلات التي قدمت وتنوعها وغنى المداخل النظرية والرؤى الفلسفية التي طرحت، بحيث شمل العرض الأول بالدرس والتحليل والنقد ثلاث اتجاهات كبرى:
وقبل عرض مفصل لذلك، طرح كيدردوني في مستهل مداخلته نقدا عميقا لمن اعتبر أن بنية العقل العربي والإسلامي لا تقوى على المعرفة العلمية، وتظل حبيسة النظرة الغائية. مذكرا بأن الدين لم يقف حائلا أمام العلم عند العرب، فهمبولدت مثلا يعتبر العرب المؤسسين الحقيقيين للعلوم الفيزيائية، فالتجربة والقياس هما أبرزا ما أخذته العلوم الطبيعية الحديثة منهم. ولعل المفكر الأمريكي داربر في كتابه: "النمو العقلي لأوروبا" (1857) يشير لهذه الحقيقة "تأخذك الدهشة أحيانا عندما تنظر في كتب العرب القروسطيين، إذ تجد آراء كنت تظن أنها لم تولد إلا في زماننا، كالرأي القائل بترقي الكائنات العضوية وتدرجها في كمال أنواعها. فإن بهذا الرأي بالذات كان يقول به العرب ويدفعون عنه في دراساتهم، بل يذهبون به إلى أبعد مما ذهبنا به نحن، حيث كان عندهم علما يشمل الكائنات غير العضوية بما فيها المعادن."
ولذلك فاعتبار الذهنية العربية ذهنية لا تستطيع أن تتجرد من إسار الإيمانيات والوثوقيات وتتعالى عن القدرية في التفكير وتغوص في الفهم وبناء الهياكل والأنساق المنطقية، أو أن تظل بحسب البعض حبيسة التحليل الجزئي المتناثر، عاجزة عن الخروج بمنظور فلسفي يربط بينها ويوحدها بهيكل منطقي متماسك قول مردود على أصحابه. فلم يمنع الدين العرب من خوض في أشياء جد حساسة لا نستطيع اليوم أحد منا نحن الخوض فيها دون زعيق وصياح أو دون الكيل بمكيالين!
ولقد استند أيضا في رده هذا بالرجوع إلى معنى لفظ القرآن ذاته، ليشير أنه مشتق من القراءة، وأن أول كلمة نزلت على محمد، هي "اقرأ" وفيها الأمر القوي المحكم، والتوجيه العلمي الملزم، لكل مسلم ومسلمة في كل زمان ومكان... إلى العلم والتعلم. كما أن أول قسم في القرآن كله، في ثاني آية نزلت بعد الأمر بالقراءة، صدر بحرف الهجاء، وكان بالقلم، شرف فيه الله القلم وأصحابه: "نون والقلم وما يسطرون".
واعتبر أن الإمام الغزالي ورؤيته التي تجمع بين العلم والأخلاق من منطلق المزاوجة بين معالجة "الصحيح" من "الخطأ" على نفس منوال عزل قيم "الخير" عن "الشر"، تعتبر رائدة في هذا الصدد. وهو في هذا الباب استعرض قوام النظرية الرشدية المزدوجة، والتي تقوم على اعتماد حقيقتين: حقيقة الوحي وحقيقة العقل. مما يؤكد في نظره أن فلسفة العلوم عند العرب لها قاعدة ثابتة في الأرض ولكنها متصلة في نهايتها بأسباب السماء.
<%2 52 Fb>% 3C/p>
وفي معرض استعراضه لما يجري في العالم العربي حول العلم والفلسفة والدين، فلقد عرض لأبرز الاتجاهات الموجودة في فضاء الفكر حول العلم في العالم العربي والإسلامي، هناك:
- الاتجاه الأول يدافع عن منظور واحد ووحيد للبحث الإسلامي العلمي، وهو ذلك الذي يربط جذور البحث العلمي وأسسه بمسلمات دينية، من حيث اعتباره أن القرآن يتضمن رؤية علمية سابقة عن الفرضيات والنظريات العلمية زمنيا. وهذه الرؤية أضافت من وحي اجتهادها مسلمة إعجاز القرآن العلمي لمسلمة الإعجاز اللغوي وأفرزت في النهاية حكما يقضي بوجود حقائق علمية في القرآن. وهذا المنظور يحمل في طياته حكما يقضي بحصر الطريق أمام إمكانية وجود طرق أخرى للبحث العلمي، ما دام أنه يعتبر أن العلوم الإسلامية التي تزاوج بين الدين والعلم هي النموذج الكوني الوحيد والجدير بالاتباع. ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه العالم الباكستاني محمد عبد السلام (1926- 1996) الذي يرى أن الذي أحكم الخلق وفصل الآيات في الأكوان هو سبحانه الذي أحكم الأمر، وفصل الآيات في القرآن.
وأسباب تدهور الحضارة الإسلامية في هذا الباب، يعتقد الحائز على جائزة نوبل أن انغلاق الفكر الإسلامي وانقطاع تفاعل المسلمين الإيجابي مع العصر وسيادة المقلدين ونزعة المحافظة المغالية عرقلت التجديد ووقفت أمام النهضة، من كانوا يرفضون تدريس الجغرافيا والرياضيات والفلسفة وعلم اجتماع ابن خلدون ويعتبرها علوم معادية للدين الإسلامي.
- أما الاتجاه الثاني فهو ينحو منحى نقديا للاتجاه الأول، ما دام أنه يعتبر أنه ليس هناك من طريق واحد في اتجاه العلم، بل يعتبر وفق النظرية التي قدمها الفيزيائي توماس كون، أن طريق العلم طريق منعرجات ومنحنيات، تارة يستقيم التوجه فتسود منطلقاته، وتارة أخرى تهوي مسلماته وتنقلب على نفسها فاسحة المجال لأخرى تصحح وتقوم ما بها من اعوجاج. وهذه الرؤية هي الأقرب لما وقع في تاريخ العلم لأن أي نظرية علمية غير كاملة، فلقد سادت هندسة أوقليدس برهة من الزمن، غير أنها هوت على يد هندسة نيوتن الميكانيكية التي اعتقدناها أزلية قبل أن تهوي بدورها أمام هندسة أينشتاين النسبية.
ولعل أبرز فكرة يدافع عنها هذا الاتجاه أن الحقائق العلمية ليست مجردة، كما نعتقد، بل هي محملة بعدة قيم. لذلك فهو يرى ضرورة تأسيسها على القيم الإسلامية بإعادة مراجعة أسسها المعرفية والنظرة الغربية التي تقول بفك الرؤية القيمية عن الرؤية العلمية السائدة في الغرب. وابرز ممثلي هذا الاتجاه اسماعيل راجي الفاروقي الذي أسس لعدة مراكز بحوث علمية إسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقيم.
- بالمقابل يتمحور الاتجاه الثالث الذي يتزعمه السيد حسين نصر على النقيض من ذلك، فهو يطالب بالعودة إلى العلوم الشرعية، لأن الفكر العلمي الغربي تطور في ظل السيطرة المادية وغلبة الرؤى المنفعية على أسسه ومنطلقاته. لذلك فهو يرى أن الحقيقة العلمية يجب أن لا تحالف الحقيقة الروحية ولا ينبغي لها ذلك، ما يمهد عنده بالعودة للتقليد الإسلامي في العلوم والعودة إلى العلوم الإسلامية القديمة، بخاصة منها الفلكية التقليدية! (على الرغم من كل فرضيات هذا العلم أسقطت فرضياته من طرف العلم الحديث سواء من طرف غاليليو ونيوتن وأينشتاين..). يتموقع هذا الاتجاه في ظل المطالبة والتأكيد على وحدانية الله والربط بين الأخلاق والعلم لصالح هذه الأخيرة.
ويخلص كيدردوني لرفض هذه الاتجاهات وصياغة بديل يضع على عاتقه المزاوجة بين الحقيقية العلمية والحقيقة الدينية من منطلق الفصل بينهما والحفاظ على التوتر بينهما، لأن كلاهما يخدم مصلحة البحث عن الحقيقة من منظوره الخاص، وهما وجهان لعملة واحدة. كما اعتبر أن الفرضيات العلمية فرضيات نسبية، تحتم علينا تقديم معنى لها وللغايات التي يتوجه إليها العلم أو توجهه، من منطلق رفضه للنزعة العلموية الوثوقية التي تتدثر بالحتمية. ويعتبر أن الأنموذج الجديد في العلم المعاصر بكافة اختصاصاته ومدارسه يقوم على النسبية واللاوثوقية وبرفض الحتمانية، إنه أفق مفتوح على جميع الاحتمالات، ومن هذا المنطلق يجب أن نتمثل هذه النظريات ونستشف أبعادها ومنطقها. والخروج من مستنقع تمجيد الماضي والاحتماء به، أو التعلق بنزعة علموية مغرقة في الحتمانية والوثوقية.
كما ينهي مداخلته بأن بذور هذا الاتجاه في طور النمو على يد علماء مسلمين أغلبهم مقيمون في الغرب، مما يمهد مستقبلا لتفاعل جيد مع العلوم المعاصرة، لا يتطاول عليها بالتقليد والماضي أو بوضع المنطلقات الروحية في مواجهة المنطلقات الوضعية. ولا يقف عند قيم هذه الأخيرة من منطلق خصوصيته الحضارية وانتمائه الروحي للإسلام.
أما المداخلة الثانية كانت لخبير فيزياء الفلك الجزائري نضال قسوم،الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالشارقة (الإمارات العربية المتحدة)، ابتدأ فيها بالسؤال عن ضرورة تحديد ماهية فلسفة العلوم قبل مباشرة أي ربط بين العلم والفلسفة والدين. ثم طرح مجمل المعيقات والمشاكل التي يتخبط فيها العالم العربي ومفهومه للعمل والبحث العلمي وكيف يمارسه، وهل هناك فلسفة تؤطر هذه الممارسة.
ويستفيض قسوم في طرح إشكالية تعريف لفلسفة العلم من منطلق أعم، يشير فيه إلى تنوع المنطلقات النظرية وأسسها المعرفية، فالفكر البشري ينقسم بشأن العقل إلى أكثر من تيار ومدرسة، فهناك النزعة النسبية والنزعة الحتمية والنزعة التفكيكية والنزعة التجربية، علاوة على أن هذه النظريات تعمم استعمالات شتى، فهناك من يقوم على الاستنباط وهناك من بقوم على الاستقراء.. ويعتمد النتائج من منطلق الصلاحية أو عن طريق الإثبات والصحة فحسب...
المهم يجب أن نعرف ماذا نقصد بالعلم قبل طرح نفس السؤال على فلسفة العلم. فالعلم يتضمن تمييزا أساسيا بين مظاهر الأشياء وجوهرها، ومن المستحيل أن نتوصل إلى حقائقها ما لم نفرق على وجه التأكيد بين ما هو عرضي في الأشياء وما هو أساسي فيها. أي استبعاد الصفات المتغيرة والاحتفاظ بالصفات الثابتة.
ينتقل بعد ذلك الباحث ليرى أن فلسفة العلم موزعة بدورها بين العديد من التيارات، بحيث هناك من ينطلق في تحليله للنزعة الواقعية التي تحاول إعادة إنتاج للعالم في قوالب ومنطلقات حسابية ورياضية، وهناك من يفضل منطلقات النزعة الموضوعية التي تقوم آلياتها على منطق الملاحظة والرصد بمعزل عن أي رؤية ذاتية. وعلى طرف نقيض هناك منهج النزعة التركيبية للظواهر والأشياء والعوالم الذي يسود اليوم.
وبطرح هذه الاختيارات، يعرج الباحث على الوقوف على ما يجري في العالم العربي، وتسمية الأشياء بمسمياتها، حتى نتمكن من تقديم رصد موضوعي لما يجري.
أولا، لا يحتاج تقديم الجواب كبير عناء، فالعالم العربي أبعد من أن يتمثل الإجراءات والقواعد العلمية الصارمة، بل أبعد من أن يتمثل أي منهج علمي بعينه. فلا النزعة التشكيكية معتمدة ولا النزعة التجريبية قائمة كليا، ما دام هذا الميدان يعج بالحابل والنابل ويسير عن غير هدى من أمره.
وفي هذا الباب ينادي نضال قسوم باعتماد المنطلقات العلمية بطريقة صارمة وتخليصها من أي مؤثرات كيفما كانت طبيعتها، ثم اللجوء إلى المناهج العلمية التي أثبتت صلاحيتها. ولعل وقوف الباحث على أبرز المصطلحات العلمية التي تحبل بها العلوم المعاصرة سيتبين حجم الفجوة واتساع الهوة التي تفصلنا ومرتكزات العلوم الحديثة. فمفردات مثل "التطور" و"الشك" و"المادية" و" العقلانية" و"الانتقاء" يتم النظر إليها في العالم العربي بكثير من التوجس والخوف واللاعقلانية والرهبة، بحيث يمكن القول دون إطلاق الكلام جزافا أن هناك سلوك مرضي مصاب بالانفصامية اتجاه العلم، إنه سمات عقل يؤمن بالتعويذة ويستخدم الكمبيوتر.
ففكرة المادية التي تثير كثيرا من اللغط، هي من كانت مثلا وراء انتظام الطبيعة وقانونيتها، وهي من سمحت بعد ذلك بالتدرج من اعتبار الكون مادة إلى اعتباره طاقة والإقرار بمعقولية العالم. إلا أن القول بها يصادف تشنجا يطرح أكثر من سؤال...!
ثم إن تزايد حجم الأمية العلمية يزيد الطين بلة، ويحول أمام أي نهوض. فإذ قارنا معدل الإنتاج العلمي في العالم العربي سنجد نسبة كارثية لا تتعدى 0.1 بالمئة، أما معدل حجم النفقات المرصودة للبحث العلمي فلا تتعدى 0.2 بالمئة من سائر الميزانيات المخصصة. ناهيك عن عدم وجود مجلات علمية محكمة، وإن وجدت كما هو حال مجلتين تصدرهما جامعة الدول العربية، فنسبة توزيعهما لا تتعدى ألف نسخة لعدد من السكان يقدر بـ 320 مليون نسمة!
ويخلص الباحث إلى أن العلم والنظرة الموضوعية للأشياء هي وسيلتنا الوحيدة لحل مشكلاتنا، فالعلم أقرب طريق للإنسان العربي نحو الموضوعية والنزاهة في الأحكام دون تحيز أو ذاتية، وتخليصه من النظرة الشخصية للأمور. ولعل الباحث في دفعه هذا يرى أن معالجة الأمور بالطريقة الموضوعية واستخدام آليات العلم ستجعل المواطن العربي يعالج ما يحيط به من مشكلات اجتماعية وفردية بنفس الأسلوب الذي يعالج به العالم الطبيعي ما يعرض له من مشاكل، ومن دون الحاجة لأن يتحول الجميع إلى علماء محترفين ومتخصصين.
أما الباحث محمد طاهر بنسعادة أستاذ الفلسفة بالمدرسة العليا إيليا بريغورين ببروكسيل، فلقد تخلل حديثه عن فلسفة العلوم في العالم العربي هاجس الربط الاجتماعي، ومؤداه أنه لا يمكن أن لا نربط في هذا السياق بين فلسفة العلوم وسوسيولوجيا العلوم، حتى نقف على أرض صلبة في رصدنا لمعالم هذه الأزمة.
ومن المرير القول أن ليس هناك اليوم من يعتقد أن العلوم ستظل حبيسة الأسوار الوطنية والدينية والجغرافية في ظل العولمة، لذلك يمهد الباحث لحقيقة جديدة مفادها أن سوق العلم لم يعد وطنيا، فهو الميدان الذي أصبح عابرا للأوطان بحق.
وفي معرضه رصده لما يجري في العالم العربي، اعتبر أن العلم كممارسة اجتماعية لا تتعدى سقف الاستهلاك، بحيث لا نجد أي إصدار أو إنتاج علمي نابع من صلبه منذ سبعة قرون. وللوقوف على أسباب ذلك، يستحضر الباحث نموذج الاندماج الذي وقع بين العلم والتقنية في الغرب أو بين الحرفي والتقني. وغاب كليا عندنا.
ثم محاولة استكناه العالم بنظرة كمية وعلمية تقوم على رصد الظواهر وتفكيكها والتخلص من الاستيهامات والتفسيرات السحرية للكون. في الوقت الذي أخلد العقل العربي الاستكانة للتفسيرات الجوهرية والغائية..
وللخروج من هذا الوضع الحرج، يجب علينا في نظر الباحث مجاراة ومحاولة اللحاق بفهم الأسس التي قام عليها العلم الحديث، سواء في صورته الميكانيكية عند نيوتن والوقوف على تطبيقاته الاجتماعية. منه محاولة فهم العالم في هذا الأنموذج كانت تتمحور كليا على السيطرة على العالم بأنظمة فيزيائية وحسابية، لأنه عالم يقع خارج اللغة، ومحاولة تطويعه تبدأ باعتباره حقيقة خارج اللغة. والعلم بمثابة المقاربة المرجعية التي لا غنى عنها، سواء للتعرف عليه أو التحكم فيه.
وبالوقوف على الأنموذج الجديد الذي حل محل هذا الأنموذج، يجب استيعاب حقيقة جديدة أن العلم لا يستوعب ولا يستوفي الواقع مهما بلغ، ثم إن العلم ليس هو مجموع القواعد العلمية فحسب، بل العلم هو أيضا ما يتهيأ بفضل التجربة والخبرة، لأن النظريات العلمية لا تستطيع تعليب الواقع واختزاله في أنظمتها على وجه الحصر.
وهو ما استوعبه العلماء اليوم جيدا، عندما اعتبروا أن العلوم بتطورها ونضجها أصبحت أكثر تواضعا وأكثر اقتناعا بالنسبية وأبعد من الترويج للوثوقية والحتمية، فالواقع أكبر تعقيدا من الموضوعية العلمية مهما حاولت سبر أغواره والنفاذ إلى أعماقه.
ومن شأن هذا الأنموذج الجديد أنه أعاد النظر في السؤال القديم والجديد، هل يوجد القانون العلمي في الطبيعة ذاتها، أو في الذهن البشري؟ أو هما معا؟
فالقانون العلمي الذي كان عبارة عن إدراك حسي يتم عن طريق الاختزال الذهني، فسح المجال للعلية (منطق العلية ملاحظة حدوث تعاقب معين وتكرار حدوثه ثم استمراره في المستقبل). غير إن العلم لم يقف عند حد ذلك، بحيث يستحيل اليوم القبول بقاعدة على وجه المطلق أو الجزم بها كليا، فالكل معرض للاحتمال وليس في وسع العلم أن يبرهن أو يثبت شيئا على وجه المطلق ولا التكهن بالسير في اتجاه واحد أو مجرى دون آخر.
فالعلية في الكون معقدة ولا تخضع للحتمية، وليست شبيهة بمثل رفع الحجر باليد، كما أن الإرادة ليست مبدأ كونيا، فإذا كان بوسعنا أن نصف طريقة حدوث ظاهرة، فليس بوسعنا أن نقرر لماذا حدثت.
ويخلص بنسعادة إلى ضرورة الربط بين فلسفة العلوم وسوسيولوجيا العلوم، لمعرفة نوع الاحتياجات التي يفرضها الواقع العربي والإسلامي. الأمر الذي من شأنه أيضا أن يعزز فهم المواطن باطلاعه على الاختلافات التي وقعت في التاريخ بين نماذج متعددة من المعرفة العلمية ومعرفة أسباب تمايزها وكيف تطورت...
على سبيل التحذير، الذي لا يخلو من دعابة وحكمة، اعتبر أن العالم العربي اليوم يعج بأنصار الديكارتية وحلفاء الميكانيكية وتفسير الكون وفق أنظمة علمية صارمة لا يأتيها الباطل من خلفها. والأخطر من هذا كله وجود ديكارتيون بدون ديكارتية، بالقياس إلى الزمن الذي ظهرت فيه.
والسر في هذا التنبيه، أن النظرة الميكانيكية والحتمية والسببية والوثوقية التي نشأت على غرار الفلسفة الديكارتية عاجزة اليوم عن الإجابة على مشكلات الإنسان وتفسير ظواهر الكون، ولذلك فالحذر كل الحذر من إسقاطات من هذا القبيل تريد تفسير الكون بمسلمات إيمانية وحتمية.
وإذا كان الباحث في سائر دفوعاته متشبث بتحليل الفيزياء الكوانطية للأشياء، ما جعله على طرفي نقيض مع المتدخل السابق، فلقد استمتع الجمهور بمعرفة سر التناقض الذي يوجه أسس المعرفة العلمية الموضوعية ويفصلها عن الأسس المعرفة العلمية النسبية.
أما الجلسة الثانية فقد ترأسها د. سليم بدوي رئيس تحرير إذاعة مونتي كارلو (راديو فرنسا الدولي للشرق الأوسط) والتي باشرها بطرح السؤال عما إذا كان هناك من موقع للعلماء والباحثين في المجتمع العربي.مؤكدا بصدقيته المعروفة أن لا انعزال لهؤلاء البحاثة عما يموج حولهم من قضايا وأحداث جسام، إذ أصبحت تؤثر عليهم بطريقة أو بأخرى ـ إن سلبا أم إيجابا ـ في أدوارهم.
وقام خبير فيزياء الفلك المغربي خليل شمشام، الأستاذ بجامعة أكسفورد، بتقديم مداخلة مركزة تمت فيها الإحاطة بملابسات الوضع المؤسف الذي توجد عليه العلوم في العالم العربي، فشتان بين الوضع الذي كان العرب يملكون فيه مفاتيح الحضارة الإنسانية، ووضعهم اليوم الذي ينذر بغياب أي ثقافة علمية الذي عزاه إلى غياب التربية العلمية.
ومشكلة المعرفة ليست جديدة، بالقياس إلى التخبط الحاصل في هوية من يشتغل بالبحث العلمي والأزمة العويصة التي يتخبط فيها العالم العربي. فالأمر لا يتعلق بنشر الأبحاث وإلقاء المحاضرات فحسب.
فالأزمة أعمق بكثير من ذلك وطريق الخلاص يمر لزاما بالبحث عن أي علم نريد وبأية مواصفات والوقوف على أعراض المرض المستشري بتوطين الوعي بمصداقية الحرية الشرط الأول نحو تعميق أبعاد الروح العلمية بين الشباب.
وأشار إلى ضرورة الانخراط الواعي في سيرورة التاريخ العلمية، بوصفها أنجع وسيلة يمتلكها الإنسان المعاصر للتعامل مع واقعه، وهو في هذا المنظور متشبث بمنظور كوني لبنية النظرية العلمية، ما دام أن الممارسة الصحيحة للعلم يجب أن تتم وفق المعايير الدولية الجاري بها العمل. إلا أن أولى الخطوات في رحلة الألف ميل تبدأ بحرية التعبير، فَدَيْدن العلم أن يجد تربة خصبة من الحرية تسمح له بالنمو، صوب مزيد من التقدم والكشف والمراجعة.
ولقد سبب غياب الحرية في العلم العربي فواجع كثيرة، أولها رحيل العديد من الباحثين الجامعيين عن أوطانهم تاركين البوم ينعق فيها، مفضلين اللجوء إلى الجامعات الغربية حيث حرية التعبير والكتابة مكفولة ولا أحد بوسعه الاعتراض عليها.
ولا غرو في أن يدعوا الباحث لتأمل الوضع كما هو عليه الحال في العالم العربي، لنخلص إلى غياب السياق الضروري والمؤهل للبحث العلمي، ناهيك عن وجود ميزانيات جد ضعيفة، لا تتيح للباحثين تمثل المعايير والمقاييس الدولية في أبحاثهم.
وفي هذا يمكن القول إذا كان من الناحية الواقعية الفعلية غياب وجود الشروط الموضوعية لبحث علمي يكمن في انعدام الحرية والتضييق على الباحثين، فهناك عدة مشاكل أخرى أهمها غياب السياق والشروط الذاتية التي تفرز بحثا علميا مسؤولا. فنحن ما زلنا لم نتجاوز آثارهما وما زلنا حبيسي النقل الميكانيكي للعلوم الذي من أبرز سماته تعثر حقل الترجمة وسقوطها في مستنقع التكرار والاجترار بعيدا كل البعد عن المساهمة ولو بمثقال في تغيير الوضع.
أما مداخلة خبير الفزياء الجزائري عبد الحق حمزة أستاذ الفيزياء في جامعة برينشويك الجديدة بكندا، فلقد تمحورت على العلاقة بين التربية والعلم، وكيف يتم صقل شخصية الأطفال منذ الصغر في التوجه نحو هذا الطريق أو ذاك. فانطلق من سرد قصة حياته الشخصية التي بدأها من حي جزائري صغير مذكرا بجهود والديه المضنية في تعليمه.
وعلى الرغم من أن عائلته كانت محافظة ومتمسكة بالتقاليد، فلقد كانت لهم رؤية جد متقدمة في تعليم أبنائهم، فلم يختاروا التعليم التقليدي ولا التعليم الحكومي، بل قررا تعليمه في مدارس مسيحية عند الآباء اليسوعيين في الستينات، حتى ينفتح عن قرب على ما يستجد في العالم ويتعلم اللغات الأجنبية، السبيل الذي أتاح له الانفتاح على آفاق أرحب وأوسع ومكنه من الحصول على أكبر فرصة ممكنة لشق طريقه في الحياة.
هذا عن تكافؤ الفرص، أما تعرضه لحيثيات المسار الذي انطلق منه، فلقد تعرض من خلاله لفهم عقليات مختلفة، منها العقلية الفرنسية وتركيبتها الذهنية، ثم بعد ذلك احتك بالشخصية الأمريكية في معهد ماساشوسيت الشهير. مما وضع قناعاته الشخصية على المحك وجعله متمهلا في أحكامه، لأن اقتحام أبواب الحقيقة ليس باليسير والهين وأن طرقه غير معبدة ولا واحدة أو وحيدة.
كل هذا دفعه لأن يعي حجم تضحيات والديه لتربيته تربية سليمة، تربية لا تقوم على معرفة أحادية الجانب، بل معرفة منفتحة تتيح له الاستفادة مما يعج به العقل البشري على اختلاف الحضارات والأديان والعقليات. وأن البحث عن التربية المؤهلة يبدأ بزرع البذرة وتركها تنمو بالرعاية والثقة في من يحمل تلك البذرة وأن يعود صاحبها على المسؤولية وتحملها.
وفي ختام مداخلته عرج على تجربته في أحد البلدان العربية بالخليج، بحيث قدم وصفا دقيقا لحالة البيروقراطية وثقل المساطر الإدارية المتبعة والانتظارية التي تطبع ميدان البحث العلمي. ابتداء من وصوله حيث وجد نفسه مجبرا على تسليم جواز سفره للسلطات المعنية، وكيف كان له أن يجتاز بصبر أيوب كل المراحل الضرورية لطلب إذن بالسفر للمشاركة في مؤتمر علمي أو ندوة علمية.
ثم عرج على ما هو عليه حال الشباب في هذه البلاد من تعطش وعدم عناية، فاعتبرهم بذرات تزرع في أرض صلدة، ما دام باب تكافؤ الفرص موصد أمامهم، وأنى لهم من حرية حتى يشقوا طريقهم في معترك الحياة...
بالمقابل ركزت المداخلة التي قام بها أستاذ فيزياء الجزائري الأصل غالب بن الشيخ، رئيس المؤتمر العالمي للأديان من أجل السلم على التذكير بحقائق تكشف عن دور العرب في حمل لواء المنهج العلمي طوال قرون، في الوقت الذي انحسرت فيه الحركة العلمية في أوروبا بعد أن أطبقت الظلمات عليه منذ أن منع الإمبراطور جوستنيان الفلسفة وحارب العلماء والمفكرين وحاول تدجينهم بالترهيب والترغيب.
فلقد شهدت العلوم نهضة كبرى لديهم وانتعشت الترجمات لأمهات الكتب اليونانية والهندية، فلقد ظهرت ترجمة كتاب "الأصول لأقليدس" أحد كبار كتب الهندسة قاطبة طوال قرونـ وتهيأت السبل بعد ذلك على يد إدرلاد الباثي الذي كان ملما بالعربية وترجمه من العربية إلى اللاتينية سنة 1120. هذا غيض من فيض عن القيمة الخطيرة التي نذر لها العرب جهدهم وأتت بثمارها، بحيث ترجموا وأضافوا ونقحوا وصححوا حتى تواترت إنجازات عديدة لديهم في الطب والجراحة والصيدلة... منه على سبيل الإشارة ابتكار أول نظام فلكي غير بلطمي في مرصد "مراغة" الواقع حاليا في شمال إيران حتى يعتبر ابن الشاطر أول من مهد لظهور العالم الفذ كوبرنيكوس. وهو ما يعرفه إلا القليلون.
وبطبيعة الحال مادام إن العلم ظاهرة إنسانية تنمو وتتدفق في سياق الحضارة الإنسانية وبفعل الإنسان، فلقد شارك في هذا المسعى كل الأقوام التي كانت تعيش في البلدان العربية والإسلامية، ولا أدل على ذلك من الحضور الفاعل للعرب المسيحيين في بناء معالم هذه الحضارة، حين كانت لغة الضاد، لغة العالم العلمية.
فلا بد أن نراهن على الإنسان إذن، غير إن الأمر للأسف في العالم العربي والإسلامي يئن تحت وطأة ظروف خانقة في ظل غياب موارد وميزانيات كافية ومشجعة للبحث العلمي. ثم أشار الباحث من جديد لمشكلة الحرية من جديد واعتبر أن مأساة تدريس العلوم في العالم العربي تكمن أننا ندرس علوما في غياب الاطلاع على الظرف التاريخي الذي أنتجها والسياق التاريخي والاجتماعي الذي مهد لظهورها. فمباحث تاريخ العلم وفلسفات العلوم متروكة في الهامش ولا تدرس، إن لم يمارس عليها التعتيم، مما يضبب الرؤية لدى الشباب ولا يعرفون كنه النظريات العلمية ومقاصدها والفلسفة التي توجهها ونوع القيم التي تحبل بها.
ولا غرابة يشير الباحث ويا للمفارقة! أن العدد الكبير من جحافل الطلبة الذين كانوا مسجلين في الشعب العلمية، هم من وقعوا فريسة التعصب والعنف في العالم العربي والإسلامي، لأن ما كانوا يتلقونه مفصول عن التاريخ والمنطق والسياق والدروس والعبر الذي اكتوى به العقل البشري في تاريخه الطويل.
ويضرب مثلا عن نوع الدروس التي كانت تلقى آنذاك في الكليات العلمية في الجزائر، مما يمجه السمع ولا يقبله منطق: "إن الخطان المستويان لا يلتقيان" إلا إذا أراد الله تعالى ذلك!
إن من شأن هذا كله بناء شخصية مزدوجة ومنفصمة، لأنها لا تستطيع الربط ولا التمييز بين الأشياء في حقل دلالتها، ناهيك عن التوفيقية التلفيقية التي تعتبر أن النظريات الفيزيائية تسبح في ظلال القرآن، محولة إياه إلى مدونة للعلوم أو كتاب في الفيزياء أو الرؤية النقيضة التي تبحث بكل ما لديها من قوة وجهد لدحض حقائق القرآن الإيمانية بحقائق علمية.
وبين هذا وذاك فلا سبيل للخروج من هذا المسار المأزوم رؤية ومنهجا إلا بقطع الطريق عن الدجالين والمشعوذين وفتح المجال للعلم وربط هذا الأخير بسؤال المعنى معنى الوجود، فالمعرفة الدينية لم تخلق لمعرفة قوانين العالم وفك شفرة رموزه، بل ليعرف الإنسان بها الله. والأديان تأتي كمنهاج لمعرفة طريق الله.
والحكمة التي يحاول الباحث التنبيه لها، أنه لا طريق التقليد مسعف لبلوغ شاطئ النجاة ولا العلموية قادرة أن تسد جميع منافذ القلق والتوتر الذي نعاني منه.
وفي الجلسة الختامية، تم معاينة نوع السياسات والبرامج العلمية التي يمكن سنها للخروج من النفق المسدود، لذلك كان من الطبيعي أن يسمح للخبراء ورجال القرار أن يدلوا بدلوهم في هذا الباب، وذلك من باب معاينتهم الميدانية لما يجري.
ولقد استهل مستشار رئيس معهد العالم العربي الخبير نيكولا جون بريهون منسق المحور الأخير بالتذكير بالمراحل التي قطعها البحث العلمي والجدال الذي عرفته قضية الربط بين العلم والوجود منذ عصر النهضة الأوروبية. وبعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ جاك فوتييه وزير سابق للتذكير بما اسماه بثورة الكبرياء التي قامت على الرياضيات منذ القرن السابع عشر حتى أصبح من المألوف لدينا الكلام عن التخطيط العلمي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي، وكلها مجالات أصبحت توجه بطريقة علمية منظمة، وكل نجاح يحرزه أي تخطيط إنما هو نجاح للنظرة العلمية التي وراءه. فمنذ الثورة العلمية التي أرساها عصر التنوير أصبحت جميع ميادين المجتمعات الحديثة تخضع للتنظيم العلمي المنضبط والدقيق.
فلا مجال للارتجالية والاعتباطية والتلقائية والعشوائية في عالم الألفية الثالثة. ومن اليوم بإمكانه الدفاع عن عدم اعتماد الأسلوب العلمي في معالجة الأمور محتال أو غبي.
وذكر بأن طريق العلم تأرجح دائما منذ جاكوبي (1832) وجوزيف فوريي بين المصلحة العامة ورد الاعتبار للعقل الإنساني، فمن سمات هذا العقل أنه ينجز التراكم المبني على التطوير والابتكار وتصحيح العثرات. غير إن البعض يفسر ذلك بقصور العلم، مما يدفع البعض لاتهام العلم والمعرفة العلمية بالقصور والضعف. وهو بذلك غير مدرك لسمة أساسية من سمات العلم أن العلم متحرك وغير ثابت، وهذه الحركة الدؤوبة يجب فهما أنها دلالة قوة وتجدد لا دلالة ضعف وقصور.
والذي يعنينا من هذا كله أن التنظيم القائم على المعرفة العلمية والتفكير العلمي القائم على التنظيم يتيحان أفضل تخطيط في هذا العالم المليء بالتشابك والتعقيد. ففكرة النظام والتنظيم هما أبرز إرث استخلصه الإنسان من المعرفة العلمية لتطويع هذا العالم والتحكم فيه. إذ اقترنت هذه الغاية بمعرفته وسبر أغواره والتحكم فيه، فالعلم منذ فيثاغورس غير منفصل عن هذا العالم حتى في أشد نظرياته تعقيدا، لدرجة أن هذا العالِم كان يود أن يفكر في العالَم ويستنطقه من منطلقات رياضية وحسابية بحتة.
ومن هذا الأساس توالت الجهود لتزويد الجنس البشري بأصناف من العلوم، توخى بها الإنسان السيطرة على الطبيعة وترويضها بالشكل الذي يخدم مصلحته.
بعد ذلك تناول أستاذ الرياضيات جورج حداد رئيس جامعة السوربون بانتيون السابق ورئيس رؤساء الجامعات الفرنسية ومدير قسم التعليم العالي بمنظمة اليونسكو حاليا، بالتحليل حقيقة أن تحدي العلم اليوم هو نفس التحديات المرتبطة بقضايا الحوار بين الحضارات والشعوب. فتاريخ العلم وتطوره منذ ديكارت وباسكال مقترن بالحوار الذي أتاح الفصل بين سائر العلوم وتخصصها الدقيق، بحيث انتقلنا من المعرفة الموسوعية إلى المعرفة المتخصصة والدقيقة. ولم يتأتى بلوغ ذلك من دون جهد وأعاصير.
وتظل أحد الفتوحات الكبرى في العلم تأسيس علم الجبر الذي ما يزال يحتفظ باسمه العربي كعلم مستوفي أحكامه وأدواته ومنهجه من التربة العربية، بحيث تم وضعه من طرف محمد بن موسى الخوارزمي قبل أن يخلفه عمر الخيام الذي جمع بين الشعر والرياضيات واستطاع أن يقدم حلا لعدة معادلات رياضية كانت جد مستعصية على الذهن البشري.
ومن المؤكد اليوم أن السؤال المطروح بحدة لماذا استثني العالم العربي والإسلامي من حظيرة العلم بعد أن كان من أحد رواده؟ والأهم من هذا كله كيف يمكن للعالم العربي والإسلامي أن يعيد بناء صرحه العلمي وذاته علميا في علاقة وطيدة مع ثقافتة. إذ يطرح الباحث نموذج الشعوب المحسوبة على الحضارات الشرقية، بخاصة منها الهند الذي فكت أغلال التخلف العلمي وبقيت وفية لثقافاتها المحلية، وتعتبر الهند اليوم من الرواد في المساهمة العلمية في العالم، بحيث تعتبر هي والصين العملاقين المقبلين من دون شك. وهو ما يطرح بالنسبة له مد الجسور بين العالم العربي وبين العوالم والحضارات القريبة منه لمزيد من التفاعل البناء.
ولا طريق أمام العرب إلا باعتماد طريق التربية الحديثة والمراهنة على الموارد البشرية وتكتل الجهود وتوحيدها، بحيث ضرب المثل بإعلان بولوني بإيطاليا (1998-1999) الذي حاول منه وزراء التعليم في كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا سن برنامج موحد حظي بالعديد من الاهتمام وامتد تأثيره اليوم إلى قرابة 47 دولة أغلبها من آسيا استطاعت أن تستفيد الشيئ الكثير من أوروبا عبر الشراكة العلمية.
أما الأستاذ رشيد بنمختار رئيس جامعة الأخوين بالمغرب، فقد اعتبر امتلاك ناصية العلم الرهان الكفيل بإخراجنا من مستنقع ما نتخبط فيه منذ سنين. وعرج في معرض حديثه أن العالم العربي ليس كتلة متجانسة ولا يمكن اعتماد معايير موحدة في هذا المجال، فالمشرق مشرق والمغرب مغرب وشتان بينهما، فهما اليوم برزخان لا يلتقيان.
وبتقديمه لإطلالة وجيزة ومحكمة الدلالات عن دور العلم اليوم في العولمة، اعتبره بمثابة الرهان الاستراتيجي الذي لا يمكن القفز عليه لتحقيق التنمية وإطلاق روح الانبعاث والمبادرة من جديد. وفي هذا الصدد أكد أن ذلك يتم أولا من خلال التفكير في واقع كل بلد عربي على حدة ومن منطلق حاجياته، ولو أن الإرث ثقيل والأعباء جسيمة ومشاكل الاندماج في العالم الحديث غير هينة وليست هي بالسهلة.
وقد ذهب إلى القول بأن المعيقات أشد بأسا، هي تلك الشوائب الثقافية التي علقت بذهنيتنا وأفرزت عدم الاهتمام أو قل قتلت الرغبة في حب الاستطلاع والنقد والشك... وحل محلها الجمود والتلقين والوثوقية والتعصب الجموح لها... والمشكلة هنا في نظره تربوية بالأساس، بحيث يلاحظ على المستوى الاجتماعي أن الطبقة التي يمكن أن نضع على عاتقها إنجاز ثقافة المبادرة والحرية والجرأة والمسؤولية، غير موجودة عندنا. بل هي مكبلة حتى النخاع بثقافة محافظة وبالية، فالطبقة البرجوازية المتوسطة في العالم العربي لا تمتلك نهائيا مواصفات نظيرتها الغربية، فهي على العكس من ذلك تماما محافظة وتقليدية، كل همها الحفاظ على مصالحها وإن تعارضت مع مصالح أوطانها. فالاستهلاك هو يافطتها المحببة وأما الابتكار أو المساهمة ففي خبر كان، مما يجعل من الصعوبة بمكان ردم الفجوة.
وقدم الباحث رؤية استشرافية طالب بموجبها الباحثون العرب بالجامعات الأجنبية الانخراط بكل جدية في جبر هذه الهوة السحيقة التي تفصل العالم العربي عن العالم المتقدم قبل أن تستحيل طوفانا يجرف كل ما حوله. مؤكدا أن العرب حاضرون كأفراد في العديد من المؤسسات الجامعية المرموقة، وإن كانت المؤسسات الوطنية ما زالت ضعيفة وإمكاناتها صغيرة. لكنه عبر بكل تفاؤل عن تجاوز هذه المعيقات بتكوين شبكات عبر الإنترنت تمكن العلماء والباحثين العرب من الانخراط في مقاربة كونية للعلوم، أملا في ردم الهوة السحيقة التي تفصلنا عن العالم المتقدم.
وكمسك الختام جاءت مداخلة الأستاذ سيف علي الحجري نائب رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع؛ بعرض مواصفات المدينة العلمية بالدوحة، أو بالأحرى" مدينة للعرفان " تحمل مواصفات ومقاييس وتعتمد معايير دولية وأنظمة جد متطورة، لا يجادل فيها اثنان. الغاية منها إحداث نقلة نوعية في ميدان التعليم في قطر مع مراعاة احترام الخصوصية الثقافية وهوية البلد الإسلامية، مشددا على استقلالية مؤسسة المدينة العلمية المادية والاعتبارية، لأنها تعتمد على صندوق مالي وطني ثابت لها، علاوة أنها مؤسسة غير حكومية ولا تخضع لقوانين الدولة. والتي تسعى لتحقيق نموذج مدينة كبرى للتعليم والمعرفة(على مساحة 10 م.م. مربع)، بتوظيف أحدث طرز المباني الحديثة المشبعة بالتكنولوجيا المعاصرة، تؤسس لمشروع أكبر مدينة علمية عالمية للفكر والمعرفة. تحتوي على متاحف وحضانة وثانوية وكليات ومراكز أبحاث ومركز لتربية الخيول العربية الأصيلة وكلية لدراسة الحضارة الإسلامية ومركب جامعي استشفائي رصد له مبلغ 8 مليار دولار.
غاية هذه المدينة العلمية أن تحيط بجميع مراحل التعليم، بدءا من التعليم الأساسي وصولا إلى التعليم الجامعي، وأن تستقطب لمشروعها أهم الجامعات والمؤسات العالمية (كورنيل، تكساس، جورج تاون...) والمعاهد الدولية (كمؤسسة الراند الشهيرة، و تضم عدة مختبرات للتفكير والرصد مختصة في الدراسات الاستراتيجية والمخابراتية والبحوث الأمنية والعسكرية)، لتشمل في هذا الإطار برامج الجامعات المصنفة العشر الأوائل في العالم. إذ يتم اعتماد برامجها الدراسية وشهاداتها وبحثها العلمي على يدي أساتذتها مباشرة.
وشدد على أن المحادثات مازالت مستمرة مع الجانب الفرنسي والبريطاني لكي تفتح جامعاتهما فروعا هناك، مذكرا بقرب افتتاح مركز علمي فرنسي قريبا في إطار هذه المدينة العلمية، كما لم يغب عن الأستاذ الحجري أن يذكر أن الكليات الخمس (حاليا) في علاقة وطيدة مع كبار الشركات العالمية (شال، توتال..)، بحيث يتم تدريس عدة اختصاصات علمية كالهندسة البترولية والتقنيات الإحيائية وعلوم الاتصال، بحيث يحذوها الهدف إنشاء منظومة متكاملة من المعارف تستقطب جميع الطلاب من العالم (حوالي36 جنسية حاليا)، غايتها ربط ومد الجسور بين الشعوب عبر المعرفة، تشارك فيه صفوة من أشهر الجامعات الدولية.
ولم يغفل د. سيف علي الحجري التذكير بأن غاية "مدينة العرفان الجديدة" هي إعداد كوادر مختصين في مخاطبة الغرب ومحاورته، يتم اختيارهم من صفوة الطلبة.
بتصرف عن : ميدل ايست اونلاين
