بعض معوقات الحوار الإسلامي - المسيحي وشروط تجاوزها
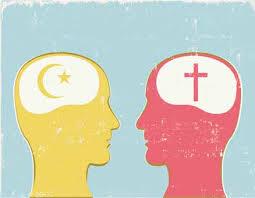
عبد المجيد الصغير
1 - إذا كنت قد فضلت اليوم الحديث عن مشكلة الحوار الإسلامي-المسيحي، دون بقية محاور هذه الندوة، فلكون هذا الموضوع يمثل شكلا من أشكال حوار "الإسلام والغرب"، بل إنه بالتأكيد أقدم أشكال هذا الحوار وأكثرها استمرارا في التاريخ المشترك للعالمين، الإسلامي والغربي، وإذا كانت محاور هذه الندوة توحي بأهمية "البعد الحضاري" المهيمن على موضعها الذي هو مشكلة العلاقة بين الإسلام والغرب؛ إلا أن هذه المشكلة الأخيرة لا تنحصر في مجرد التساؤل عن التلاقي أو التباعد، عن الانسجام أو التنافر بين أنماط اقتصادية أو سياسية بحتة، بل للمسألة بعد أعمق من ذلك يخص بالأولى أنماطا ونماذج من التفكير والرؤى للحياة وللقيم، إنها أنماط "حضارية" بكل ما تحمله هذه من خصوصية إنسانية…
وحيث إن العلاقة القائمة بين الأنماط والنماذج المختلفة هي في آخر التحليل شكل من أشكال التلاقي و "الحوار"، فإن هذا يدفعني إلى تأمل طبيعة هذه العملية الأخيرة التي هي "الحوار"؛ إن الحوار في أساسه يتضمن بالضرورة "اعترافا" بحق الاختلاف وبإمكانيته، إذ لا بد لعملية الحوار أن تكون مسبوقة بالاعتراف بالآخر المخالف، ولا قيام لحوار حقيقي يبدي فيه طرفا الحوار أو أحدهما "نفيا" للآخر…!
2 - وما دام الأمر هكذا، وحيث إن الحوار المعني هنا يتعلق أساسا بحوار إسلامي- مسيحي، فمن الممكن طرح السؤال الذي يفترضه المقام، وهو هل بالإمكان قيام "رؤية إسلامية" لصالح الحوار؟ أو هل يتضمن الإسلام "إرادة" للحوار؟ جوابا على مثل هذا السؤال دعوني أيها السادة أن أؤكد لكم أن بنية الإسلام في الأصل، ومنذ كان، بنية حوارية واضحة، يشكل فيها "الاعتراف بالآخر" أولى مميزاتها بل أساسا "اعتقاديا" فيها. ونستطيع القول إن القرآن لم يثبت شرعية وجوده ويدافع عن اختياراته وبدائله إلا عبر أخلاقيات الحوار والنقاش، بل ربما انفرد القرآن من بين نصوص الأديان الكتابية الأخرى بذلك الحرص القوي، الذي يطبع جل آياته، على محاولة طرح اختياراته الإصلاحية عبر أسلوب الجدال والحوار ومحاولة البرهان على اختياراته وبدائله، وإقناع مخالفيه بها. وما هو أهم من هذا "اعترافه" الضمني والصريح بذلك التراكم المعرفي والأخلاقي الذي يمثله تاريخ الديانات الكتابية وسيرها الحثيث نحو الإصلاح والتصحيح والكمال العقائدي والأخلاقي؛ الأمر الذي اقتضى من الإسلام، قرآنا وسنة، ضرورة "الاعتراف بالآخر" باعتباره مساهما فعالا في ذلك التطور الفكري والأخلاقي القابل دوما للإصلاح و "التتميم".
إن دفاع الإسلام عما اعتبره أصولا "جامعة" ومقاصد "مشتركة" بين كل الديانات السماوية يشكل بحق القاعدة الأساس التي بنى عليها الإسلام مشروعية رسالته، مثلما أقام عليها اعترافه بالمخالفين له، هؤلاء المخالفين الذين لم يكن بدا من أن تسري عليهم سنة التطور وضرورة الإصلاح والنزوع نحو الكمال، بحيث تصير منزلة الإسلام في سلسلة تلك التطورات ليست نفيا ولا نقيضا أو إنكارا بقدر ما تصير منزلة إثبات وتتميم ووضع "اللبنة" الأخيرة في صرح الرسالات السماوية والدعوات النبوية(1).
ومن المعلوم أن حرص الإسلام على الانتساب إلى ذلك "الأصل المشترك" بينه وبين المخالفين من أتباع الديانات السماوية قد تكرس مرة أخرى عبر اسمه الذي رضيه لنفسه ولأتباعه، ألا وهو "الإسلام"؛ حيث إن من شأن دلالة هذا الشعار أن تجعل المسلمين غير مرتبطين في ولائهم بجنس أو شعب أو بشخص من الأشخاص، بقدر ما أن ولاءهم متعلق بذلك "القاسم المشترك" من القيم العقدية والأخلاقية بين الأديان الكتابية وهو الذي يكرسه معنى الإسلام الدائر بين الخضوع لله وحده وإفراده بالوحدانية والتسليم له وتنزيهه عن الشريك.
إن من شأن هذا الإسلام أن يعمق لدى أتباعه ذلك الشعور بالوحدة الجامعة، وهو شعور يتجاوز الخلافات الظاهرة والعرضية ويرقى إلى معانقة تلك الوحدة الفكرية والعقائدية التي من شأنها أن تجمع بين الرسالات السماوية؛ إذ رغم تسجيل الإسلام لتلك الحقيقة الواقعية المتمثلة في اختلاف الشرائع والعادات والتقاليد "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"(2)، إلا أنه لا يلبث أن يعلو على مثل هذه الاختلافات الظاهرة والضرورية ليذكر أتباعه بوحدة الخطاب الموجه لسائر الأنبياء، ذلك الخطاب الذي توجه في الأصل إلى هؤلاء بقوله لهم "إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون"(3).
من ثم جاءت تلك التأكيدات المتتالية في القرآن تذكر المؤمنين به، قبل غيرهم، أنهم حلقة من سلسلة من تلك "الحنفية" التي يعتبر إبراهيم الخليل واسطة عقدها ولبنة أساسية فيها، وحيث ذلك أمر المسلمون في تعاملهم مع "أهل الكتاب"، ورغم الخلافات الواردة، أن يبادروا إلى الاعتراف بهم وأن يكونوا أكثر تفتحا وأبعد عن التعصب، وأن يقولوا: "آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيؤون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون"(4).
ذلك هو معنى الإسلام، وهذا هو إيمان المسلم، إيمان بقدر ما يحمل مشروعا للتكميل والإتمام ومتابعة الإصلاح(5) يتضمن بالضرورة اعترافا بالآخر ورؤية تدرك "الوحدة" الجامعة رغم الاختلافات الظاهرة.
3 - غير أن ما يلفت الانتباه ويستغرب له في تاريخ العلاقة بين الأديان الكتابية الكبرى أن ينكر السابق منها اللاحق، ويعترف اللاحق بالسابق عليه! فاليهودية في صورتها المقننة نفي واضح لرسالة المسيحية والرسالات السماوية… في حين أن المسيحية تقابل ذلك الإنكار بالاعتراف بالتراث اليهودي وتدعو للتعامل والحوار معه كتراث مشترك ومقدس، تشكل المسيحية صورة منه، وإن تكن متميزة عنه…
غير أن الموقف اليهودي من المسيحية تكرره هذه الأخيرة في صورتها الرسمية مع الإسلام! فهي تنكر نسبته إلى تاريخ الأديان الكتابية ولا تعترف به كدين سماوي ينتمي إلى سلسلة الدعوات الدينية الإلهية(6). في حين أن الإسلام، الآتي أخيرا، يقابل ذلك الإنكار المزدوج والمتبادل بين اليهودية والمسيحية ومنهما إلى الإسلام، يقابل ذلك الإنكار باعتراف مطلق، جعله منذ البداية يؤمن بإمكانية فتح باب الحوار مع حاملي "تراث مشترك" من شأنه أن يقرب ويوحد، أكثر مما يبعد ويفرق(7).
لسنا بعد هذا في حاجة إلى أن نذكر القارئ، وإن كانت الأمانة العلمية وأخلاقيات الصراحة تقتضي أن نذكر بذلك النشاط الإيديولوجي الذي قوبل به ذلك الاعتراف الإسلامي بالآخر وهذه "الدعوة" إلى الحوار مع مخالفيه من أتباع الديانات الكتابية؛ لقد قوبل الاعتراف الإسلامي بنقيضه وهو النفي المطلق، كما قوبل بالتصميم على سحق وجوده ومحو مصدر دعوته وتشويه صورته، سواء لدى الملتقطين لأخباره والمكلفين بالكتابة وإنشاء "معرفة" عنه، أو لدى المخيلة الشعبية لجماهير الناس في الغرب…لقد قوبل الاعتراف الإسلامي بذلك النوع من النشاط الأيديولوجي الذي نستطيع نعت تاريخه، باعتراف الأوساط المسيحية المعاصرة، بأنه كان مجرد تاريخ "للكذب" على الإسلام(8). الأمر الذي أضفى على ردود الفعل المسيحية القديمة طابعا أكثر عنفا وأغزر إنشاء وأبعد أثرا على المستوى الثقافي…
4 - من ثم كانت مثل هذه المواقف الموروثة من مخلفات القرون الوسطى الأوروبية تستوجب اليوم مراجعة نقدية وإصلاحا، حيث من الممكن بل من الواجب أن يبادر الجانب الأوروبي - المسيحي إلى إظهار إرادة في "النقد الذاتي" وإذابة جبال من جليد عدم الثقة التي أقامتها الأجيال السابقة أمام فضيلة الحوار، وزادها ترسيخا تاريخ الاصطدامات العسكرية القديمة والحديثة والمعاصرة.
والمظنون أن البيان الشهير للمجمع الثاني للفاتيكان (1962-1965) يمكن اعتباره، من حيث المبدأ، مساهمة إيجابية في الظاهر لإذابة الجليد وإزالة بعض تلك العوائق التي تحول دون قيام علاقة طبيعية بين الإسلام والغرب عامة، وبين الإسلام والمسيحية خاصة.
وحيث تأدى بنا الأمر إلى هذا الموضوع الأخير، ورغم اعتقادنا أن الثلاثين سنة التي مرت الآن على إعلان بيان مجمع الفاتيكان الثاني حول الحوار الإسلامي - المسيحي تقتضي هي الأخرى مراجعة نقدية لهذا البيان من حيث البنية والأهداف، إلا أننا اليوم نفضل أن نبقى في حدود "الممكن" ولا نطمح في الوصول سريعا إلى الأفضل، ونؤمن الآن على قيمة هذا البيان، إلا أننا نضطر أن نتساءل عن علة تلك الاستجابة المحتشمة والمواقف الريبية التي أحاطت إلى اليوم بتلك الدعوة إلى الحوار الإسلامي - المسيحي: هل بالإمكان وضع الأيدي على بعض العراقل التي تقف حائلا دون "وضوح النوايا" وإشاعة جو من الثقة بين المهتمين، عسانا إن تعرفنا على هذه العراقيل أن نزيحها من طريقنا و"نجدد إيماننا" عندئد بإمكانية تلاقي الإسلام والغرب وتفاهم المسلمين والمسيحيين؟
نلاحظ في البداية، ورغم كل ما يمكن أن يقال عن بطء تصحيح الأخطاء في "المعرفة" الاستشراقية حول العالم الإسلامي وحضارته، أن هناك تطورا ملحوظا وتصحيحا ذاتيا أو مفروضا يلاحظ في تلك "المعرفة" من حين لآخر… إلا أن ما يؤسف له أن الإنتاج الأوروبي الآخر والذي تمثله المجامع والأوساط الكنسية المتعددة المشارب، ورغم كونها أقدم وجودا من الاستشراق وكانت هي الملهمة له، فإن تلك الأوساط على ما يبدو لم تستفد من أخطائها التاريخية الكبرى ولا تزال تظهر من حين لآخر وهي أكثر تصميما على تنفيذ هد ف "البعثات التبشيرية" القروسطية الذي أعلن عنه خاصة قبل وعقب الحروب الصليبية؛ ذلك الهدف الذي لم يكن هو الحوار مع الإسلام، بل كان التصميم واضحا هذه المرة على تنصير جميع مسلمي ا لعالم وغزوهم إعلاميا وعقائديا في عقر دارهم عبر ما تتيحه وسائل الإعلام الحديثة من قدرة فعالة في ذلك.
فمن الملاحظ أنه رغم ما تعلنه تلك الأوساط المسيحية الرسمية المعاصرة على اختلاف مذاهبها من "نية" في الحوار ومن الرغبة في "التفاهم"، إلا أنها، خلافا لتلك النوايا المعرب عنها، تأتي من الأفعال مما يجعل كل ملاحظ نزيه يتأكد من أنها أكثر تصميما على العودة من جديد إلى نشاطها المشبوه القديم وإلى تجربتها القديمة مع الاستعمار؛ مستغلة هذه المرة مختلف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أعقبت الفترة الكولونيالية أو خاصة تلك التي أعقبت الأحداث الدولية المتتالية والمتسارعة من بداية سبعينات هذا القرن إلى تسعينياته (أي بعد الفترة الناصرية واتفاقية كامب ديفيد إلى حرب الخليج سنة 1990)، وبذلك تبين التنظيمات الكنسية والحركات التبشرية المرتبطة بها أنها غير مستعدة لتصحيح ذاتها؛ بل إنها أكثر مما مضى أصبحت تتخذ من "تاريخ الفشل" في التبشير القديم دروسا "للعبرة" لتطوير الوسائل وتحديث المناهج مع الإبقاء على نفس الأهداف الدائرة حول وجوب الغزو و"الاختراق"، خاصة بين أوساط الفقراء والعاطلين والمرضى والأطفال القاصرين كذلك!
5 - حيث وصل بنا المقام إلى مثل هذه العوائق التي تحول دون قيام حوار سليم وحقيقي ودون إعادة بناء الثقة مع الجانب الإسلامي، فلنمثل لتلك العوائق ببعض الوثائق -الشهادات المعاصرة التي أتت بعد أكثر من عشر سنوات من التزام الفاتيكان بطي صفحات الماضي واستئناف حوار يتضمن اعترافا بالآخر واحتراما لخصوصيته.
إنها شهادات - عوائق لا يمكننا إلا أن نعتبرها أشواكا تدمي قدم كل من يلج اليوم باب ما يعرف بالحوار الإسلامي-المسيحي.
أعتقد أن الأوساط المسيحية تضرب عرض الحائط بكل قيم الحوار حينما تعلن بعد أكثر من عشر سنوات من بيان الفاتيكان المنوه به أن غرضها من ذلك اللقاء الذي يعد أكبر تجمع كنسي في عصرنا الحديث والذي ضم أساطين ممثلي الكنائس العالمية بولاية "مولورادو" بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1978، أن غرضها إنما هو بالتحديد إعادة التخطيط "لعملية تنصير المسلمين" وابتكار مختلف الأساليب الجديدة الممكنة في سبيل ذلك. وإذا اكتفينا-لضيق الوقت عن التحليل- بالاستشهاد ببعض "المقررات" الصادرة عن ذلك الملتقى الكبير فإننا نقرأ فيها ما يلي:(9)
"هذه هي المرة الأولى […التي ] يُعقد فيها مؤتمر يضم هذا العدد من قاعدة المسيحيين ليناقشوا عملية تنصير المسلمين" كما نقرأ: " نحن بحاجة إلى مآت المراكز التي تؤسس حول العالم بواسطة النصارى للتركيز على الإسلام، ليس فقط لخلق "فهم" أفضل للإسلام، وللتعامل المسيحي مع الإسلام، وإنما لتوصيل ذلك الفهم إلى المنصرين من أجل اختراق الإسلام في صدق ودهاء"! لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع كل النصارى والكنائس الموجودة في العالم الإسلامي… ويجب أن تخرج الكنائس القومية [ في العالم الإسلامي ] من عزلتها، وتقتحم بعزم جديد ثقافات ومجتمعات المسلمين الذين تسعى إلى تنصيرهم. وعلى المواطنين النصارى في البلدان الإسلامية وإرساليات التنصير الأجنبية العمل معا، بروح تامة، من أجل الاعتماد المتبادل والتعاون المشترك لتنصير المسلمين". ثم "إذا كانت تربة المسلمين في بلادهم هي، بالنسبة للتنصير أرضا صلبة […] ووعرة […] أفليس بالإمكان إيجاد "مزارع" خصبة بين المسلمين المشتتين خارج بلادهم [ في بلاد الغرب ] حيث يتم الزرع والسقي والتهيئة لعمل فعال عندما يعاد زرعهم ثانية في تربة أوطانهم كمنصرين؟" غير أن الطموح إلى هذا الغزو المنتظم تتفتح شهيته أكثر حينما يعترف أنه "لكي يكون هناك تحول إلى النصرانيةفلابد من وجودأزمات ومشاكل وعوامل تدفع الناس، أفرادا وجماعات، خارج حالة التوازن التي اعتادوها. وقد تأتي هذه الأمور على شكل عوامل طبيعية، كالفقر والمرض والكوارث والحروب؛ وقد تكون معنوية كالتفرقة العنصرية أو الوضع الاجتماعي المتدني… وفي غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة فلن تكون هناك تحولات كبيرة إلى النصرانية. إن تقديم العون لدى الحاجة قد أصبح أمرا مهما في عملية التنصير. وإن إحدى معجزات عصرنا أن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية قد بدلت موقف حكومتها التي كانت تناهض العمل التنصيري فأصبحت أكثر تقبلا للنصارى".
ومن الغريب أن يعترف بعض المشاركين في هذا المؤتمر أن الغاية من بعض المجامع والنوادي الفكرية ليست هي الدراسات العلمية البحتة بقدر ما هي استغلال ذلك لأجل توظيفه في عملية التنصير ذاتها؛ ذلك أن المركز المسيحي للدراسات في "راولبندي بباكستان [مثلا] هو في الواقع مركز "للدراسات" الإسلامية، وهو يحاول أن يؤمن قاعدة للتفاهم المتبادل بين النصارى والمسلمين، وأن يعلم النصارى كيف ينصرون المسلمين بطريقة فعالة… وتسعى رابطة تنصير الأطفال […] لاستمالة الأطفال إلى جانب المسيح عن طريق تنظيم اجتماعات الأطفال وتجمعاتهم في مدرسة يوم الأحد وتقديم الوسائل السمعية البصرية لتشجيع الأطفال على تسليم أرواحهم للمسيح"!
والجدير بالإشارة أن مسألة الحوار الإسلامي-المسيحي لم تكن لتغيب عن ذلك الملتقى الكبير، لكن الأهداف الكبرى المهيمنة على رجاله فرضت عليهم تأويلا لمعنى الحوار ولمقاصده ينسف معناه من الأساس! وقد تم التساؤل هناك وبالحرف: "هل يمكن أن يكون الحوار بديلا عن الإعلان والدعوة المباشرة الصريحة [للتبشير]؟ أو أن فائدته مقصورة على فترة ما قبل التنصير، أي أنه أداة لتحريك الناس ليكونوا أقرب إلى النقطة التي تكون فيها النصرانية هي الخيار الحقيقي…؟"
وقد كان من رأي مجلس الكنائس العالمي، جوابا على هذا السؤال "أن الاشتراك في الحوار لا يعني على الإطلاق وقف المرامي التنصيرية"!! ومن الغريب أن يستخلص المكلف بملف الحوار جوهر المواقف الكنسية فيؤكد بقوله: " إني أعتقد وجود قيمة حقيقية في الحوار، سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي؛ فعلى المستوى الرسمي يمكن القيام بالكثير لتصفية المياه العكرة التي أثارتها قرون من الامبريالية الدينية والسياسية على كلا الجانبين… وعلى المستوى غير الرسمي فإن للحوار وظيفة طبيعية يمكن أن تفتح أبوابا للصداقات وتخلق "تفهما" متبادلا بغرض المشاركة في حقيقة الحياة كما يراها المسيحي وفيما لا يستطيع شخص مسيحي مخاطبا شخصا آخر في جو الحوار أن يقول: "اندم، وآمن بالكتاب المقدس ، فإنه يستطيع أن يقول: قد ندمت وآمنت، وهذا ما حدث لي…"!
ولنسجل أن هذا المفهوم الغريب والمحدد سلفا لمقاصد الحوار لا يزال على ما يبدو سائرا إلى وقتنا الحاضر، ويعترف بذلك الكاتب الروسي المسيحي المعاصر أليكسي جوارافسكي بقوله: "وفي الحقيقة تبرز هنا إشكالية العلاقة أو الصلة بين مفهومي الحوار و "التبشير". وقد جرت في المجمع الفاتيكاني الثاني محاولات [معزولة] لمقاومة النزعة الرامية إلى جعل الحوار ذا طابع إنجيلي تبشيري، كما ورد في مقررات المجمع… حيث وردت إشارات صريحة إلى أن مهمة الكنيسة الكاثوليكية… أن تبشر بالمسيح والمسيحية بين مختلف الشعوب. وكان موقف الكنيسة الكاثوليكية واضحا تماما حول هذه المسألة ومحددا تماما :الحوار "الحقيقي" يشكل إنجيلية بحد ذاتها"(10) وأعتقد أنه لن يفيد في طمس هذا البعد التبشيري القسري في مفهوم الحوار الإسلامي-المسيحي ذلك الالتواء حول المشكل والذي يشير إليه نفس الكاتب بتأكيده أن الكنيسة الكاثوليكية أصبحت اليوم تفضل استعمال صيغة "الاهتداء إلى المسيح" بدل صيغة التبشير أو "التحول إلى المسيحية"! وأن هذا لا يعد قضاء على الديانات الأخرى، بل هو يعمل على "نضجها الطبيعي؛ فالمبشر المسيحي - يؤكد الكاتب- يتوجب عليه أن يساعد في تسريع ذلك النضج" وتقريبه من "الخلاص"! ولا يجد الكاتب المسيحي غضاضة، وهو يتحدث عن ثقافة الشعوب الأخرى، في أن يستنتج بأن "هذا يلقي على عاتق المبشر دور القائد الروحي المؤثر في تكوين النخبة الفكرية المحلية"(11).
ذلك هو القصد المحدد، القريب والبعيد، من الحوار في التداول الكنسي المعاصر كما يقدمه لنا هذا الكاتب المسيحي الذي يعد من أكثر المسيحيين المعاصرين اعتدالا وتحمسا للحوار…
6 - ومهما يكن فذلك نزر يسير من الكتابات ومن ركام من المقررات الصادرة عن المجامع والمؤتمرات المسيحية القديمة والمعاصرة، وهذا هو تصورها لمعنى الحوار الإسلامي-المسيحي وأهدافه، ولست أعدم بعد هذا شهادات الواقع الحي المزكية لكون تلك المقررات تعرف باستمرار طريقها إلى التطبيق في غرب العالم الإسلامي أو شرقه؛ وإلا كيف نبرز تلك الميزانية الضخمة التي تفوق حقا ميزانية بعض الدول مجتمعة والتي يوفرها الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي مثلا لعملية تنصير المسلمين في أندونيسيا… لست أتحدث عن المستشفيات القارة والمتنقلة والمؤسسات الاجتماعية، ولكنني أتحدث عن المطارات الجوية والأساطيل البحرية والمحطات الإعلامية والصحف اليومية، ناهيك عن آلاف من الأطر البشرية المدربة؛ مما يجعل عملية التبشير في أندونيسيا وحدها حركة تستهدف صراحة المسلمين أنفسهم وحربا معلنة عليهم وخطة قائمة على قدم وساق؛ وهو ما أسفر مؤخرا عن قيام حركة انفصال جزئية تزعمها أحد الرهبان الذي لا ندري المغزى من ترشيحه في المدة الأخيرة لجائزة نوبل "للسلام"!
وأحسب أنه من المتعذر علينا أن نقنع اليوم تلك الأوساط الممولة لمثل هذه الحركات، تحت غطاء الإعانة الإنسانية، بأن تعرب عن نيتها "الطيبة" وعن محبتها للإنسانية، فتعمل على إرسال مثل تلك الميزانية الضخمة إلى دول تلك الشعوب ومؤسساتها الوطنية، فتتولى صرفها وتوظيفها لصالح المعوزين في المجال الصحي والاجتماعي، دون واسطة من تلك الفآت التي تصر أن "تبيع" خدماتها الضرورية مقابل إيمان المحتاجين!
نعم! من حق الديانات الكتابية، انطلاقا من طبيعتها المعروفة، أن تسعى إلى ممارسة "الدعوة" وإقناع الآخرين بقيمها ومبادئها؛ غير أنه حينما يخرج الأمر إلى التصميم على "سحق" الآخر المخالف والعمل على طرده من بيئته الأصلية، واستغلال الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية، والتوجه بذلك إلى الأطفال والقاصرين والنساء، وزيارة البيوت في غياب الآباء والأزواج… كل ذلك يعتبر في الواقع نسفا لأساس الحوار ومجرد إحياء للمواجهات القديمة. إن مفتاح الحوار وشرطه في عصرنا الحديث لا قيام له لدى الجانب المسيحي إلا بقدر استعداد وعي هذا الأخير أن يتخلص من ذلك الثقل الذي أثقله به قديما رايموند لول (1316م) حينما اعتبر الإسلام نقيضا وعدوا وموضوعا، بالتالي، "للمعرفة" التي لا تبغي غير التشويه والغزو والاختراق الفكري والمادي… وما نخشاه حقا أن يكون ذلك الثقل عاد ليتحكم بأشكال جديدة في علاقة الإسلام والغرب في سنواتنا الأخيرة.
كل ذلك كان من الممكن تصور وقعه في الفترة الاستعمارية السائدة، ولكن بعد تلك التطورات السياسية الهائلة في العالم، وخاصة بعد الإعلان عن حسن النوايا التي فهم منها تكريس إرادة "لطي صفحة الماضي" وفتح آفاق جديدة من الحوار والتفاهم والاعتراف بالاختلاف، فإن مثل تلك المواقف الكنسية الرسمية المعاصرة لتعتبر في الواقع انتكاسا حقيقيا وتراجعا عمليا عما قطعه الجانب المسيحي على نفسه بالالتزام بأخلاقيات الحوار وباستعداده للاعتراف بالآخر المخالف. ولا شك أن الجميع يذكر أن مدينة مراكش المغربية قد ضمت آخر سنة 1996 احتفالا رسميا قدم فيه رئيس "المجلس الدولي من أجل الحوار بين الديانات" بالولايات المتحدة الأمريكية ميداليته الذهبية إلى الملك الحسن الثاني، حيث اعتبرت تلك المرة الأولى التي تمنح فيها مثل تلك الميدالية إلى شخصية إسلامية… ولكن لم تأت الأفعال مخالفة للنوايا ومعرقلة لترسيخ فضيلة الحوار؟ هذا الحوار الذي أكدت كلمة الملك الحسن الثاني في ذلك الاحتفال أن الإسلام يعتبر مصدرا للقيم التي تكرس مفهوم "الحوار"…
7 - تلك بعض النماذج من العراقيل والعوائق والعمليةالتي تحول حقا دون الإيمان بجدوى قيام حوار إسلامي-مسيحي ودون زرع الثقة بين الغرب وعالم الإسلام.. إلا أننا لو رجعنا اليوم إلى اختبار ما تم على مستوى اللقاءات التي وقعت بالفعل في إطار الحوار الإسلامي-المسيحي، فإن هذه اللقاءات لم تكن فيما يبدو إلا انشغالا بالمشاكل الهامشية وتهميشا للقضايا الكبرى التي تهم المسلمين بقدر ما تهم العلاقة بين العالمين الإسلامي والغربي.
ولعل أولى التبريرات التي كانت تقدم لصالح تلك اللقاءات الإسلامية-المسيحية تكوين جبهة من المؤمنين" ضد "الإلحاد"… إلا أنه بالنظر إلى تلك العوائق العملية المشار إليها آنفا والمصممة على غزو المسلمين في عقر دارهم والهجوم على النساء والأطفال واقتحام منازلهم عليهم في غياب الأزواج والآباء، فإنه والحالة هذه لا يستبعد أن تكون نتيجة الحوار عكسية! وذلك حينما يكتشف المحاور المسلم أن "المؤمن" المسيحي الذي كان يحاوره بقصد مواجهة الإلحاد إنما كان يضلله بذلك فقط لجره إلى الخروج من الإسلام إلى المسيحية… وذلك قد يكون مدخلا سريعا للمسلم إلى الإلحاد، لا إلى الإيمان! وكأن المبشر أو المحاور المسيحي إنما يعمل في الحقيقة على نشر الإلحاد، وهو عكس المقصود!
هذا علاوة على مبررات أخرى ليست هذه مناسبة بسطها تتعلق بالمفارقة التي يشعر بها المسلم حينما يكتشف "كذب" نبيه ورسوله محمد (ص)، فيسهل عليه حينئذ أن يكذب ويشك في كل الأديان، وأولها المسيحية نفسها التي قد يراها أولى بالشك لأجل ذلك! لهذا فالتبشير المعاصر في الواقع يؤدي إلى عكس المقصود، يؤدي إلى الإلحاد، لا إلى الإيمان؛ وأخشى أن تكون بعض تصريحات كبار المبشرين تقبل بهذه الغاية وترضى بها بالنسبة للمسلمين!
ثاني المؤشرات الدالة على انشغالات لقاءات الحوار الإسلامي-المسيحي بالأمور الهامشية دون المشاكل الحقيقية، ذلك الغياب أو التغييب التام والمقصود للقضايا التي تشغل بال العالمين، الإسلامي والمسيحي، تمس في الصميم علاقة الإسلام بالغرب، وإذا ما صادف وطرحت في مثل تلك اللقاءات أو في المجالس الكنسية العليا بعض تلك القضايا، فإن التعتيم يكون سيد الموقف، وإذا ما تم التصريح والتوضيح فالموقف الرسمي المتخذ يكون هو الاجحاف وعدم الجنوح إلى العدل والإنصاف؛ كما هو الشأن حينما تثار في تلك المجالس المشكلة الفلسطينية.
ففي نفس الفترة التحضيرية للمجمع الفاتيكاني الثاني حول الحوار مع الإسلام قدمت ورقة بابوية موازية رسمية ترمي إلى "تبرئة اليهود من دم المسيح"(12). ثم قيل في مجلس الكنائس العالمي المنعقد بجنيف سنة 1974 أن "حق اليهود في كل فلسطين مسألة يسندها الكتاب المقدس"، أما حقوق الفلسطينيين فمسألة غير لاهوتية، إنها مجرد قضية أخلاقية!!
ونفس التهميش قد لاحظناه قبل ذلك في مؤتمر الحوار الإسلامي-المسيحي الذي عقد سواء في "عجلتون" سنة 1970 أو في "برمان" سنة 1972، وكلاهما عقد فوق أرض عربية، وهي لبنان؛ حيث احتج منظمو المؤتمرين بأن مشكلة فلسطين مشكلة سياسية، لا علاقة لها بالعقائد الدينية التي هي جوهر اهتمامات الحوار الإسلامي-المسيحي!(13) مع أن هناك لقاءات للحوار المسيحي-اليهوي يتم فيها بوضوح تزكية "حق اليهود في أرض الميعاد، كما حدث في أديس أبابا سنة 1971(14).
هذا فيما يخص الجانب السياسي الملح الذي يمسه ذلك الاجحاف والابتعاد عن الإنصاف في مثل تلك اللقاءات الثنائية. غير أننا على المستوى الفكري المحض قد لا نعدم بعض التوجهات التي نعتقد أنها لا يمكن أن تخدم الحوار ما دامت تسير في اتجاه معاكس للمصالح الطبيعية والمستقبلية للعالم العربي والإسلامي، وذلك من قبيل ما لوحظ في أكثر من مناسبة من محاولة بعض المشاركين المسيحيين في تلك اللقاءات بث روح الإتكالية والعداء للتقدم التكنولوجي بدعوى حماية الإنسان وإنقاذ "روحه" من أزمات العصر(15). ولا شك أن الخاسر الأول والأخير من مثل هذه الدعوى هو الجانب الإسلامي الفاقد اليوم لمثل ذلك التقدم الأوروبي!
ويتعلق بهذا الجانب الفكري أيضا ذلك الاتجاه الرامي إلى إحداث نوع من الخلط المشوه بين الثقافات واقتراح نوع من المزيج الشبيه بالمزيج "الغنوصي" الذي لا يحترم الحدود ولا يقر بحق الاختلاف؛ وقد سبق للأب ميشيل لولونج (M.Le Long) في ملتقى الحوار الإسلامي- المسيحي المنعقد بتونس سنة 1974، أن اقترح على مستوى القيم إحداث نوع من المزيج والخلط بين المفاهيم، تؤدي بالضرورة إلى تشويه الإسلام والمسيحية معا! من قبيل ضرورة حذف العبارات النقدية ضد كل جانب في النصوص الدينية الأصلية!(16) وضرورة التعاون بين الجانبين لكتابة مقرر تعليمي مشترك للتربية الدينية؛ حيث إن فكرة الله، مثلا، تكتب "مشتركة" انطلاقا من النصين المقدسين، جوابا على مثل هذه الأسئلة: ما هي السعادة؟ ما هو الشقاء؟ لماذا الشر؟ لماذا الألم؟ ما معنى الحياة والموت؟ ما دلالة التاريخ البشري…؟(17) وكأن صاحب هذا الاقتراح لا يقر بحق الاختلاف ويفرض هموما مسيحية خاصة على ثقافة أخرى. وليس هذا أبدا هو الهدف من الحوار الذي يقر أساسا بحق الاختلاف كما أكدنا منذ البداية… وشبيه بهذا ما عرفته بعض لقاءات الحوار "المتعدد الديانات" من إجراء فترات "للعبادة المشتركة" بقيادة بعض المشاركين، بحيث تلتقي الأرواح وتنمحي الاختلافات والرسوم والأشكال…!(18).
8 - تلك جملة من العراقيل والعوائق التي يمكن تلمسها في الواقع اليومي المعيش إلى يومنا هذا، والتي تحول في نظرنا دون قيام حوار حقيقي وسليم بين الإسلام والمسيحية؛ وهي العوائق المسؤولة في ظننا عما نجده من شكوك قوية في جدوى هذه اللقاءات لدى العديد من مثقفي العالم الإسلامي، فهل من سبيل لتجاوز تلك العوائق والإيمان بجدوى الحوار؟ وهل بالإمكان مطابقة الأفعال للنوايا الطيبة المعلن عنها؟
إن أبلغ ما نتمناه هو ألا تستغل الأوساط الكنسية، التي ازداد نشاطها منذ عقدين من الزمن، ما أصبح ينعث عند البعض "بالنظام" العالمي الجديد، وما أسفر عن هذا النظام من انتهاء صراع الشرق والغرب؛ فتعمل تلك الأوساط على توحيد الفكر الغربي وتوجيهه ضد "إبليس" جديد، وتعمد في سبيل ذلك إلى بعث جديد واستئناف عصري لنماذج كريهة من الأعمال اللاإنسانية من قبيل ما كانت تتميز به أعمال وأنشطة الكاردينال La vigerie (1892) أو الأب Ch. De Foucauld في المغرب العربي أثناء الفترة الاستعمارية، ولا حتى من قبيل بعض المحاولات المعاصرة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد المستقلة، كما حدث في شهر ديسمبر من سنة 1996 حينما سمحت دول السوق الأوروبية المشتركة لنفسها أن تصدر بلاغا "تحتج" فيه رسميا على دولة عربية إسلامية مستقلة وذات سيادة (الجزائر) لكون دستورها يؤكد على جعل اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد! ولا أظن أن في مثل هذه التصرفات ما يساعد على قيام حوار حقيقي خال من الألغام والعوائق…
نعم! من الخطأ اعتقاد أحد العالمين، الإسلامي والغربي، إمكانية استغناء أحدهما عن الآخر، وذلك ليس فحسب لكون عالمنا المعاصر أصبح أشبه بقرية كونية، بل لأن التاريخ قد حكم عليهما قبل اليوم ومنذ القديم بذلك اللقاء الأبدي الذي لا انفصام له؛ وذلك بحكم تجاورهما في المكان وبحكم تناوبهما على "قيادة" العالم القديم، وأيضا بحكم "اختلافهما" في تأويل ثقافة دينية "مشتركة"… الأمر الذي لا نجده متحققا بالنسبة لتلك المجتمعات الأخرى التي ظلت شبه منعزلة جغرافيا وثقافيا، كما هو الحال بالنسبة للصين أو اليابان.
وربما كان من سوء حظ العالم الإسلامي، وهو يريد أن ينهض من كبواته المتلاحقة ويخرج من عصور الانحطاط، أنه يحتل من المواقع وسط العالم القديم ويجاور أوربا الناهضة؛ وأحسب أن لو كانت اليابان تحتل نفس موقع العالم الإسلامي من الغرب لما سلمت من ملاحقات ومطاردات المارد الأوربي، ولتعرضت إصلاحاتها في القرن التاسع عشر لما تعرضت له إصلاحات الدولة العثمانية أو مصر أو المغرب من عوائق عديدة لا تحصى… غير أني أعتقد مع ذلك أن هذا الجوار في المكان وذلك الاشتراك في الزمان حرى أن يشجع على الحوار ويتوسل إليه بأفضل السبل الممكنة.
لأجل هذا، إذا كنا سنؤكد وشيكا أنه لا حوار خارج "العلم" والبحث عن الحقيقة العلمية، فإن ذلك معناه أنه لا غنى للحوار عن "التسامح"، بشرط ألا ينطوي هذا المفهوم على معاني ملغومة، تجعله سلاحا بيد الأقوى، وتنفر منه الضعيف وتجعله يلجأ إلى مختلف الوسائل للدفاع عن النفس، فالحذر أن يصير مفهوم التسامح نفسه "سلاحا" خفيا للاختراق واستغلال الفرص(19)؛ ولا تزال ذاكرة العرب المحدثين محفورة بالتاريخ الأسود لنوادي الماسونية و "الروطاري" التي لم تكن تجعل من مبدأ التسامح إلا وسيلة للتشويه ثم مقدمة للاختراق…
9 - ومهما يكن، فإذا كان التسامح هنا مطلوبا في مثل مواطن الحوار الإسلامي-المسيحي بالتحديد، فيجب أن نسجل أن هذا النوع من الحوار ممارس بالفعل في التجربة الإسلامية على المستوى العملي والواقعي بين المسلمين والمسيحيين في المشرق العربي منذ قرون خلت، وقد أظهر هذا الحوار العملي الشعبي فعاليته وإيجابيته… أما إن أريد بالحوار مثل ذلك الذي يدعو إليه المجلس العالمي للكنائس أو ذلك الذي صدرت بصدده مبادرة المجمع الثاني للفاتيكان، فإن هذا الحوار في رأينا يجب أن يندرج بالأولى في إطار حوار إسلامي-غربي بالأساس.
وعليه فلم لا يأخذ هذا الحوار أبعاد الثقافة الغربية في جملتها؟ مبتعدا عن تلك "التحديدات" الكنسية التي رأيناها تضيق من أفق الحوار بين الإسلام والغرب، والتي ربما حجبت عنا، بسبب ذلك، الأبعاد الإيجابية لإمكانيات الحوار ونجاحه، الأمر الذي يعني أن تلك "العوائق" التي لاحظناها تحول دون قيام حوار إيجابي والتي توشك أن تنسف به، إنما هي آتية في جملتها من التنظيمات الكنسية الغربية أو من بعض الأوساط الشرقية القليلة التي استقطبت من طرفها، وقلما نجد مصدر تلك العوائق من الأوساط المسيحية الشرقية(20).
في ضوء كل ذلك نؤكد من جديد أنه إن أريد إنقاذ الحوار الإسلامي-المسيحي وإزالة العوائق من طريقه فالواجب رفع مستوى هذا الحوار إلى حوار "مدني"، يتم فيه توسيع قاعدته ليصبح حوارا "ثقافيا" غير مطبوع بطابع "كهنوتي" قائم على احتكار للمعرفة؛ إذ الغرب نفسه، منذ عصر النهضة، لم يعد يقبل بمثل ذلك الاحتكار؛ بل إن "الحقيقة الدينية" نفسها أصبحت ملكا للجميع، وخاصة للدارس الباحث والمثقف، ونعتقد من جهتنا أن كل مسلم قابل، بل إنه مؤهل للدخول في مثل هذا الحوار مع الغرب، بحكم عدم اعترافه بذلك النوع من الاحتكار للمعرفة وللمقدس؛ إذ العلم نبراسه، والحقيقة هدفه.
وحيث أن توسيع دائرة الحوار أمر واجب، فالأفضل إخراجه من نطاقه الضيق الذي طبع به لحد الآن، والذي صار بسببه وكأنه لا يتم إلا تحت مظلة كنسية محضة وعبر محاور عديمة الجدوى في علاقة الإسلام والغرب، كتلك المحاور التي سبق وأن اقترحها مجمع الفاتيكان الثاني (وهي: الوحدانية، التقليد الإبراهيمي، الدراسات المسيحية لدى الجانبين، الدراسات المريمية، مسائل الآخرة، التعاليم الأخلاقية، العبادات)(21).
لهذا فإن المسيحي المعاصر، بل إن كل مفكر ينتمي لدائرة حضارة الغرب، لا يمكنه أن يكون وارثا للتراث النقدي الذي دشنته أوروبا عصر النهضة إن لم ينتبه ويعطي الدلالة الكاملة لتلك الاعترافات التي صدرت، في زمننا المعاصر، من مجامع كنيسة وأوساط وكتابات مسيحية متخصصة؛ اعترافات بتلك الأخطاء المعرفية الكبرى والاتهامات المزورة التي أنشئت وصيغت صياغة عقدية رسمية ثم رمى بها الإسلام.
ولا أدل على مبلغ تلك "الحرب الإعلامية" القديمة وتغلغلها في النفوس أن الإنسان الأوروبي المعاصر قد استطاع التحرر من جل ما غذته به ثقافة القرون الوسطى وأعاد النظر فيها، ومارس عليها مختلف أنواع "النقد التاريخي"؛ إلا ما تعلق بما ورثه عن المعرفة الوسطوية حول الإسلام! فإنه لا زال يعرف ترسخا في النفوس يستعصى على الاستئصال والمراجعة النقدية حتى بعد الدعوة إلى تصحيح أخطاء الماضي…!
وعليه، فمن غير المقبول بالنسبة للمثقف الغربي، هذه المرة، ألا يستنتج، في ضوء التقليد الفلسفي الديكارتي المعروف، أن وقوعنا في تضليل بعض مصادر المعرفة وانخداعنا بها، ولو مرة، واحدة، يستوجب بالضرورة إفراغ كل محتويات ما امتلأ من تلك المصادر والشك في صدقها وإعادة البحث مجددا عن الحقيقة، والحقيقة وحدها.
والحقيقة هنا لا قيام لها إلا اعتمادا على المراجعة التاريخية و "النقد التاريخي" لتطور النظريات الدينية والذي يتماهى مع التطور العام الفكري والفلسفي ضمن تاريخ البشرية الواحد.
10 - وأخيرا، ومهما يقال اليوم عن فضيلة الحوار وحق الاختلاف، إلا أن هذا الحوار ليس من المؤمل أن يقتلع في وقت قصير تلك الجذور المتمكنة من النفوس والتي كانت تجعل محل الحوار العداء والمواجهة… وعليه لا بد من الانتباه إلى أن مرحلة ميلاد هذه الدعوة إلى الحوار قد تخفي بقايا نوايا التربص والحصار والمواجهة. فإذا قيل مع ذلك إن الحوار ضروري لكونه أنسب لروح العصر، فالخشية أن يكون اللجوء إلى الحوار مجرد تغيير في "الأسلحة" مع الإبقاء على نفس النوايا الإقصائية. لذا من المفيد في كل طرح لمسألة الحوار العمل على كشف وتعرية تلك النوايا السيئة التي لا تزال كامنة وراء بعض الدعوات إلى الحوار الإسلامي-المسيحي؛ وذلك لن يتحقق في رأينا إلا بالنظرة الكلية للجهة الداعية إلى الحوار، بحيث لا يجب أن تقع هذه الأخيرة في مواقف مزدوجة ومتناقضة بين دعوتها إلى الحوار وعملها في نفس الآن على نسفه بمختلف وسائل الإقصاء والتربص والتشويه والتخطيط "للإختراق"(22).
هذا ما تعلق بضرورة مراجعة قاعدة وبنية الخطاب الداعي إلى ممارسة فضيلة الحوار. أما من حيث منهجية العمل، فلا قيام لأي حوار دون اعتماد الأسلوب العلمي المحض القائم على المراجعة الموضوعية للمواقف وللمكونات الثقافية والعقائدية للطرفين المتحاورين؛ إذ ليس الحوار بالمداراة والنفاق والسكوت عن المناطق المحرمة، فهذا لن يخدم الحوار الإيجابي، بل الحوار يرمي إلى القبول بالمراجعة النقدية الشاملة قصد البحث عن نقط الالتقاء ومواطن الاختلاف أيضا، مع احترام حق هذا الاختلاف n
وفي كل ذلك دليل، كما قلنا، على وجوب توسيع دائرة هذا الحوار الإسلامي-المسيحي، كي يصير حوارا إيجابيا بين الإسلام والغرب، قائما على أبرز ما في ثقافتيهما من قيم لا شك أنها منذ عصور خلت قد أثبتت قدرتها على مد جسور من التفاهم ومن العلاقات الإنسانية النبيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - في الحديث النبوي" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"؛ قارن بالحديث الآخر الذي يشبه فيه الإسلام "باللبنة" الأخيرة في صرح البناء الواحد للأديان السماوية… أنظر عباس محمود العقاد، العبقريات الإسلامية، القاهرة:دار الفتوح للطباعة، د.ت.، خاصة ص 113-125.
2 - قرآن، المائدة، 48
3 - قرآن، الأنبياء، 92
4 - قرآن، البقرة، 136؛ قارن بنفس السورة، آية 285
5 - "وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه" قرآن، المائدة، 4 8إ ن هذا الاعتراف يتضمن ويقتضي تكميلا وتقويما بحكم التأخر الزمني والتراكم المعرفي، وبحكم اغتناء التجربة الدينية للإنسان وإمكانية التقويم الشامل…يصدق هذا على المسيحية تجاه اليهودية، وعلى الإسلام تجاه الأديان السابقة عليه. ومن هنا معنى الإشهاد الوارد في الآية الأخرى، "وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لتكونوا شهداء على الناس" البقرة، 143 والإشهاد هنا يحتمل معنى الاخبار والعلم والتقويم العادل المترتب عن ذلك التأخر الزمني والتراكم المعرفي.
6 - انظر التحفظ والشك الذي أبداه المجمع الكنسي، وهو الصورة الرسمية المعاصرة لموقف الكنيسة من الإسلام، من انتساب الإسلام إلى ملة إبراهيم، أو من كون المسلمين يعبدون "الإله الواحد الرحيم"! قارن: أليكسي جورافسكي،الإسلام والمسيحية، الكويت، عالم المعرفة، ط1، نوفمبر 1996، ص 146-148 (ترجمة محمد الجراد).
7 - بديهي أن اليهودي والمسيحي لا يشعران بحرج ديني حقيقي حينما تنتهك حرمات ومقدسات المسلم؛ في حين أن هذا الأخير يأبى عليه إيمانه واعترافه باليهودية والمسيحية إلا أن ينزل حرماتهما ومقدساتهما منزلة حرماته ومقدساته الخاصة…
8 - قارن جوارافسكي، الإسلام والمسيحية، مرجع سابق، الفصل الثالث والرابع.
9 - النصوص المستشهد بها هنا منتزعة من دراسة د.محمد عمارة لمقررات هذا المؤتمر والتي صدرت ترجمتها العربية عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن بعنوان: التنصير خطة لغزو العالم الإسلامي؛ انظر عمارة محمد،استراتيجية التنصير في العالم الإسلامي، دراسة في أعمال مؤتمر كولورادو لتنصير المسلمين، مالطا، مركز دراسات العالم الإسلامي، ط1، 1992
10 - الإسلام والمسيحية، مرجع سابق، ص 170.
11 - نفسه، ص 171، والجدير بالإشارة هنا أن النموذج الذي يقدمه الكاتب لمثل هذا الدور المنوط بالمبشر المعاصر هو أندونيسيا الذي يعترف مع ذلك بأنها من الدول "الإسلاميةّ! والملاحظ من جهة أخرى أن تاريخ المسيحية الأولى يشهد على هذه النزعة الانتقائية (Ecléctiste) في التعامل مع "الغنوص" والعقائد القديمة ومحاولة استيعابها وتدجينها.. وشبيه بهذا الأسلوب تكرره اليوم الكنيسة المعاصرة… ولا أحسب أن مشاركة الأوساط المسيحية فيما يسمى بـ"مهرجان الموسيقى العريقة" المقام هذه السنوات الأخيرة بقلب مدينة فاس المغربية بمعزل عن تلك الرغبة في "توظيف" مفهومي الحوار والتسامح لأجل إعادة الاختراق و"الاهتداء" إلى الخلاص…!
12 - جورافسكي، الإسلام والمسيحية، ص 138-139.
13 - انظر: سليمان، وليم، الحوار بين الأديان، الهيأة المصرية العامة للكتاب، 1976، ص 61-62، 69-70.
14 - نفسه، ص 6-7، 38-39؛ وأن التفكير في تبرئة اليهود من دم المسيح في هذه الظروف دليل قوي على ذلك: ذلك أن كل مسيحي يساهم في الحوار بين الأديان "يجب عليه أن يبدأ فورا بالاعتراف بالعلاقة المشؤومة بين اليهود والمسيحيين، وعليه أن يقدم توبة عن ذلك" Johan Snock, Jewish-Christian dialogue Today؛ نقلا عن المرجع السابق، ص 39، هامش 2. ولا نحتاج هنا للتذكير بذلك التباين بين مواقف الفاتيكان والغرب من استقلال "لتوانيا" ودول البلطيق وضغطهم القوي على الاتحاد السوفيتي سابقا لأجل منحه الاستقلال لهذه المنطقة المسيحية الخالصة، مقابل سكوتهم عن الأحداث الدامية في "الشياشان"…ونفس الموقف لوحظ في موقف الفاتيكان من استقلال "كرواتيا" وعدم تحمسه لاستقلال "البوسنة والهرسك"…!
15 - من جملة "القصص" التي كانت تروجها بعض المراسلات التبشيرية داخل العالم العربي، تأكيدها أن الحرب الأهلية بلبنان إدانة صريحة للتقدم التكنولوجي وإشارة إلى الفراغ الروحي الذي ليس له من حل سوى تحول الجميع إلى المسيحية، وليس في تحقيق الأهداف السياسية الديمقراطية…!
16 - وهو نفس ما اقترحته " إسرائيل" في نفس الفترة على مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد!
17 - انظر: P.M. LE LONG Pour une recherche dans le domaine de l'enseignement religieux
ضمن الملتقى الإسلامي-المسيحي، قرطاج-الحمامات-القيروان: 1974، ص 167-170 من القسم الفرنسي.
18 - كما حدث ذلك في "عجلتون" بلبنان سنة 1970، انظر وليم سليمان، مرجع سابق، ص 49-50.
19 - لقد نبه كثير من الإصلاحيين في الدولتين العثمانية والمغربية في القرن التاسع عشر إلى أن مفهوم التسامح الذي كانت تفرضه الدول الاستعمارية على المجتمعات الإسلامية لم يكن إلا قيمة "ملغومة" ترمي إلى خلخلة الوضع الاجتماعي والاقتصادي تمهيدا للتغلغل الاستعماري…
20 - قارن الحوار بين الأديان، مرجع ساق، في مواطن عديدة.
21 - الإسلام والمسيحية، مرجع سابق، ص 144.
22 - إن المقررات الخطيرة الصادرة عن مؤتمر "كولورادو" لتنصير العالم الإسلامي، المشار إليها آنفا، تعتبر بالفعل مثالا صارخا للتناقض بين الدعوة إلى الحوار والعمل على نسفه من الأساس!
